"وريدة" البنغازية ذاكرةُ (سوق الحشيش) بين النوستالجيا والأنطولوجيا
تواصل الكاتبة الليبية تسجيل إضافاتٍ إبداعية مهمة في جنس الرواية السردية الذي يتيح لنا فرص الإبحار في فضاءات زمنية ومكانية متعددة تكتسي الكثير من الجاذبية والإمتاع والتشويق. ولا شك بأن العلاقة بين المرأة عموماً والأجناس السردية الأدبية هي علاقة عشق قديمة ترجع بنا إلى حكايات ألف ليلة وليلة التي طرزتها شهرزاد بالكثير من العذوبة والتشويق مرتكزة على عنصر اللغة وتركيبات جملها وتعدد مفرداتها المتنوعة، لتوطين عوالم من البهجة الحسية والفكرية في فضاء السرد غايتها إرواء ظمأ ولهفة المتلقي وما به من عشق للقص والحكايات كافةً.
لقد استطاعت المرأة العربية عبر مسيرتها الروائية الطويلة أن تعيد تشكيل الواقع وتجميله بنسج علائق متداخلة بين المكونات السردية كالتخيل، والحوار، والوصف، ونقل أو صناعة الأحداث بكل حبكاتها المشوقة، ومن ثم الإمساك بها مجتمعة لابتكار فضاء يمتلك طاقة متوهجة من الإبداع تطوق فكر ووجدان المتلقي فتأسره وتسكنه بين سطورها بكل طواعية واستسلام وتلذذ.
وفي ليبيا قطعت الرواية النسوية منذ بزوغ فجرها الأول بصدور (شيء من الدفء) سنة 1972م للأستاذة مرضية النعاس أشواطاً مهمة زمنياً وعددياً، تزداد في كل شوط نضوجاً وتألقاً والتصاقاً بالحياة في أوجه تفاعلاتها كافةً، حتى إن ظلت مواضيعها محدودة المجالات والمضامين، مقتصرةً على البوح الوجداني الخاص وملامسة بعض الشؤون ذات العلاقة الشخصية المباشرة. ومن بين تلك الأعمال الروائية تقدم رواية (سوق الحشيش) الصادرة حديثاً للكاتبة عائشة أحمد بازامة وجبة غزيرة من المعلومات التاريخية حول فضاءها المكاني وهو حي سوق الحشيش بمدينة بنغازي، وذلك من خلال الجولة التي تقوم بها بطلة الرواية (وريدة) في هذا الحي الشعبي البسيط، بمشاعر الحنين العارم القوي لذاك الحاضر الذي كان. فالإنسان غالباً يستشعر الأمن والأمان والبهجة كلما استذكر معيشته الماضوية المستوطنة ذاكرته التي يتمسك بها ويرجع إليها غالباً، لأنه نسج أحداثها وطرز وقائعها ونقش ثناياها بكل طاقاته الحسية والفكرية والمادية، عكس معيشته في الزمن الحاضر التي يتصورها مختلفة عن نعيم ذاك الماضي، ومليئة بالقلق والمخاوف والتوجس من كل خطوة نحو المستقبل. فالحنين إلى الماضي وتنشيط الذاكرة بأحداثه هو فعل سيكولوجي نفسي أصطلح على تسميته (نوستالجيا) ابتكره طالب الطب بجامعة بازل السويسرية (يوهانس هوفر)، ويعتبره بعض علماء النفس الدفاع المتين لعقل الإنسان من أجل الحفاظ على تحسن حالته النفسية ومزاجه الذهني، خاصة أثناء مواجهته صعوبات التكيف مع المحيط والشعور بالوحدة، وهو ما يجعل النوستالجيا أحياناً حالة علاجية مهمة لتنشيط العقل وتوليد طاقات صحية وعاطفية ذات فوائد كبيرة للإنسان والعودة به إلى لحظات ممتعة وبهيجة.
وقد استخدمت الروائية عائشة بازامة في (سوق الحشيش) أسلوب الوصف الظاهري المباشر لعناصر ومحتويات ومكونات ذاك الفضاء الجغرافي على لسان الساردة البطلة (وريدة) بداية من الشخصيات الفردية والعائلات القاطنة به والبيوت والمساكن والدكاكين والمدارس، وجعلت وظيفة الوصف هي تتبع التاريخ الماضوي للحي وكينونته السابقة وكذلك نقل بعض آثار ما آل إليه في حاضره الراهن كما تشاهده أثناء تجوالها، وما تعرض له من تبدلات معيشية سكانية بشرية، وتغيرات إنشائية عمرانية مختلفة عن الفترة التي تربت وعاشت فيها (وريدة) بين أحضانه وجنباته.
سوق الحشيش (المكان الواقعي):
هو ميدان صغير يقع بمدينة بنغازي (يتوسطه ما يشبه حوض نافورة ماء قديمة تهالكت بفعل عوامل أيدٍ بشرية كان الأولاد يتخذونها مكاناً لإبراز مواهبهم العدوانية في عراك ومصارعة بعضهم، أو ملعباً لكرة الشخشير وكثيراً ما تقام بهذا الميدان الصغير حفلات وسهرات، شهدت صولات وجولات أعظم الشخصيات البنغازية، وعروضاً سينمائية، يقوم بها نخبة تلك البقعة والكثير منهم من يقطنون هذا الحي، مظاهر ثقافية وعروض زخر بها هذا الميدان الذي ترعرع به غالبية ليست بالقليلة من مريدي العلم والثقافة ومن مبدعين وفنانين وشعراء. هذا المكان لم يكن يحمل ذكريات فقط بل كان سلماً نحو المجد لكثير ممن احتضنتهم عتباته وبيوته وناموا تحت أضواء لياليه الباهتة، المتواضعة، كانت تتخلله دكاكين الباعة...)
وكان يحيط بالميدان في السابق عدد من الدكاكين الصغيرة حتى صار مركزاً تجارياً للمدينة يتوافد عليه أسبوعياً أهل القرى والمناطق الرّيفية القريبة محمليّن بمنتوج مزارعهم لبيعها أثناء اللقاء الأسبوعي بالسوق. ولم تقتصر شهرة حي سوق الحشيس على ذاك اللقاء التسويقي التجاري فحسب، بل ظل دوره الاجتماعي والرياضي والفكري والثقافي طوال عقود زمنية مهماً على مستوى البلاد بأسرها، من خلال مجموعة من الشخصيات التي أنجبها وترعرعت فيه وأسهمت بنصيب وافر في الحياة الوطنية مثل الصحفى الرياضى الأستاذ أحمد الرويعى أشهر كتاب الصحافة الرياضية في ليبيا، وكذلك الأديب والمفكر الشهير صادق رجب النيهوم، ورفيقه الأديب خليفة الفاخرى والأديب الأستاذ يوسف الدلنسي، وغيرهم. أما من المعالم المكانية السابقة لحي سوق الحشيش فقد كان مقهى سى عقيلة العمامى تجمعاً وملتقى لكثير من أبناء الجيل الثالث من طلبة وخريجى الجامعة الليبية في بنغازى، كما احتضن شارع "شمسه" بهذا الحي واحدة من أهم الرائدات الإعلاميات في ليبيا وهي الأستاذة حليمة الخضري التي شاركت في تأسيس الإذاعة الليبية كمقدمة برامج ومذيعة لنشرات الأخبار، وغير ذلك كثير.
سوق الحشيش (الفضاء الروائي):
في رواية (سوق الحشيش) جسّدت شخصية الفتاة (وريدة) ذاكرة هذا الحي الشعبي الغزيرة بالحكايات والمعلومات والأحداث التي شهدتها طوال حياتها به، واستطاعت أن توثق بسردها السيال الممتع قدراً كبيراً من الوقائع والمناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية، والشخصيات الحقيقية بأسمائها الصريحة المعلنة، بأسلوبٍ تسجيلي سلس بمفرداته اللغوية وسياقاته الفنية، أبرزت من خلاله ثراء لغتها وإمكانياتها الوصفية التعبيرية، وقدرتها على التعالق والترابط بين زمنين ينتميان إلى ماضٍ غابرٍ وحاضرٍ معاش، وإن طغت على ذاك الأسلوب السردي مسحة من الألم والتحسر ونفحة حزن وآسى على خلو المشهد من شخوص الأحبة وعلامات تحمل سطوة كبيرة على الذاكرة، وغياب العديد من المعالم المكانية والشخصيات والعائلات التي غادرت (سوق الحشيش) إما إلى أماكن سكنية أخرى داخل البلاد وخارجها، أو توفاها الله وغمرها بعفوه ورحمته.
سوق الحشيش (سيمياء العنوان):
إذا كانت العتبة الأولى في رواية (سوق الحشيش) تحيلنا مباشرة إلى موقع مكاني معين بذاته يقع بقلب مدينة بنغازي، وهو ما يجعلنا نطلق على هذه الرواية بأنها رواية مكان، لأن تفاصيل جغرافية الحي بأسمائها الحقيقية مزروعة فيها بغزارة، كما أن صوت الساردة (وريدة) التي أنابت الكاتبة في قص حكاياتها وذكرياتها، يحيلنا إلى أسلوب االسيرة الذاتية التي صارت جنساً إبداعياً مترسخاً في المشهد الأدبي، وبالتالي فإن صفة السيرية تليق جداً بهذه الرواية. وطالما أن السيرة الموضوعية والمكان الجغرافي متوفران في النص فهما بلا شك يضيفان إلى (سوق الحشيش) دلالة أخرى مهمة وهي البعد الزمني التاريخي لتلك السيرة وذاك المكان، وبالتالي فإن وصف (سوق الحشيش) بأنها رواية تاريخية مقبولاً جداً، نتيجة التداخلات العديدة بين التاريخ والمكان والسيرة الشخصية فيها.
أما صورة الغلاف التي تعد إحدى العتبات السيمائية في النص وصارت تحظى حديثاً باهتمامات وقراءات وتحليلات متعددة فإن وجه الفتاة الباسمة (وريدة) يعزز القول بأن النص هو سيرة ذاتية لها تحت مظلة العنوان الرئيسي المكتوب (سوق الحشيش) وهذا الخلط يتيح للرواية أن تكون كل ذلك ولا ينتقص من أهميتها ومساحة الإمتاع التي توفرها.
(وريدة) بطلة سوق الحشيش:
الساردة "وريدة" بطلة رواية (سوق الحشيش) هي إمرأة تعيش حالة حنين قوية بارتدادها الماضوي وحنينها لفضاء سوق الحشيش ومعالمه القديمة (يزيد ما مضى من عمرها عن الأربعين... يشعّ من عينيها بريقٌ ينم عن نفسٍ تواقةٍ وروحٍ لا تهاب عثرات الزمن، في وجهها لمحةٌ من حزنٍ مسحتها حيويتها ونشاطها الذي يبدو واضحًا من خطواتها الواثقة. ترعرعت في كنف أبوين ربياها في بيت تظلّله المودة والحب رغم شظف العيش وقلة الحيلة. ... قررتْ في ذلك اليوم أن تقف على أطلال ذكرياتها تلك، في الحي الذي سمّاه الناس بأشهر سوقٍ في مدينتها سوق الحشيش)، وربما الكاتبة عائشة أحمد بازامة التي طرزت هذه الرواية، وأتقنت تحريك الساردة واستنطاقها خلال رحلة تجوالها في الحي، تكون قد استعارت الشخصية من إحدى زميلاتها، أو اتخذتها قناعاً وستاراً لذاتها، بغرض توثيق سيرتها الخاصة، وبث بعض التشويق في القاريء لتجعله يلهث لمعرفة حقيقتها!
ولقد برعت (وريدة) في استخدام الأسلوب السردي بلغة ثرية بسيطة، انغرست فيها المفردات العامية في بعض الأحيان أو كلمات الأغاني أو الأمثال والأهازيج الشعبية، ولكنها حافظت بإتقان على تعبيراتها الوصفية للعناصر المادية التي يكتظ بها حي وشارع سوق الحشيش، وكذلك في إبراز المشاعر العاطفية المتفاعلة فرحاً حيناً وحزناً أحياناً أخرى في أعماق الذات الساردة، أثناء تقليبها صفحات تاريخ المكان العريق واستذكار شخصياته المتعددة.
إن "وريدة" بأسلوبها السردي الممتع لسوق الحشيش وأحداثه تذكرنا برواية (محطات) للأديب الراحل كامل حسن المقهور التي وثق بها سيرة حي الظهرة بمدينة طرابلس محافظاً على أسماء الشخصيات والمعالم الحقيقية، مع تغيير بعضها أحياناً وفقاً لما تتطلبه الضرورة الاجتماعية. وكذلك ما سجله كتاب (محلة كوشة الصفار بين ذاكرتين) الذي قدم سرداً طوبوغرافياً ومهنياً وسكانياً من خلال سرديات الراحلين الباحث/علي الصادق الحُسنين، والحاج محمد الوراق رحمهما الله، وهما من سكان زنقة المُكني بمحلة كوشة الصفار بالمدينة القديمة بطرابلس، وقد تناولا خلال جولتهما في هذه المحلة حالتها التاريخية السابقة من خلال ذاكرتهما وما اختزنته من أسماء ومعالم بكل أبعادها وارتبطاتها.
لقد استنطقت (وريدة) وهي تتجول في أنحاء وأركان حي سوق الحشيش الجدران والأزقة المتربة والعديد من الأحداث والذكريات والشخصيات بانسيابية ممتعة وتشويق متواصل يزداد شغفاً ورغبة في كل خطوة للساردة في أنحاء وأرجاء عديدة من سوق الحشيش.
البداية التعليمية والمنهل الثقافي:
كانت الحياة الواقعية اليومية في سوق الحشيش هي المصدر الأساسي التي يستمد منها الأهالي معارفهم وثقافتهم، إلاَّ أن "وريدة" لم تكتفي بذلك، بل التحقت بالمدرسة النظامية الحكومية، ففي (صباح ذلك السبت من أيّام أحد شهور عام 1960م كانت داخل ذلك الصندوق الضيق محشورة مع عدد من زميلاتها، في مواجهة تلك السبورة السوداء، لتتلقى ما شاء الله لها من دروسٍ وكمياتٍ غير هينةٍ من غبار الطباشير، كانت في الدرج الأول ويا له من ظفر، الدرج الأول له مكانة خاصة لكل طالبة، رغم كميات غبار الطباشير المختلطة مع كميات رذاذ تلك المعلمة التي فقدت جزءًا لا بأس به من أسنانها).
ومن خلال ما أتاحه لها التعليم المنهجي المدرسي ولد شغف تعلقها بالكلمة وعشق المطالعة والثقافة والكتابة الصحفية والنشر بالجرائد اليومية والمجلات السيارة الصادرة آنذاك، وقد (نالت التشجيع والتقدير من رئيس التحرير لجريدةٍ ذاتِ صيتٍ وباعٍ بين الناس القرّاء والمتابعين ممّا زاد في سعادتها وحماسها لعطاءٍ جديدٍ، قبلت عروضه على استمرار زرع حروفها على مساحة هذه الجريدة، على صِغر سنّها كانت لها الحظوة لموهبتها المتفردة في فنّ الكتابة، أصابها الفخر والزهو والخيلاء، رأت نفسها ملكةً متوّجةً على درب الكلمة، غاصت أكثر في القراءة وأبحرت عبر أمهات الكتب. زادت من نشاطها الثقافيّ متنقلةً بين مدرستها والمركز الثقافيّ الذي ترتاده بين الحين والحين، احتوتها المراكز الثقافيّة في المدينة، نسيت نفسها بين الكتاب والكتابة، تجاوزت مجلّدات سمير وميكي وبساط الريح إلى مجلاتٍ أكثر مسافةً من سنيّ عمرها، قرأت من دواوين الشعراء، داهمت مكتبة الخرّاز القريبة من بيتهم، أذهلتها كمية المطبوعات، ربطت علاقةٌ حميمةٌ مع الصحف اليومية، تصدّر قراءتها الأولى للشعر ديوانٌ لنزار قباني، تصيبها الدهشة لجرأة تلك الكلمات، لقربها من نفسها، لصيقةٌ بحناياها، حفرتها على جدار روحها، نقلتها من ذلك الكتاب الصغير إلى كرّاستها لتكون أكثر حميميّةٍ، نسيج معانيها يُحاكيها، يتقمّصها بيد أنها طفلةٌ على مشارف أنوثتها الحالمة، أغوتها أشعاره، قرأتها مرارًا، جعلتها رفيقتها، ردّدها لسانها فأضْحت أغنية يومها. لم تدرِ يومًا أنّ تلك القصائد ستكون لعنةً ووبالاً عليها).
ولم تغفل رواية (سوق الحشيش) التحديات والصعوبات والعراقيل التي واجهتها المرأة الليبية الكاتبة والمبدعة في بواكير بداياتها فسجلت ما تعرضت له "وريدة" من تحجيم وعقوبة عائلية نتيجة انخراطها في المجال الأدبي والثقافي وإسهاماتها فيه، فعندما (وقع ديوان الشعر بين يديْ شقيقها (فرج)، قامت القيامة في بيتهم، تفرّس فيها بنظرةٍ افترست كلُّ ما فيها، حاولت أن تفهم ماذا هناك؟ صدرت لها الأوامر الصارمة، لقد تجاوزت حدود العيب، الذي يعني الممنوع. كيف لها أن تقرأ أشعار الحبّ والغزل، وتتفتّح عيونها على هذه الكلمات، لماذا تقتني كتابًا ينقلها إلى أحلامٍ محرمةٍ في هذا البيت. ألا لعنة الله على من فتح بابًا لتخرج فيه كلماتك للصّحف والمجلات، كانت هذه الجملة تتردّد كثيرًا على لسان (فرج) وهو يؤنّبها ماذا بقيَ بعد؟ كلماتٌ خرجت من فمِ شقيقها معلنًا قراره السُّلطوي الحاكم في وجود أبيها وأمها، ليقطع عليها المسير في شقّ طريقها نحو أملها المتفرّد المنشود، فلم يعد هناك من متّسعٍ لاستيعاب حياتها بهذه التفاصيل المغايرة لحركة مسيرة الحيّ القابع في سلطةٍ مجتمعيّةٍ سائدةٍ لا تتبدل، سلطةٌ ذكوريّةٌ تقمع كتاباتها وتأمّلاتها، تستدرجها إلى الكواليس المعتمة حيث تحيا كلّ الإناث حتى الموت.).
بهذا المستوى الفكري الظالم ظهر صوت "فرج" المعارض لطموحات المرأة الليبية، وحتى إن جعلته الرواية صوتاً فردياً واحداً يقف أمام رغبات الفتاة الليبية، فإنه إشارة إلى صوت الجموع آنذاك، سواء في نطاق سوق الحشيش أو خارجه، ولا شك أن تضمين هذا الحدث في ثنايا الرواية تغنم بها وظيفة تذكرية وتوثيقية أخرى بتسجيله ونقله للأجيال التالية لكي تعي حجم مكابدات المرأة الليبية وجسامة التحديات الفكرية المتخلفة التي واجهتها في سبيل إثبات وجودها.
بعض دكاكين سوق الحشيش:
تأسيساً على عنوان الرواية واقتباسها اسم المكان الحقيقي (سوق) في عتبتها الأولى، تتجلى طبيعة ذاك الحيز الجغرافي الخدمية ووظيفته للمجتمع. فهو عبارة عن موقع يضم عدداً من المحلات التجارية ودكاكين البيع والشراء لمختلف السلع والبضائع تمثل سوقاً تجارياً تجولت بنا "وريدة" في ردهاته متتبعة بعض الدكاكين وذكرياتها الماضوية معها، فحين (جالت ببصرها الذي وقع على مكان دكان الجزار سيدي (عوض)، الذي خلا من بنيانه وأهله؛ الآن مساحة مملوءة بالتراب خالية من الحياة كمن ترك ثيابه مرميةً في الطريق ورحل عارياً. ذكرها هذا المشهد بسؤال كان دائمًا يحيرها إلى هذه اللحظة، منذ أكثر من أربعين عامًا ولم تجد له إجابة، لماذا سيدي (عوض) يركب الكاليس؟ رغم أن المسافة بين بيته ودكانه لا تزيد عن خمسين مترًا تقريبًا؟!..)
وتواصل السير في الحي بخطوات ثقيلة وفكر يسرح للماضي البعيد الموغل في عراقته (هذا دكان سيدي (المهدي)، صاحب الخبز والتونة وصاحب براميل زيت الزيتون الأصلي والنقي، كانت تذهب إليه بين الحين والحين بزجاجة ليملأها لها بزيت الطعام من أبهى شجيرات الزيتون التي ترعرعت وجادت بقطوفها من مزارع القوارشة وهي محمية طبيعية تحوي آلاف أشجار الزيتون المباركة، براميل الزيت الرابضة بجلال على ناصية الدكان توحي بخصب المحصول وجودة معاصره، ووفرته، كان سيدي (المهدي) يطلب منها تشغيل مضخة عالقة ببرميل الزيت لتعبئ زجاجتها وتتعجل بالمسير لبيتهم، كان دائم العجلة لا يهدأ له بال في زحمة زبائنه، حيث كان دكانه يعج بكل جديد من كافة أنواع البضائع المحلية والمستوردة، لكن براميل الزيت هي امتياز خاص به. وشطيرة التن بالهريسة هي أشهى ما يقدمه لتلاميذ المدارس كل صباح حتى أضحى يتقاسم الشهرة هو وسيدي (المصري) في هذه الصنعة الشهية، تذكرت كل هذا حين لفت انتباهها مكان دكان سيدي (سليمان)، ذلك التاجر الذي كانت كلما اشتهت الحلوى أو طرف الشكولاطة أتت إليه متضرعة فيلبي طلبها على الفور كانت تعود لبيتهم فرحة بأنه أعطاها الحلوى ببلاش، عندما كبرت اكتشفت أن والدها كان يدفع ثمنها من بعدها وهي لا تدري..).
وتمضي في اتجاه آخر لتتحدث عن مكان وزمن غابر فتقف أمام (دكّان سيدي (رجب) كان عامًرًا بكل ما تطلبه نساء الشارع من عطريةٍ، وموادٍ غذائيةٍ، وحتى الحناء والجاوي، كانت تقتحم هذا الدكّان وتلتقط ما تبعثها أمها لجلبه لها، تضع القروش وبعض الملاليم على خشبةٍ ممدودةٍ على هيئة طاولةٍ يتكئ عليها سيدي (رجب) عندما يستقبل زبائنه، نقول عنها لوحة يأخذ قروشه، ويضع عليها قراطيس السكر والشاهي وبعضٍ من الكاكاوية، هذه القراطيس من الكاغط يلفّها بطريقةٍ جميلةٍ تبدو كحلزونةٍ بحريّةٍ التقطها من شواطئ الصابري، فتحمل غلّتها، وتنصرف إلى بيتها).
وحين توجهت إلى ناحية ركن آخر (أشارت إلى مكان دكّان عمّي مسعود، هذا الدكّان الذي لم تفهم محتوياته إلاّ بعد حينٍ، كأنّه منطقةٌ محرّمةٌ، قد كان وقتها محرّمًا عليها حتى الاقتراب منه، يحوي علباً ذات ألوانٍ مختلفةٍ وأسماءً لمدنٍ ليبيةٍ: جفارة وغريان ولبدة، كانت تشاهدها وتقرأ عناوينها عبر زجاج واجهة المحل، ما يثير عجبها هو أن هناك أسماءً مكتوبةً بلغةٍ أجنبيةٍ لم تستطع قراءتها والأكثر عجباً لها، تلك العلبة المكتوب عليها سيجارة الجمل! ولطالما تساءلت محلٌّ يبيع الدخان كلّ العلب فيه بأسماء مدنٍ، ما معنى أن يحشر بينها نوعٌ واحدٌ باسم الجمل؟ وما علاقة الجمل بالتدخين؟ إنها لم تشاهد في حياتها جملاً يدخّن! ولو أنّها سألت أحداً من أهلها بتساؤلاتها هذه لوقعت في العقاب، ظلّت هذه الأسئلة عالقةً في ذهنها إلى لحظات تدوينها ذكرياتها هذه عن دكان سيدي (مسعود) لبيع السجائر.).
وهكذا نلاحظ أن السرد الروائي عند الكاتبة لم يخلو من إيقاظ الكثير من الذكريات الماضوية في حي سوق الحشيش، واستحضار أسماء بعينها، وأماكن محددة، وإطلاق العديد من الأسئلة التي تنبش في فكرٍ قديم، فتعيدُ بث الروح فيها من جديد، وتبعثُها ثانيةً في الحياة الراهنة بكل ما فيها من تباين وتحسر.
البيت العتيق بسوق الحشيش:
يعتبر المكان القديم محفزاً للكتابة والتعبير عن عوالمه وشخوصه وأحداثه بأزمنته التاريخية المتعددة، وهو بما يمثله من خزانة معلوماتية يفتح شراهة البوح مثلما يعمق درجة الحنين والاشتياق. وقد عرف الشعر العربي العديد من القصائد التي تؤكد سطوة المكان الكبيرة على الإنسان، فالشاعر العربي (أبو تمام) تفطن لذلك مبكراً فأنشد:
كَمْ مَنْزِلٍ فِي العُمُرِ يَأْلَفُهُ الفَتَى وَحَنِينُهُ أَبَداً لِأَولِ مَنْزِلِ
كما تأسى الشاعر (امريء القيس) على المكان بقوله:
قِفَا نَبْكِي مِنْ ذِكْرَى حَبِّيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخَوْلِ وَحَوْمَلِ
أما عنترة العبسي فقد طالب الدار كناية عن المكان بالتكلم والحديث عن سيرته وفروسيته وحبه حين حياها قائلاً:
يَا دَارَ عَبْلَةَ بِالجَوَاءِ تَكَلَّمِي وَعِمِّي صَبَاحاً دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي
ويبدو أنه حين وقفت الساردة "وريدة" أمام بيت أسرتها القديم أثناء جولتها في (سوق الحشيش) أغرق طوفان الحنين صوتها وغابت الذات المتكلمة وتوارت بعيداً خلف دموع الشوق المتهاطلة بغزارة، فتولت الذات الكاتبة القيام بالوصف مستخدمة أسلوب الإشارة إلى العائلة حين نعتت المكان (هذا باب بيتهم الذي احتضن طفولتها، كأنّي بها تتحسّس نبضات يد كلّ طارقٍ عليه وكل داخلٍ وخارجٍ منه وإليه. نظرته شاحبًا حزيناً على فقدهم، اختطفه القدر، تحول هذا البيت ليكون مأوًى لأسرةٍ أتت إليه من آلاف الأميال، قطعتها من باكستان لتستقر وراء عتبة باب بيتهم، جلست بهدوءٍ على عتبة الباب، لامست يداها صفحته الإسمنتية الباردة، تسربت البرودة لجسمها، هذا البيت الذي احتضن اقتران أبيها (قدورة) بأمها (حسنة)، شهد هذا البيت على علاقة مودةٍ بينهما ورضًى بما قسم الله لهما من بنات وبنين). واستمرت في تذكر أيامها وأحداثها (هنا كانت تجلس على عتبة هذا الباب تحلق ببصرها عبر الشارع كله، هذه نافذةٌ تقابل باب بيتهم في مواجهته تمامًا، تطلّ منها فتياتٌ جميلاتٌ حيناً بعد حينٍ تتبادل أختها الأكبر منها معهن الحكايات والطرف، وآخر صيحات الموضة والحلي، كانت النافذة حلقة وصلٍ بين بيتٍ في شارعٍ آخرٍ مع بيتها في شارع شمسه، هي مغلقةٌ الآن، أحزنها إغلاقها.)
إن البيت والمكان القديم يمثل حياةً جزئية من حياة الإنسان وسيرته الشاملة، ويحتضن الكثير من المشاعر والأحاسيس التي تفاعلت بين جدرانه ووسط زقاقه وفي ربوعه، وبالتالي فإن رواية (سوق الحشيش) ظلت توقد الذكريات وتبعث البهجة في قلب (وريدة) بكل ما يتداخل فيها من توصيفات أدبية جنسية، وزادت فاعلية هذا الدور بتعدد الأصوات الساردة وتنوع خطابها بين ضميري المتكلم والغائب.
الكشافة والجزائر في (سوق الحشيش):
تقر "وريدة" بأهمية الحركة الكشفية وقيمها النبيلة التي تغرسها في منتسبيها، كما تصرح الرواية بأنها (تعلمت في فرقة الكشافة أن تعمل خيرًا كل يوم، تعلمت أن تحيّ العَلَم وتنحني له إجلالاً، تعلمت أن تعطي، بيد أنّها لا تملك ما تعطي، لا تدري أين يكون هذا العالم ومن هم الناس الذين يستحقون الخير، ومع شغفها بما في الكشافة من نظام ونظافة فإنّ لها أسئلة في ذاتها الصغيرة لم تستطع قائدتها الإجابة عليها).
وتذكرنا الساردة جانباً من حياة "وريدة" الكشفية عند وقوفها على العتبة القريبة من بيتهم القديم في سوق الحشيش فتقول (هنا على هذه العتبة كانت وريدة تنتظر قائدتها في فرقة الزهرات عندما طوّقت عنقها حينها بمنديلٍ برتقالي، قالت لها ستسيرين معي لنجمع التبرعات للجزائر، كانت لا تدري لماذا؟ فقط عليها أن تضع في جيدها صندوقاً خشبياً وتطوف شوارع البلاد وتدخل البيوت لتطلب منهم التبرع للجزائر برفقة شبيبة الكشافة وقائدتها (أسمهان)، لا زالت تتذكر أن ذلك المنديل البرتقالي شرّفتها به هذه القائدة، أي شرف وهي تتهادى به كطاووسٍ صغيرٍ يحبو على جسرٍ مهيبٍ في واجبٍ وطنيٍّ لم تدرك معناه إلاّ بعد سنين، هي في العادة زهرةٌ صغيرةٌ من زهرات الكشافة تلف رقبتها بمنديلٍ أصفر تحوّطه خطوطٌ خضراء، كانت زهرةً لا تعرف ما معنى الحرب، وما معنى التحرير، لكنها أدت تلك المهمة بنجاح، كانت فرحانة جدًا، مندهشةً أكثر عندما ترى النساء يخلعن مصوغاتهن من أعناقهن وأياديهن، ويطلبن وضعها في ذلك الصندوق، تساءلت عدة مراتٍ من هي الجزائر؟ وممّن يريدون تحريرها؟ لا أحد ينتبه لأسئلتها، كانت تردّد مع الكبار كلمة آمين عندما تجهر ألسنتهم بالدعاء للجزائر بالنصر المبين).
يتضح جلياً أن بذرة المشاركة والاهتمام بالعمل الخيري والتطوعي الإنساني لدى البطلة قد زرعت مبكراً في فكرها وسلوكها، بالتوازي مع عشقها الإنتماء للوطن، والتعاطف الوجداني مع القضايا العربية القومية والتي كانت من أبرزها مناصرة الشعب الجزائري الشقيق في كفاحه ضد الإحتلال الفرنسي، ومساهمتها في جمع التبرعات وتعلقها الكبير بخطاب الزعيم الجزائري (أحمد بن بيلا) أثناء زيارته مدينة بنغازي، وتصف الرواية جانباً من ذلك الحماس القومي (أخبروها ذات ليلة أن المناضل بن بيلا سيزور بنغازي، تسرب الخبر إليها عبر زميلتها من زهرات الكشافة، كانت تواقة هي لترى هذا المناضل) .
ويختلط فضاء ميدان سوق الحشيش في بعده المكاني مع أبعاده السياسية والدينية والاجتماعية المتقاطعة الأخرى من خلال مشهد الحضرة الدينية الصوفية واحتفالاتها التضامنية مع الشعب الجزائري مثلاً (تيقّظت بعد برهةٍ على صوت ضجيجٍ ينبعث من ذلك الميدان الذي يتفرّع منه شارعهم الصغير، مصاحبًا لصوت أمها وهي تقول: الدنيا مقلوبة برّة، انظر شنو فيه؟.. إنّها الحضرة وهي تدقّ الدفوف والطبول وتتعالى الأصوات لاهجةً بذكر الله، كان هذا في الأسبوع الأول من الشهر السابع لعام 1962م. استأذنَت أمها بأن تخرج أمام بيتهم لترى ضاربي الدفوف من الشيوخ والشباب، إنهم جاءوا ليشاركوا احتفالات الحي بنصرة الجزائر، وما هي إلاّ لحظاتٍ ويصلوا لهذا الميدان الذي لازالت تتواصل فيه الاحتفالات والأعراس الشعبية تضامناً مع الأشقاء لنيل استقلالهم من فرنسا)، كما أن ذكر الحدث مؤرخاً في أسبوع وشهر وسنة معينة يعطيه تأكيداً ووثوقاً في واقعيته، ويمنح الرواية خاصية أخرى تنتمي إلى جنس كتابة المذكرات التسجيلية المستقطعة من وقائع الماضي الحقيقية وإسكانها في حضن عمل روائي جامع بين الواقعي والافتراضي.
منصور الحبيب في (سوق الحشيش):
مثَّل (منصور) ابن الجيران الحبكة العاطفية في رواية (سوق الحشيش) والذي يمكن أن نطلق عليه البطل الثاني أو الموازي للبطلة "وريدة" الساردة الرئيسية، وهو شخصية كانت المحرك العاطفي للساردة طوال تنقلها في أزقة الحي وزيارتها لبيتهم القديم (عادت ببصرها إلى عتبة الباب، تذكرت كيف كانت تقف هنيهاتٍ على هذه العتبة وهي تتعقب بنظراتها المارّين والسائرين إلى وجهاتهم المختلفة، الذين يعبرون هذا الشارع الممتد إلى شارع عمرو بن العاص ويتفرع منه ممر صغير يضفي إلى ذلك السوق، كان بيتهم على زاوية بين تقاطعين وكانت لا تهتم لأحد إلّا لنظرة من (منصور) ابن الجيران، نظراتها الخجولة إليه كانت أقصى آمالها، عندها تكتفي بهذا اللقاء. تظل على تلك العتبة فيما عيناها يتبعان (منصور) حتى يربط دراجته ويقفلها بذاك السلسال الحديدي ويلوح لها بيده ويدخل بيته، تملأ قلبها بهجة وسعادة ويغمرها إحساس لذيذ بلقاء (منصور) ورؤيته وتهيم في خيالها... )
ولو عنّ لنا أن نتسأل هل يطرق الحب أبواب قلوب وبيوت سوق الحشيش في ذاك الزمن البعيد؟ وهل هو قادر على فك الأقفال وفتح الدروب أمام علاقات عاطفية نقية وبريئة بين شاب وفتاة من سكان الحي؟
إن إجابة هذين السؤالين يمكن اكتشافها من خلال الأسئلة المتوالدة في ذهن الساردة وهي تحكي بصوت المونولوج الداخلي (كيف تغني للحب في وجود أمها وأبيها، كيف تترنّم بأغاني الحب وهي إحدى الممنوعات في هذا البيت، وكيف لو عرف أهلها أنها تحب (منصور)؟ تذكّرت يوم أن فتحت أختها الراديو ذات يومٍ، كانت أغنية محمد صدقي تشنّف الآذان وتنطلق أغاريده في أرجاء البيت إذ دخل أبوها وقامت الدنيا ولم تقعد وعوقبت البنات بعدم اقتناء ذلك الراديو، وأودع حجرة أبيها لا يتم الاستماع إليه إلاّ حين نشرات الأخبار أو متابعة خطابٍ لجمال عبد الناصر، من يومها صار الاستماع للأغاني يتم خلسةً وبالسرقة بعيدًا عن أنظار الأب والأم. أحيانًا ـ. )
وإن كانت شخصية (منصور) قد أبانت عن جوانب عاطفية مكتومة خاصة بين البنت وابن الجيران فإن ذاك السرد كشف عن توفر أجهزة إذاعية حديثة (الراديو) في البيت القديم للاستماع إلى الأغاني والخطب السياسية، واسم مطرب مشهور (محمد صدقي) وكذلك زعيم عربي كبير (جمال عبدالناصر) مما يعطي صورة واسعة عن فضاء الأسري المعرفي والثقافي لا تخلو من الطرب والسياسة. كما أننا من خلال (منصور) نفسه نكتشف أن الأسئلة المفتوحة المتدفقة والحوار باللهجة العامية كان ملامساً لوجدان القاريء ومبعث دفء وحرارة في روح نص الرواية (فجأةً يطلّ (منصور)، يقف في مواجهتها يضحك ويقهقه بصوتٍ عالٍ، وين كنتِ؟ شنو اللي على دبشك؟ خجلت وهرولت في خطواتٍ طائرةٍ كأنها غزالٌ يهرب من انقضاض سبُعٍ عليه، إذ حزّ في نفسها أن يراها (منصور) على هذه الهيئة، وصلت بيتهم، ذرفت أول دموع جرحٍ من حبيبها. انزوت في ركنٍ من بيتهم، ذرفت ما شاء لها أن تذرف من دمعاتٍ استشعرت حرارتها من حرارة حجم السخرية واللامبالاة التي لاقتها هذا اليوم، سرحت بتفكيرها بعيدًا تندب حظّها السيء ومن ثم اهتدت إلى أنّها لا زالت لم تنه قراءة سطور قصة غاندي فانهمكت وهي تغوص بين أحداثها وتغمس نفسها في كلماتها، تصوغ من حروفها مؤنسًا يواسيها ويبدّل سخرية (منصور) منها إلى تسلية ذهنيّة هي في أمسّ الحاجة لها، تساءلت كيف لهذا المناضل غاندي أن يشنّ على عدوّه حربًا هادئةً لا قتال فيها؟ كيف له بابنةٍ لم يكن أباها الحقيقي؟ إنّها أمام دروسٍ غريبةٍ لم تعْهدها ولم تتعلّمها. فتحت لها أحداث هذه الحكاية أبوابًا في الحياة أخرى، رغم أنها لا تفقه في تفاصيلها شيئًا، لكن متعة القراءة أوصدت أبواب حزنها)
الخاتمة:
ظلت بنية السرد في (سوق الحشيش) تتأسس على حركتين متلازمتين هما الحركة التذكرية الاسترجاعية المرتبطة بالماضي وروح الحنين والنوستالجيا المهيمنة على الساردة، ثم الحركة التأملية البصرية المشاهدة وفق متغيرات ومستجدات الحاضر المرتبطة بالمكان الحقيقي، وقد أثمرت أسماء وأحداث ومناسبات جعلت النص يضفي على المكان أبعاداً جغرافية واجتماعية ودينية وسياسية متعددة، ويوطن كل ذلك في ذاكرة القاريء بلغة لا تفقد مفرداتها وعباراتها توهجها وبريقها وحضورها المتألق.
إن كل هذا الثراء السردي يجعلنا أمام رواية متعددة التصنيفات والوظائف والغايات وقد أنتجت أنطولوجيا معززة بالمعلومات التاريخية المرتبطة بالمكان الروائي (سوق الحشيش) وشخصياته التي شاركت "وريدة" البطلة والكاتبة وبقية شخصيات الرواية في مناسباته وأحداثه، أو شهدتها، أو سمعت بها، وحتى إن لم تكن هذه الأنطولوجيا كاملة أو دقيقة، فإنها جديرة بالاحتفاء بها من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومؤسسات مدينة بنغازي بداية من المجلس البلدي للمدينة، والأدباء والكتاب والمهتمين بتاريخ المدينة كافة، وتكريم هذا العمل الذي يضيف للمشهد الإبداعي رواية أدبية ذات قيمة إبداعية مهمة.
فهل يا تُرى نشهد إحتفالاً في مدينة بنغازي يليق برواية (سوق الحشيش) قريباً؟
(*) كاتب وأديب وإعلامي مستقل من ليبيا، يمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني:
Fenadi@yahoo.com





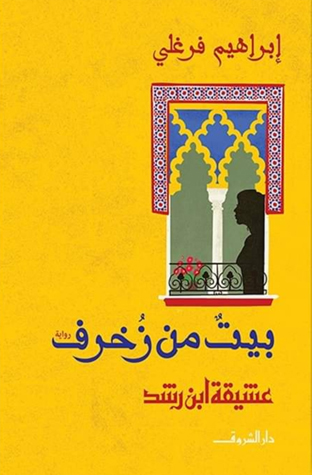


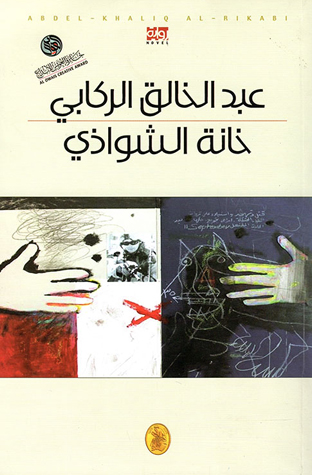

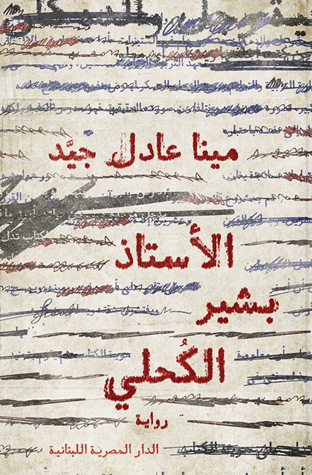

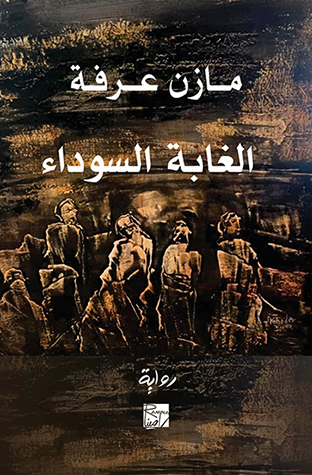


0 تعليقات