قراءة تفكيكية في (ثملا على متن دراجة هوائية) لإسماعيل غزالي
استعادة الكيخوطي: من أجل تكسير أفقية الكتابة السردية: قراءة في
(ثملا على متن دراجة هوائية) لإسماعيل غزالي(1)
في مسألة بنية النص ورهانه المخلخِل:
من عادات قراءاتي ألا يتم البدء بمقدمات الكتب، تفادياً لأي تشويش على مسار التلقي والتذوق الشخصيين، كنت قد اقترفت الطقس ذاته، بشكل تلقائي، كما هذه الحالة، مع المجموعة القصصية لإسماعيل غزالي (ثمِلاً على متن دراجة هوائية)؛ فعلٌ يجد مَوْطِنَ اشتهائه في النفس أولاً، وفي هندسة الكتاب ثانياً؛ ذلك أن المقدمة هنا جاءت مثبتة في "النهاية"، فكان لابد من البدء بما سمّاهُ الكاتب (خاتمة)، لكن هل يكون ذلك أيضاً ضروريا؟
هو طقس إغوائي من الخلف كان قد مارسه بارث حين أمسك السلاح، أو كلما أمعن النظر في سيارة، كاشفاً عن خبايا اللاوعي كمادة مستثمرة في خطاب الرسائل الإشهارية للإيقاع بمتلقيها، فيدمِّرها سيميولوجيا (2).. وكأن إسماعيل غزالي بهذا التوزيع لفضاء مجموعته القصصية الجديدة يكرِّس فيك نزعة الاختيار ويجعلك تذهب إلى تمجيد فعل الخلخلة ومساءلة كل موروث، كما يعمل على إخراج القارئ الكسول من عاداته "المزمنة" والمورَّثة له من قبل "تاريخ القراءة"، بل إنه يُحْرِجُ الكاتب المتمترس والمتقوقع في أكاديميته الفجَّة، للإقرار بإمكانية الكتابة من الخلف؛ بداية نحو نهاية هي بداية، كحالة دائرية مُتَحَصِّلَةٌ هندسياً.. وهو فعل يجعلني أستعيد الاغتباط ذاته لطقس سكنني طويلاً أثناء تصفُّح جريدة (الصباح) من الخلف، لِمَا تعرضه من "فتنة الأقاصي"، بِتَبْئِيرِها الأنثويةَ في الوجود، هي حتماً كانت مصدره. ومعلوم أن الجريدة كانت قد استمرت ردحاً من الزمن تقترف هذا الطقس، في حالة يُتْمٍ وتَفَرُّدٍ بعد أن تَخَلَّتْ جريدة (الأحداث المغربية) عن الفعل المستفز إِيَّاهُ، مستجيبة بخضوع تام لأولئك المرضى المحتمين نعامةً بثقافة التَّسَرّي، الصانعة لقطيع يرعاه مَن سميناه "الطُّهْرانِي"، ذات أمل جريح.. (3).
طقسٌ يوميٌّ كنتُ أفعله إذن من خلال معروض الجريدة من الخلف، للتأكيد على أن الصباحات هي بدايات لنهارات أولها حياة، أَوَّلُها وردٌ، أَوَّلُها وجودٌ يُعَوَّلُ عليه، وللتأكيد على النسق التحريري الذي احتفرتْهُ الجريدة، قبل أن يُصادر ذاك "الطُّهراني" إيديولوجياً غوايةَ الأنثوية الطالعة افتتاناً من ظهر جريدة، من خلفيتها الورقية، وتهريبها في الظلام إلى تخوم الشواطئ لتقديم مَصٍّ أو استمناء بغاية المساعدة على القذف، أثراً لاستيهام الفراديس المحلوم بها..
وقد كان طقس الجريدة ذاك مكروراً قبل أن يحتجَّ "الظلاميون" على الحياة المستهامة حفيفَ لذةٍ في ختْمِها عددَ أوراقِها.. ختمٌ يكون بداية لكل الاشتهاءات..
هكذا، يكتب إسماعيل غزالي خارج "الأصل"؛ ذاك الأصل الأفقي، المشدودة هويته إلى أرسطية/ جدلية/ سببية، الأصل الذي يجعل إدمانه يذهب إلى اللقاء اللازب بالكسل لأنه يتحاشى السفر العمودي الذي كان من نصيب أورفيه، ومن نصيب إسماعيل غزالي ممارساً للغطس من العلوِّ الشاهق، وحيث يوريبيديسه هنا هي القصة الخارجة من أعطاف متخيَّله. بذلك، فهو يعمل في كتاباته على انتهاك بنية نموِّ النص في حالته الأفقية والمنطقية، مرتاداً أفق قلب المواقع ليصبح الْخَتْمُ بدايةً، والبداية ختماً؛ دوار متاهي يُمَجِّد الاختلاف.. وفعل يجعله يخلق للكتابة شفوفها في الطِّباق؛ وحيث الأولوية والتمييز مجردُ إجراءٍ فقط، فهو لا يصمد طويلاً أمام غواية الكتابة كلغة خاصة به، إنه هشٌّ في الرِّقَّةِ وفي السعي نحو الانتساب إلى الإنساني وفي الحضور الدائخ بفتنة ال "كيف"، غير مُبَالٍ ب (ماذا) ولا ب (لماذا)، إلا من باب اشتراطات المدلول الغميس في الوعي الوجودي الحاد للدال.
تؤكد، مرة أخرى، كتابة إسماعيل غزالي، في هذه المجموعة القصصية، بأنها شغوفة ب "البئر الأولى": الطفولة، التي يَسْتَلُّ منها هويته ماء، نبعٌ منذور أيضاً لاستلال الهوية من الأعالي الكثيفة الأرز.. والتي بها يُسْهِمُ وبكيفيته الخاصة في بناء وجود السرد العربي.. سرد له كينونته المختلفة والمتعددة، والشاهقة المديح للهامش وللظلال؛ ذلك أنه في البدء كانت (الحاشية)، التي لطالما نُظِرَ إليها كَسَقْطِ متاع في جسد النصوص التراثية العربية، باعتبارها تذييلات وملحقات مناوِشة للمتون الشعرية في شِقَّيْها الإبداعي والتعليمي، وكأنها سهم في خاصرة الريح. وإذا كانت الحاشية نصّاً يضيء، ويُذَيِّلُ الكلام، وكانت رِدْفَ المتاني في وجود الكتابة، كما اشتهر بها سواء أبو بكر الصولي في ذائقته المجددة، أو الآمدي في ذائقته المحافظة مثلا (4).. أو كانت تلك التي اشتهرت بها (أوراق)، باعتبارها مرآةَ كتابةِ العروي، فإنها مع إسماعيل غزالي، تصبح مركزاً والمتن كذلك، ولا أسبقية لأحدهما في الوجود على الآخر، إنهما بمثابة الانبثاق/ الطلقة، وحيث كل شيء له اعتباره، ولا أحقية لجهة في الاستعلاء على أخرى؛ تلك هي ديموقراطية بناء السرد، وأن مقولة يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد عفّى عنها الزمن؛ إذ لكل منهما خصوصياته وثراؤه الدفين في الجمال، فالثراء والدهشة اللذان يكتب بهما إسماعيل غزالي الرواية يكتب بهما القصة مع جرعة زائدة في الانزياح الشعري+؛ أي في الكثافة اللغوية، وفي المتاهي الذي يَتِمُّ اعتماده من منطق "اللكسيم"، سفراً دواراً في البنية، وسفراً شعرياً في الدليل..
تبدأ المجموعة القصصية، إذن، بالحاشية على العنوان؛ وهي مصادرةُ الكلام بما له من حظ في الإضاءة والإعتام على حدٍّ سواء، كما قضت حكمة الإغواء سفراً نحو تأجيج الصبوات ونداءاتها النَّدية، ذلك أن وظيفة الكاتب هي الإلغاز والإرباك، وهي "تخييب أفق انتظار" المتلقي، إنها الخلق بعجائبية أَخَّاذة على مقاس المينوتور، بإلباس النص أنواعاً مختلفة من الدوار المنسوب تارة إلى النهر، وأخرى إلى البحر، وثالثة إلى الموت، ورابعة إلى الشمس، وخامسة إلى السينما.. هي تسميات له (= الدوار)، وتحديدات لفراسخه الموجعة في الحياة.. تلك الفراسخ المفعمة بالقلق والضجر ولواعج النفس في أنواع متفرقة من الفقدان..
ثم لعلَّ اهتمام إسماعيل غزالي بالحاشية، أي بما يمكن أن نسميه الآن بالهامش ـ marge ـ والذي قد يكون لاحقا/ إحالة، هو استعادةٌ مُسَائِلَةٌ للتصور الكلاسيكي للترجمة لدى العرب، أي ترجمة الشعر ليس إلى لغة ال "آخر" وثقافته، والذي به يتشكل الوعي بالذات "مثاقفة"، وإنما ترجمة الشعر العربي في العربية ذاتها، فعل ما ينفكُّ يتزحزح حتى يستقر، ترجمة حرفية لعلها مجرد تنويع فقط تسافر بالنص، وتسافر بالمتن من مركزيته إلى هامشه عن طريق الشرح والتعليق والحاشية (5).
وحين يطرح الكاتب إسماعيل غزالي هندسةً مختلفةً لمجموعته القصصية، فإنه يزحزح "الكتابة الأكاديمية" عن جِدِّيتها المحتمية بغباء السيمتري، مستعيداً نداءات صاحب المطرقة في ضرورة العمل على تحطيم الأصنام وجعلها تَأْفَلُ، وليطرح سؤالاً ثاقب النَّباهة: كيف نقدم لما لم يتم إنجازه بعد؟
ذلك أن ما يجب التقديم به هو ما يُقَدَّمُ له كإنجاز، لذا كان من الضروري، ومنطقياً البدء بالخاتمة للإعلان عن "الإتمام"، التوصيف الواهم، مادام لا شيء منتهياً في هذه الكتابة.. أما المقدمة فتُذَيِّلُ الكلام. يفعل إسماعيل غزالي ذلك لأن المقدمة عتبة ـ seuil ـ وهي آخر ما يوضع بعد تشييد البيت؛ ففي كثير من الكتابات الأكاديمية المتورِّمة الساقين والأطراف، تلك المتورِّمة دمامل "نظرية"، عادةً ما تَعِدُ كذباً في مقدماتها دون أن تَفِيَ ب "حلمها التحليلي".. كتابة تُرْهِبُ القارئ بالنظريات والمفاهيم، ولا حظَّ لها في الإنصات إلى الإبداع..
إن إسماعيل غزالي يكتب المتنَ، ثم يسجِّل أولا الآفاق التي حقَّقها دون إغلاق، ويجمعها كمنجز هو قَبْضُ اليد في كبسولة ضاغطة سُمِّيَتْ عادةً مقدمة، وهو يفعل ذلك ليُعيد بناء الشك في مقولة موت المؤلِّف، باحثاً عن حَيِّزٍ لإعادة بعثه من جديد باعتباره أول قارئ للعمل حين يكون بصدد كتابة هي بالضرورة قراءة، لذا فالمؤلف مُؤَوِّلٌ من بين آخرين، وله الأحقية في تفكيك وتشريح العنوان والتعليق عليه، بل في رسم أفق للقراءة الممكنة، تلك القراءة غير المريضة بالمركز، غير المريضة بالمنوال، صَنَماً يجب أن يأفل ليُفسح هامشاً من الحرية أمام تحقق الكتابة المتوقَّعة.. وهي القراءة أيضاً المُتَلَفِّتَةُ للظلال، والمتيقِّظةُ في انتباهتها للتفاصيل الشاعرية التي تمتلكها الهوامش.. والمبتهجة أيضاً بالشاعرية التي يحوزها القبح؛ فليس، كل مرة، القبح قبحاً، وليس الجمال جمالاً.. فلكلٍّ منهما حظ في الآخر ومنه، في الانبثاق والتَّفَتُّقِ، وحيث التماسك الواهم هو ما يمنحه إرجاءَهُ، أي ما يمنحه اختل(ا)فَه الدِّريدي.
تذهب الكتابة في (ثملاً على متن دراجة هوائية) إلى منطق الدائرية، إلى منطق اللانهائي والمتاهي.. منطقان أثيران لدى كل كتابة أصيلة، كما في (ألف ليلة وليلة)، وفي سيمولاكراتها المتولِّدة عنها في مسوَّدات ستندال الحالم بنسيان قراءة كتاب (الليالي)، وفي القراءة المتواصلة لسارد بروست.. (6).
ويُسْلِمُ إسماعيل غزالي سروده لنوع من الكتابة ـ المتاهة، ولنوع من الدائرية والتوليد المتداخل العناصر، حيث كل دائرة تشدُّ إلى أخرى في تأثيث متاهي لبنية القصة المتداغلة فسائل نسيجها؛ ففي (الثلاثائيون) نجد السارد يتبوَّل في مرحاض قذِر وهو على متن قطار، وضع يكون مدعاةً للتفكير في احتمال تَبَوُّلِ شخص آخر وفي اللحظة ذاتها بمرحاض طائرة، وذلك على ضوء تَأَمُّلِ النجوم المتلألئ ضوؤها في السماء، وضع يُمنح لمبدأ التباين بين القذارة والنظافة، وبين كون الأول يطل أعلى، في حين الثاني يُطل أسفل.. في إشارة إلى أن الإنسان محكوم بالفعل ذاته الذي يفعله غيره، فقط يكون الاختلاف في الوضعية وشروط الإنجاز، ذلك أننا محكومون بالتكرار والتشابه، للانفلات منه لابد من زلزال وخلخلة عنيفة لتكون الأحوال محتفية بحياتها المودعة في المختلف والمتعدد، وهو ما جعله يضع قصته هذه في جوٍّ كابوسي حادٍّ، فكان كل حكي فيها يفضي إلى الكارثة؛ ذلك أن القطار يزيغ عن السكة، والطائرة تهوي من السماء، والسفينة تغرق.. هي تحوُّلات/ أسفار متعددة في المكان وبوسائل مختلفة لكن نهايتها فجائعية ومأساوية.. تلك هي جرعة الأوديسّا الممنوحة للوجود في إطار الاستجابة للقدرية العمياء..
وفي قصة (عليها تسعة عشر)، وحيث العنوان معلق في غياب المعدود المشار إليه في الضمير المتصل (ها)، والذي يفترض اللعنة: ("عليها تسعة عشر" لعنة)، وحيث المقصود هنا هو (كوفيد) المدشِّن لكارثة إنسانية شاملة، حتى عُدَّ الوباء الأكثر قسمة بين الناس، منذ سنة 2019، الوباء الذي يتم تسريده بالتأمل الإيتيمولوجي في إطلاقه، عن طريق تفكيك وتفصيل مكوِّناته الصوتية الخمسة (ك، و، ف، ي، د).. تسريد يتم بشكل عمودي مخصصا تعريفات هَوَوِية ـ euphorique ـ لمكونات اللفظ، أو لعلها حالات متساكنة على شكل عمارة عدد طوابقها تسعة عشر، إشارة مضمَّنة إلى عدد الشقق، وحيث كل منها يقدم برنامجاً سردياً مترجِماً لحالة ساكنيه وأوضاعهم، كما اكتشفها ماسح الزجاج أو صبّاغ الواجهة، سيان، والتي يمكن تجميعها في الخلاصات التالية:
19 ـ نافذة القراءة. 18 ـ نافذة سوء التفاهم. 17 ـ نافذة الرسم الطفولي. 16 ـ نافدة المتعة والعري. 15 ـ نافذة محاولة الانتحار. 14 ـ نافذة الخيانة. 13 ـ نافذة الملاكمة. 12 ـ نافذة الافتتان بالذات. 11 ـ نافذة إعدام ذاكرة. 10 ـ نافذة الجسد ـ الذاكرة. 9 ـ نافذة العراك. 8 ـ نافذة الأفيون. 7 ـ نافذة الاحتضار واللامبالاة. 6 ـ نافذة المشاهدة ـ الفرجة. 5 ـ نافذة المكتبة. 4 ـ نافذة التحرش. 3 ـ نافذة غنج طبيبة. 2 ـ نافذة غضب الرئيس. 1 ـ نافذة المكان الرعب: كوفيد.
وكأن هذا الهبوط يمكِّن الفعل القرائي من مدينيته لمبدأ التحوُّل الكافكاوي، حين "يَتَخَرْتَتُ" الإنسان وينمسخ، تأويل تجود به حركة ماسح الزجاج هبةً لإحساس ينتابه أثناء فعل النزول وصولاً إلى تَحْت حيث الوباء الرعب: كوفيد وهو يحتسي قهوته، وحيث فجيعة الطابق الأول تحيل على الطابق التاسع عشر، طابقان موصولان بسقوط ماسح الزجاج من أعلى إلى أسفل، وحيث التي تَلَقَّتْ خبر سقوط الأب هي زوجته ( = الأب). حالة من الْتِفافِ الدليل ودائريته بالنظر إلى العلاقة بين الطابقين: التاسع عشر والأول؛ توصيف دائري يضمن بقوة خاصية الكتابة المتاهية، هكذا يبدأ الوصف ـ الصعود، أي رحلة مسح زجاج النوافذ أو صباغة واجهة بناية المسرح البلدي، سيان، باعتباره سفراً يُنجِز تأويلاً، وينجز إخباراً مبنياً على وصف المكان بصورة معكوسة، وهو ما نجمله في الصياغات التالية:
1 ـ زوجة الأب بالطابق الأول تتلقى خبر سقوط الأب من الطابق التاسع عشر. 2 ـ هو نفسه مديرا لشركة ملابس. 3 ـ عشيقته طبيبة الأسنان وصديقة زوجته. 4 ـ موظفة يبتزُّها بفيديو. 5 ـ ابنته الوحيدة من زوجته الأولى. 6 ـ هو نفسه مربياً لكلب. 7 ـ والده الصبّاغ الذي سقط من الطابق التاسع عشر. 8 ـ هو نفسه مدمناً الأفيون بعد وفاة الأب. 9 ـ هو يتعارك مع مدير الجريدة. 10 ـ زوجة الأب وهي تَجُسُّ تَرَهُّلَ أنوثتها. 11 ـ هو يحرق سيرته الذاتية الفاضحة. 12 ـ زوجته الثانية تداعب أنوثتها في حوض حمام. 13 ـ هو يُحَسِّنُ من لِياقته في الملاكمة. 14 ـ هو متنكِّراً لزوجة غريمه. 15 ـ هو محاولاً الانتحار. 16 ـ هو مع عشيقته. 17 ـ طفلته مع زوجته الثانية. 18 ـ هو يصفع زوجته. 19 ـ كوثر؛ زوجته الأولى، السينمائية، التي طلقها بغباء.
هي إذن حكاية مقلوبة، الحكاية باعتبارها كتابة بالمرآة، أو كتابة بالضِّعْف، يُتْقِنُها إسماعيل غزالي ويبحث لها عن تلوينات وإقامات سردية متعددة المقامات والسياقات؛ حيث الانتساج رهيب بين الحكايات، ففي قصة (الأفعوان) نجد الأب الذي كان صائد ثعابين يَلقى حتفه بلدغة أفعوان، هو الأفعوان ـ الثعبان. في حين ابنه سائق الترام المتقاعد سيلقى المصير ذاته لكن بدهسه من قبل الترام ـ الأفعوان، تعددت وسائل المأساة لكن تبقى نهايتها واحدة.
أما في (باب المغاربة) فتنطلق الرحلة من العالم باتِّجاه الذات، وذلك على خلفية زيارة السارد للقدس، حيث اغتيال الرغبة في تَمَثُّل التاريخ واستعادة الفائت ذاكرة، رغبة صادرتها صلافة الجندي الإسرائيلي، وحيث الوضع مأزوم خانق الأنفاس. ينفلت منه متذكراً ما مضى بالعودة إلى زمن الطفولة حيث ذاك البراق المحقق لفعْلَي الإسراء والمعراج يعادل جحش الطفولة المسروقة، والتي لا حَظَّ لها في اللعب، هي منزوعة من عالمها البريء المتحلِّل من أي نوع من الالتزام، والزَّجِّ بها في القيام بوظائف الكبار عبر فعل السُّخْرَةِ من قبل العمَّة لجلب الماء بواسطة جحش كان له منطقه الخاص في الإسراء الأرعن، وفي استباحته أمام أقرانه في مشهد من فرجة ساخرة ومستهزئة..
عملٌ يساعد إسماعيل غزالي أيضا على أن يكتب بالألم، ويساعده على تضعيفه بتحليك مشهد الانكسار الفظيع للروح، وبتضعيف الفجائعي والمزعج والكابوسي؛ ففي (طواف الدراجات الهوائية) يقف على رعب المعلم الجلاد المنكِّل بجسد طفولي عجيناً مطيعاً لكل القوالب، وعلى اكتشاف الأب مضاجعاً للخالة، وعلى أعتى الإحساس بالضجر والسخط مخافة تفويت متعة مشاهدة الدراجات المتسابقة والمارة، في حدث استثنائي، بالبلدة، نزولاً عند رغبة الأخ في الحصول على سكين لردِّ الاعتبار لكرامة الذات الممسوسة، لتؤول الأمور إلى تلك النهاية المأساوية المرعبة، حيث مصرع الأخ على يد غريمه بضربة سكين، مصرع متبادل في الذهاب إلى ضِعْفِ الحلكة والسواد والإبادة..
ومعلوم كذلك، أن إسماعيل غزالي يهتمُّ كثيراً بالجملة الأولى صياغة في مفتتح سروده القصصية؛ يكثفها ويودِع فيها البشارات، ويجعل الغلال كامنة في بطنها، فتكون الجملة الأولى أميرة، بمثابة الطلقة المسدِّدة والمهندسة للإصابة اللازبة، وحيث بقية الجمل السردية وصيفات تعملن على إضاءتها. طقس في الكتابة يذكِّرنا بالسرود التي شكَّلت منعطفات مهمة وملحوظة في تاريخ الكتابة السردية العربية؛ كما مفتتح (ثرثرة فوق النيل): "شهر أبريل، شهر الغبار والأكاذيب". أو مفتتح (شرق المتوسط) المسرِّدة لتراجيديا رجب إسماعيل: "أشيلوس تَهْتَزُّ، تترجرج، تصيح كديك مذبوح". هنا في قصة (الجسر)، المكان المرعب الذي لا حظ له من رقة ورومانسية (يا جسراً خشبياً..) لفيروز، هنا نجد الجملة الاستهلالية تلعب بقوة هذه الوظيفة الاختزالية الثّاوية فيها كل التفصيلات: "وقفت على الجسر أرصد برثاء النهر النّافق". ص 19.
وإسماعيل غزالي، على عادة الكتابات الأصيلة، يكتب بالحلم، حيث قصة (الكاتدرائية) تعتبر نافذة حقيقية لاشتغال الذاكرة باستعادة زمن قضاه السارد في الجامعة، الزمن البُلْشُفي الغميس في الحلم بالتغيير، وبالحلم بالكتابة؛ في أن يصبح السارد شاعراً، وفي أن يصبح صديقه أوشَّنْ روائياً. وتنتهي القصة برعب القتل، حدث مسرحه بإيطاليا، وهو يحمل بصمة المافيوزية اللاعجة، أو كما تنتهي أيضاً بقعر النهر مبلَّلَة برعب الغرق، فتكون كتابة موهوبة لكابوسية الأحلام.. في حين يوهَب نص (المشّاؤون) للكتابة بالمرآة، وذلك بالنظر إلى تشعُّب وغنى "دليل" المشي، على اعتبار أن المشّاء المسرنَم تعلم المرأة المتقافزة ككنغارو قصته، كما تعلم نواياه.. وهي بدورها يعلم حكايتها الرجل النحيف المتعارج في مشيته، كما يعرفها السارد أيضاً، فهي (المرأة الحصان)، أما هو فيعرف حكايته صاحب الطاكسي معتقدا بأنه كاتب، وحيث هؤلاء جميعاً ينتهون إلى مصحة عقلية، عبرها يتمُّ التَّعرُّف على أسباب خبلهم، وحيث الطبيبة تلعب دور المرآة لتعكس بجلاء صور انكساراتهم وخساراتهم المعتمة، كما تعكس حقيقة السارد باعتباره محققاً بوليسياً تَكَتَّمَ على أسرار وجرائم مبدِّلاً إِيّاها بأخرى متخيَّلة لتستقيم هويته باعتباره كاتباً روائياً..
لابد من الإشارة أيضاً إلى أن كتابة إسماعيل غزالي تقوم على عجائبية منبنية على مفارقات حادة لصور يستوْلِدها التأمل في الأشياء والوجود والذات، وتستولدها أحلام صحوه التي يُنجزها سواء كان ماشياً، أو مسافراً في دهاليز الروح أو نازلاً إلى قعر كأس مستقرئاً أحواله وهيئات أهوائه.. شرطاً قائماً لضمان الوجود، أو مسافراً/ مقيماً، سيان، في أرخبيلات لها كامل الحصة من الرذاذ الموهوب للاستيهام الجارف والمحمَّل بالحلم غير المتخلل بالتقديس، فدمه غير منذور ليرشو اليأس على شاكلة الأغونشيشي، بل المخترق بكامل هيبة المتعدد والمختلف وفق نزعة وثنية عاهلة بسمُوِّ الشامبانيا المنفلتة من اعتقال زجاجة ومن انحدار الماء، ممجدة لاشتعال شرارات النار السامية.
هكذا، يجاور في لوحاته حيوانان خرافيان، أعمى هارباً مع كلبه، أو يعادل بين دون كيخوط ممتطياً حصانه بلصٍّ يقود كبشاً أو بمصارع يروِّض كلباً، أو يعادله به هو راكباً على متن دراجة؛ صورة مستصدية لشعار دار المتوسط، حيث دون كيخوط يوقِّع الأعمال المطبوعة ويهبها هويته الفروسية المغامرة سفراً في جغرافيا الأرواح والمهندسة لأرخبيلاتها.. في مثل هذا الجنون من الكتابة. وقد وهبها ظله على متن دراجته الهوائية القاذفة به في منحدر الرعب، وحيث لا قرار لدوران عجلَتَيِ الدراجة إلا سقطة مدوية تطحن لحمَهُ وتمزِّقه وتكسِّر عظامه وتفلق جمجمته، وحيث هنا فعل الدوران يحاكي طواحين الهواء، الفعل المتاه المعالَج بطعنات مجنونة بسيف الكيخوطي، معادلاً لطعنة سكين غادرة على جسر النهر..
هي عجائبية مدينة في مرجعها للأصل في تسريد (الكائنات الخرافية)، وفي امتدادها أيضاً في تسريد (عين الفرس) للميلودي شغموم. ص 67.
وإسماعيل غزالي ذاك ديدنه بالنظر إلى استجابته لمبدأ الحرية النسبي، وباعتباره منقاداً إلى الاستجابة للمختلف وللمخلخِل ولِغير المهادِن.. وباعتباره أيضاً منقاداً إلى كتابة خاضعة لإحساس الطفل الذي يلعب بجدِّية، إنه يكتب وهو يتحرك، فهو المشَّاء، يكتب وهو يَرُجُّ جسده معادِلاً لفكره ولذوقه الجمالي في الحياة وفي العلاقة بأشياء العالم وعلاماته.. هو يفعل ذلك حين يكتب على غرار طقس الكتابة ـ اللعب لدى الطفل الذي انتبه إليه فيه: بورخيس، مما جعل قارئ عمل غزالي يجد نفسه أمام كتابة مشهدية، كتابة مسكونة بالحركة، ومدينة في مرجعيتها للسينما، ومسكونة بمنطق التتالي للقطات. هو أسلوب أيضاً مدين للوعي بنموذج من الكتابة، يمكن نعتُه، باستعارة بنعبد العالي بالكتابة بالقفز والوثب، وذلك في سبيل توصيف منجز كيليطو في الكتابة الموصولة بنظيرتها لدى مونطيني (7)، وهو أيضا نموذج يسعف في تَمَثُّلِ حالة التحويل إلى لقطة مصوَّرة.. من شأنه أن يخلق فسحة هائلة من الاستيهام لكل القراءات الممكنة، كما يُمَكِّنُ كل قارئ من الإحساس بأنه يمكن أن يتحوَّلَ إلى قارئ بالعين، قارئ يحمل الكاميرا على الكتف، لِيُحَوِّلَ اللغة إلى مشهد مصوَّرٍ، وهي إمكانية قرائية، أي هُرْمُسِيَّةٌ لها ما يبرِّرها في الهوية السردية المعتمَدة في كتابة إسماعيل غزالي..
مبدأ "الحركة": ماء السرد وهاجس التروبادور:
يكتب إسماعيل غزالي جملته بعين بصرية محكومة بالدينامية والتَّحوُّل، أي محكومة بالحركة. إنه يكتب بعين السيناريست، وكأنه يجعل من (ثملاً على متن دراجة هوائية) ولادة متخلِّقةً من (عزلة الثلج)، أو من (موسم صيد الزنجور)... وكلها طاقة هائلة من "السرد الفيلمي"، ومنبثقة من أعطافها؛ هو أفق في الكتابة يتخلل كل تفاصيل هذا العمل، منذ الإعلان عنه في البدء، أي في صيغة خاتمة الكتاب، تلك الخاتمة المبدوء بها: (خاتمة مسبقة: تمرين غير صالح للعرض)، حالة تؤكدها أيضاً صيغة المقدمة والمتضمِّنة بدورها لما يشي بهذه المرجعية السينمائية وفق لفظ (سيناريو) ولفظ (المخرج): (مقدمة لاحقة: سيناريو سقط سهواً من مذكرة المخرج).
يحتفي إذن، إسماعيل غزالي بالسينما عبر تخصيصها ب "الدوار" الأخير، معزوفة في المديح، مكرِّساً لها عشقاً يكوي الضلوع، وفي الآن نفسه رثاءً للمآلات التراجيدية التي كانت من نصيب دُورِها وتاريخها الممجِّد لها في مساءات أربعاء سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين؛ هكذا، يكون (انتباه، كاميرا) نصاً موهوباً لمديح السينما من خلال الإشارة إلى تشكُّل الوعي البصري وجماليته لدى السارد، عبره ومن خلاله تشكل لديه الخيال الموهوب للعشق العاصف للأفلام.. بَّاطوسٌ كان الفضل في استنباته في وجدان الطفل الذي كان ل (أكيرا كوروساوا) من خلال عمله اللافت في تاريخ السينما التي ترعى الذكاء، والذي عَدَّهُ بمثابة الفيلم المدشِّن لسلسلة من البحث عن أفلام شبيهة لمخرجين سَحَرة كانوا "من عصابة المخرجين الملاعين". ص 123.
اقْتُنِصَ عنوان هذه القصة من الإطلاق بالصيغة ذاتها على نادٍ سينمائيٍّ: (انتباه، كاميرا)، والذي كان له الدور الكبير في التأطير والتوجيه وصناعة الفرجة المبنية على الذوق الرفيع بلمسة شاعرية محلِّقة.. بعيداً عن كل هاجس تجاري يُسِفُّ الذوق ويَسْتَنْزِلُهُ إلى الدرجات المعتمة الخفيضة جداً، وحيث النادي قدَّم أعمالاً هادفةً كانت نتيجتها ذهاب السارد إلى امتهان الإخراج السينمائي، وعيٌ جمالي بمكونات الفرجة اكتسبه أيضا بإحدى الدُّور السينمائية، والتي حاق بها مآلٌ مفجعٌ يَهْجِسُ بمتاجرة فيلمية لا نصيب لها في تربية الذوق، كما أن امرأة قاعة السينما أو سيدتها، ستكتسب أدوات مهمة لِفَكِّ شفرات الرسائل البصرية، كانت قد ورثتها عن النقاشات التي شهدها النادي السينمائي إِيَّاهُ، مما سهَّل التقاطع بينهما على مستوى الهواجس نفسها من حيث كون قصة فيلم (مصباح علاء) تنتهي بما يُحرِّضُ على مشاهدة النهاية التي آل إليها بطل (راشومون)، تأويل مبني على المرآوي، للتأكيد أيضاً على الكيفية التي يقتفي فيها البصري المكتوب، والتي تُدينُ فيها الأعمال لسابقاتها باعتبارها مرجعها.
هكذا، فإن (انتباه، كاميرا) جاء خطاباً في التَّأَسّي على عهد في الفرجة ولَّى وباد.. عهد كان جادّاً في صناعة الإنسان، أي في صناعة رؤيته إلى الوجود كما حال سيدة القاعة تلك، أو حال حارس السيارات الذي اكتسب هو أيضاً ذوقه في الحياة من خلال ما دمغه به وجدانياً وعقلياً فيلم (راشومون)، الأثر الممتد أيضاً في الشفتين، في لهيب القبلة اللاعجة التي ظفر بها (الكومبارس)، أو لعله الاغتباط المعلَّل ـ motivée ـ، دالٌّ لأثر في النفس، والاغتباط المجرّد والحر والمكرِّس للرغبة في كل انفلات بعد أن كان الكومبارس مدمناً على ممارسة أنواع مختلفة من القفز المتسلسل للإفلات من الإكراهات المؤسَّسية بدءاً من الانتساب إلى المدرسة، نحو رحابة وحرية مكفولَتَيِ الوجدان في عالم السينما..
ويزداد هذا الاندغال و"الحلول" الذي تقترفه الذات في مديحها العاشق للسينما في (آنسة "كلاكيت") ص 131، حين نجد تراكُباً دقيق الانتساج والمرآوية لمصائر شخوص يجمعها العشق وتفرقها الحروب؛ ذلك أن (ريف) الجندي المغربي المجبر على الوقوف إلى جانب إسبانيا الفرنكاوية، سيصاب برصاصة موجعة.. كانت باباً مشرعاً للأنين والصراخ الذي لا يُلَطِّفُ من غلوائه إلا النداء باللغة الأم، بالأمازيغية، وضعٌ سَيُفَطِّنُ تيثريت معشوقته التي اضطرت، هي الأخرى، للزج بها في شاحنة مهجَّرة مع أخريات إلى الجبهة بإسبانيا بغاية تقديم خدمة جنسية للجنود المغاربة للحدِّ من استفحال ظاهرة اغتصاب الإسبانيات.. تيثريت المخطوفة كانت لها كل المواصفات المؤهِّلة للفرار من "غيطو" الاستغلال الجنسي والانضمام إلى جبهة الثوار الجمهوريين والمعارضين لديكتاتورية فرانكو، وأيضاً حمل السلاح، لتكون مسعفة (ريف)، قادتها إليه أمازيغيته، ولتكتشف بأنه عشيقها.. انعطافةٌ ستفضي به إلى تغيير وجهة النظر والوعي بقوانين اللعبة، حيث المغاربة ملعوب بهم، ويتحول (ريف) إلى مناصرة الجمهوريين والزواج بتيثريت، لينجبا ابنهما (أسيف)، لكنها ستلقى حتفها في الحرب، وبعد عودته إلى المغرب، كان ابنه بصحبته، ينعم بنشأة قائمة على حُبِّ السينما، عشق قاده إلى امتهان الإخراج، كما قاده إلى عشق آخر عاصف لحاملة الكلاكيت. والذي، على خلفية مواعدتها، لَقِيَ حتفه وهو في الطريق لجلب باقة ورد، إذ سيسقط عليه مِظَلِّيٌّ بدل العشب، فيكون الساقط هو الأب (ريف)، والضحية هو الابن (أسيف). هي حالة موهوبة للكتابة بالمتاه، يقدمها إسماعيل غزالي حيث المصائر والحيوات تتداخل وتتكرر في عَوْدٍ أبدي ولانهائي، آلية في أسلوبية مستبدة بأغلب قصص (ثملاً على متن دراجة هوائية).. والتي نطالعها بوضوح أكثر في (فراشات البركان النائم) حين يضيء (أنا) (هو)، بل إن (هو) لا ينتهي أبداً إلا ليبدأ (أنا) في ذهاب هذا الأخير إلى جغرافيا النفس وإلى لعنة الأقدار في حالة من الاستنساخ للحيوات والخضوع لمنطق التشابه؛ فالكشكيُّ يذهب ممتداً وعكسياً في الراوي، والراوي، بدوره، يذهب ممتداً وعكسياً في الكشكي، ذلك أنهما يريان الفراشات السوداء، وأنهما معاً "يَتَبَسْبَسان"..
وتتأكد، مرة أخرى، حالة التداخل تلك بين سائق الطاكسي والعجوز المسافرة على متن قطار، خضعا لِمِحَكِّ التعدد في الزواج، كل بطريقته في الانشداد إلى المرجع الثقافي والمُبَايِن بينهما في ما يُوَقِّعه الجسد من خطوٍ زمناً، لكنهما أيضاً يتفقان معاً في مسألة الانخطاف الوجداني إلى واحدة، وإلى واحد.. بالرغم من ذاك التعدد، كأنها حالة من التبئير المختزل، أو النقطة التي ينطلق منها فعل العبور الدائري على مساحة كرة باسكال.. هي بمثابة الكتابة بالضِّعْفِ وبالمرآةِ أو ما عبَّرَ عنه إسماعيل غزالي نفسه ب "الدوار"، والمؤكدة بواسطة الصيغة المترددة ("وقصص أخرى") في البرنامج السردي للعجوز الحاكية دون إنهاء حكايتها لَمّا كانت على متن القطار، وأيضاً في البرنامج السردي للمفترض أنه عدّاء ماراطون، كما، وتماماً في البرنامج السردي لزوجة العدّاء..
وتتأكد الكتابة بالسينما لدى إسماعيل غزالي من خلال ذلك الظهور الوامض الشبيه بالإطلالة الخاطفة لدى ألفريد هتشكوك، والتي بها يُوَقِّعُ أفلامه، وحيث السارد في تجربة القصِّ لدى إسماعيل غزالي هو مهندس سيناريو فعل القتل الناجم عن عراك على متن قارب، قتل له كامل العبث إنجازاً بالنظر إلى المنطقة المرتجة وفق الحركة المندفعة أو الفاترة لمياه النهر والموصولة بجلسة مرتجَّة أيضاً في الفعل الذي يحدثه النبيذ، وما أسفرت عنه النزوة المقترفة من استبدال لِفاعِلَيِ المتعة الجسدية، هي ليلة ماجنة اختلط فيها اقتراف الأهواء، وامتدت في نهار تُصَفّى فيه الحسابات على ظهر "القارب المترنِّح".. ثم تلتبس خيوط السرد ليكون حدث المجون والجنس ذاتهما قد وقعا للسارد لمّا اصطحب الزبونُ ذاتُه صديقتَه إلى شقته المحتشدة كتباً. ص 27.
هكذا، يمكن النظر إلى طريقة الكتابة هذه، باعتبارها مرآوية، أو لعلها الكتابة بالضِّعْفِ، بإنجاز برامج سردية على ضوء أخرى.. بشكل لامتناهٍ يترجم حالة إخضاع متخيَّل السرد للكتابة ـ المتاهة، والتي توفّر للدال هامشاً مهماً للتسنين وفك التسنين، أو التركيب والتفكيك السينمائيين. كما يمكن النظر إليها من خلال تمكين السارد من الوعي بماجريات الأحداث، ومشاركاً فيها يضمن له صناعة الحدث وهندسته، ويضمن له إطلاق ( intradiégétique) دليلَ الحضور كما تسميه مياك بال في التمييز بينه و ( hétérodiégétique).
هي كتابة متاهية ومتشابكة تتخلل قصص إسماعيل غزالي، وتجعل الحيوات فيها موصولة ببعضها، أو لعلها شرفات تتبادل أدوار متعة النظر، ولا منطق للتتالي، بل للدوران وللعود الأبدي؛ ففي قصة (السفينة) يكون السارد قد اعتقد بأن الذي رآه على ظهر السفينة هو جبرا، في حين لم يكن إلا مخرجاً سينمائياً أرجنتينياً، والذي رآه، مرة أخرى، واعتقده كورتاثار المخرج السينمائي الأرجنتيني، لم يكن إلا جبرا الرسام الفلسطيني.
ثم من بار محمد شكري، في الطريق إلى بار إزمرالدا على متن طاكسي تُقِلُّهُ وصديقته الإسبانية باولا، يفيد المذيع بأن سفارة مصر ببغداد قد تفخَّخَت، فتهدَّمَ بيت الكاتب الفلسطيني جبرا بشارع الأميرات..
وكأنَّ إسماعيل غزالي، بهذا الصنيع، يؤكد على أن حياته منزوعة من أحلامه في جزعها وفزعها وكابوسيتها.. يجعله مفجِّراً لنزعة كافكاوية في كتابة السرد؛ فهو كاتب حالمٌ، كاتب مجرِّبٌ وكاتب صادمٌ بمتخيَّله الكابوسي والمرعب ذاك، فكم يبدو هذا المتخيَّل قاسياً، وكم يبدو متلقيه غارقاً في تيهه ومتاهاته، حين يتدفَّقُ سرد إسماعيل غزالي ويندفع شلّالاً في تمجيد السقطة الأولى المستعادة حلماً وغوايةً "لاواعية".. لترجمة الإحساس بهباء الانتساب إلى هذا العالم ولعنته.. فَأَنْ تَعِيَهُ هو أن تكون رؤيتك إليه منهوبة، مصعوقة في انذهال لايُحدُّ..
كل ذلك الإرباك والقلب لما بات يقيناً، والتشكيك فيه، هو حالة تتأكد باعتماد صيغة النعوت المؤكِّدة والمعضِّدة لما يريد أن يتشكك فيه ويرتاب منه؛ نقصد النعت في ما يذهب إلى الطباق، من خلال صيغة: خاتمة/ مسبقة، وصيغة: مقدمة/ لاحقة.
بهذا العمل، وبكل أعماله التي تشكل توليفة متخيَّلِهِ، يتأكد بأن إسماعيل غزالي شخصية سردية سندبادية دائمة البحث عن إيثاقاها الملتبسة والغامضة الشاسعة الجغرافيات؛ يسافر مغترباً ليأتي بالغلال، إذ على متن دراجة هوائية، يكون قد حمل كل الجهات وقال: "أسكن أينما وقعت بي الجهة الأخيرة"، وذلك على غرار ما يفعله الغجر حينما يختارون الفراغ وينامون، فعل قريب من ريح الكردي وقد سكنت نَفَسَ درويش (8)، والتي هي في هذه السرود ممهورة بحس وجودي قائم على التجربة ومنتزعاً منها.. إنه ما يجعل نصوصه تروي عن نفسها، طامسة وملغية الوعي القرائي الذي يجعل المؤلِّف صاحبها؛ نصوص تتخلَّق بنفسها وكأنها تنبثق من بين الصخور مستعيدة طقسية انبثاق مياه عيون أم الربيع، باحثة عن منافذ ومسارات لمساربها مدرَكة أو غير مدرَكة، سيان، ذلك أن حياتها منذورة للضياع و"للتَّحَلُّل" في الملح (9).. وهو ما يجعل وظيفة المبدع محددة في تنفيد فعل التحقق لزمن السرد هو تماماً كجريان مياه النهر.
يتمثل رهان إسماعيل غزالي، في النزول إلى نهر السرد، بإتقان الكتابةَ سباحةً بابتهاج كبير، كأنه يكتب "سرود المرح"، وهو يسبح، أي وهو يكتب، لا يقترف هذه "الخطيئة" كالأوروبيين، ولا كما يَسْبَحُ سُرَّادُ المشرق العربي (10)، ذلك أن رهانه وهو يطالع فَنِّيَتهم في الْعَوْمِ ويستحضرها تضميناً، هو أن ينتسب إليهم دون أن يكون أولئك ولا هؤلاء، ولكن أن يكونه هو، وفقط هو، في هويته السردية المودعة في الكيفية التي تتجلى بها سروده.. حالة من الكتابة وفيها كان قد ورثها، لاوعياً، عن أُمِّهِ وهي تُطَرِّزُ الإيقونة ألأطلسية الأمازيغية ضوءاً ملغزاً وفاتناً في مساحة زربية، ثاوية فيها كل أنواع أحزان الوجود، في رهبة الْقَرِّ الذي يوفره بسخاء "أعاري"، ويمنحه بكرم كبير أكثر كل فصل شتاء، كما يمنحه عنجهيةً وصلافةً مجتمعٌ أبيسيٌّ يُهَنْدِسُ بإمعانٍ رجولته المريضة المنتقمة من المرأة ومن ظُلْمِ الكولونيالي، حسب إلماعة صاحب (الاسم العربي لجريح) (11) أو (جرح الاسم الشخصي) حسب تنويع آخر، تلك الإلماعة المفكِّكة لهندسة المجتمع والمنتقمة من إعتاماته "الجغرافية" الأبيسية منها والسياسية..
إن دَالَّ التشكيل الهندسي في رقعة الزربية مُعادٌ ومكرورٌ في مختلف الرُّقَعِ التي تجود بها الصانعات، لكن تلك التي شَكَّلَتْها أُمُّ إسماعيل غزالي لها خصوصياتها في ذهابها إلى وَعْدٍ هو هذه الكتابة السردية الفاتنة والمستمرة في إحساس إبداعية الأم بطريقة مختلفة وبوعيٍ حادٍّ بحدود التَّماسِّ بين الصنعة والفطرة الذاهبة به إلى الْحِرَفِيَّةِ، أي إلى اكتساب صفة بورخيس تلك الممنوحة له من قبل الخطيبي: elhacedor. (12). لذلك يحتفي إسماعيل غزالي بأمه، مستحضراً إياها في سروده بطريقة تذكرنا بالفعل إيّاه كان قد اقترفه محمد برادة في "لعبة النسيان"، حين تساءل البطل: (من منكم يعرف أمي؟)، وحيث المقام لاعج في نضالية الحزب بحثاً عن فهم ملابسات المرحلة في انعطافتها القامعة، هنا في نموذج غزالي نُذَكِّرُ بما يلي:
(كم يشبه أزرق جلباب أمي) ص 64.
(تذكرت قرط أمي موشومة الوجه) ص 67.
وكأن إسماعيل غزالي يستعير اهتمامَ الخطيبي وكَلَفَهُ بالعلامات، مفكِّكاً شفراتها بسيميائياته المخصوصة، تلك النَّاحتة لمفاهيم جعلت بارث ـ Barthes ـ الهرم المجدد في درس الأدب الأوروبي يدين له مفهومياً، كما صرَّح في عنوان تقديم (جرح الاسم الشخصي): (ce que je dois à Elkhatibi)، (13)، وإسماعيل غزالي بدوره يستعير هاجس البحث في الوشم وفي الزربية من خلال كلفه بالعلامة البصرية، لِيُقَوِّضا معاً، هو والخطيبي، الميتافيزيقا جَاعِلَيْنِ من العالم مجرد حكاية، وحيث التقويض هنا أيضاً لا يتحقق إلا بشرط أساس "هو الانتقال من "الألفة إلى الغرابة" (14)، وحيث مهمتي هنا كقارئ ليس رَدُّ الغرابة إلى الأُلْفَةِ بالمَخْبَرِيَّةِ الْهُرْمُسِيَّةِ المتطلِّبة؛ ذلك أنني لست مؤرخاً، فتاريخ الأدب يُضْجِرُني لَمّا كان هِبَةَ السياسي الماكر، وقد تَمَّ إيداعه بغباء تحت وصاية ما يسمَّى ظلماً "الأطاريح الأكاديمية" لتستمر سلطة السياسي في الوجود مهندسا لمساحة التفكير وحدوده، بل الأجمل هو تضعيف تلك الغرابة لترتاح النفس في قلقها، في تيهها وإمعانها في الضلال، هو صنيعٌ من شأنه أن يقود إلى "أفول الأصنام" المورِّثة للكسل القرائي.. كتابة إسماعيل غزالي مستفزة لا تقود إلى الفردوس، تلك الأراضي المضجرة بالاستهلاك، فقط تكون ماتعة إذا كانت "فراديس مصطنعة" (15)، بل هي كتابة تُسْلِمُ القارئ إلى الدَّوار وإلى المتاهات.. وحيث إسماعيل غزالي في كل إصدارٍ جديد يتجددُ شرطُ الموعد مع الغرابة كما أرادها كيليطو في كتابه ـ التأسيس: (الأدب والغرابة). إنه يتجدد لأنه يغترب، ولأنه يُنَوِّعُ إقاماته؛ فهو وإن كان لم يَنْتَوِ الخضوع قسراً ل "إقامته العاشقة والمزمنة" بموغادور، فإن نفسه تهجس متلبِّسة ومُفْتَتِنَةً بنزعة الغجر والتروبادور الذاهبة إلى السَّكَعِ العمودي حيث كل ما في المكان يُسْعِفُ في النزول إلى النفس السادرة في صمت الرواقية المتطلِّب عزلةً وتأملاً وبهما معاً.. تُوقِعُ به موغادور، وهي المفخَّخةً/ المكتظة بالقطط وبلحظات الغروب الشاهقة، في استعارة عيون الفاتن والجميل القادم من الشمال والمتوحِّد بفتنة وجمال عيون القطط.. تلك التي يجب التقليل من سهام رموشها، ومن فتنة لازورديتها بِالْفَقْءِ كما حال إدمون، أو بطهيها كما حال فعل شهيد بركة النبيذ: باكوس.. حالات ممعنة في دهشة واضطراب النفس الراجحة بقداسة النبيذ، والعاهلة به وسادنة المكان، كما تحكيها بجنون عاصف (قطط مدينة الأرخبيل).. (16).
ورغم ذلك، فإسماعيل غزالي منذور للترحال، فها هو يختار مبادلة الشاعرة منى ظاهر الصفات؛ فيكون كنعانياً وتكون هي أطلسية، وكما تكون الشمس في موغادور، في امريرت، مكناس، أصيلة، طنجة، سلا، الرباط، نيقوسيا.. ثم تغيب، يكون هو أيضا في هذه الأمكنة ثم يغيب.. يفعل ذلك ليجدد الرؤية، وليجدد الحلم باحثاً عن سبيل يجري فيه ماء السرد مندفعاً بعنف في فضاءاتها المتشعِّبة والقوطية؛ هي سقطةً وجوديةً، منتزعة من رؤية تراجيدية في الأسطقسات؛ من ماء وتراب وهواء ثم تلك النار الكامنة في لاوعي جدع الشجرة الشامخة أرزاً، وفي لاوعي مستقبلها الموصول بعيون أم الربيع.. النهر المكسِبُ المبدعَ هويته من خلال هذا العمل ومن خلال (النهر يعض على ذيله) (17)؛ انتساب يجعل إسماعيل غزالي يقترن بنهر أم الربيع كما اقترن نهر الراين بشومان وهولدرلين، وكما اقترن نهر سبو بمحمد الطوبي..
تأمل الوجود، تأمل الزمن في النهر:
في البدء كان النهر؛ حيث في الانجراف، أي في مهوى الشَّلّالِ المنقذف من أعلى يكون الدوار، كينونةٌ مصادَرةٌ حياتُها لِيَتِمَّ فسح المجال أمام تراجيديا الموت، فالنهر الذي كانت مياهه متدفِّقة ومندفِعة هو الآن "نافق".. هكذا يُدَشِّنُ السرد آليته في الكتابة بجنائزية تجعل الذات مفجوعة في النهر: (وقفتُ على الجسر أرصد برثاء النهر النافق). ص 19. وحيث الأحجار التي صقلتها الأمواه في القاع تبدو شبيهة بوجوه منهوبة الملامح من شدة الصدمة الفنية ذات النزعة الأرطوية ـ نسبة إلى أرطو ـ سواء في حقله الأثير: المسرح، أو في حقل الدرماتورجيا المدعوة لتحقيق مشهدية الكتابة، و لتأثيثها كأكسيسوار، كلغة سينوغرافية لها أثر تمكين حاسة الأذن موسيقيا من نصيبها المشهدي، أو علامة بصرية ذاهبة إلى ذوق رسّام في إعادة المفقود إلى الفاقد.. لمنحه هويته قبل هذا اليباس، وقبل هذا السواد الأشد حلكة: هو الموت المانح كامل الرعب للوجود، وحيث لا حركة ولا نَأْمَةَ لكائن حي، إلا من نملٍ أحمر "يُعَسْكِرُ" حول عظام الأسماك وجماجم الضفادع.. هنا يصبح القيظ حليفَ الموت وتَوْأَمَهُ في النهش إِزْمِيلاً يُثَقِّبُ طبلَ الوقت المخروم، الواهب طعنة غادرة، والتي جعلت السارد يَنِزُّ دماً، عَلَّهُ يترع النهر على الحياة، حياة لا تستقيم إلا في ما تَتَطَلَّبُهُ دَمَ قُرْبَانٍ؛ فالموت لا يتنازل عن حصته، دون أن يقايضها.. هكذا أصبح الجسر مسرح طعنة نجلاء في بطن السارد، كأنه نعشه أو مقدمة سريره الأبدي، جسر منزوع من وظيفته في رتق الجهات، وفي النقل من الجنوب إلى الشمال، الجسر الذي لم يعد جسراً في لكسيماته المنزوعة بدورها من أنواع متفرقة من الجسور على جغرافيا العالم التي وَطَأَتْها قَدَمَا السارد..
وكأن إسماعيل غزالي يقول بأن الحظ هنا وافر في القيظ وفي الجفاف وفي الموت المُثَقِّبِ إِزْمِيلُهُ جسدَ الطبيعة، موت هو بمثابة الجسر الواصل بين عالمين؛ بين الجنوب رمزا للموت والقحط والفراغ، وبين الشمال المنذور لحياة مجهولة، لكنها مُتَمَنَّاة.. وكأن حظَّ السارد من هذا الوجود هو الإقامة في "الْبَيْنِيَّةِ"، والإقامة في البرزخية، تكريساً لمبدأ النسبية، ودفاعاً عن القلق وعبثية الوجود في اندفاعه العابث وقتاً.. والمترجَم في دوران عجلة الدراجة الهوائية، هي برزخية تعادي كل أنواع اليقين لِئَلّا يُصاب بالغباء، مُرَمِّزاً له بالجسر.. كما أن حظَّهُ أيضا يكمن في ما يوهَبُ له خطأ، كتلك الطعنة النّجلاء الغادرة في عزِّ الظهيرة، وأين؟ على الألواح الخشبية للجسر، سرير عبور هو ذاكرة لحياة شجرة الأرز، رمز الهوية ذات النَّفَس النتشوي، والعاهلة بِتَنَشُّقِ نسائم الأعالي ويانسونِها.. وهو سارد تائِهٌ لا يعرف قراراً، ولا يعرف وِجْهَةً تُقَلِّلُ من فداحة اغترابه الناتج عن الإحساس بكثير من الضجر حين يكون العالم محكوماً بالخواء والفراغ، وحينما تنعدم الحركة.. إنه سارد برزخي وهو يُشَمْئِلُ ثاويةٌ فيه كل الجهات، تماماً كما حين يُغَرِّبُ، فكل شيءٍ يكون متشابهاً، متطابقاً، مكروراً أجوف لا حَدَّ لغبائه..
وبالنتيجة، فإن قصص إسماعيل غزالي تؤسس لكتابة جذمورية في احتفائها بالأشياء والعناصر المتكاثرة في تشابكها وفي اتصالها المندغم بعضها ببعض، سرد جذموري يجعل من عناصره المنصَّصة سرداً بمثابة النسيج المتداغلة فسائلُهُ؛ إنه دقيق في صناعة الانتساج، وفي الآن نفسه في صناعة الأفخاخ للإيقاع، كمين قتل، بكل نزعة كسولة.. محتفياً بالقلق، وممجِّداً للّاطمأنينة ضامناً لها الحق في التَّسكُّع، وحيث الإحساس باللاجدوى وبالهباء لكل انتساب مؤسَّسي هو النداء ـ الشعار الذي تصدح به حناجر هذه التجربة القصصية..
_____________
إسماعيل غزالي، ثملا على متن دراجة هوائية، مجموعة قصصية، دار المتوسط، 2022.
Roland Barthes, Mythologies, seuil, 1957, p 8
خطاب الوداع الميتافيزيقي بمناسبة إنهاء مهمة التدريس والمنشور في موقع خاص انحجب بسبب ارتفاع تكلفة الضريبة السنوية.
علال الحجام، خمائل في أرخبيل: قراءة في خطاب الميتالغة عند أدونيس، سليكي أخوين ـ طنجة، 2022، ص 46.
+ كثيرة هي العبارات التي كتبت بنفَس اللغة الشعرية، نمثِّل لها فقط، بما يلي: ـ "وقَّع الفجر إمضاءه الرفيع أسفل صفحة السهرة" ص 72. ـ "يرمق السائحة الفرنسية بعينين غابويتين يُرقرق فيهما نهر "أم الربيع" [...]". ص 118. ـ "الشعر المندلق كشلال أطلسي". ص 131. ـ "انفرج شقّ الفستان مفصحاً عن الطريق الجارف إلى شاطئ العجيزة المكتنزة". ص 132.
إسماعيل غزالي، ثملا على متن دراجة هوائية، مرجع مذكور، ص 7 وما بعدها.
عبد السلام بنعبد العالي، عبد الفتاح كيليطو أو عشق اللسانين، منشورات المتوسط، 2022. ص 58.
عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة بالقفز والوثب، منشورات المتوسط، 2020. ص 10.
نحيل هنا على القصيدة الاحتفائية الشهيرة التي خصّ بها محمود درويش سليم بركات باعتباره الغجري الأخير، والقصيدة مديح شاهق في اختلاج روحيهما.
خورخي لويس بورخيس، قصيدة (الشعر)، ضمن سداسيات بابل، حسن ناصر، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2013، ص 271.
عبد السلام بنعبد العالي، عبد الفتاح كيليطو أو عشق اللسانين، مرجع مذكور.
عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، ترجمة محمد بنيس، دار العودة ـ بيروت، 1980، ص 13.
عبد الكبير الخطيبي، بورخيس والشرق العربي، ترجمة ع. الطويل، مجلة (حكمة)، آفاق المغرب، 1992.
عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، مرجع مذكور.
عبد السلام بنعبد العالي، عبد الفتاح كيليطو أو عشق اللسانين، مرجع مذكور.
شارل بورلير، الفراديس المصطنعة في الحشيش والأفيون، ترجمة ناظم بن إبراهيم، منشورات المتوسط، 2018.
إسماعيل غزالي، قطط مدينة الأرخبيل، رواية، منشورات المتوسط، 2020.
إسماعيل غزالي، النهر يعض على ذيله، رواية، دار العين، 2015.

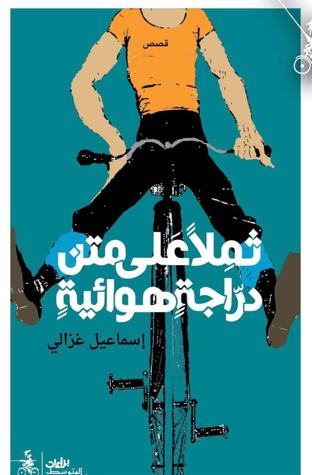


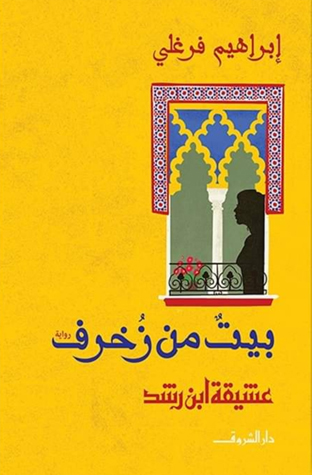


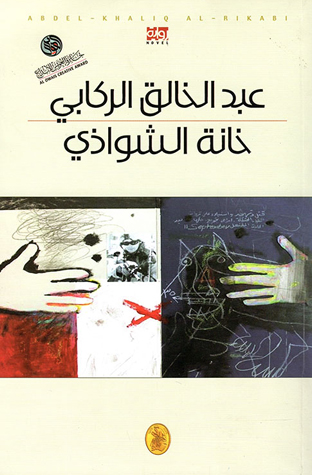

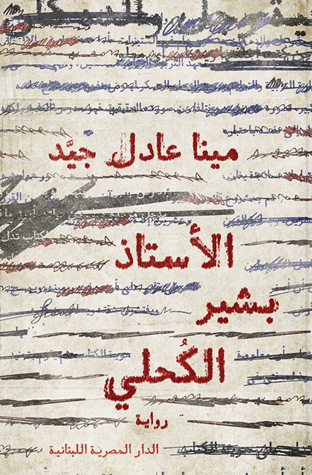

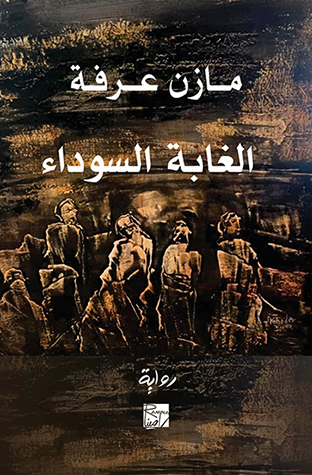


0 تعليقات