حكاية اعتقالِ ثورة عبْرَ «بوح امرأة عطشى»
قراءة بنيويّة: زياد الأحمد
تزامن بركان الثورة السورية مع بركان روائي حاول أن يرصد مجريات الحدث، والإحاطة بأسبابه، ووقائعه، وتحولاته وتداعياته، مئات الأعمال صدرت تحت مسمى رواية، منها ما كان زمن السرد فيها متزامناً مع الحدث، ومنها ما كان سابقا له بسنوات، فرصدتها بدءاً من تفاقم استبداد النظام وقبضته الأمنية، وما نتج عنه من كبت للحريات، وتغييب للأحرار في غياهب السجون، ثم تابعت رصدها بحرية أكبر منذ انطلاقتها السلمية 2011م، مروراً بجرجرة النظام لها نحو التسليح، واستخدام ترسانته العسكرية هو وحلفاؤه لقمعها، ومحاولاته لصبغها بثوب الإرهاب والدين والطائفية، ثم لإظهارها للعالم تحت مسمى الحرب الأهلية، مظهراً نفسه للعالم بطلاً في مكافحة الإرهاب، وما لحق بذلك من دمار وخراب وقتل وتشريد للملايين..
ولعلّ أكثر الصفحات في تلك الأعمال سواداً وإيلاما وفضحاً لوحشية ذلك النظام هي صفحات السجون والمعتقلات التي قلما خلت منها رواية من روايات الثورة السورية، وكان الأفظع في أدب السجون ما روي عن سجون النساء، والمعتقلات السياسيات في سوريا، ومنها رواية هبة دباغ "خمس دقائق وحسب1998"م، وحسيبة عبد الرحمن في "الشرنقة" 1999م و"نيغاتيف" و"حراس الهواء لروزا ياسين حسن" 2008م. ومنها الرواية التي سنسلط الضوء عليها في هذه الدراسة "بوح امرأة عطشى" لعقاب يحيى الصادرة عن دار نون4/ 2017م
بوح امرأة عطشى: بين العنوان والمضمون:

لا شكَّ أنّ عنوانَ النص هو العتبةُ النصيّة الأهمُّ التي يفترض أن تهيئ القارئ للدخول إلى مضامينه، بل ويرسم في مخيلة المتلقي أفقاً تنبئياً يوحي بموضوعه، والأفكار التي يحُتمل أن يتطرق إليها. وهناك من يلجأ متعمداً إلى عناوين حياديّة لا تشف عن معنًى محدّد، وهنا يجب أن يتكفّل النص بكشف غموضها، وثمة عناوين خادعة توهم القارئ بمعان كثيرة يكون آخرها هو الاحتمال الذي سيتطرق إليه النص، ولكل من الأنواع الثلاثة ميزته التي قد يفضلها كاتب ويرفضها آخر.
أما بالنسبة لعنوان هذا النص "بوح امرأة عطشى" فأذكر أنه دخل مكتبتي منذ أكثر من سنة، وقمت بتأجيل قراءته لأن اهتمامي كان منصباً على متابعة ودراسة روايات الثورة السورية، وخاصة تلك التي تؤرخ لجرائم هذا النظام، وقد أوحى لي هذا العنوان أنه بعيدٌ عن موضوعي، ومتابعاتي فهو "بوح" وقد أسند هذا البوح إلى "امرأة" واسندت المرأة إلى "العطش" ولا شك أن لفظة العطش حين ترتبط بالمرأة وبوحها ستخرج عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية كثيرة تظمأ إليها المرأة العربية المكبّلة بعاداتٍ وتقاليدَ شلتها وأبعدتها عن حركة الحياة ودورها الفاعل في بلادنا منذ مئات السنين، فهذا التركيب الإسنادي الذي اعتمده العنوان قد جنح بخيالي عن الثورة السورية، وما زاد في هذا الدور الذي مارسه علي العنوان من حجب لمضمون النص العتبةُ النصيّة التي كتبت على الغلاف الأخير، ونقرأ فيها مشهد حالة نفسية لامرأة تقف على حافة الانجراف نحو شهوة مُحرّمة؛ لكن يستيقظ في تلك اللحظة في عقلها "فرخ القرون المتيبس" ليعرض أمام عينيها جميع الوصايا والحكايا والسكاكين، ومعانيَ الشرف، والأب الذي يستل سيفَ التاريخ ليقطعَ رأسها ويغسل عارَه...
ورغم أنّ لوحة الغلاف التي تصور جداراً حجرياً تتوسطه نافذة ذات قضبان حديديّة ويطلّ من ورائها وجه امرأة؛ وكل هذا متربط بمفردات بصرية للسجن إلا أن العنوان باعتقادي سينجرف باللوحة هي الأخرى نحو معانٍ مجازية أيضاً تجنح بالقارئ نحو سجون الكبت والمعتقدات، والتقاليد، والتخلف الاجتماعي الذي سجنت فيه المرأة العربية.
وكانت المفاجأة بعد أن قرأت عدة صفحات من الرواية لاكتشف أنها رغم تسليطها الضوء على المظالم التي لحقت خلال عقود طويلة بالمرأة، ولكنّ موضوعها الرئيس هو الثورة السوريّة، بل هي واحدة من أفضل الأعمال التي سلطت الضوء بكثير من الموضوعية والعمق على تفاصيل إشكاليّة، وتحولات جذرية في سيرورة تلك الثورة، إضافة إلى الممارسات القمعية والإجرامية التي اعتمدها النظام لقمعها، ويمكن تصنيفها ضمن أدب السجون؛ بل أعتى أنواع تلك السجون؛ وهي معتقلات النساء. ومن هنا يمكنني القول أنّ هذا العنوان قد مارس عليّ كقارئ دوراً تضليلياً، وتغييبيّاً لمضمون العمل.
المحاور الرؤيويّة للرواية:
تسلط الرواية الضوء على خمسة محاور رئيسة:
- البنية الفكرية والذهنية للمجتمع السوري قبل الثورة:
بأسلوب حكائي بعيد عن التقريرية والمباشرة تقدم الرواية تشريحاً للحالة الفكريّة الذهنية التي تتحكم بالمجتمع السوري الذي يعيش حالةً خلائطيّة من مورثات الماضي ومعطيات العصر، وذلك من خلال مجموعة من الملامح؛ أهمها:
- قمع المرأة والتحكم بمصيرها:
ونلمح هذا من خلال حياة الشخصية الرئيسة (ليلى/ سلمى) والكثيرات من زميلاتهما في الثانوية فنتعرف من خلالهن إلى مجتمع قمعي تحكمه عقائدُ دينية سطحية، وعاداتٌ وأعرافٌ، وتقاليدُ باليةٌ كفيلة بالإطاحة بأحلام جيل الشباب، وخاصة المرأة، وتحطيمها، ومنه تدمير طاقات الأجيال المتعاقبة، فبطلة الرواية ليلى كانت تحوّم كفراشة مُثقلة بالحلم من عالم إلى آخر لرسم مستقبلها؛ مرة تحلم أنها في الجامعة، وأخرى أنها بطلة رياضيّة، ثم مغنيّة، وترسم صورة فارس أحلامها دون أن تمَلّ من التغيير في ملامحه، وفجأة يقرع باب أهلها - وليس بابَها- النصيبُ أو ابن الحلال لتجد نفسها مرمية أشبه بالجواري في بيت الزوجية، محرومة حتى من الحلم بذاك الفارس الذي صنعته، فدونه تهتز سيوفُ الوصايا وكرابيج الشرف التي تسلخ لحم الخارجين على منظومات قابعة في أعماق أعماق سراديب الشائع المتراكم المتواصل (ص6)
- التقنع بالدين:
الدين الذي يفترض أن تكتمل به الأخلاقُ الفاضلةُ في المجتمع نراه هنا مطيّة لمآرب شخصية، وقناعا لإخفاء القبح الداخلي الذي لا يلبث أن يطفوَ بعد أن يحقق صاحبه مآربه. فزوج سلمى جابر العراف رجل يتظاهر بالتدين والتّقى، وبهذا الوجه تقدم إلى سلمى، وزوجوه منها، لتكتشف أنه رجل خليع منافق، وخائن لأقرب أصدقائه، ومنهم زوج صديقتها ليلى التي تحرش بها أكثر من مرة، بل وحاول اغتصابها.
- هيمنة الثقافة التناقضية الخليطة من خرافات الماضي وتقنيات العصر:
توضح الرواية هيمنة الموروث الماضوي واصطراعه مع معطيات العصر الحديث في أعماق الشخصيات، وليس هذا حكراً على الجيل القديم؛ بل حتى جيل ليلى وسلمى الذي ينتمي إلى عصر الأنترنت، وثورة الاتصالات والمعلوماتية، وهذا ما تصفه ليلى بقولها "في دواخلنا تراكمات تناقضية عجائبية تجعلنا ازدواجيين فعلاً، ومتناقضين داخلياً ففي حين نعيش آخر منتجات العصر، ونستخدمها كل يوم خاصة الانترنت المحمول وتطوراته؛ كان في داخلنا ذلك الإنسان الحامل لتراث اختلاطي غرائبي مملوء بالغث والسمين بما في ذلك اعتقادنا بحكايات الغولة والسحر والتنجيم والعين التي تقتل الجمل والتقمص...." ص 196.
- تكريس النظام للفساد والعمل على تفاقمه:
هذا الواقع المتردي فكرياً عمل النظام على انحلاله وتفككه اجتماعياً وأخلاقياً وخاصة من خلال قبضته الأمنية، وسياسة القمع والتجويع التي انتهجها؛ مما أدى إلى خلق مجتمع قائم على الخنوع والنفاق، والصمت والانتهازية والحيادية، مجتمع محكوم بالخوف، والرعب والشكّ "فالأب يشكّ بأولاده وأهله، والأخ يخاف أخاه والحيطان تُخاف" ص76. وبالتالي هو مجتمع اغتيل كلُّ حيّ فيه، وعُجن في أفران الاستبداد والنفاق والتبويق.
حتى إنّ العاهرات يُحمّلن النظام مسؤولية انحرافهنّ، فتروي فاتن أنها لولا النظام لما احترفت العهر، وأن أزلامه من المخابرات والمخبرين اغتصبوها، ولاحقوها مراراً، وكذلك معلمتها جمانة التي دفعها فقرُ أبيها وجشعه إلى الانحراف؛ حين عملت معه في دكانه؛ ليكسب من ورائها زبائن أكثر. وخاصة أصحاب النفوذ من المسؤولين " حتى العاملات بالتهريب يحملن النظام الفاسد سبب وجودهن ويروين قصصاً مثل الخيال عن الفساد والرشاوي وحماية عصابات التهريب، مقابل مبالغ ماليّة أو حصص ضخمة، وتقسم أمينة أم صبحي أن أكبر عصابات التهريب محميّة من ضباط كبار في المخابرات، أو من قبل مسؤولين معروفين". ص144.
وبعد الثورة وصلت حالة الفساد إلى المتاجرة بكل شيء حتى بأخبار المعتقلين، فمن يعتقله النظام يحسب في عداد الأموات، وليس من السهل أن يُحصَلَ على خبر عنه، ومن هنا بدأ كبار المسؤولين وعصاباتهم المتاجرةَ بأخبار المفقودين، وغالبا ما تكون أخبارهم كاذبة مقابل أموالٍ طائلة، فتشكلت " مافيا حقيقية لها أذرعها وأساليبها في ترهيب الأهالي، وبثّ الشائعات عن مصايرَ مجهولةٍ للمعتقلين، ولا مانع من أن تنشر أخبارَ وفاتهم، أو مرضهم الخطير، أو أشياء تثير الأهالي وتدعوهم لبذل دم قلبهم لأجل معرفة أيّ شيء عن مصير أبنائهم وذويهم... وقد يكون الخبر ملفقاً من أساسه" ص153.
- الآثار الإيجابية للثورة:
تركز الرواية وبشكل غير مباشر على الدور العظيم الذي لعبته رياح الثورة في العصف ببنيان النظام الحاكم وذلك في مجالين:
الأول: ساهمت رياح الثورة في تعرية الكثير من الشخصيات، وكشف زيف حقيقتها ومنهم زوج سلمى، ولكنّ الأهم كشف حقيقة النظام المجرم الذي لم يتورع عن قتل شعبه؛ لأنه ثار عليه مطالباً بحريته فابتكر لذلك أعتى أدوات القمع والإجرام؛ ومنها تلك المعتقلات التي تفصّل الرواية دقائق رهيبة لما يحدث في غياهبها.
الثاني: اقتلاعُ رياح الثورة ومنذ بدايتها الحواجز النفسية التي كانت تشلّ حركة الجماهير سواء أكانت سياسية أم اجتماعية، فالنظام بقبضته الأمنية بنى جبالاً من الرعب تجثم على صدر الجماهير، وتحول بينه وبين حريته، حتى أن أحداً لم يكن يتخيل أن هذا الشعب المبرمج على كلمة (نعم) سيعيد إلى معجمه كلمة (لا) التي ألغاها النظام من كل قواميسه، وكأن تلك الجماهير التي خرجت في وجهه اليوم هي غير التي كانت بالأمس، وعلى الصعيد الاجتماعي تركز الرواية على أن الثورة نسفت القمقم الذي سُجنت فيه المرأة، أو فرضته على نفسها. فتصف ليلى نفسها كامرأة كانت في موقع اللامنتمي بلا حول ولا قوة ولا رأي "أنا اليوم غيرها التي كانت، أتنفس هواء الثورة، وأشعر أنني تغيرت بسرعة، وأنني شبه حرة ... مزقت جبني وخوفي ... إنني أنتمي إلى هؤلاء، وأغادر بإيمان كبير موقع اللامنتمي موقع المرأة التي دفنت كلّ أحاسيسها وحقوقها في مألوف يلتهمها بالتقسيط وينهشها ليلقيها أشلاء"ص79. كما ساهمت الثورة في تبدل طبيعة المرأة ونمطية حياتها فقلبتها من حالة "النسوانية" التي تتسم بالثرثرة والحسد والغَيرة، والعلاقات المملّة في الحياة الزوجية إلى حالة أخرى لها فيها أحلامها وآمالها، ومن هنا يركز الكاتب على أن الثورة لم تكن ضد النظام المستبد فحسب، بل ضد موروثات مجتمع قمعي ساهم هو الآخر بتهميش المرأة عقود طويلة. تقول ليلى "الثورة وضعتنا في فرنها البلوري النظيف؛ كي نخرج أناساً آخرين غسلنا كثير الآثام والموبقات والخوف والنفاق والتهميش والانتهازية فينا وما علق خلال العقود". ص85. وتقول سلمى: "الثورة هي التي أوجدت فينا قوة اقتحام دواخلنا المريضة، وتهديم صروح مملكة الرعب والممنوع". ص162.
- تعثرات الثورة وانحرافاتها: بموضوعية وحيادية تقدم الرواية رؤية عميقة للمطبّات التي وقعت بها الثورة، وللأسباب البعيدة التي انحرفت بها عن مرادها، وأخّرتها عن أهدافها التي خرجت تنادي بها.
وأول ذلك وسائل النظام في اعتقال وتصفية الناشطين الحقيقين والواعين "ليجيء من هو أقلّ وعياً والتزاماً، وربما أقل تمسكاً بالأهداف التي ثرنا لتحقيقها" ص133.
وبعد ذلك عمل النظام على حرف الثورة نحو الطائفية، وتشجيع التشدد والمذهبية واليافطات السوداء والأسماء الدينية؛ ليدخلها تحت عنوان الصراع المذهبي، ويفقدها سمتها الرئيسة بأنها ثورة لكل السوريين ضد نظام مستبد فاسد. وقد نجح النظام في ذلك بأن جعل البعض يظنّ أن الثورة حكر على طائفة معينة، وأن النظام الطائفي يجند كل المحسوبين عليه، وعدّ المعارضين من طائفته مندسين على الثورة وعملاء للنظام.
ولا تنسى الرواية دور تجار الحروب وأمرائها، والتآمر الخارجي، والمال السياسي الذي بعثرَ الخنادقَ، ومزق راية الثورة إلى رايات متناحرة تسيّر كل منها رياح الجهات الممولة لها؛ لتحقيق مصالحها، ولتحل تلك الرايات مكان راية الجيش الحرّ، وكفاءات ضباطه المنشقين الذين ابعدوا عن مكانهم الحقيقي، ودورهم الفاعل.
وعلى لسان سلمى تتلخص أهم الأسباب التي ساهمت في انحراف الثورة عن مسارها ومنها "هزال المعارضة، والمؤسسات المحسوبة عليها، تشتت العمل العسكري وتوزعه اتجاهات، وتشكيلات، ورايات وخندقات وحروباً بينية، وحروب مغانم واختراقات في كل المجالات" ص206
- وحشية النظام في قمع الثورة (معتقلات النساء):
لإظهار هذه الوحشية في أقسى صورها يختار الكاتب تركيز الضوء على ظلمات السجون؛ إذ تشغل تفاصيل ويلاتها معظم صفحات الرواية، وذلك من خلال ما ترويه وتعايشه ليلى وزميلاتها في سجون النساء.
وأول ما تنفرد الرواية في تقديمه عن روايات الحرب والسجون السورية أنها تشرح البنية النفسية لهؤلاء السجانين؛ فهم لا ينتمون إلى طائفة النظام بل هم مزيج من كل الطوائف، قام النظام بتصنيعهم على طراز وحوش فهم لا طائفة لهم ولا دين ولا أخلاق، وهم مدمنون على ما يقومون به من أفعال لا إنسانية.
ومما يضفي على الرواية صفة الموضوعية إشارتها إلى أن بعض السجانين لم يكونوا من طبيعة تلك الوحوش، بل كانوا يرفضون اغتصاب السجينات. ويتعاطفون بسرية مع حاجاتهن كتأمين بعض لوازمهن من خارج السجن. كما تصور الرواية باختصار حقيقة السجون السورية بأنها مسالخ بشرية يهدف منها إلى اقتلاع الآدمية، وتقطيع أوصال الإنسان ومحاولة قتل كرامته وكبريائه وشرفه، فهناك نرى النشوة بالتعذيب، والاغتصاب، وأنين وصراخ المعتقلين. تصف ليلى تلك الأجواء: "الظلمة قوية وشبه ضوء خافت ينبعث من زاوية بعيدة، ومنظر بشر بأوضاع مختلفة والجميع عراة: نساء ورجالاً، ورهبة لا يمكن تخيلها، تبثها مكونات هذا المسلخ بكل تفاصيله، وجزئياته، وأنواع كثيرة من أدوات، وأجهزة وأصوات، ونحيب وعويل، ورائحة دم ولحم مشوي، أو محروق، وعفن بشري مخلوط بنفايات متراكمة وأنا.... وأنا والعري... وأنا واحتمالات الاغتصاب، والتعذيب والموت..." ص126.
ومن تلك المشاهد القاسية إجبار زملاء المظاهرات على اغتصاب بعضهم كما حدث مع ربيع الذي مات تحت التعذيب لرفضه اغتصاب حبيبته هديل على مرأى الجميع، حتى الحوامل لم يكنّ يسلمن من الاغتصاب، ومنهم سعاد أميري التي كانت تخشى إسقاط حملها تحت وحشيتهم، ولم يكن هذا الفعل مقتصرا على النساء كما تروي ليلى" بل مارسوه بفحش على الشباب حتى على الأكبر سناً ممن تجاوز الخمسين أو الستين، والاغتصاب أنواع، وبعضه المخترع من قبلهم أشد أذى وإيلاما كأن يدخلوا في الشرج زجاجات مكسورة العنق، وقد يمارسون اغتصاباً فعلياً بعد ذلك"ص130. وكثيرون كانوا يموتون إثر هذا كما حدث مع مازن الأحمد الذي توقف قلبه ومات.
- الفضاء الزماني والمكاني وشخصيات الرواية:
تبدأ الرواية من بلدة سورية غير مسماة لكنها تجمع أكثر من طائفة، ومذهب، تجمع بين سكانها وحدة وطنية، وعادات وهموم ومعاناة مشتركة، وكأن الكاتب أرادها نموذجاً لأي بلدة سورية أخرى، ويبدأ زمن السرد قبيل عام الثورة 2011 بخمس سنوات لا أكثر، ويعتمد حبكة سطحية متسلسلة تمضي بالأحداث حتى السنة الخامسة من الثورة.
يستطيع القارئ أن يستنتج أن الشخصيات الرئيسة في الرواية هي من مواليد الثمانينيات، وبالتالي فهم لم يشهدوا الأحداث الدامية التي مرت بها البلاد، ولم يتفاقم في صدورهم حاجز الرعب الذي أقامه النظام في صدور آبائهم حين قمع انتفاضة الشعب ضده في الثمانينيات، وبهذا الفضاء الزماني استطاع الكاتب أن يوازن لنا بين جيلين؛ الأول جيل الآباء المحنط بالرعب والمؤمن بقدرة هذا النظام على البطش والقتل لكل من يعارضه، فهم إما حياديون صامتون كزوج ليلى وإما انتهازيون منافقون كزوج سلمى، والجيل الثاني جيل الشباب الذي خرج على الجلاد بكافة انتماءاته وطوائفه. وقد اختار الكاتب بدقة مدروسة لإبراز هذا الإجماع الوطني على الخروج في وجه النظام ثلاثة أمكنة رئيسة، أولها بلدة سورية بلا اسم تجمع اكثر من طائفة وانتماء فكري وعقائدي، والثاني الجامعة التي نرى فيها كافة شرائح الشباب، والثالث هو السجن الذي يجمع كافة شرائح المجتمع فجمع بين ليلى السنية المذهب ولبنى الضاهر العلوية، ومنى وهبة المسيحية، وقد جمعت بينهن الثورةُ قبل أن يضمهنّ السجن، ووحدت وحشية النظام بين مصيرهن، ونرى في السجن الجلاد الذي لا يمت إلى الإنسانية بصلة، والحارس الطيب المتعاطف مع المعتقلين، وبهذا يكون اختيار الفضاء المكاني موفّقاً في الرواية لاختياره نماذج مكانيّة تجمع كل فئات وشرائح الشعب السوري.
ولا بد من الإشارة إلى أن الشخصيات بتنوعها وثقافاتها المختلفة؛ من المدرس الجامعي إلى ربة البيت البسيطة وما بينهما قد استطاعت الإحاطة بالحدث الكبير الذي ترصده من خلال أفعالها وحواراتها واختلافاتها في الرؤيا، فرغم الغنى الفكري والكم الكبير من الحقائق الذي تقدمه الرواية عن الثورة وتحولاتها، وتداعياتها إلا أنها لم تقع في مطب المباشرة أو التقريرية بل بقيت الحكاية هي الناظم السردي لهذا العمل.
وتجلت براعة الكاتب في شخصية بطلة الرواية؛ فالظاهر في العمل أن ليلى هي بطلة الرواية الرئيسة، وتتبعها سلمى، ولكن الحقيقة أن الرواية بطلتها واحدة هي (ليلى/سلمى) ولكن في شخصيتين؛ روح واحدة في جسدين. فمن بدايات الرواية نلمح أن ليلى هي الوجه الداخلي للشخصية البطلة وسلمى هي الوجه الخارجي، ففي الوقت الذي كانت فيه ليلى تحلم بصوت داخلي مكبوت كانت سلمى تحلم بصوت خارجي مسموع، وقد تعمد الكاتب هذه التقنية (انقسام البطل إلى قسمين) ليتمكن من رصد الأحداث من خلالها خارج المعتقل وداخله، ففي الوقت الذي ترصد فيه ليلى ما يحدث في داخل السجن تتابع سلمى نصفها الآخر رصد ما يدور خارجه، وتصرح الرواية في نهايتها بهذه الحقيقة " سلمى وليلى شخصية واحدة أراد الحبيب غسان أن يقسمها قصداً إلى اثنتين وأن يفترض لكل منهما حياة منفصلة مستقلة بدت متناقضة أحيانا في تركيب الشخصيتين ثم جاءت الثورة فألغت الحدود والتمايزات بينهما" ص 229.
وثمة رسالة يقدمها الكاتب من خلال إبداعه لهذه الشخصية المزدوجة تلخص إيمانه وتفاؤله بانتصار الثورة في النهاية مهما تعرضت له، فيمكننا إسقاط اسم (ليلى) كمعادل موضوعي (للثورة)، فليلى هي الثورة، وبالتالي فهي النصف الذي اعتقل لكن نصفها الآخر سلمى كان حراً طليقاً عصياً على الاعتقال، يستطيع اختراق جدران السجن متى شاء، وما يؤكد هذا إنجاب سلمى لغسان وليلى بعد استشهادهما في رمزية شفافة واضحة لاستمرارية الثورة وعجز هذا النظام عن قتلها في المعتقل الذي سجنها فيه.
ختاما: يمكننا القول أمام الكم الكبير من الروايات التي قذف بها بركان الثورة السورية أن هذه الرواية هي من أهم الأعمال التي استطاعت أن تصور الحدث بعمق وموضوعية بعيداً عن التخندق، والثأرية والانفعالية إضافة إلى امتلاك كاتبها تقنيات السرد الروائي، ولغة فصيحة، مكثفة، غنية بمفرداتها وإيحاءاتها التي تقترب أحيانا من سقف الشعر، ودون أن تغادر مستوى الشخصيات، فقدم من خلالها ما يريد طرحه من رؤى ومقولات بعيداً عن المباشرة، والتقريرية عبر حكايات متداخلة مترابطة، وشائقة ليشكل النص في النهاية شهادة أمينة ومتفائلة على مرحلة من مراحل الثورة السورية؛ مرحلة اعتقال الثورة وليس قتلها.




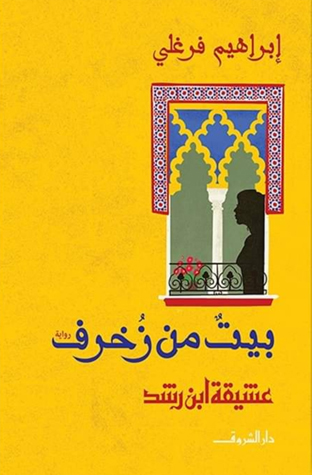


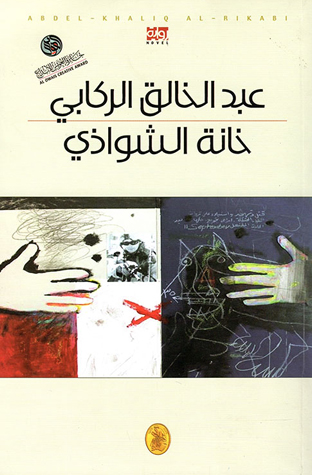

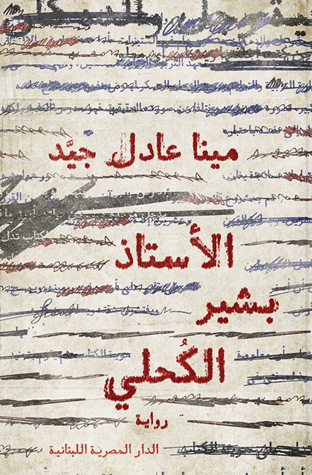

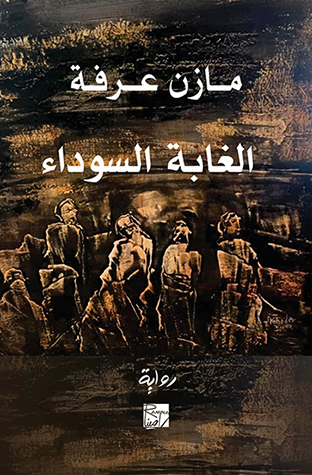


0 تعليقات