لهذا أخفينا الموتى: روايةُ ما قُتِلَ على شفاه صور قيصر
زياد الأحمد
لاشك أنّ صور قيصر كانت صرخةً مدويّةً اخترقت سراديب وأقبية سجون النظام السوري لتصل إلى آذان الضمير العالمي الأصمّ الأبكم والأعمى أو المتعامي عن كل ما حدث من جرائم إنسانية بحق الشعب السوري، والمتأمل لتلك الصور -إن امتلك قلباً لذلك- سيلاحظ أنّ أغلبَ الأفواه في تلك الصور فاغرةٌ، جمّدَ الموت على شفاهها روايةً مكتومةً، كانت تصرخ بها، فحال دون وصولها إلينا... لا شك أنه على كل فمٍ منها حكايةُ موت تقشعر لها الأبدان أراد ذلك النظام المجرم أن يقتلها كي لا تفضح وحشيته التي ما عرف لها التاريخ مثيلاً... استطاع قيصر أن يسرب تلك الصور وملامح حكايات ميّتة، لتأتيَ معها روايات المعتقلين الذين حالفتهم الحياة فنجوا من جحيم تلك السجون ليرووا لنا ما عجزت تلك الأفواه عن روايته...
ورواية وائل زهرواي "لهذا أخفينا الموتى" واحدةٌ من تلك الروايات، لكنّها من أصدقها فهي ليست سوى وثائق عاشها الكاتب ذاتُه، وعاينها سنين طويلة في معتقلات النظام السوري.
"لهذا أخفينا الموتى" روايةٌ لا تُحتمل قراءتها، فكيف احتمل الزهراوي ومئات الآلاف من صحبه أحداثها، صورٌ من العذاب لا يمكن متابعتها، ولابد لكلّ صاحب حسّ إنساني من أن يتوقف بين مشهد وآخر؛ ليلتقط أنفاسه، وينظر مرتعباً حوله ليتأكد أنه في أمان، بعيداً عن تلك الوحوش البشرية التي تتلذذ بتعذيب ضحاياها، وتحول بينهم وبين الموت لتمدّدَ مسافةَ متعتها بامتداد آلامهم، مخترعة طرائقَ من التعذيب لا مثيل له حتى في الإسرائليّات التي صورت لنا ويلات عذاب جهنم.
روايةٌ لا تُحتمل قراءتُها، وإلا كيف لذي قلب أن يتابع مشهد تعذيب أبٍ وأم وهما عاريان أمام طفلتهما؟
كيف يمكن متابعة مشهد التعذيب بالشمعة؛ حين يؤتى بالمعتقل عارياً، ويقيّد بإحكام إلى كرسي حديدي بلا قاعدة، وتوضع تحته شمعة على بعد سنتيمترات من المنطقة الفاصلة بين فتحة الشَرَج والخصيتين؛ لتحترق ببطء تلك المنطقة التي تجمع أكثر الأعصاب رهافة، فيذوب لحمها وشحمها ويسيل مع دموع الشمعة، ولا يُنزّل المعتقل قبل أن يفتح اللهب ثقباً جهنميّ الألم في تلك المنطقة.
كيف لنا أن نتخيل غرفة "مستنقع الموت" وهي غرفةٌ ضيقة مغمورةٌ أرضُها بماء ممزوج بالبول والبراز، والدم والقيء، وفتات الأجساد البشريّة المتفسّخة المتعفنة يحشر فيها المعتقلون جماعاتٍ ويُتركون أياماً وأسابيعَ وقوفاً يغمرهم الماء حتى ركبهم، وحين تعجز بعد أيام أقدامهم التي تتعفن وتتفسخ في الماء عن حملهم يقعون فيغرقون في الماء الممتزج ببولهم وبرازهم ومنه كانوا يلتقطون فتات الخبز التي يرمونها لهم متعمدين ليزيدوا بها حياتهم ساعاتٍ لا أكثر، يتلذذون خلالها بموتهم.
كيف نتخيل شعور الزوج حين يسمع صوت زوجته تُغتصب في زنزانة مجاورة؟ وصوت استغاثتها يصمّ العالم؟
كيف لذي قلب أن يتخيل حجم ألم ذاك المُعتقَل الذي دسّوا له خرطوماً في فمه حتى وصل إلى معدته وأنزلوا فيه سلكاً شائكاً من تلك التي تسّور بها الحدود، ثم سحبوا الخرطوم تاركين أشواك السلك تنغرس في جسده مع كل حركة يتحرّكها، ليموت محروماً حتى من حقّه في الصراخ ...
كيف يمكن قراءة المشهد التالي في وصف معتقل كان يستغيث بالله من ألمه فجاء السجان لنجدته:
"أمسكه السجان وكبل له يديه للخلف كحين يصفّق بهما، ثم جعل ظهره للباب، وأدخل كلّ أصابعه حتى الرسغ بين الباب الحديدي وإطاره، ثم صرخ بكل صوته: ربك الذي ترجوه معتقل في زنزانة أخرى، وصكّ الباب بكل قوته على إطاره الحديدي فانهرست أصابع المعتقل بين الإطار والباب ... ص30.
يكفي أن يخبرنا الزهراوي: لماذا قام السجناء وهو واحد منهم بإخفاء الموتى في زنزانتهم؟ يقول لأن نظام السجّان أراد لهم أن يموتوا جوعاً، ولكن ببطء شديد فكان يعطيهم كل يوم بضعة أرغفة من الخبز يتقاسمونها، وتكون حصة الواحد ما يساوي حجم إصبعه، وكلما مات واحد من الجوع والتعذيب أمرهم بإخراج جثته، وأنقص حصته من كمية الخبز، إلى أن بلغ بهم الجوع حدّ أن يفكروا بإخفاء الموتى ليحصلوا على حصتهم من الخبز، فعاشوا بين الجثث وروائحها، وتفسخها، ومع الديدان التي ترعاها في سبيل حجم إصبع من الخبز...
هذا غيض من الفيض الذي يرويه الزهراوي الذي اعتقل بتهمة مطالبته بالحرية والهتاف لها في المظاهرات السلمية التي بدأتها ثورة سوريا على نظام الأسد عام 2011م.
والغريب أنّ هذه المشاهد وغيرها كثيراً ما كانت تسبق بكلمة (التحقيق)، تلك الكلمة الرهيبة على امتداد الرواية، في الوقت الذي لا تذكر الرواية أيَّ سؤال من أسئلة ذاك التحقيق، لأنه لا أسئلة في الأصل لدى المحقق ليجبر المُحقَّق معه على الاعتراف بها، والجملة الوحيدة التي تتردد: سأريك كيف تطالب بالحرية، وتتمرد على النظام، فالتهمة ثابتة، والحكم بالموت قد صدر مسبقاً، فالتحقيق في تلك المعتقلات هو جلسة لتنفيذ الحكم، وهو التعذيب حتى الموت، وفي توضيح الهدف البعيد من هذا الحكم يقول الدكتور برهان غليون في تقديمه لرواية الزهراوي تلك:
"الهدف الأول لها القضاء على أرواح المعتقلين الجاحدين قبل القضاء على أجسادهم. نحن هنا أمام حالة استثنائية للقتل المُقطَر الذي لا يهدف إلى تغيير اعتقادات الأفراد الضحايا، أو حتى إلى كسر إرادتهم، ولكنه يمارس على ضحايا مكسورين، ومستسلمين أصلا، حُكم عليهم سلفاً بالإعدام." ص5
ومن تلك المشاهد التي تؤكد هذا القول مشهد تعذيب طفل أمام أبيه، فبينما كان المحقق يدخن نارجيلته متلذذا بالمشهد، يأمر بوضع جمرتي النارجيلة على ظهر الطفل، وأمام عينيّ أبيه، حتى تملأ أنف الأب رائحةُ شواء لحم طفله الطري وعندها:
"تضاحك أحدهم وقال سيدي هذا الصغير احترق. فأجابه المسخ اللعين خذه وأطفئه، وأعطاه إبريق الماء الذي يغلي فوق الموقد فصبّه المسخ على ظهر الطفل دفعة واحدة .... وتلعثمت محاريب المساجد أمام طفل يحرقونه بالجمر ويطفئونه بماء مغلي....."
وليس التعذيب محصوراً بجلسات التحقيق تلك أو بمواعيدَ خاصةٍ به، بل هو في كل سلوك أو حاجة يقوم بها المعتقل، فنومه على نصف بلاطة من أرض الزنزانة وهي كل ما يملكه من اتساع الأرض جلسةُ تعذيب، وكذلك طعامه، وشرابه، وخروجه للخلاء، ففي كل حاجة له جلسة تعذيب، ومن أمثلة ذلك الذهاب الى المرحاض:
"ندخل كل خمسة معتقلين إلى مرحاضٍ واحد، أحدنا يجلس كي يقضي حاجته، والأربعة الآخرون يتوزعون على زوايا المرحاض الأربع، ويبولون فيها، ومن يكون بحاجة للتبرز ينال ربع كمية البول من المعتقلين الأربعة البقية، والمدة المعطاة لنا هي دقيقة واحدة" ص80.
يطرح الزهراوي سؤالا متكرراً: لماذا كل هذا الموت؟ وخير إجابة نراها ما ذهب اليه الدكتور برهان غليون في مقدمته للرواية بعد أن رأى أن هذه السجون هي جبهة موازية للجبهة الخارجية التي قامت بقتل السوريين بالطيارات، والدبابات، والغازات السامة والبراميل المتفجرة ويضيف:
هدفها الرئيسي هو كسر العظم، واستبعاد أيّ تسويةٍ، أو مصالحة أو حوار بين الفرقاء، وتأكيد مبدأ إمّا قاتلاً أو مقتولاً؛ أي الذهاب في العداء والعنف المرافق له إلى أقصى حالاته التي لا رجعة فيها، وبالتالي بناء جدار الحقد والعداء الدائم وتغذية ضرع الكراهية، وروح الانتقام الذي سوف يسمم حياة السوريين لحقبة طويلة قادمة.
وبمعنى آخر يمكننا القول هذا النظام لم يكتفِ خلال حكمه بقتل سوريا الماضي، ولم يكتف بقمعه للثورة ضدّه بقتل السوريين على الجبهات الخارجية، بل هو يقوم بقتل سوريا المستقبل في تلك الأقبية والسراديب كي لا تنبت أية حالة من الصلح والحب والوئام بين أبنائها.
الرؤية السردية:
يبدو للوهلة الأولى لقارئ الرواية أنها تنتمي إلى أدب السجون الذي تتمحور فكرته حول تصوير المآسي، والويلات التي تحدث في غياهبها، وهذا شيء لا يجانب الصواب، وفي المشاهد السابقة ما يؤكد هذه الرؤيا، ولكن الرؤيا السردية لهذه الرواية تنصب على بؤرة أعمق من غرض أدب السجون، خلاصتها أن الوطن السوري كلّه مُعتقل كبير وأننا جميعاً في الوطن سجناء، ولو كنا خارج القضبان، ويذهب أبعد من هذا: فالوطن ذاته سجين معتقل وراء قضبان تلك الفئة التي تحكمه بالنار والحديد والموت، ولذلك يتساءل الزهراوي: كيف يكون حراً من كان وطنه معتقلاً؟
ويتجسد هذا الشعور في وصف موغل في الإحساس بخيبة الحقيقة حين يطلق سراح وائل الزهراوي ويقف على الباب الخارجي للمُعتقل فيحدّث نفسَه:
"إلى من أنتمي؟ إلى ذاك الذي اعتقلوه منذ زمن بعيد؟ أم إلى هذا العائد من الموت، وهو يرتعد من الحياة؟ لا بأس فبوجود هؤلاء لا فرق بين الحرية والسجون، والموت والحياة، الوطن والمعتقل، ليس هناك أيُّ شيء يمكن أن يعطيَ حياتنا أيَّ قيمة طالما أنهم موجودون بيننا". ص108
وهذا ما اكتشفه وائل بعد خروجه من المعتقل ليجد مدينته؛ حلب التي كان يحلم بها في ظلمات سجنه قد قام النظام بتقطيع أوصالها، وتدمير كل المرابع التي شهدت طفولته فيها، بل أصبح الحصول على رغيف من الخبز فيها يعني المغامرة بالمرور من تحت رصاصة القناص التي لا تخطئ، وكأنه أراد أن يقول: إن إطلاق سراحه لا يعني أكثر من الانتقال من سجن لآخر؛ من عالم كانت حصته فيه من الخبز بحجم إصبعه، وتحت سياط الموت إلى عالم يتطلب الحصول فيه على لقمة خبز لأولادك المرور تحت رصاصة قناص لا يخطئ، وهذا ما حدث لصديق وائل.
ومما يجب التوقف عنده في قراءة هذه الرواية ما جاء بشكل غير مباشر لتوضيح هذه الرؤيا العميقة أنّ وائل حين خرج من المعتقل كان جائعاً وحين اعتقلوه ثانيةً كان جائعاً أيضاً فرحابة الوطن وضيق المعتقل سيّان.
بطولة الرواية:
يتوازع البطولةَ في الرواية بطلان؛ كلاهما جماعيّ لا فرديّ، وهما المكانُ والشخصيات، فوصف المكان من زنزانات محشوة بالجثث، وبقايا الأحياء، والأدراج المكسرة التي أصبحت وسيلة إعدام، والمراحيض، والممرات، ومستنقع الموت، وغيرها، لها الدور الأكبر في بطولة الرواية، ولا تقل أهمية عن الشخصيات الكثيرة والمتنوعة جنساً وأعماراً؛ ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشباباً وشيباً، وكلها جمعتها تهمةٌ واحدةٌ، ومصير واحد، وعدو لا يرحم، وقد برع الزهراوي في وصفها خارجياً وداخلياً ليقدم من خلال وصفها صورة غير مباشرة للتعبير عن وحشية هذا النظام المجرم بحق الإنسانية ذاتها
الحكائية وشاعرية اللغة:
تتميز الرواية باكتظاظها بكم هائل من الأحداث، والمشاهد والحكايات الفجائعية المروّعة التي وصفتها مقدماً بأنها لا تُحتمل قراءتُها أو متابعتُها، وعلى الرغم من عدم وجود خيط سردي رابط بينها إلا أنها جاءت مترابطة متكاملة تستطيع الإمساك بعيني القارئ وأنفاسه التي تكاد تتوقف مع كل مشهد مروّع من مشاهدها.
وقد سيطرت على هذه اللغة نفحةٌ شعريةٌ نابعة من قسوة الحكاية، وذلك الكم الهائل من الألم الذي تضمنته، ولم تأت نافرة عن بؤرة منابعه بل متناغمة معه، ومن ذلك حين وصف تعذيب الأب أمام طفله:
"بكى الطفل كما تبكي المعابد المغتصَبة، وهو يشاهد السجان الذي وقف فوق أبيه وراح يحرق جسده الذي لم يبق فيه شيء ليحترق" ص 85.
وفي وصف موت زميله في "مستنقع الموت":
"كان عطشاً ونحن في بركة ماء، وحقائب العمر بدت ضريرة..." ص66
وتتجلى اللغة الشعريّة في هذا المنولوج بينه وبين نفسه حين اعتقل جائعاً مرة ثانية:
"كان الجوع يتهدل طيوفا تريني الآتي من خلال رجس بقائهم، أردت ألا أسقط أمام بعضي؛ لكني لم أعد أحتمل كلّ هذا، تراميت على أطراف ثقوبي وأسلمت نفسي للبكاء.. لقد كان يؤلمني أن تعتقلَ مرةً أخرى؛ وأنت جائع يا ذاك الذي يسكن في داخلي". ص118
الخطابية والتقريرية:
على الرغم من هيمنة الكمّ الكبير من الأحداث التي تتمحور حول بؤرة واحدة؛ وهي الألم، وأفانينهم في اختراعه؛ كانت لغة السرد في أحيان كثيرة تبتعد عن الحكائيّة لتنجرف نحو الانفعالية والثأرية التي تصبغها بنبرة خطابية تقريرية مباشرة ومن ذلك:
"أيها السوريون الذين ستقرؤون هذه الكلمات حين سأكون عظاماً في قبري لقد كنا نخبئ جثث رفاقنا في زنزانتنا من شدة الجوع، نخبئهم ليس حباً بالحياة، فالحياة هناك كانت أمرّ بكثير من الموت؛ بل لأجل أن نبقى، ولا نفنى؛ لأجل ألا يموت الوطن .. نستمر لأجل حريتكم وحريتنا، لأجل فعل الشرف الذي هو واجبنا إزاء الوطن..." ص62
ومثل هذه المقاطع تتكرر في مواضعَ كثيرةٍ عقب تقديم الحكاية مما أوقعها في الحشو والتكرار، ولا شك أن هذا مردّه إلى الحالة الانفعالية التي عاشها الروائي؛ كونه واحداً من الأبطال الذين عاشوا الأحداث حقيقة لا خيالاً. وكان من نتيجة ذلك أعني الانفعالية أيضاً تدني المستوى النحوي والصرفي والإملائي في لغة العمل. وكل هذا لم ينقص من أهمية وثائقية هذه الرواية، وتقديمها شهادة حق ناطقة باسم أولئك الذين قُتلت معهم حكاياتهم وأسرارهم، فرواية "لهذا أخفينا الموتى" هي لسانهم الذي قطعوه، وحكايتهم التي صلبوها على شفاههم؛ بل هي من أروع الشهادات التي قدمها أدب السجون، وستبقى وصمة عار على جبين هذا النظام الذي لا يمت إلى الإنسانيّة بصلة.

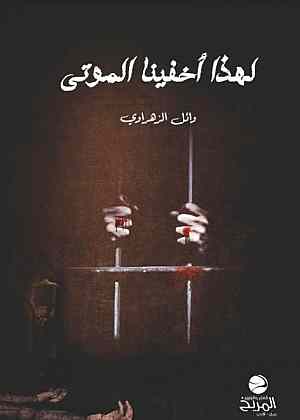


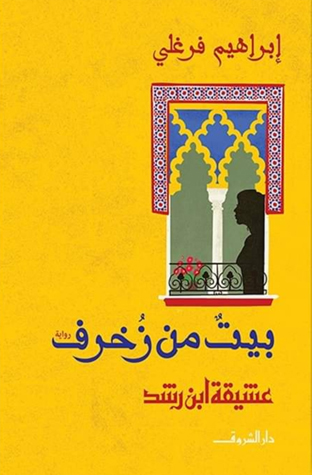


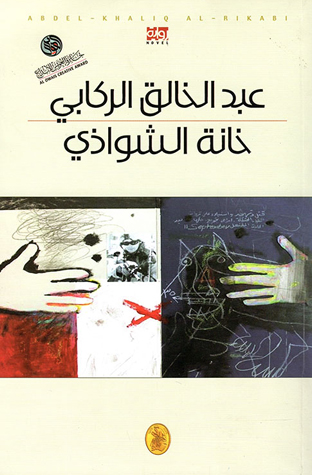

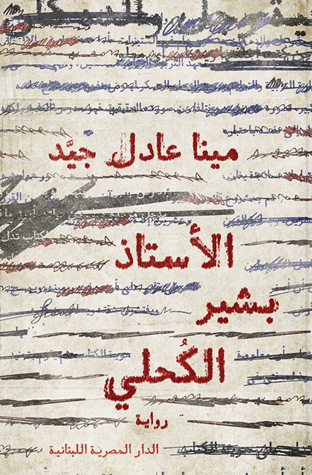

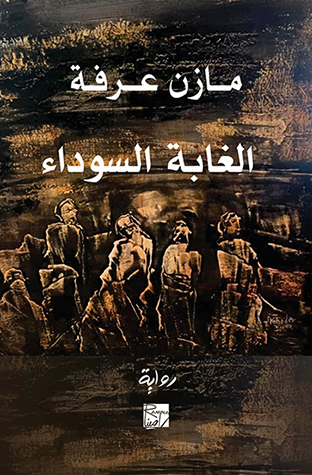


0 تعليقات