مغامرة الروائيين في اقتفاء أثر الأعمال الشهيرة
هيثم حسين
هل يمكن بناء رواية على أساس رواية سابقة، وانطلاقا من عوالمها وأجوائها؟ إلى أيّ حدّ تشكّل رواية مبنية على رواية أخرى تمثّل لها شرارة الانطلاق تجديدا في ميدانها؟ أين يكون الابتكار في هذا العمل؟ هل البناء على أسس رسّخها آخرون ونجحوا في هندسة تفاصيل عالمهم الروائيّ يرنو إلى التقليد والإفادة من المنجز المتحقّق أم يروم الإضافة إليه من خلال استلهامه؟
يقتفي بعض الروائيّين آثار روائيين آخرين سابقين حقّقوا إبداعات لافتة ومميّزة في عالم الفنّ الروائيّ، وكانوا قد تمكّنوا من تشكيل علامات فارقة في تاريخ الرواية، أو صياغة أعمال مهمّة لا يمكن إغفالها حين الحديث عن تاريخ الأدب في عصورهم، وذلك في محاولة تجيير جزء من النجاح السابق المتحقّق من أجل نجاح لاحق مأمول، أو استحضار عالم الروائيّ المنجَز وإعادة إنتاجه وتصديره بحلّة معاصرة.
ولعلّ بالإمكان الإشارة إلى أنّ سعي الروائيّ اللاحق يتجلّى بالرغبة الملحّة لربط اسمه وعمله باسم السابق وعمله كنوع من الإحياء والتقدير، أو من التأثّر والتقليد، وربّما لغايات أخرى في نفس الكاتب الذي يجد ضالّته لدى الآخر، ويقوم بتوظيفها من أجل تصدير عمله وتصوّراته، أو ما يتخيّلها إضافاته ولمساته الجمالية.
يتكرّر توظيف أسماء روائيّين كبار أو عناوين روايات شهيرة في روايات معاصرة، بحيث تكون الإحالة وسيلة لجذب الأنظار، والبحث عن سبل للتسويق بشكل ما، والتمويه على العمل الذي يمضي في ظلّ أسماء مكرّسة أو يسير تحت ظلال عناوينها التي أصبحت بمثابة ماركات مسجّلة موثوقة.

على خطى أوستن
عملت الأميركية كاري جوي فاولر في روايتها “نادي قراءة جين أوستن” على اقتفاء أثر الروائية الإنكليزية جين أوستن (1775-1817) التي تصفها بأنّها تتمتع بقدرة غريبة على إشغال الجميع؛ فلاسفة الأخلاق وفلاسفة الحب العذري وغير العذري، والماركسيين، وأتباع فرويد، وأتباع كارل يونغ، والمتخصصين في علم السيميائيات، والهدامين، وأنّ جميعهم يجدون ملعبا مثيرا في ست روايات متشابهة تتناول حياة الطبقة المتوسطة في الريف الإنكليزي. وتلفت إلى أن أدب أوستن يتجدد دوما عبر الأجيال.
تؤكد فاولر في روايتها أن القراءة اكتشاف مستمر متجدد، وأن هناك أعمالا كثيرة تحرض على حب الحياة، وتنتظر أن يقبل عليها عشاقها بشغف ليكتشفوا الرسائل والشيفرات الدفينة المخفية بين طياتها، وأن هذا ما حصل لشخصيات روايتها التي أعادت اكتشاف أوستن من خلال مقاربة رواياتها وتفكيك ألغازها وتجديد رسالتها المحبة للحياة. وتمهد بجملة لأوستن من روايتها إيما تقول فيها “نادرا ونادرا جدا ما تنكشف الحقيقة بأكملها عبر الأشخاص؛ ونادرا ما لا تبقى أمور خفية نتيجة التورية أو الخطأ”، لتنطلق في فضاء روايتها باختيار عنوان لافت للفصل الأول وهو “لكل منا أوستن تخصه”، وذلك للإشارة إلى التماهي بين شخصيات روايتها وجين أوستن، وحتى أبطال رواياتها.
ست شخصيات تقدم قراءاتها لروايات أوستن الست في نادي القراءة، ويكون استحضار أوستن في كل التفاصيل، والسؤال عما كانت ستفعل لو كانت في الوقت الراهن، أي تعمل على استدراج شخصية أوستن وبعثها بطريقة روائية، واستنطاقها، وتلبيسها بعض ردود الأفعال التي تفترض أنها كانت لتأتيها لو كانت حية معاصرة.
تتماهى الشخصيات مع أوستن، وتتقمصها، تعيش حالاتها وصورها، برودي مثلا تعتقد أنها قد رأت في الحلم أن أوستن كانت تسير معها في أحد القصور وتطلعها على غرفه، وهي لا تشبه صورة جين المعروفة بل تشبه جوسلين، ولكنها في معظم الأحيان جين، وهي شقراء ومرتبة وعصرية، وترتدي سروالا حريريا فضفاضا.
تركز الروائية على ما كانت تشدد عليه أوستن بالقول إن الأهم هو أن تكون لديك عادة أن تعلم نفسك الحب، وهو الذي انعكس على الشخصيات التي دخلت من مرحلة إلى أخرى، بفضل الحوافز الإيجابية التي أثارتها لديها قراءة أعمال أوستن ومناقشتها وتفكيكها ومحاولة كشف ما بين السطور المخبوءة فيها.
في ملعب زوسكيند

أمّا الفرنسي فيليب كلوديل؛ العضو في أكاديمية غونغور، فإنّه لا يشير إلى رواية “العطر” الشهيرة للألماني باتريك زوسكيند، والتي صدرت سنة 1985، أثناء كتابته لروايته “عطور”، التي يتناول فيها فكرة إحياء الروائح والعطور وجوه الطفولة، وكيف أن أي رائحة يصادفها أو يتذكرها تعود به إلى حادثة معينة في مرحلة من مراحل حياته، سواء في الطفولة أو المراهقة أو الشباب.
وكغرونوي بطل رواية العطر لزوسكيند، يبدو بطل كلوديل الذي يثير لديه كل ما يحيط به روائح تعيده إلى أزمنة سابقة، كالفحم الذي يغير الأجواء ويفرض عليه رائحته، حيث كان الناس يحرقونه في منطقتهم في كل مكان تقريبا، وفي البلد الذي لا يزال يستثمر المناجم، ويقول إن رائحة الفحم عبرت من أيام طفولته، ورائحة فقر وحزن أيضا معه، كما لو كانت جزيئات الوقود السوداء شاهدة على التعاسات، كبيرة كانت أو صغيرة، مضرة أو تافهة، دائمة أو عابرة، ويرى أنها كلها توضع فوق الحيوات البشرية.
ويسعى كلوديل للابتعاد عن تأثيرات زوسكيند المباشرة، والنأي بنفسه عن التخريجات الفنية للشخصية، مكتفيا بعالم العطر الذي لا يكون حكرا على روائيّ بعينه، وإن عرف أو اشتهر به أكثر من غيره، ليؤكد أن الرائحة العالقة في ذاكرة راويه كانت رائحة جغرافيا أرض وريح، برية وفضفاضة، وأنها مدى لانهائية الحكايات، والخرافات والأناشيد والصور التي قرأتها ونظرت إليها، والتي تجعل منه تحت السطوح، وعند أولى خطوات النوم، في سريره المريح، رحلة سماوية ومطمئنة. يصف نفسه حينها بأنه كائن هش يعرف أنه كان ذات يوم محاطا بأهله سعيدا.
عمل كلوديل، وهو كاتب ومخرج فرنسي من مواليد 1962، على أن تكون الرائحة المستعادة أو المتخيلة أداة وذريعة لعقد مواجهة بين الذكريات والواقع، ولعبة الرائحة والذكرى، والعطر والتخييل. ويعلن بطل الرواية أنه الصوص الصغير لكنه أصبح غول الحكاية، أمامه الحياة كلها، تطرد جدته التي توفيت عندما بلغ الثامنة من عمره، ضباب المطعم الحقير عبر النافذة المطلة على الباحة، وتسكب في صحنه الخزفي المرمم الذي يحب تآكله المشقق والمزين برسوم الصيد.
قرّاء الأدب ودارسوه لن يتوانوا عن إسقاط العمل الذي يطمع للتسلّق على اسم عمل سابق والإلقاء به في سلّة المهملات كأنّه لم يكن، أو كأنّه كان عبارة عن خطيئة أدبيّة وجناية روائيّة لا تستحقّ أن تحجز مكانا لها في فضاء الفنّ الروائيّ
يتساءل الراوي عن ماهية العطر، ويتذكر فترة مراهقته، وأنه كان مع رفاقه على حافة هوة الحياة التي كانوا يطمحون إلى أن يلقوا أنفسهم كقنابل بشرية صغيرة من دون أن يعرفوا عنها شيئا. ويقول إنهم كانوا متوحشين ومنفلتين لا يقلقهم شيء، يقطرون أحلاما وحبا، يتقيؤون جعتهم ومعها عالم اليافعين، ويصبحون مترنحين باحثين عن ذواتهم ودروبهم في متاهة الحياة. ويشير إلى أنه كبر في بلد المواسم المقطعة بالفأس، والقاسية والحاسمة، ليس أقلها الشتاء الذي يغلق الباب على السنوات، كما نغلق باب غرفة مليئة بالذهب والكريستال. وأنهم كانوا يحلمون ويغنون ويأكلون ويشربون فيه.
لا يخفى أنّ عالم الإبداع يظلّ مشرعا على مصراعيه لأيّ محاولة للإفادة من إنجازات سابقة، لأنّ تراكم الإنجازات والقراءات والتأويلات والتوريات يفسح المجال أمام رؤى جديدة مختلفة، تسعى إلى التجريب، والبحث في مواضيع سبق معالجتها وتناولها من روائيّين كبار، ومقارعتهم في أرضهم، والإيحاء أنّ بالإمكان الإضافة على منجزاتهم، أو مضاهاتها بطريقة تستوحيها وتبني عليها.
ولا يخفى كذلك أنّ الأمر يحمل مخاطر الانزلاق نحو المقاربة والمقارنة المفترضتين، ويبقى الزمن هو الحكم، والغربال، كما أنّ قرّاء الأدب ودارسيه لن يتوانوا عن إسقاط العمل الذي يطمع للتسلّق على اسم عمل سابق والإلقاء به في سلّة المهملات كأنّه لم يكن، أو كأنّه كان عبارة عن خطيئة أدبيّة وجناية روائيّة لا تستحقّ أن تحجز مكانا لها في فضاء الفنّ الروائيّ، إذا لم يقنعهم، ويؤكّد لهم أنّه يحمل بصمة مبتكرة لافتة يمكنها أن تختطّ لنفسه مسارا فرعيا بناء على طريق مسلوك من قبل.
عن صحيفة العرب اللندنية




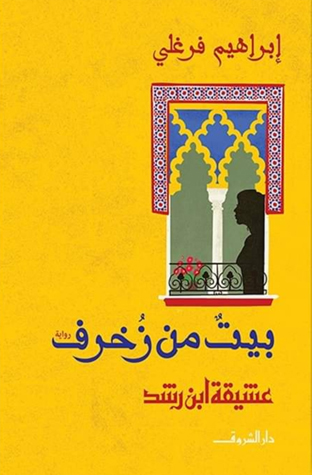


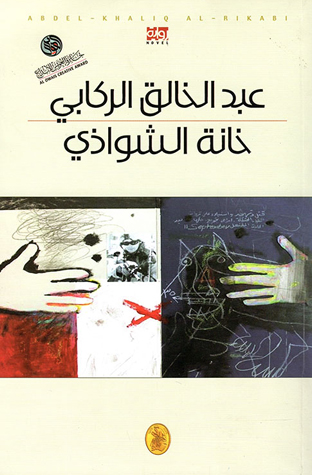

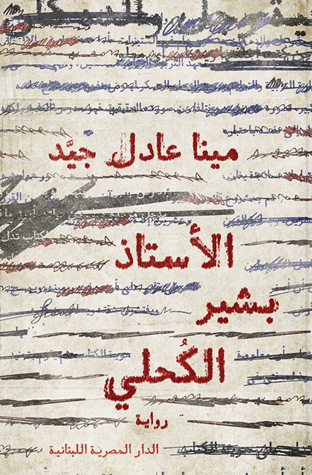

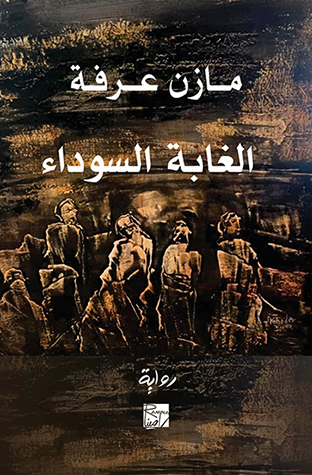


0 تعليقات