إشكالية التبئير في العمل السردي وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والسياسية
عماد قيدة
يعتبر مصطلح التبئير (Focalisation ) في الفنون السردية من أكثر المسائل الخلافية بين النقاد والمهتمين بدراسة الأعمال الأدبية، وذلك للتحولات الدائمة والتطورات التي طرأت ولا زالت تطرأ عليه .
والمقصود بالتبئير هو تقليص مجال رؤية ومعرفة الراوي الذي يقص الحكاية على المتلقي، والمكان الذي يتموقع فيه من خلال الأحداث ودرجة قربه من شخصيات الحكاية معرفيّا ووجدانيّا.
وقد تعددت النظريات بشأن التبئير من ناقد إلى آخر، كلٌ حسب المنظور التاريخي الاجتماعي أو المرجعيات الثقافية التي ينهل منها ويراها أنسب، ومن التسميات الأخرى له أيضا نجد "وجهة النظر" و"زاوية الرؤية" و"المنظور" ، وتحيل كلها بدرجات متفاوتة على ما وصفناه أعلاه بالموقع الذي يتخذه الراوي لنفسه، أو بالأحرى الدور الذي يقوم الكاتب (المؤلف) بحصره داخله.
وقد توصل كبار المنظرين مثل تودوروف وجون بيون وجيرارد جينيت ورولان بارث إلى وجود ثلاث مستويات أساسية للتبئير، لعل أهمها وأكثرها وضوحا ما ذهب إليه جينيت أن التبئير يكون إمّا:
اللاتبئير:
أي أنه لا وجود لبؤرة (زاوية نظر) محددة يتناول من خلالها الراوي الحكاية وأحوال الشخصيات، وإنما هو "منتصب كإله" فوق كل عناصر الحكاية، يعلم كل ما حدث وقيل وما سيحدث ويقال، وبمقدوره النفاذ إلى دواخل الشخصيات واستخراج آرائها واختلاجاتها ومشاعرها ، وهو يتوجه إلى المتلقّي المسرود إليه مباشرة ودون أي وسائط، ولا ينسحب من هذا الخطاب المباشر إلى نادرا ، مثل الحوارات، حيث تأخذ الشخصيات المتحاورة المشعل لتتوجه هي مباشرة للقارئ دون حاجة إلى السارد، فيما عدا التدخلات لتوجيه الحوار على غرار "قال، أجاب، قهقه قائلا .."
في هذا الصنف من التبئير يكون السرد عادة بضمير الغائب، إذ أنه لا يمكن لأي شخصية أن تضطلع بالصلاحيات الواسعة لهذا "الراوي العليم" كما جرت العادة على تسميته.
التبئير الداخلي:
وهو المستوى الذي تتساوى فيه معرفة السارد بما تعرفه الشخصية، ولا علم لديه يفوق ما تصرح به الشخصية قولا أوما تظهره من حركات وتفاعلات وملامح وجهية.
ويستعمل هذا الصنف عادة في النبش داخل قلوب الشخصيات المأزومة والمسكونة بهواجس وعواطف مكثفة كالحب أو الرعب أو الضغينة، من خلال تعمد الكاتب دفعها للاعتراف أو للتفكير بصوت مسموع (بالنسبة للقارئ وليس بالضرورة لباقي الشخصيات المشاركة في القصة) والبوح بما يختلج في صدرها وهوما يظهر في المثال التالي:
"من اللحظة التي تركته فيها هذا المساء بكيت، بكيت طويلا. بدأ بكائي وأنا في السيارة، وفي غرفتي أغلقت على نفسي وبكيت. لا اعرف لبكائي سببا قد استطيع تحديده والتأمل فيه ... أم أن الجواب عندي؟ ولكنني أتجاهل وأراوغ كأي امرأة؟ هل كانت لدي الرغبة مثلما كانت لديه فحاولت إقناعه بالعكس وأنا اعلم أن بداخلي امرأة تستطيع أكثر مما أتصور أنا ويتصور هو فأفزعني ما أنا عليه ؟ أهذا هو المأزق الذي سعيت إليه ؟ وهل مقدر علي أن أعيش تلك المعادلة الصعبة التي تتكرر معي إلى ما لا نهاية ؟
من "يوميات سراب عفان" لجبرا إبراهيم جبرا
التبئير الخارجي
في التبئير الخارجي يقتصر الحقل المعرفي للراوي (وبالتالي القارئ) على المظاهر الخارجية للشخصيات وعلى ما تبدو عليه الأحداث، وفيه تتمتع الشخصيات بمعرفة أكبر من تلك التي لدى الراوي، سواء فيما يخص مشاعرها (الخوف، الحذر، الهدوء، التوتر..) أوما تنوي القيام به، فقد تسلك في أي لحظة سلوكا لم يتوقعه السارد وبالتالي تفاجئه هو قبل القارئ.
وعموما يتم استعمال هذا الصنف من التبئير من قبل المؤلف قصد إضفاء جو من التشويق والترقب من خلال جعل الراوي يقتصر على وصف خارجي محايد وملاحظة لسلوك ومظهر الشخصية التي ينوي إكسابها الغموض المطلوب لمشهد معيّن.
مثال:
" ظهرت أمام باب داره فتاة ربما كانت في صيفها السادس عشر ترتسم على وجهها ابتسامة لطيفة. لم تطرق باب أفكاره أو تتطفل عليه بل وقفت هناك تنتظر بأناة حتى أدرك وجودها فدعاها إلى بيته قالت له أنها أصبحت يتيمة منذ فترة غير بعيدة وقالت انه لا يوجد لديها مصدر رزق وأنها لا تريد أن تعمل في المبغي وقالت له أيضا أن اسمها دنيا .."
سنتان وثمانية شهور وثمان وعشرون ليلة لسلمان رشدي
ولمدة طويلة من تاريخ الرواية، منذ مهدها الأوروبي وحتى انتشارها لتصير لغة مشتركة تتكلمها كل الشعوب تقريبا وتتبادل حولها التجارب والخبرات والتأثيرات، احتفظ الراوي العليم بالدور الأكبر في القص واستأثر بدفة الكلام لنفسه حتى ضُنّ أنه لن ينزل عن ذلك العرش.
ورغم أن قسما كبيرا من كلاسيكيات الأدب العالمي قد سلك المبدعون فيه نهج الراوي العليم المتكلم بضمير الغائب، مثل أنا كارنينا لتولستوي، ومدام بوفاري لفلوبير والملهاة الإنسانية لبلزاك والأم لماكسيم غوركي و1984 لأورويل ومدن الملح لمنيف وأغلب أعمال محفوظ وحنا مينا، بيد أن هذا النوع من القص بدأ يتراجع تدريجيا متأثرا برجّات متتالية من تيارات تجديدية وأخرى تجريبية، حتى ترك مكانه لطرق ورؤى سردية أخرى نافسته وأثبتت جدارتها وثراء رؤيتها، فمنذ زمن ما عدنا نرضى أن نجلس مقرفصين حذو المدفأة متحلقين حول هذا الشيخ (الراوي) الذي يعلم ما لا نعلم ويتلاعب بعقولنا وأحاسيسنا فيبوح بما يشاء ويكتم ما يشاء، ويغوص في أنفس بعض الشخصيات المحكي عنها ويكتفي بوصف الأخرى وصفا خارجيا سطحيا.
لقد طرأ، بفضل التجديدات ما بعد الحديثة خاصة، تحولات ثورية نجحت في إعادة تشكيل داخلية لفيزيولوجيا اللعبة السردية، كان من بين نتائجها أن تهدم هذا المعمار الكلاسيكي الدائري، الذي يتحلق فيه المتلقون حول ذات مركزية واحدة هي التي تمن بالسّرد على الجميع، لتقص حكاية شخصية بطلة تقف هي الأخرى كمحور مركزي وسط مجموعة من الشخصيات الثانوية والمساعدة والهامشية، وتدور كل الأحداث وتتحالف كل الصدف ضدها أو تتواطأ جميع الأقدار لصالحها.
صار بإمكاننا بعد هذا التراكم من التجارب والتحولات (مثل تجربة "الرواية الجديدة"، ورواية الميتافكشن أو رواية الرواية) أن نتحدث عن هامش أكبر من الحرية في التخفي والظهور بالنسبة للراوي، وآفاق جديدة لا تحصى تفتح أمام المؤلف ليخلق داخل عمله السردي عالما من المعرفة المتنوعة التي تزخر بها كل شخصية، وتضطلع بمفردها بروايتها والتعبير عنها على طريقتها انطلاقا موقعها الطبقي والثقافي والجندري وغيرها من مستويات الاختلاف.
انتفت إذن أي وصاية للراوي العليم على عناصر الحكاية وشخصياتها في الرواية المعاصرة، كما خسر أسهما إضافية لصالح صوت المؤلف نفسه، إذ صار بإمكان الأخير حتى أن يصعد بنفسه على الخشبة ويقول ما في جعبته للقارئ أو لنفسه أو للنقاد، بينما يضع الحكاية بمن فيها في وضع الانتظار، وهوما يمكن أن نعتبره معادلا لتقنية كسر الجدار الرابع بين الممثلين والجمهور في المسرح والفنون الركحية. وإليكم في هذا الصدد مقطعا من رواية بعنوان "امرأة الضابط الفرنسي" لجون فاولز:
... لا اعلم، هذه الحكاية التي احكيها لكم كلها محض خيال. هذه الشخصيات التي خلقتها ليس لها وجود أبدا خارج عقول شخصياتي وأفكارهم الدفينة، وذلك لأنني اكتب مدفوعا بقناعة راسخة على المستوى الكوني في وقت كتابة روايتي هذه: الروائيون يشغلون مرتبة تلي الله مباشرة. قد لا يكون الروائي كلي العلم والمعرفة مثل الله لكنه، برغم ذلك، يعمل ويتظاهر على أساس من معرفته الكلية بدقائق الأمور . أعيش في عصر ألان "روب غرييه" و"رولان بارث" وإذا قدر لعملي أن، يكون رواية فليس في مقدورها أن تكون رواية بالمعنى الحديث للكلمة.
لكن بعد أن تم خلع الراوي العليم عن عرش السرد، ما هي تداعيات ذلك على تماسك البنية السردية وتأثيره على عنصر الإمتاع والتسلية التي هي أساس كل عمل سردي ؟ متى يكون القارئ المتلقي مستعدا لمقايضة هذا العنصر (الإمتاع) بعنصر الدهشة والانتشاء بالطرافة الأسلوبية التي يقدمها العمل التجريبي ؟ وهل هو، أي القارئ، مطالب بهذا أوبأي شيء آخر ؟
من شأن المتحفظين على التجريب والتجديد في الأدب أن يبرروا مهاجمته لكل من يتعاطاه بأن الانشغال بالتجريب لا يخلف سوى منتوجا ومادة أدبية مريضة قاصرة على أن تمت بصلة إلى الواقع الذي جاءت منه، والتي هي مطالبة دوما بأن تنصت إليه وتشير إلى مواطن الداء فيه، فتراها تغرق في مسائل شكلية لا فائدة محسوسة منها ولا يفقها سوى نخبة من النقاد والمهتمين بالتسميات والعبارات الفضفاضة، أما القارئ والمستهلك "العادي" للرواية فلا يهمه من العمل الذي بين يديه سوى الحكاية المتماسكة والحبكة والتشويق والقيمة المعرفية التي تتضمنها صفحاته، والتي لا بد أن تدفعه لكي "يلتهم" العمل في جلسة أو جلستين، كما درج القراء على وصف الأعمال التي يعجبون بها.
لكن هذا "الالتهام" المحموم والسريع لعمل استغرقت كتابته شهورا وأعواما، هل هوبالفعل مؤشر إيجابي وطريقة صحيّة للتعاطي مع ما يكتب وينشر اليوم في العالم العربي والعالم؟ أم أن على الكاتب الجاد أن يخلق نوعا من المكابح الدرامية والأسلوبية لمنع هذا الانزلاق السريع والجري المتلهف نحو نهاية العمل، ما يؤثر سلبا على استيعاب المقاصد والتأملات التي مكانها بين سطور العمل لا في نهايته.
في رأيي، فإن التأني في التعاطي مع المادة الأدبية هو ضرورة اليوم، خاصة أمام المتغيرات الدائمة التي هي نتاج النظام والعقلية الاستهلاكيين، حيث صرنا نبحث دائما عن الاستهلاك ثم الإتلاف السريع،من أجل مزيد من الإنتاج فالاستهلاك من جديد، وحيث لا يشذ الفن والأدب عن ذلك، كونه صار سلعة محكومة بقوانين السوق والمضاربات ومراهنات البورصة.
ولمّا كان الفكر والأدب والفن الحرّ أبدا أداة مقاومة لتسلط الأنظمة، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية، فإنه يتحتم على كل مشتغل في ميدانها، أن يساهم من موقعه في كبح ذلك التوجه الاستهلاكي ال "الالتهامي".
وهنا يتنزل دور التجريب والبحث والنبش الدائم في إمكانات العمل الفني، في سبيل الوصول (صدفة ربما، أو بتخطيط مسبق) إلى أدب ضد التيار من شأنه أن يكون فسحة للتفكير ولحظة للشك في مجتمعات لا تسوّق لها الأنظمة سوى اليقين الزائف.
"يجب على التجريب أن يسفر عن تجربة" هكذايحلوا للكثير من الروائيين العرب القول، لكنهم يغفلون حقيقة تاريخية مهمة، كونه ما من تجربة من التجارب المهمة التي عرفها الفن والأدب كانت قد قررت في لحظة ما، أن تصير تجربة أو تؤسس مدرسة أو تيارا، وإنما وقع ذلك من خلال تقييم النقاد لها بعد أن تراكمت وبدأت تتشكل وتنضج.
فمثلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تعالت صرخات الشعوب المستعمَرة مطالبة باستقلالها وبرفع أيادي الغرب الامبريالي على مواردها، ولدى حصول تلك الشعوب على ما أرادت حل مكان الفن والأدب المقاوم، ما عرف بتيار الفكر ما بعد الكولونيالي ساعيا إلى ترميم ما أطنب فيه المستعمر من طمس لهويات الشعوب وتاريخها وإلباسها جبة الحداثة الفضفاضة دون مراعاة لخصوصيات هذه الشعوب وتاريخها، وقد استمد ذلك التيار مرجعيته الفلسفية من كتاب ومفكرين ما بعد كولونياليين مثل فرانس فانون وادوارد سعيد وغيرهم ممن انتقدوا الاستشراق وآلياته وخلفياته المشبوهة. وسرعان ما حذت الرواية حذو الفلسفة وبقية الأنشطة الفكرية لينتج روايات ثارت على كل ما له صلة بالنمط الغربي الحداثي وزعزعت أركان هذا الصنم الذي ضن الغرب أنه أعظم ما سيتوصل إليه العقل البشري، وهوما نقرأه في أعمال رائدة لأيقونات سردية جاءت من صلب حالة التشوّش تلك التي عقبت موجات التحرر، كروايات السوداني "الطيب صالح" والبريطاني ـ الهندي "سلمان رشدي".
وكخلاصة فإن البحث الدائم عن أساليب طرح وقول سردي جديد هو ضرورة اليوم أمام كل من يكتب الأدب إبداعا ونقدا، وما قضية التنويع الصوتي والتبئير المتغير داخل رواية ما، سوى انعكاسا طبيعيا لما تنزع إليه الشعوب العربية منذ قرابة العقد للانعتاق من سطوة الصوت الواحد والرأي الواحد والمنظور الأوحد. ومن هذا المنطلق فإن الكثير من الأساليب والتقنيات الفنية (ومسألة الراوي في الفنون السردية إحداها) قد تجاوزها الزمن والأحداث، وصار محتما علينا الشروع في السؤال عمّا قدمته تلك التحولات الاجتماعية والسياسية، التي صرح روائيون أوروبيون أنه يغبطون الكتاب الذين يعيشون في بلدان الربيع العربي على هذه المادة والإمكانات في البحث والتجديد، التي توفرت لهم فجأة دون الأمم الأخرى.
كتبت هذا المقال بعد جلسة تقديم لرواية كاتب صديق، كنت قد قرأت روايته ووجدت أنها عمل دسم يزخر بكثير من نقاط القوة والمعلومات والبحث الجدي في اللغة وفي المضمون، لكن شيئا واحدا كان في نظري ينقصها بل ويضيع عليها فرصا في الإيمان بها وأخذها على محمل الجد، وهي أنها كُتبت من أول فصل حتى النهاية متناولة حيوات شخوص لا تحصى ومصائر دراماتيكية مكثفة في خضم إرهاصات التحولات السياسية المتسارعة في تونس، إلا أن الكلام فيها
كان من نصيب هذا الراوي الذي نصّب نفسه إلهاً، يزعم أنه مازال باستطاعته أن ينفذ الى دواخل الناس ويتحكم في مصائرهم، يسرد ماضيهم ويتنبأ بمستقبلهم، منتظرا أن يؤخذ كل ما يقصه على أنه حقيقة لا مفر منها.
بعد أن أنهى صديقي تلاوة فصل من فصول روايته، صفق له الجمهور، فسأل إن كان لدينا تعليقات. لم يكن يدور في خلدي سوى السؤال التالي:
من ما يزال يصدق الراوي العليم؟
لكنني قررت ألا أطرحه، وخيرت أن أكتب عنه هذه الأسطر.

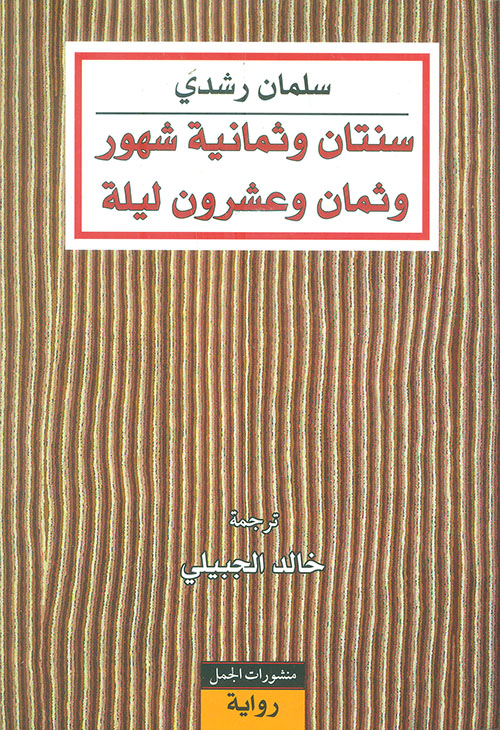


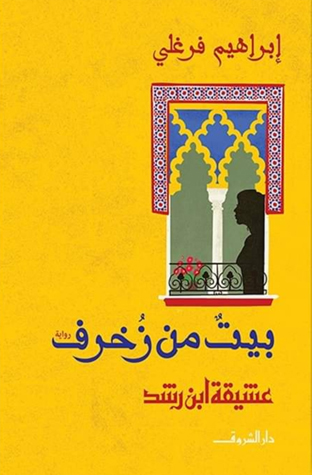


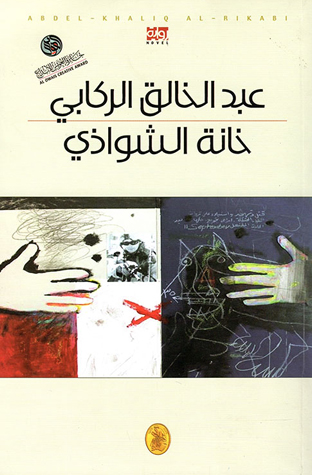

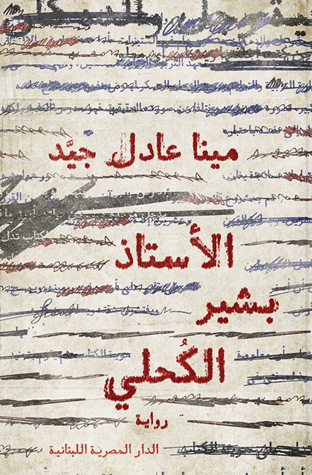

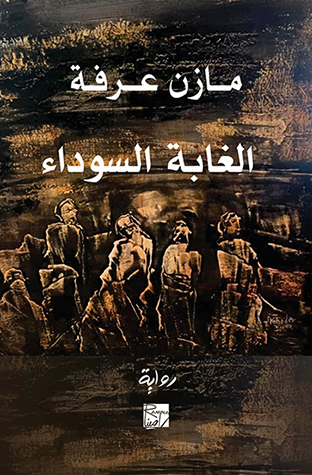


0 تعليقات