الصوفية وما بعد الحداثة لدى خليل الرز
عمل كتاب أدونيس "الصوفية و السريالية" على مقاربة الصوفية من السريالية حتى كاد أن يجعلهما شيئاً واحداً. و هذا شيء لافت ومهم في لقاء الحضارات وحوارها، إلّا أنّ هذا الحوار يبقى مشروعاً ذهنياً، لا نجاعة واقعية أو فنية له، طالما أنّ الصوفيين لن يعيشوا كالسرياليين، ولا السرياليون سيعيشون كالصوفيين، وكلاهما لم ينجز أشكالاً جمالية متشابهة. ودرستُ قبل ذلك في كتابي "الشعرية العربية" الصوفية من خلال شعرائها أنفسهم، اعتماداً على رؤية محي الدين بن عربي للمراتب، ولا سيما البرزخية منها. وشرحت مساهمة الشعراء الصوفيين في تجديد الشعر العربي، مثبتاً، قدر ما يمكن، أصالة قصيدة النثر عربياً في نصوصهم، لأنفي عن هذه القصيدة بعدها الاستشراقي المعكوس، ولأثبت أنّ الجنس البشري قابل بشكلٍ متساوٍ للحضارة المتجدّدة بغضّ النظر عن اختلاف أعراقه ولغاته. وكنت أرى أنّ هذا كافٍ بحدِّ ذاته للبرهنة على مكانة الأدب الصوفي وأهميته في التراث العربي. لولا أنّ هذه الأهمية اتسعت مع ظهور الرواية كجنس أدبي جديد في اللغة العربية ورغبة كثير من الروائيين المعروفين بتوظيف الصوفية في سردهم. ولكن، من خلال مقاربة الصوفية ورؤاها، في مشروعها الكلّي، كشيء يشابه محاولة أدونيس النظرية لمقاربة التراث بالحداثة. وما كنت سأتدخّل في كلّ ذلك حالياً، لولا أنّ رواية (البدل، دار المحروسة، القاهرة، 2016) للروائي السوري خليل الرز، قاربت الصوفية من منظور ما بعد حداثي – وحالة ما بعد الحداثة هي مشروعي النقدي الذي أعمل عليه منذ زمن – فأردت أن أقارب من خلال هذه الرواية علاقة الصوفية بما بعد الحداثة كما يقترحها عمل خليل الرزّ لا غيره. تقوم رواية (البدل)على بناء معماري هشّ مكانياً، لا هو في موسكو، ولا هو في دمشق. ولا يمكن أن يكون في كليهما معاً. إنه مكان زائف أقرب إلى رمزية الواقع، ومن غير أن يكون الواقع نفسه. تحضر موسكو في هذا المكان من خلال اسمه الحيّ الروسي، ومن خلال اسم القبضاي أو الفتوة بوريا وصاحبة الكشك ليزا إضافة إلى شخصيات روسية أخرى من الخبراء والمتقاعدين الذين آثروا البقاء في دمشق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ويذكر السارد أنّ هذا المكان هو حيّ الملاهي في دمشق أيضاً، وإذا لم يكن في منطقة الربوة، فهو في سوق الصالحية، واحتمال أنّ يمازج الروائي بين المنطقتين في مكان واحد ضعيف، لكن، من المؤكّد، هو داخل دمشق القديمة، بجوار منطقة العزيزة حيث خمارة آكوب في مدينة حلب التي تبعد عن دمشق حوالي أربعمئة كم. هشاشة المكان الإلصاقية هذه تجعله قابل للحركة بسهولة - حركة كشك ليزا مثلاً. لكن هذا الكشك ليس مثالاً وحسب، بقدر ما هو محرّك للحي الروسي في الرواية، تبعاً لحركة شخصياته: ليزا، و السارد، و فيكتور إيفانيتش ... وإذا كانت حركة الكشك محكومة بإرادة بوريا، فإنّ حركة شخصياته لعدم أهميتها بالنسبة إلى تحصيل الإتاوات، ليست كذلك. ربما هذا الوصف للمكان في رواية (البدل) هو شيء جديد وطريف في السرد السوري. لولا أنني أردت أن أشرح من خلاله أنّ المكان في هذه الرواية أو في الحيّ الروسي دراميّ أكثر من أيّ شيء آخر. فهو، بإلصاقيته السابقة، وحركة إكسسوارته، لا يبدو بهياً بذاته، ولا أهمية نوستالجية له إلا من خلال الفعل وعلائقه بشخصياته. ولأنّ شخصية السارد هي محور الرواية ومكانها، ستلعب دوراً أساسيّاً في هذا الإلصاق الدراميّ. فمن خلال انتماء عائلته إلى إحدى الفرق الصوفية، كان مضطراً أن يتدرّب في صباه على الرقص الصوفي في مدينة الرقّة. وحسب فهم هذه الفرقة المحاربة ومراتبها فإنّ معلّم السارد هو بدل من الأبدال، وما يهمّ، هنا، من هذا البدل هو قدرته على التواجد في عدّة أمكنة في الوقت نفسه، لأفسّر عنوان الرواية، و أفسّر المكان الإلصاقي الذي اخترعه الروائي لروايته، على الرغم من فشل سارده في الوصول إلى الحال التي ترضي معلّم الرقص، بسبب قوة ذهن هذا السارد و احتماله للدوران من غير أن يؤثّر ذلك على توازنه. لكنّ تجمّع الأمكنة في الحيّ الروسي لا يعتمد على البدل الصوفي إلا من حيث الشكل. وتواجد السارد فيه هو رغبة دائمة بالهروب من البدل الحربي الذي بقي يطارده من جهة عمه. فلا يدري السارد لماذا اختاره هذا العم أن يكون قائداً للانقلاب العسكري الذي يخطّط له بدلاً من أولاده؟. وأن يُفشل السارد جميع هذه الخطط منذ البداية، فلا يلتحق بالكلية العسكرية وإنما بكلية التاريخ، ولا يصبح عضواً في حزب عمّه، وإنما شيوعياً، لم يمنع العم من متابعة حلمه الانقلابي به، ولاسيما بعد أن زوجه من ابنته "رجاء" بعد عودته من موسكو بشهادة مختصة بالأدب الروسي. لم يجد السارد عملاً يناسب شهادته الأدبية، فالتحق بالعمل لدى صديقه عبدو في تنقية المياه، متخلّياً عن رهافة اللغة الروسية لصالح ميكانيكية الآلات الصينية و قرقعتها – حسب توصيف الرواية. وربما لأنّ رجاء تشارك أبيها الذي منحها وزوجها شقّة فاخرةً بخادمتين، حلمه بالانقلاب، وتُعامل السارد كرئيس قادم، إن كان من خلال سلوكها وحديثها اليوميّ معه، أو من خلال العناية بمظهره الرسمي حتى أثناء طلب الرافعة لنقل كشك ليزا في منتصف الليالي. ولأنها رقيقة، ويحبها السارد، ويستمتع بعشق جسدها، وأحلامها المرفرفة بالفراشات، كان من الصعب عليه أن يخبرها بحقيقة عمله، أو بأوقاته التي يقضيها في كشك ليزا بالحيّ الروسي. وهي أوقات عاديّة تتناول العلاقات الروسية السورية في أنقى مظاهرها الإنسانية. وتكاد تقتصر هذه العلاقات في الرواية على علاقة الصداقة بين السارد السوري وليزا المطلقة من سوري آخر - كان يحضّر لنيل درجة دكتوراه في موسكو، وذلك من خلال رحلة مكوكية كان يقوم بها كلّ أسبوعين ينقل فيها من دمشق إلى موسكو البضائع السورية الخفيفة، ويشتري من جامعات موسكو و معاهدها شهادات الدكتوراه الغيابية لمسؤولين سوريين كبار. غير أنّ الدكتور بعد عودتهما إلى دمشق يطلق زوجته ليزا بعد عملية بتر لثديها، و ينقل ابنتهما لينا للعيش في كنف والديه، ليتزوج بامرأة أخرى.
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:320px;height:100px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="7675478845">
تعاني ليزا من استبداد زوجها السابق من خلال منعه إياها اللقاء مع ابنتهما بسبب رفض والديه لذلك. ويعاني السارد من استبداد رغبة عمه بالانقلاب الذي يصيبه بالغثيان لمجرّد ذكره، بسبب ما يعنيه من تسلّط و سفك للدماء كما حدث في الانقلابات السابقة، ولا يرغب بتكرارها مجدّداً. وهذا دلالة واضحة على رفض السارد للعنف حتى من أجل التغيير أو ما شابه. مقابل هذا الاستبداد يعيش الصديقان حياة حرّة، منفتحة، يوفّرها لهما الحيّ الروسي، ولا يكدّرها سوى رغبة بوريا المستمرة بنقل الكشك لسبب أو لآخر. لولا أنّ حضور فيكتور إيفانيتش الرجل السبعينيّ، و الصحفي السابق في النسخة العربية من جريدة أنباء موسكو، مع كلبته الأفغانية، و حرصه على تقديم وردة حمراء إلى ليزا في يوم المرأة العالمي، لتمنحه هذه الأخيرة قبلة على خدّه تحمرّ إثرها وجنتاه. إضافة إلى تعاون السارد معه في ترجمة بعض المقالات القديمة التي ينشرها في مجلة الحائط المعلقة بحديقة الحيوانات التابعة للحيّ الروسي، يمنح هذه الصداقة طقساً روسياً صافياً وودوداً. وفقاً لهذين المستويين من الاستبداد و التحرّر، والمسرودين، غالباً، بطريقة استرجاعية ضمن أحداث الرواية، يقسم الروائي هذه الأحداث بطريقة درامية مشهدية، لا يتجاوز زمنها اليوم الواحد، الزمن الدرامي المعتمد في المسرح الكلاسيكيّ. و تأخذ هذه الأحداث ثلاثة اتجاهات يسلكها السارد: الأول: هو لقاء السارد بصديقه القديم عبدو في أحد خمارات أو ملاهي حيّ العزيزية، و ما نتج عنه من اتفاق على العمل معاً. و استعانة السارد به في توفير الرافعة، وأشياء أخرى. الثاني: تبدأ به الرواية من خلال رغبة ليزا بتركيب دراجات حديدية لكشكها، ليسهل تنقله في الحيّ الروسي، بلا حاجة إلى رافعة. وقد صادف ذلك يوم ثورة الحزب المصادف لنفس يوم المرأة العالمي. حيث كان الزحام الذي شكلته الرافعة، وإعاقتها للاستعراضات الاحتفالية، مناسبة لكشف مواقف الناس من المناسبتين في يوم واحد. ثمّ يرافق السارد ليزا إلى حي مساكن برزة بدمشق لترى ابنتها ذات التسع سنوات، حيث حوّلها جدّها و جدّتها إلى فتاة متدينة، تظهر النفور من أمها. الشيء الذي لم تفهمه ليزا، ولم يثنها عن محاولة عمل الكيك لابنتها في بيت حماها. لولا أنّ حضور زوجها السابق، واستفزازها له، يجعل هذا الأخير يضربها ضرباً شديداً، مما يجعل تورمات وجهها تشكّل قلقاً قبل لقائها المرتقب مع اللجنة الفاحصة لإمكانية عملها في الكباريه عاهرة ليلية. وكان يمكن للجنة المشكلة من قبضاي الملهى عصام الكردي و صاحب الملهى أرتين أن يوافقا على تشغيلها بسبب وساطة عبدو صديق السارد، لولا اكتشاف ثديها المبتور أثناء تعرّيها. الثالث: هو زيارة بيت عمه، وما نتج عنه من زواج بين السارد و ابنة عمه رجاء. لكن أن يكفّ السارد، بعد هذا الزواج، عن الذهاب إلى بيت عمه، متملّصاُ من الدعوات المتكررة لزيارته، خشيةً من حديث الانقلاب، لم يمنع عمّه من أن يرتّب له هذه الزيارة عنوةً. يكتشف السارد أثناء هذه الزيارة أنّ عمّه قد التقى أحد القياديين في الحزب، وأنّ هذا الأخير موجود في السهرة ليزّف له خبر حصوله على العضوية العاملة ، وأنّ هذا الحزب سيعقد جلسة قريبة ليتولى مركزاً قيادياً فيه. يتردّد السارد ويسترخي لحياته الهنية مع زوجته، ولا سيما أنها أخبرته بحملها. لولا أنّ ثمة شيء لم يجرِ كما ينبغي في خطة العم، و هو مشاهد النفاق الذي جرت بين القيادي وعمّه، بل و امرأة عمّه التي أخذت تطعم هذا القيادي بيدها، إضافة إلى تفكيره اللجوج بلوحة تشكيلية لأحد كبار الفنانين الروس أرخيب كوينجي، وكيف وصلت من أحد المتاحف الروسية إلى بيت عمه الذي اقتناها بسبب ثمنها المرتفع، وما يعنيه ذلك من استثمار للفنّ في تبييض الأموال، رافعاً صوته مرّةً، وموبّخاً مرّةً، وسط رضا الجميع وكأنّه تقمّص شخصية الرئيس القادم حقيقة. تحت ضغط هذا الكمّ الهائل من الاضطرابات، وللتخلّص منها كلّها، سوف يلجأ السارد للاستعانة بصديقه "عبدو" مجدّداً، فيخبرهم بطبيعة عمله معه و أنه يعمل تحت إمرته، فتنهار شخصية الرئيس المفترضة من خيال الجميع وتسقط رجاء مغمياً عليها، وينحسر ثوبها، فتظهر شعرات من عانتها، ويضع القيادي يده على شعر العانة، قرب الجنين، فيسحبها السارد بقوة و يحمل زوجته و يخرج وسط ذهول الجميع، وهو يفكّر أنّ عمّه مجرّد شخص عصابي يستغل الآخرون أوهامه السلطوية لسرقة أمواله. بعد ذلك ينتقل السارد إلى التواجد أمام حديقة الحيوانات مع ليزا و فيكتور إيفانيتش و كلبته. لتقوم ليزا بما كانت ترغب بالتهرّب منه لو قُبلت عاهرة في الكباريه، فتخرج من السوبرماركت بصحبة شابين و يركب الجميع سيارة أجرة إلى أحد أسطحة عمارات حي المزة الدمشقي. و بينما منعت الشابين من ملامسة صدرها، تركتهما يمارسان الجنس معها وهي تستذكر علاقتها بزوجها السابق بصوت يسمعه السارد، ربما لتشرح له نفسها. بعد أن تخلّص الشابان من حماس شهوتهما كلّ بدوره، شعرا بأنهما ارتكبا إثماً، و حمّلا هذا الإثم لخداع ليزا لهما، فأخذا يضربانها تكفيراً و انتقاماً بينما السارد وأرتين يراقبان، لولا تدخّل الكلبة وإيقافهما. بعد رحيل الشابين ينزل السارد وليزا وفيكتور إيفانيتش إلى الشارع و قد ازدادت الظلمة و البرودة بعد منتصف الليل. وتنتاب الجميع نوبة من الضحك، كأنّ ما حدث على السطح لم يكن سوى مشهد تمثيلي أوما يشبهه. و يأتي عبدو بشاحنته ليعيد الجميع إلى الحيّ الروسي، و في الطريق يرافقهم عصام الكردي وزوجته رشيدة المغربية عازفة العود في الملهى. وبين عصام ورشيدة قصة غريبة، تتلخّص في أنّ رشيدة أحبّت عصاماً ولم يستجب عصام لهذا الحب إلا بعد أن وقعت رشيدة في انهيار عصبي أُصابها بشلل نصفي، ولهذا دلالة سآتي إليها. تفاجأ ركاب الشاحنة حين وصولها إلى الحيّ الروسي باعتراضها من قبل بوريا و تجمّع سكان الحيّ حول هذا المشهد المتوتّر، خوف عراك محتمل بين بوريا وعصام الكردي لأنّ هذا الأخير جعل ملهى أرتين بمنأى عن إتاوات بوريا و بلطجته. لكنّ الثلج يسقط، و أمام انشغال الجميع به، يحمل عصام رشيدة وينزلان من الشاحنة دون اعتراض بوريا لهما. ليكتفي بوريا بالطلب من ليزا مغادرة الحيّ الروسي نهائياً إلى قرب مبنى البريد. سيلاحظ قارئ الرواية أنّ ما تقدّم من أحداث يرويها السارد بطريقة درامية قائمة على السرد التعاقبي أو التبادلي أو الاسترجاعي للأزمنة و الأمكنة، وما يعنيه ذلك من استطراد في التفاصيل، وتدخلات السارد وصفاً وشرحاً فيها، إلى جانب آرائه وهلوساته حول الفن التشكيلي والأدب الروسي. من غير أن يمنع ذلك من تقسيم الرواية إلى عدّة عناوين: "عجلات كشك ليزا"، "ما حدث البارحة في زيارة لينا"،" ما حدث البارحة في الكابريه"، "ما حدث البارحة في بيت عمي"،" ما حدث البارحة عند حديقة الحيوان". يحصل هذا على الرغم من الإشارة الصوفية إلى إمكانية تواجد السارد في جميع الأمكنة و الأزمنة في وقت واحد، و طريقة السرد هذه و أشكالها كلّها معروفة في السرد العربي و العالمي. لكن في القسم الأخير من الرواية و المعنون على هذا النحو: " ما حدث البارحة في كشك ليزا ما حدث البارحة في خمارة آكوب ما حدث البارحة في المشفى الفرنسي" سوف يقوم السارد بحكي هذه الأحداث دفعةً واحدة من جميع أمكنة الرواية وأزمنتها:" حين وصلنا، أنا و ليزا، إلى الكشك كان الغرسون، في خمارة آكوب، ينظر إليّ، مثل مباغت بي...."، و لإيضاح مهارة خليل الرز في سرد هذا الحكي المتشظّي، أورد مثالاً آخراً:" – أنا زميلك في المسرج الجامعي، هل تذكر "يحيا الكعب"؟ قدمناها معاً على مسرح سينما فريال في الجميلية. قال إبراهيم صيداوي و كان السجق لذيذاً فطلب عبدو كأسي عرق أخيرتين، و بحث عن شيء في موبايله، ثمّ ركّب سماعتيه، و قدّمه لي. – سنجرّب العجلات أخيراً.. - قالت ليزا – وإذا اعتذر عبدو فسوف نستأجر أي سيارة أخرى نعثر عليها. في كلّ الأحوال لن يكون الكشك أثقل من سيارة أجرة معطلة. المهم ان نكون، صباح الغد، في مكاننا الجديد. شعرتُ، في تلك اللحظة، بأنّ زوجتي تنظر إليّ، ربما منذ دخلت إلى الغرفة. و لسبب لم أفهمه، برغم المسرح الجامعي الذي أبرزه في وجهي مثل بطاقة هوية، كان إبراهيم الصيداوي، بعد أن قدّم إلينا كأسَي العرق، ينظر إليّ هو الأخر، من وراء الكونتوار الخشبي، نظرات بدت لي حادّة ومحيّرة..". ربما صار من نافل القول: إنّ خليل الرز لا يتعامل مع الصوفية برؤيتها الكلّية للوجود، ربما لعدم مقدرة سارده على الوصول إلى الحال الذي يرضي البدل، بالإغماء بعد رقص الدوران كما ذكرت. و ربما لأنّ الرواية لا تورد أيّ فهم عرفاني للصوفية، و إنما تكتفي بسطحها المرئي، مع نقل مكان رؤيا البدل الصوفي من ساحات الحروب، إلى ساحات المدينة و أمكنتها كما نرى السارد في الرواية. هذا التعامل الما بعد حداثي مع الصوفية لا يقتصر على سطحها المرئي، وإنما سيوظفه الروائي في شرح العلاقات السورية الروسية من خلال المدينة العالمية متعدّدة الأعراق والأجناس (الكوسموبوليتية) ، وطالما أنّ هذه المدينة غير موجودة واقعياً، يقوم الروائي بإيجادها في روايته من خلال بنية الإلصاق الما بعد حداثية، كأن يفترض أنّ مقدرة السارد على التواجد في عدّة أمكنة، و مع عدد من الشخصيات في وقت واحد، سوف يسمح بتواجد هذه الأمكنة و الشخصيات معاً في مدينة واحدة. لكن هذا الافتراض الفني، لا يعني أنّ الرواية لا تنصت إلى الواقع، بل هي على العكس من ذلك تماماً، إنها تتناول مصائر شخصياتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بمنظور سلمي يرفض التغيير و الإصلاح عن طريق العنف، كأن يرفض السارد فكرة الانقلاب، و يكون إجهاض زوجته رجاء نتيجة لهذه الفكرة. وربما أهم من ذلك كأن يكون عدم تدخّل السارد حين تعرّض ليزا للضرب من زوجها و الشابين، فكرة تحرّرية تتحمّل المرأة، خلالها، عواقب أفعالها من غير رعاية أو وصاية، و لاسيما أنّ ليزا مهتمة بتمكين المرأة وتعمل على إنشاء موقع الكتروني من أجل ذلك. وربما علاقة عصام برشيدة تأتي في هذا المنحى التحرّري للمرأة من سلطة الرجل و قوّة جسده و فحولته. و بمنظور نقدي للتحولات الثقافية و الفكرية التي همشّت الفنون والآداب لصالح أشكال هابطة من النشاطات الترفيهية. و ربما هذا ما يفسّر ظهور شخصية إبراهيم الصيداوي في نهاية الرواية، فإبراهيم إضافة إلى أنّه يتخلّى عن المسرح ليعمل نادلاً في حانة، شأنه شأن السارد الذي تخلّى عن الآداب و الفنون ليعمل لدى عبدو في تنقية المياه، لا يرى في لقاء السارد فرصة لمعاودة النشاط الثقافي و إنما يطالبه بدين قديم. ولا يفعل السارد شيئاً تجاه ذلك سوى إيفاء هذا الدين بخمسمئة ليرة. لكنّ لحضور إبراهيم وظيفة أخرى لا تفارق اهتماماته القديمة وإن فارقها، وهي مقدرة الرواية على حشد مختلف الفنون في سردها، وربما لم يكن حضور الموبايل سوى للتأكيد على هذا الحشد، فابنة عبدو ستظهر خلال هذا الموبايل وستتواجد مع السارد من مكان و زمان آخرين وهي تغنّي لأبيها، بما يوسّع دلالات البدل، أقصد البدل الذي يمثله السارد، وليس البدل الصوفي. تحيل دلالات السارد، في هذه الرواية على الأقلّ، إلى فصامية الحالة التي تفرضها المدينة الكوسموبوليتية على سكّانها على غير ما هو شائع عنها من قبول التنوّع و التعدّدية. و ربما يعود ذلك إلى سطوة الاستبداد على مدينة (البدل) كما شرحت سابقاً، و كما يشرح واقع نشوء هذه المدينة تاريخياً من خلال الحروب الاستعمارية أكثر من لقاء الشعوب و حريتها في الانتقال و المواطنة على هذه القرية الكونية التي اسمها: الأرض. و مع ذلك لا يمنع أن تمهّد أن هذه الفصامية، إذا ما تحرّرت من مرض استبدادها، إلى قبول التنوع و الاختلاف و الحوار كحالة عامة و طبيعية - من طبيعة البشر و معرفتهم و تاريخهم. هل تفكّر رواية (البدل) في ذلك؟. أعتقد أنّ ليزا قد تعبت من التفكير في كلّ ذلك، فقد وضعت يديها المرتعشتين على وجهها، كما فعلت ابنتها لينا هذا الصباح، وشرعت ببكائها المرّ، إلى أن توسدت ذراع السارد، ونامت. لكن، ربما خليل الرز لم يتعب. وربما أنت لم تتعب أيضاً، وربما أنا لم أتعب كذلك.
الرواية نت – خاصّ
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="1305511616">
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="3826242480">
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="4898106416">




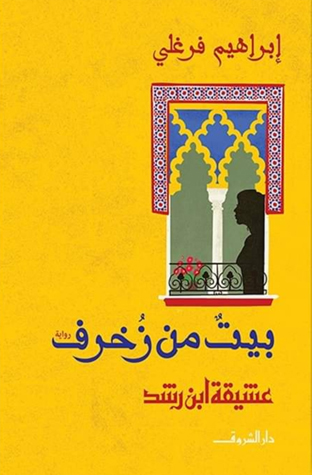


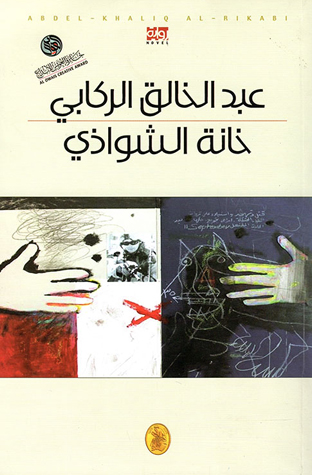

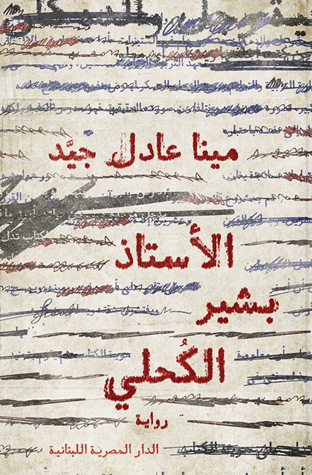

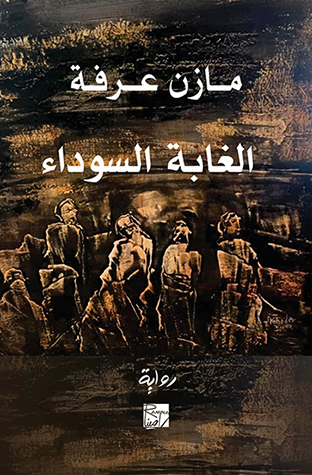


0 تعليقات