"أبواب الروح السبعة" لأيوب الحجلي.. بين سلطة النصّ وانفتاح القراءة
تمهيد:
يعمد الكاتب في هذه الرواية إلى إعادة سرد التاريخ الإنساني بصيغة حكائية مشوّقة، فيتوغل في ثنايا الأسطورة والحدث القديم ليقدم روح الإنسان بشكل مفعم بالتأمل والتفكر والوعي.
وإذا كانت المناهج النقدية تسعى إلى ربط النصوص السردية غالبا بأشكالها البنيوية وصيغها الموضوعية، فإن هذا النص يجمع بين القدرة الألسنية (البلاغة) والسمة الموضوعية (الإنسان) ليمرّر خطاب الفكر الذي ألحّ على أهميته "حسن حنفي" قائلا: " ويبدو أن أنواع الخطاب في الأدبيات المعاصرة قد تم استبعادها لحساب عمومية الخطاب وإخضاعه لمنطق لغوي ومنهج تحليلي واحد. وفي العمومية تختفي الخصوصية. فقد اتجهت المدارس اللغوية المعاصرة نحو الشكل دون المضمون. وبالتالي لم تعن إلا بالألفاظ والتراكيب..." مبينا أن (فحوى الفكر) لا يمكن تجاوزها في عملية الإبداع؛ لأنها تنقل من الخبرات المعرفية ما لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه في تحسين الذائقة النقدية على العموم.
1- مرجعيات السرد وأفق التلقي:
إن قراءة هذه الرواية تحتاج إلى تركيز شديد ويقظة فكرية ومعرفية واسعة للفصل بين زمن الحكاية الفعلي وزمن الحكاية الخطي " بعدها شعرت أني ممدّد فوق الكثيف والحرارة تبارحني... عندما بدأت أنسلّ من الفتحة في صدري إلى الأعلى، أيقنت أني متّ أو أني ذاهب في طريق الموت، وأن روحي تفارق جسدي، والضيق الذي رافقني لعدم قدرتي على التنفس قبل ثوان اضمحل وتلاشى، وكأني لم أعد بحاجة للتنفس... ربما.. هنا تضاجت الأسئلة على ذهني... لماذا أنا هنا؟ لماذا انتهت حياتي على هذه الأرض الرملية؟ لماذا أزهقت تاريخي المعرفي بحد سيف قاطع بارد صلب صلد؟ ولكن لم أعد أستطيع العودة، أو أني لم أرغب بالعودة، عندها فقط تذكرت الحكيم في معابد الحكمة هناك أعالي جبال الهيملايا..." (الرواية ص 8 – 9.) فالكاتب لعب على عنصر الزمن بعذوبة ورقة متناهية، وكان سفره عبر اللغة داعما لسفره بالقارئ عبر الخيال، وهي ميزة تتوفر عادة في روايات تيار الوعي إلا أنها هنا تفوقها ابتكارا؛ لأن الذكريات التي يتقمصها البطل ليست ذكريات أصيلة أو موجودة بالفعل، بل هي اشتباكات الوعي المعرفي بالوعي الروحي الذي ينتصر له الكاتب ويصرّ عليه؛ خاصة وأن البطل لا يبدي أسفا على اضمحلال الجسد، بل يركّز على التاريخ المعرفي ممثلا في الفكر، الذي سنجد الرحلة تقود إليه تباعا وتعمل على ترسيخه أسلوبا للحياة وإن كانت فانية، كما أن " تقديم وجهة مغايرة لوعي البطل الأساسي في [الرواية]، ليس إلا مساءلة لهذا الوعي، فأي وعي مقدم في عمل فني، يحاول دائما أن يمتحن نفسه من خلال عرض هذا الوعي على وجهة نظر مقابلة، خاصة إذا كان البطل الرئيس لديه هذه المساحة من الشك في توجهه ومسعاه" (عادل ضرغام/ في السرد الروائي.) ولهذا فإن الكاتب هنا يعمل على إدانة التقمّصات البشرية للألوهية في مسعى الخلود، وينتصر لرقي أرواح الأنبياء المترفعين عن آلام الجسد، ليبيّن الفرق في كيفية استلهام القيمة من الأثر الإنساني المشوب بالمطامع الدنيوية المنتهية إلى الفراغ، ومن الأثر الإلهي المعجز المتفرد في الإحالة على لانهائية الكون والمعرفة المرتبطة بالوحي.
ويمكن القول إنّ تقمّص البطل لذكريات ليست ملكا له إصرار آخر على طبيعة المعرفة، وهي ذكريات تمكن القارئ والمؤلف من الاشتراك في عملية الاسترجاع، مما يجعل النص هنا محلا لإعادة إنتاج نفسه مرارا وتكرارا؛ إن " تحليل النص هو أولا إتقان الإصاخة إلى قوله. هذه الإصاخة التي تفترض إلغاء لكل افتراض مسبق، معالجة المحلل الأدبي للنص كما يعالج المحلل النفسي شخصا يعوده، أو كما يعالج الخبير كتابة اصطلاحية (شفرة)... يعني ذلك قبل أي شيء آخر امتلاك أذن (عين، رأس...) راقية الحساسية والمعرفة في آن. فليس الكلام المعالج للتسجيل والاستعادة، إنما هو للفهم والتأويل. إنما الفهم الصائب والتأويل الصحيح يفترضان ثقافة منهجية عميقة وانفتاحا ذهنيا احترافيا... إن التحليل عملية اختلاء بالنص، أو خلو له، بقدر ما هو عملية انصراف إليه وإقبال عليه. إنه عملية جدلية لا تستقيم إلا بتفاعل حدّيها " (سامي سويدان/ أبحاث في النص الروائي): المبدع والناقد، في سياق حضارة السرد المنتشية وفق تصور ثقافي جامع ومتنوع وشامل لكل الأنواع السردية التي لم يكن معترفا بها قبل وقت وجيز.
تبدأ الرواية بمشهد صادم يمثل حالة موت (استشهاد) البطل إثر طعنة في الصدر، يستفيق بعدها ليلقى شخصا (الحكيم)؛ الذي يصبح البطل نفسه في آخر الرواية بعدما يكون قد ولج الأبواب السبعة وعاد منها " نظر إليّ وقد أحاطته الغرابة من كلامي هذا، تقدمت من البحيرة ومددت يدي إلى النبع، فارتفع الماء للحافة لكي يشرب، أردته أن يشرب منه رشفة واحدة، فإن شعر بالارتواء أكملت رحلتي معه من هنا، وإن لم يشعر كان لا بد له أن يلتحق بالتلاميذ في هذا المعبد، وعندما أخذ الرشفة الأولى انتبهت لانعكاس خيال صورتي على الماء، وما لفت انتباهي في صورتي بعيدا عن الصلعة الملتمعة تحت أجنحة المساء الضحكة الجميلة التي كانت ترتسم على وجهي رغم أنها لا تنتمي لتفاصيلي في الوهلة الأولى " (الرواية ص 17) وهذه الضحكة على ما يبدو هي المكسب الجديد لرحلة الروح تلك.
يمثل الحكيم ذاتا غامضة، قادرة على الاطلاع على ما يجول في فكر البطل ومناقشته، وإثبات غلط منطقه في نظرته إلى الأشياء المادية والحكم عليها، وكذا في طبيعة العلاقة الإنسانية بالروح وبكيفية التعامل معها، ليتحول البطل نفسه إلى ذلك الحكيم في نهاية الرحلة مما يبين أن الحكيم قد مرّ بتلك الأبواب قبل أن يصبح ما هو عليه " لديك الوقت الكامل لتخوض هذه التجربة، ستخوض تجربة لم يجربها إلا قلة من الناس، ولا تسألني: لماذا أنت؟ ربما ستجد الجواب عند عودتك، نسمي هذه الرحلة "أبواب الروح السبعة" ستغيب عن هذا المكان فترة تحددها أنت في رحلتك وعبورك الأبواب... تذكر ما هدف هذه الرحلة؟ ومن أنت؟" (الرواية ص 17.20) وتلك النتيجة هي ما كان ينتظره من البطل الذي اختار أن يمضي سابحا في ملكوت الروح، ولكن الأمر لا يتوقف هنا " كان الحكيم يطرح الأسئلة التي صنعت زوبعة فوضوية في جمجمتي، ولكن لم يعطني إجابة أو فرصة للإجابة، ورغم هذا كنت مرتاحا" ( الرواية ص 14) أما السؤال الذي يطرح نفسه في نهاية الرحلة: من هو البطل؟ وهل كان هناك بطل بالفعل على عادة الروايات التقليدية؟ هل كان بطلا واحدا تقمّص تلك الشخصيات واندمج في رحلة روحية معها؟ أم أنه كان شخصا توهم كل ذلك دون أن يتحرك من مكانه، بينما كان يقرأ كتابا يصادف ما فيه من معرفة حين ينتقل هنا وهناك عبر الخيال أو عبر الموت ؟
أسئلة محيرة أو هي مربكة بالفعل، تجعل القارئ يعود من جديد إلى بداية الرواية ليعاود القراءة عله يفهم أو يعي. فهل هذه الرحلة الدائرية كانت فعلا مقصودا من الكاتب وهو يرسم خارطة الرواية، ليجعل القارئ يدور في حلقة مكتظة بالمعرفة، معتقدا في كل مرة أن النهاية هي بداية جديدة؟ أم أن المعرفة تحتاج إلى أن تدور حول نفسها ساعية إلى الاكتمال الذي لا يكتمل؟ أم أن طبيعة الروح هي التي تسهم في العودة إلى البداية كي تنهل من دفق المعرفة حدّ الامتلاء دون أن تمتلئ؛ ذلك أن الجسد ذا الطبيعة المادية لا يمكنه إلا أن يستمر قدما نحو الفناء؟
إن الحركة البنائية (الدائرية) التي قصد الكاتب أن يرسم وعي الرواية ضمنها هي صميم التجربة العرفانية التي سعى جاهدا ليثبتها، ولعل معرفته بأغوار النفس - من خلال تخصصه الأكاديمي - قد لعب دورا مهما ومتميزا في سبر أغوار الذات، والارتقاء بالإنسان إلى مصاف الصوفية المعرفية المضمّخة برحلة الروح نحو الخلود، من خلال إدراك طبيعة الوجود وأسرار الخلق، لهذا فإن الرواية لا يمكنها أن تكون مجرد وسيلة للتسلية والمرح العاطفي؛ " تهدف الرواية بالطبع، وينبغي لها أن تهدف إلى توضيح نفسها بنفسها " (ميشال بوتور/ بحوث في الرواية الجديدة) وتلك الاختبارات التي مرّ بها البطل في رحلته عبر التاريخ الإنساني، كانت تمثل عملية استكشاف للذات من جهة، وعملية كشف للمراحل الكبرى في تاريخ البشر وصولا إلى مكتسبات الحضارة الآنية وانهيار القيمة بالتوازي من جهة أخرى.
ولهذا تتعاظم الرؤى المعرفية في هذه الرواية عبر الارتقاء في سلم التاريخ منذ لحظة الخلق الأولى " القوة المقدسة داخلنا خرساء، لأن الكون خلق بالصمت" (الرواية ص 5) هكذا يفتتح الكاتب (د. أيوب الحجلي) روايته، مشيرا إلى طبيعة المعرفة البشرية الراقية والمنفلتة من حدود الجسد المادي الصاخب بمتطلباته ونعيق غرائزه، لكنه يراها خرساء بينما يحاول طيلة زمن الرواية أن يعلّم القارئ كيف يجعلها تنطق داخله، من خلال جملة من الأخلاق والسلوكات الراقية التي عليه اتباعها على صعوبتها واستحالتها أحيانا، خاصة وأن الكاتب استعمل في نصه لغة تجريدية قريبة من الفلسفة والصوفية يعسر على القارئ البسيط استيعابها أو حتى تأويلها.
نحن إذا أمام نص مشكل بالفعل؛ يرفعك إلى مصاف الاكتمال والمثالية إن اقتربت من معانيه قدما، ويضيعك بين متاهات السؤال والسؤال إن تغاضيت عن الفهم أو البحث؛ إنها معضلة الكتابة الأزلية؛ الإفلات من لحظة الكتابة الخطية والرحيل في افتراضات الكتابة الروحية؛ أن تعيش زمن الكتابة واقعا فتصير لحظة القراءة هي الافتراض، ولهذا يستعين الكاتب على لحظة التمفصل بين الواقع والافتراض بطقس سحري تتكرر معه لازمة لغوية تجتمع فيها مشاعر الاستغاثة والألم والغريزة، وبدونها لا تتحقق دهشة السفر عبر الروح ولا تستقيم فكرة الانفلات من قيد الزمن " – ما أول الطريق؟
- نغمة تصلك إلى ألحان وترتيبات الذات.
- ما هي؟
- أغمض عينك، وأمسك بيدي وحاول السفر إلى خارج حدود الوقت وأخبرني: ماذا تسمع؟
بدأت أرتفع من مكاني وأنا أخالط روح الحكيم وتناغمات الذات، وعند ارتقائي خارج مدار المادة سمعت أول نغمة... متواصلة وعميقة تصدر من روحي، وليس من خارج كياني "آووووم"، وهي من وصلتني بتلك الترنيمات التي أحسست أنها تصدر من أرواح كثيرة متوحدة ومتشاركة في نعيم الذات، منتظمة في طريق ونظام " (الرواية ص 19) فهل هذه الرواية هي تصميم نظري لرؤية فكرية سامية؟ أم هي صناعة مفتعلة لدقائق الموجودات وطبيعتها وتفاصيلها التي لا تطيقها طبيعة العقل البشري البسيط؟ من أين تنبع مثل هذه الصياغة الروائية المبتكرة، من العقل أم من الحدس أم من الخبرة؟ ومهما يكن منبعها، هل ما فيها من المعارف قابل لأن يخضع للتجريب ضمن نطاق الحواس، أم أن الإدراك في مثل ما هو مرسوم هنا يكون كافيا للتقمص الفكري وبالتالي لذوبان المعرفة في أصقاع العقل وتحول الإدراك إلى سلوك فعلي؟ يؤسّس (د. أيوب الحجلي) لميزات تقنية مختلفة في الكتابة الرواية العربية المعاصرة، يمكننا أن نعدها تحديثا أو ابتكارا لا يخرج الكاتب من خلاله عن طبيعة السرد ولا عن بنية الجنس الروائي، غير أنه يصمّم نوعا من الكتابة يختص غالبا به دون سواه باعتباره ساردا وبطلا في الوقت نفسه؛ إنه التأسيس لثقافة السؤال، إذ إن المعرفة لا تتفتق مغاليقها من خلال عرض المعنى فحسب، بل ومن خلال تكثيف استفهامات العقل حتى تتحول إلى هاجس ملحّ يصعب معه استمرار الحياة على وتيرة واحدة " وقد يتجلى ذلك بشكل أوضح حين يكون السارد هو الشخصية ذاتها، على الرغم من أنه قد يعرض مجموعة إشارات تثبت كراماته، وهي مجموعة من التقنيات التي يستغلها ليحقق التواصل مع المتلقي، ومن ثم فرض عالمه الخوارقي وتصعيد قدرة المتلقي على التعرف عليه والتفاعل معه، وهنا يصبح السارد نفسه شخصية مركزية، تتمتع بحركية نفسية معرفية وحتى فيزيولوجية خارقة " (آمنة بلعلي/ تحليل الخطاب الصوفي) على الرغم من أن الرواية ليست خطابا صوفيا بالمعنى المتناهي لمثل تلك الخطابات؛ التي تكون فيها المعرفة المتوخاة محصورة في الاتحاد البشري بالذات الإلهية المنزّهة، مما لا يستقيم معه منطق تقبل الممارسة البشرية الممزوجة بخوارق ما وراء الطبيعة (والجدل حول هذا كثير في النقد القديم والمعاصر). تمثل هذه الرواية إذا منعطفا في طبيعة القراءة النقدية التقليدية؛ فهي رواية لا تستسلم للرؤى الخارجة عن طبيعة تكوينها، بل وتشترط أن يكون الناقد عارفا بخبايا السلطة المعرفية، والمفاهيم التي تسلطها عليه منذ الصفحة الأولى؛ خاصة وأنها تعود بين الفينة والأخرى لتكسر ما يقع في الذهن من ادّعاء الفهم أو الاستيعاب، لتخلخل السائد المعرفي وتزلل أفق القراءة، بكشف ما هو غير متوقع وحجب كل متوقع سابق، خاصة وأن البداية والنهاية متشابهتان، إحداهما تقود إلى الأخرى؛ لا لتكرّرها بل لتنفيها ثم لتعاود إثباتها بصيغة جديدة. إذا والحال هذه. ما هو المبدأ النقدي المنطقي الذي يجب أن نحتكم إليه في دراسة هذه الرواية؟ وهل من المنطقي أن نفعل ذلك وقد قرأنا الرواية فعلا؛ وهي التي ترفض التعامل مع الذات والموجودات ضمن المنطق المتعارف عليه مسبقا؟ " إن النص على الحقيقة أو على المجاز موضوع للتأويل وموضوع له؛ ولكن درجات التأويل تبع لدرجات الشفافية أو الإعتام، على أن ما سنهتم به هنا والآن هو النص على الحقيقة" (محمد مفتاح/ المفاهيم معالم) التي كان الكاتب يرومها لا ريب، إذ من غير المعقول أن يكبّد نفسه عناء السفر في متاهات التاريخ والأسطورة، ومحاولة تقديم المعارف والتدليل على كيفية تطبيقها دون أن تكون الحقيقة هي هدفه الأول، فبها وحدها تتحقق النبوءة وينتصر الإنسان على أوهام الجسد ومتطلباته ليعود إلى طبيعة خلقه وإلى الحكمة من وجوده " إن الحقيقة هي الوعي المعرفي داخلنا، فإذا أدركت هذه الحقيقة، أدركت قانون ما حولك ماديا وملموسا، فهو جزء من أجزاء كثيرة، وحقيقتنا المعرفية أقوى من الحقيقة المرئية " (الرواية ص24) غير أن افتراضات الحقيقة ستكون هنا متدرجة بين كونها حقيقة كاملة تستعير اللغة لكشف كل احتمالات المجاز، وبين كونها ناقصة فتتحمل اللغة عناء استعارات المجاز وتتوغل في دروب التخييل زمنا لتستخلص جوهرها وخلاصة قيمها وزبدة كمالها. تتفاوت قصدية النص (الضمني) المتقمص هنا (المتمثل في ما وراء الأبواب السبعة) انطلاقا من حالة الإدراك السابقة التي ينبني عليها النص (الإطار)، فالبطل يدرك قبل بدء الرحلة الروحية أنه ميت، هذا الإدراك يتحايل على وعي القارئ بأن لا يبدي البطلَ ميتا موتا تاما، بفعل صحوة الروح التي لا تتأتّى لكل البشر من جهة، ومراعاة الكاتب ذائقة النقد الذي يصنف مثل هذا الخطاب في دائرة (اللانص) من جهة ثانية "... يمكن القول بأنه في الماضي البعيد كان هناك تداخل بين الأساطير والسير الشعبية والملاحم من ناحية، والتاريخ من ناحية أخرى. ولعل هذا يذكرنا بالتداخل القديم كذلك بين الفلسفة والعلم، وكما انفصل العلم وتمايز عن الفلسفة، انفصل التاريخ وتمايز عن الحكاية الأسطورية والملحمية والشعبية. فأصبح للحكاية بنيتها الأدبية الزمنية الخاصة التي تتمثل في الرواية الحديثة، وأصبح للتاريخ موضوعيته المعرفية التي تسعى أن تكون علما. إلا أن هذا الانفصال والتمايز بيت البنية الأدبية الروائية الحديثة وبين المعرفية التاريخية الجديدة، لم يفضيا إلى إضعاف الطبيعة الزمنية والتاريخية الموروثة والمتطورة لبنية الرواية، بل على العكس من ذلك تماما، فقد ضاعفا وعمقا وأفسحا هذه الطبيعة الزمنية والتاريخية، بل كانت الرؤية المعرفية التاريخية الجديدة عاملا أساسيا من عوامل إبداع البنية الروائية الجديدة نفسها " (محمود أمين العالم/ البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة) وهذا ما نجده بالفعل متوفرا ضمن بنية هذه الرواية، التي حفلت بكل أنماط الموروثات المعرفية التي يقوم عليها التاريخ الثقافي للعقل البشري، من أجل الانتصار لحدث معنوي واحد، تتجلى من خلاله قيمة الروح على مرّ ذلك التاريخ الحافل.
إن الحديث عن العالم السفلي في الثقافة العربية مازال يصنّف ضمن الخطاب الهامشي، إذ لا يمكن قبوله باعتباره نصا فنيا إلا بمقدار قربه من الأدب الشعبي؛ الذي لم يخرج كذلك من دائرة الهامشي كنوع أدبي فائق الخصوصية، إذا والحال هذه، كيف أمكن للكاتب أن يدرج فكرة العالم السفلي - ممثلا بمسيرة روح البطل بحثا عن الحكمة بعد موته - في حين أن منبع الحكمة في الرواية كان متكئا على خطابات مركزية مؤسسة في الثقافة العالمية على مر العصور وهي: الخطاب الديني، والخطاب التاريخي والأسطوري، والخطاب الفلسفي؟ إن استعانة الكاتب بالأساطير على اختلافها منح تجربة البطل في هذه الرواية طابعا إنسانيا محضا، بمعنى أن استلهام مختلف الطقوس للتوصل إلى المعرفة الحقة المرتبطة بالروح، لم يكن له خصوصية ولا قومية ولا جنسية، " وفي مصر الفرعونية، كانت قد انبثقت وتواكبت بالفعل القاعدتان اللتان أسس عليهما كل من الإغريق والمسيحيين حكمتهم وعقيدتهم، ألا وهما: "حاول أن تعرف نفسك بنفسك"، و "أحبب الآخر كما تحب نفسك" " (روبيير جاك تيبو/ موسوعة الأساطير ) كما أن انطلاقه من فكرة العالم السفلي التي تشير إليه الأسطورة السومرية، يوضح سبب استعانته في رحلاته ببعض المظاهر، مثل منظر النهر - المسمى في الأسطورة (هابور) - واستعارته الأبواب السبعة من عالم الأموات، وفي الوقت نفسه تتّحد الأسطورة البابلية والكنعانية للوصول إلى فكرة إعادة بعث الإله، المتمثل في الحكيم هنا، ولهذا فإن البطل ينتهي من الموت ليبعث حكيما بعد أن يتخلص في كل باب من متاع الجسد ويكسب متاع الروح. في الحقيقة إن هذا التزاوج الثقافي للأنساق المهيمنة على مضمون الرواية لم يدخلها في دائرة التحيز الفكري أو الهجنة، بقدر ما منحها مساحة شاسعة للتوغل في البناء الحضاري للإنسان، ويبدو جليا أن هذا التشكيل الإدماجي بإمكانه أن يخرج النص من دائرة التقليد، ويمنحه صفة التفرد إن أمعن النقد على المدى البعيد الاعتناء بتفاصيله والاهتمام بمضمراته.
قد يكون للعجائبي المثير للحيرة - كشكل من أشكال الرواية الحديثة - نصيب وافر من الأداء الفني الذي يحيل إلى ما وراء النص في هذه الرواية؛ لأن " حصول هذه "الحيرة" أو "العجز" عن معرفة كيفية وقوع الفعل "العجيب" هو الذي يولّد، ويحدّد "العجائبي"، كما تقدمه لنا مختلف "الحكايات" أو "الأخبار" التي تزخر بها كتب العجائب العربية " (سعيد يقطين/ السرد العربي الحديث) لكن تأويل قصدية الكاتب لا يمكن أن يقف عند حد اعتبارها (الرواية) مجرد نص عجائبي مدهش لا هدف له، هنا يكمن الاختلاف الذي يجب التركيز عليه، فالعجائبي - غالبا - ينتهي عند حدّ المتعة المبتكرة، لكن هذا النص لا يوفر الدهشة إلا بمقدار ما تسهم في بناء المعرفة وإيقاظ الفكر وإعلاء الروح، وبالتالي فتوفر فعلي الإرادة والاختيار يلعب دورا مهما في عملية التأويل؛ التي ترتكز على ملامسة التأثيرات الفلسفية " ويولد ذلك في مستوى اللغة جدلا خفيا بين لغة الرواية التي تنحو غالبا نحو تجسيد اللغات الاجتماعية المعاصرة لكتابتها، ولغة الميتا – نص الفلسفية التي تكمن في الخلف حاملة موقفها من العالم، وباثة إياه عبر اللغة الروائية، لتولد بذلك تهجينا متخفيا وعصيا على الإدراك البسيط، غير أن هذه الظاهرة، تظل هي الأخرى، مرتبطة بالمستوى المعرفي للقارئ الفعلي، لأنها تتطلب لاكتشافها مقدرة كبرى تكمن في الاطلاع على مجمل التراث الفلسفي. وبطبيعة الحال، فإن ذلك متعذّر - وفي أحسن الأحوال نسبي..." (عبد اللطيف محفوظ/ صيغ التمظهر الروائي) إذا تعلق الأمر بالقارئ البسيط أو غير المتخصص، أما المتخصص في الفلسفة فهو في أغلب الأوقات بعيد عن النقد الأدبي.
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:320px;height:100px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="7675478845">
2- رحلات الروح وتكشّف المقصود: يبدو أن الكاتب لم يكن يستغل المراحل التاريخية والموروثات الأسطورية والملحمية وأبطالها فقط من أجل التعاليم الروحية التي يقصدون إليها، بل إن اختياراته الدقيقة إنما كانت للترميز والإحالة إلى ما يعانيه العصر من أزمات إنسانية جراء انغماسه في المادية الفجة وتغليب غرائزه على حكمته المرجوة " فالوعي بالذات... لا يحقق إشباعا إلا في وعي آخر بالذات أو في شبه الصورة المباشرة للمواجهة بين أفراد مختلفين وكأنها صورة مجازية تمثل الصراع الدائر بين الحياة والموت في قالب أنطولوجي، لأن محور الصراع هنا محور يتعلق بأعمق أعماق الوجود الإنساني وليس صراعا ماديا يمكن الوصول بشأنه إلى حلول تفاوضية وسطى " (عمر مهيبل/ من النسق إلى الذات) ولهذا كان انفتاح الزمن السردي على الماضي بمثابة استحضار دلالي مبطن بسؤال المعرفة وسائر نحوها. تقوم الحياة الإنسانية منذ بدء الخليقة على مطالب ثلاث ٍملحّة وصارمة، يتجاوزها حلم الخلود الذي لا يتوفر منهجيا إلا لدى فئة معينة من البشر "... لم أشعر بالخوف لأني عرفت من هو الآتي، ولأنني قد حسمت أمري أن أفشي أسرار زيوس، فإن حلم الخلود عصيّ على قبول حقيقتي، هأنذا أنتظره، فقد انتظرته عشرة أيام وهاهو يلبي ندائي، لحيته الزرقاء، وجسمه البلّوري، وصولجانه ذو الرؤوس الثلاثة، وتلك الأعين التي تبرق كأنها أمواج متلاطمة " (الرواية ص 47) غير أنهم يشتركون إضافة إليه في المطالب الثلاثة الأخرى والتي تتلخص في: الجنس/ المال/ السلطة " إن أصل الوجود هو الروح، وهي الجوهر الذي يحمله جسدنا، فإذا كانت الروح صافية قادت الجسد إلى بوابات المعرفة، أما إذا كانت منقادة لمطالب الجسد ضاعت في فوضى الوجود وضيعت الجسد معها " (الرواية ص17) وقد اختصر الكاتب بوابات المعرفة في عدد رمزي له دلالاته الأسطورية والدينية في الثقافة العالمية والعربية (الأسطورة السومرية)، لكنه استلهم بفضله رحيق الحكمة معتّقا وفتح به أبوابا على الروح ظلت مواربة منذ أزمان الحكمة السحيقة السالفة. ولذلك نلاحظ أن معمارية الرواية لا تسير وفق نسق تصاعدي وصولا إلى الذروة كما هو الحال في الرواية التقليدية، بل نجد كل باب يحتوي على ذروة مركزية تتبدى من خلال استخلاص معرفة معينة قد يكون لها اتصال ببقية المعارف وقد لا يكون، فـــــــــ " مفهومنا عن النوع ينبغي أن يتكئ على الجانب الشكلي... فنحن نفكر في الأنواع الأدبية، وليس في تصنيفات مادة الموضوع " (رينيه ويلك/ نظرية الأدب) وإن فعلنا هذا هنا فإننا لن ننتبه إلى تفاصيل الفكر الفلسفي الذي يجعل الوعي يتدفق - وفق سيرورة الأحداث - بطريقة مكثفة؛ مشيرا إلى أن بناء روحانية الإنسان لا يمكنها أن تخضع للركون أو الخمول، وإلا حكم عليها بالتلاشي والفشل، وهي الميزة التي وسمت الشخصيات التي اختارها الكاتب لتمرير فكرته، وتحريك الذهنية الجمعية التي سيطرت عليها مطالب الجسد فضيعت رؤى الروح " وتبعا لذلك يتقلص دور المروي له ليصبح موجها إلى المقاصد التي يرومها الكاتب، وذلك بطبيعة الحال بناء على طابع التشويق الذي يلجأ إليه هذا الأخير أبدا لإقحام القارئ باستمرار إلى أجواء القصة ولإدماجه في أحداثها وعوالمها" (سعيد يقطين/ قضايا الرواية العربية الجديدة) وهذا يقودنا إلى ملاحظة مهمة حول أفعال الشخصيات المتقمّصة من قبل البطل، فعلى الرغم مما يبدو ظاهريا حولها من حيث كونها شخصيات موجودة بالفعل أو بالأثر في مجرى التاريخ الإنساني (واقعا وفكرا)، إلا أن الكاتب ركز على دورها الفاعل في الحياة الإنسانية ولم يأت بها مفرغة من قوة الفعل التأثيري على مسار الحضارة والثقافة بأي شكل من الأشكال، إذ عمل على محاورة أسلوب الشخصية في تقديم القيمة التي تنطوي عليها بطريقة لا تميل إلى الإنشائية السردية الباهتة، بل تركز ببلاغة عقلية موجهة على مناطق الإيجاب ومواطن السلب في الأثر، ليعطي للماضي المتوارث من تلك الأفعال دفقا معرفيا يتوافق مع طبيعة العصر، ويؤدي إلى استلهام المعرفة كما يجب أن تكون "ساعده في ذلك ارتكازه على التاريخ والتراث الشعبي واستيعابه الحكاية الدينية، ودراسته القرآن الكريم والكتب المقدسة، فأعاد بعث الحكاية من جديد، وقلب الأساطير لكنه لم ينكر وجود الخالق ولم ينكر الكتب السماوية والرسل والملائكة [والشيطان حين جعله شخصا متكلما يتحاور مع بقية الشخوص ويدافع عن وجهة نظر معينة...]... وهذا بحد ذاته اختراق للمحظور الديني، فحقق في هذا الموضوع اختراقا قل مثيله بين نظرائه من الكتاب..." (علي محمد المومني/ الحداثة والتجريب...) كما لا يمكن القول إن الكاتب قد اعتمد السرد الملحمي أو الأسطوري وحاد عن الالتزام الاجتماعي والأخلاقي للرواية، إنما يمكن القول إنه قد التزم بروح فنية عالية لإعادة رسم التصميم المثالي للمأمول الاجتماعي والأخلاقي والسلوكي، موظفا الأسطورة والقصص الديني وتعاليم الفلسفة وروحانية التصوف، بعدّها روافد مهمة جدا في إعادة صنع تاريخ معاصر قادر على الاستمرار القيمي، على الرغم من طغيان المادة واكتساح الفوضى وانتشار العبثية الهادمة وتشييء الإنسان "اخترت هذه الدنيا كلّها، لا فرق عندي إن كانت نهايتي فناء أم بقاء، ولكن أعرف أني غير نادم، ربما اختارني الله لأكون عاصيا فلا يظهر الضدّ إلا الضدّ، ولا يظهر النور بدون ضياء، ولا تخرج المعصية إلا من كنف الطاعة، ولا تأتي الطاعة إلا من بعد المعصية...إذا أنا عاص، ولكن معصيتي تنطوي على طاعة، طاعة حريتي التي انتقيتها لأكون لوسيفر صانع الضياء " (الرواية ص 91) فقد راح الكاتب يجذب إلى متن الرواية "كل ما يمكن توظيفه من ألياف ورؤى وتقنيات وأشكال، من مشاغر الفنون المجاورة. وكانت الأسطورة من أبرز المصادر المحمولة، التي تمظهرت في الخطاب [السردي] الجديد... كونها دالا حكائيا... وتجربة معروفة تمثلت في الاتكاء على المضامين والثيمات واستعارة مواقف الآلهة والأبطال الأسطوريين " (فائق مصطفى أحمد/ سحر السرد) مما يبين أن ممارسته لنمط رواية ما بعد- الحداثة من خلال الوعي يفنية التخييل التي يرتكز عليها كان حاضرا وضروريا ومعترفا به. ويبدو أن المعنى العميق لهذا النص إنما يتأتى من لحظة البداية التي يعنونها الكاتب بما قبل البداية، على أساس أن نهاية الرواية ستكشف الحدث الأول من جديد في آخر الأبواب، لا ليكون نهاية، بل ليستدير على نفسه مكونا بداية جديدة لم تكن هي البداية الأولى بدقة. ويتأتى العمق الفكري في هذه الرواية من خلال استبدال الحياة بالموت في رحلة البحث عن الحكمة والمعرفة، والإعلاء من شأن الروح وتسفيه حاجات الجسد الفاني، هنا لا يمكن الاقتناع بإمكانية التقبل المطلق للمفترض التشخيصي إلا في حالتين استعان بهما الكاتب تباعا، أولاهما: بأن جعل الموت استشهادا، وثانيهما: بأن جعل الشهادة دفاعا عن القدس؛ وهي القضية التي لا يمكن لها أن تموت في الواقع العربي والإسلامي لاعتبارات متعددة " وبصرف النظر عن المؤلف الضمني والقارئ الضمني، من حيث هما بنيتان نصيتان، ثمة مؤلف حقيقي يضطلع بكتابة الرواية التي لن يتحقق حضورها إلا بالقارئ الحقيقي، أي أن يناءها الفني وتلقيها الجمالي مرتهنان بشخصين حقيقيين يوجدان أو وجدا في الزمان والمكان الفعليين. وهكذا، فالشخصية التخييلية نتاج غير مفارق للواقع بكل تناقضاته ومفارقاته. إن الرواية تعبير عن الإنسان. ولكن من هو الإنسان؟ تلك هي المسألة " (فانسن جوف/ أثر الشخصية في الرواية) التي لا تجيب عنها هذه الرواية مباشرة ولكنها تنسج خيوطها بحكمة بالغة ودقة شديدة، الإنسان الذي يريد الكاتب أن يجعله مثالا لمفهوم الإنسانية في حد ذاتها؛ والتي كانت المسعى الأول لبني آدم منذ استيطانهم الأرض عقابا أو ابتلاء أو غنيمة - لا فرق – من خلال الجهر بالسؤال الأزلي الذي يفصل بين العبثية الصرفة والإيمان المطلق؛ هل الإنسان مجرد جسد ينتهي بانتهاء دفق الحياة فيه بمفهومها العلمي المادي؟ أم هو روح بإمكانها أن تحيا حياة جديدة بعد تحررها من سجن الجسد؟ يتفاقم انهيار صرح المعرفة الإنسانية كلما ازدادت حدة الصدع والتشظي في علاقة الإنسان بنفسه، فالكاتب واضح وضوحا تاما إزاء علاقة الإنسان بخالقه، ولهذا فهو لا يقدم الأنبياء بطرق متنافرة بل بشكل متلاحم مع طبيعة المعتقدات المتوارثة من جهة، ومع طبيعة الإيمان بما هو منزل من جهة ثانية " – عبودية الروح لخالقها أرفع صفات العبد والخضوع للفناء في الهوى الروحي أزكى أنواع الحب " (الرواية ص92). كما أن إمعان النظر يجعل القارئ يلاحظ أن قصة حكيم الهند "شيري أتمنندا" وديانته الهندوسية، تفضي إلى إدراج التنبؤ بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في الإنجيل دون تعارض بينهما؛ لأن الهندوسية كما يرى كثير من الباحثين هي مزيج من اليهودية والمسيحية والفلسفة الهندية. ويستمر تأثير الثقافة الدينية تباعا بعدّها مرتكزا فكريا لا يمكن التخلي عنه في رحلة البناء الحضاري للإنسان " هأنا وحدي الآن، أجوس القفار والأماكن، المسكونة منها والخاوية التي لا يوجد فيها صافر نار، أشتمّ رائحة المعصية تفوح من كل الأرجاء، لا تحتاج الأرض إلى طوفان واحد، تحتاج في كل مطلع شمس إلى طوفان ليطهّرها من رجسها..." (الرواية ص 88) فالكاتب هنا لا يقيد القارئ بنسق ثقافي خاص بل يفتح بوابات الفكر مشرعة على الروح، حيث تتآلف سمات الإنسانية وتتواطد قيمها الفطرية الحقة. 3- تغييب السعي الروحي عن المرأة في الرواية: يبدو حضور المرأة في هذه الرواية حضورا محتشما، ذلك أن الشخصيات النسوية كانت حوالي الأربعة فقط إذا احتسبنا ذكر أمنا حواء العارض " فهمت هذه المعادلة، فرحت أغذّي تلك النار ما استطعت، فذات ذكرى حين أخرجتهم من نعيم الفردوس، كانوا عراة لا ينظرون إلى أنفسهم بنظرة الجسد أو سلطة تلك النار، أما حين استطعت إشعال نارهم نظر آدم إلى حواء للمرة الأولى نظرة شهوة أثارت حواء بشوق كبير " (الرواية ص90) تعددت الأصوات الروائية الناقلة للفكرة المرجوة داخل هذه الرواية، ولقد حاول الكاتب بإتقان شديد أن يجعل لكل شخصية صوتها الخاص، للتعبير عن الطريق التي سارت فيه، فاصلة بين متطلبات الجسد وطامحة إلى الارتقاء الروحي، إنه ببساطة يريد أن يقول إن درجات الوعي الروحي فعل إنساني محض لا يختلف فيه نبي مرسل عن أي بشر عادي أو فنان موهوب، جميعهم يحملون رسالة الروح النقية الصافية ويسعون إلى النتيجة المثالية نفسها " كانت تعاندني أرواح أولئك المؤمنين... لماذا يرفضون عطائي ويتمسكون بجوهر نقيّ لا يمكن أن تلوثّه عروضي ودنياي؟" (الرواية ص91) غير أن الكاتب لا يجعل للمرأة في الرواية صوتا معرفيا أو روحيا فهل كان هذا إلماحا إلى قصور فكري تتهم به المرأة عبر العصور الإنسانية المختلفة، أم هو تغييب لامقصود ؟ وهل من الممكن أن تكون الحكمة معطى ذكوريا لا حظّ للمرأة فيه إلا بعدّها تابعا؛ إذ يرى الهندوس مثلا أن المرأة لا يحق لها دراسة الكتب المقدسة أو الفلسفة لأن ذلك يقودها إلى الجنون ويعلمها التمرد؟ " وكان لا بد أن أوقع بها هي الأخرى، فهي في النهاية أنثى..." (الرواية ص 59) غير أن التمعنّ في تفاصيل الذات الفاعلة داخل أبواب الحكمة منح الكاتب فرصة لتعديل تلك الصورة، من خلال التركيز على استثناءات أنثوية ملهمة للمعرفة ومتشبعة بمعطيات الروح المثالية الراقية، فاختلاف الإشارات الفكرية إلى المرأة في الرواية جعل القارئ غير واثق من إمكانية تحديد رأي الكاتب المباشر إليها. في الباب الأول تبدو المرأة في شخصية الفتاة الفقيرة التي ترفض غواية الرجال، - ولعل آثار الديانة الهندوسية في هذا بادية انطلاقا من اعتقادهم أن المرأة فطرت على الغواية وإفساد الرجال حتى العلماء منهم، ولذلك فهم يحذّرون من التعامل معها - لكنها تتحول إلى غاوية تفقد الأعمى حياته كمدا حين يستسلم لسحر أنوثتها دون تربص مسبق أو تدبير؛ "- إني رأيت فيك الرجل الذي شعرت معه بأنوثتي، فتعال وانهل من هذه الأنوثة.
- ولكني لم أحاول أن أتحدث إليك فيما سبق... فلماذا أنا؟
- لأنك الوحيد الذي لم يحاول استغلال هذا الجسد، والوحيد الذي كان يعاملني باحترام رغم أني فقيرة، فقد كنت ترمي علي السلام إذا شعرت بوجودي، وكنت أدرك أنك ترى روحي لا صدري الكبير أو خصري الناحل أو أردافي المثيرة
- أنا لا أرى... ... اقتربت لتضع شفتيها على شفتي فشعرت أن رغبتي في ضمها طفقت تزداد سعيرا، سمعتها تطلق صوت تنهيدة من أعماقها، وبكن خرجت من فمها لا من صدرها كما كنت أسمع الناس، شعرت برغبة جارفة تتسلل من جسدها إلى جسدي، وهنا كانت الصدمة... عندما شعرت بجسدها الساخن لم أعد أرى ذلك البريق السرابي، أدركت أني أعمى لا أرى الطريق والعصا... حتى الفتاة لم أعد أراها... طيلة عمري كنت أتحرك ولا أخاف السقوط، فقط الآن سقطت على الأرض..." (الرواية ص 33-34-35) إن السقوط هنا يتشابه مع انسكاب ماء الحياة والمعرفة من سلة الناسك في الحكاية نفسها، ولا يمكن أن يكون وجود المرأة هو السبب الوحيد الذي جعل الحكمة تنفلت من روح الرجل، إذ نجد الكاتب يصرّ على أنّ اختبار مسالك الحياة شيء منوط بقدرة الإنسان وحده بصرف النظر عن محفزّات الانحراف. على هذا يبدو الكاتب واصفا للمرأة من خارجها وإن لم نعدم إشارات سريعة وعابره إلى ما يمكن أن يحمله داخلها من ميزات سامية تشترك فيها مع الرجل كونهما صورتين لمسمى واحد هو الإنسان " والحديث عن المرأة عبر الأدب، لم ينقطع بانقطاع العصور وانقضائها، إذ هو حديث ممتدّ، مادام ثمرة لتجربة بين الإنسان والإنسان، هي تجربة خاصة، تشكل في مضمونها أس الحياة وبناءها، فتغنى بها الإنسان مناجيا إنسانه الآخر، مناجاة تكشف عن تسامي البشرية وسموقها، وتؤطر لمعانيها الرحبة بشفافية وتلقائية وتفان، تحلق معها الأرواح قبل الأجساد، ومن ثم تأتلف معا مرة أخرى أجسادا وأرواحا، في إيماءات وإيحاءات تفتقد الفعل الظاهري، والإشارة الصريحة إلى ما دونها، التي ما إن تهبط إلى مدارج المباشرة والظهور حتى تضحى غثاء لا خير فيه " (عبد العاطي كيوان/ أدب الجسد) على هذا لا يخرج الكاتب هنا في أحد شقي توظيفه للمرأة عن مقولة: إنه " ليس من الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي، إلا نفار النفس وأنسها، فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات، ونفرت نفسه من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي، ونفرت من الفضائل والطاعات، وطالب الشر متشبه بالشيطان، وطالب اللذات متشبه بالبهائم " (ابن حزم الأندلسي/ الأخلاق والسير) ولهذا فإن معرفة الشيطان لم تتأتَّ في الرواية إلا بتقديم مشهد الابتذال الجنسي الذي تلعب فيه المرأة الغاوية دورا أساسا، هنا علينا أن ندرك أولا أن الرواية لا يمكنها أن تؤتي أكلها بمعزل عن الدين والأخلاق والقيم الفاضلة التي يؤمن بها كل مجتمع من المجتمعات البشرية. كما نلاحظ في الباب الثاني أن الكاتب يقدم صورة عذبة عن المرأة العجوز بأن يجعلها سندا لطلاب الحكمة كلّ حين " امرأة عجوز تثاقلت فوق متونها السنون، تهدّج صوتها بدفء جميل... تقدمت منها مخاطبا:
- هل أجد عندك مكانا لأستريح فيه هذه الليلة؟
- طبعا على الرحب دائما فأنا أنتظر طلاب الحكمة لأن يمروا من هنا كل فترة... نظرت إليها فإذا هي عجوز عمياء " (الرواية ص43) ويبدو أنه يوظف ثيمة العمى للإصرار على أن الحكمة تنتصر إلى المحسوس لا إلى الملموس، غير متحيز في هذا لجنس بعينه، وهو هنا يواصل مع العجوز التي تنقلب إلى امرأة عادية وديعة تشبه الحكيم وتعمل على نقل البطل من صورة الخلود المتوهم في شخص (سيزيف) إلى صورة الخلود الفعلي في شخص (المسيح) عليه السلام، مما يحتم على القارئ استحضار صورة (مريم البتول) بكل قدسيتها وطهارتها. توظيف المرأة في هذه الرواية إذا؛ هو إلحاح على الترابط الوثيق بين متطلبات الجسد والروح، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز غرائزه بوحي من ممتلكاته المعرفية التي لا يمكن أن تقوده إلا إلى السّمو ، وهو ما تشير إليه الشاعرة (آمنة المريني) بقولها: " تلك هي حقيقة التكريم الإلهي للإنسان دون اعتبار جنسه أو لونه، وما يستتبعه من خطاب عام شامل للإنسان، ومن تكليف ومن ثواب وعقاب، يستوي في ذلك الرجل والمرأة " وقد استغل الكاتب وجود المرأة التاريخي الفعلي ليصنع منه محطات لاستجلاء القيمة المتعلقة بها؛ بعدّها كائنا مقابلا للرجل وبالتالي تنطبق عليها قوانين الكون كما تنطبق عليه، كمحبة زوجة (شري أتمنندا) لزوجها التي ألح الكاتب على عرضها في عدة مواقف وفي عدة قصص، منها ما ألمح إليه في قصة (سيزيف) " أريد منك أن تنفذي أوامري وبدقة، لقد كنت رفيقة دربي طيلة هذا العمر، وأريدك أن تساعديني لأتجاوز محنتي هذه، فأنا في طريقي إلى الخلود " (الرواية ص 50) والأسبق منها قصة سيدنا نوح عليه السلام وصبر زوجته على الأذى الذي كان الشيطان يحدقه بهما، وفي هذا انعتاق تتجسد من خلاله سمات العلاقة الزوجية المثالية " هزّ رأسه كعادته بالرضا والقبول، وهذا ما كان يثير حنقي ولا أعتقد أن غضبي وحنقي قد وصلا إلى هذا الحدّ سابقا، رحت أبثّ الأفكار في رأس زوجته رحمة لتتركه كما تركه أقرباؤه وأتباعه، ولكن إيمانها به منعني هذا، وكانت تكشف ألاعيبي بقولها:
- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم..." (الرواية ص98) ونجد آثارا من ذلك الوفاء الأنثوي المقدس برباط الزوجية في الأعراف الهندية التي كانت تصل إلى حدّ دفن الزوجة حيّة مع زوجها، وقد أسهمت هذه التداخلات القيمية في التحام فكرة النص وتوجيهها نحو قيمة إنسانية واحدة، تتفق حولها الأعراف البشرية الأرضية مع التوجيهات الإلهية السماوية التي لم تفرق في طبيعة أحكامها بين رجل وامرأة. 4- مرتكزات العتبات: إن دراسة العتبات النصية في هذه الرواية لن يقف عند عرض النص الموازي المتمثل في العنوان، بل سيعرّج على النصوص المتصدرة أجزاء الحكاية (مقدمات/ عناوين فرعية) مما يساعد على ولوج الأبواب الواحد تلو الآخر، في محاولة لكشف السمات الأسلوبية التي يمكن أن يكون النص العتبة يحملها كرسالة مشفرة، وكيفية تعويل الكاتب عليها وعدّها متكأ لإيجاز ما يسهب في عرضه من رؤى متن الحكاية لاحقا. على هذا يمكننا أن نعدّ العتبات وسائط هامة في بناء أسلوب الرواية بالشكل الذي يجعل تحوير التاريخ أمرا ممكنا ومستساغا، إذ إن الأهم هنا " ليس هو الأخذ بفكرة المطابقة بين الذات والإبداع بطريقة آلية وبسيطة، بل هو مراعاة الوسيط بين الذات وما تريد التعبير عنه، أي الكيفية التي يتم بها للمبدع تحقيق طابع وجوده الخاص ضمن نوع أدبي، له وجود عام سابق على وجود المبدع نفسه " (حميد الحمداني/ أسلوبية الرواية) وهذا ما يجعل العتبات التي تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة عن جنس الرواية والتي منها الحكمة، أو الأقوال المأثورة، أو الفلسفة والخطاب الصوفي (مجازا) تمثل صيغة بيانية معنوية خاصة، تعمل على تكثيف المعنى المراد التعبير عنه داخل حكاية قد لا تكشف كل آفاق الرؤية المشار إليها إلا بالاستعانة بمحمولات العتبة. *- مقدمات الأبواب: يصدر الكاتب للباب الأول بمقولة للحكيم الهندي (شري أتمنندا): "شموس الحقيقة لا تراها كل عين"، ويعمد إلى تقريب العلاقة الموضوعية بين حديثه عن درب المعرفة في هذه الرواية وبين مسيرة الحكيم الهندي "شري أتمنندا" بشكل يجعل المسافة بين الواقع والتخييل تتقلص بشكل لافت للانتباه، وعلى الرغم من أنه يستعير شخصية الأعمى ويتقمص أداءه الفكري في القصة التي تكون مفتاح الباب الأول، إلا أن هذا المفتتح يمكن أن يكون ملخصا لطبيعة المعرفة التي ارتكز عليها هذه العمل الروائي، مع فارق بسيط يتمثل في عدد الأبواب التي كان على المريد الهندي ولوجها للتمكن من أخذ الحكمة؛ وهي ثلاث، بينما استغل الكاتب محطات ورؤى من حياة (أتمنندا) الفكرية الخاصة، ليجعل منها أبوابا إضافية تتعلق بالديانات السماوية أو بالتأله البشري الأسطوري أو حتى بعلاقته بزوجته، التي صارت مثالا لدى مريديه؛ وهي جميعا محطات لا تخلو من مناهج الإدراك المعرفي. " ومن قال لك إني أعمى؟ هل تعتقد أن فقدان البصر هو عمى؟ " (الرواية ص 27) فهذه العبارة مثلا هي الوجه الآخر لتلك الشموس التي يقصدها الحكيم في الرواية. في الباب الثاني يستعير الكاتب عتبة لحكيم صيني هو (كونفوشيوس) القائل: "التعلم دون تفكير جهد ضائع، والتفكير دون تعلم أمر خطير" (الرواية ص 39) وهي فلسفة قام عليها مذهب هذا الفيلسوف، الذي يصر على الأخلاق لبناء مجتمع صحيح ويصر أيضا على أن الأخلاق فعل قابل للتعلم، كما يعتقد أن حكم الناس بالتهديد والعقاب لن يورث الشرف بعكس القيادة القائمة على الاحترام والفضيلة، ويعزّز الكاتب العلاقة بين موضوع العتبة وبين توظيفه لشخصية (سيزيف) الأسطورية التي تتآلف مع ما يرمي إليه من حكمة ضمن هذا الباب " صورة رجل يدحرج صخرة كبيرة جدا من أسفل السفح، وبدا أن جسده الأسطوريّ قدّ من الصخر أيضا...
- إنه سيزيف...
- سيزيف؟
- نعم يا له من مسكين ! عندما قاده طموحه أن يكون إلها عوقب، ولكنه لم يتراجع عن موقفه رغم غضب الآلهة، يعلم المرء حين يجرّب تجربة شخصية، ويتعلم حين يعلّم الآخرين من تجربته..." (الرواية ص44) بدا الحديث هنا وكأنه موجّه إلى البطل وإلى القارئ معا "... اجلس هنا بقربي واقرأ قصته، علّك تعرف بعض الإجابات التي لا تنفكّ تلحّ عليك... وعندما تنتهي من رحلتك معه ستدرك حقيقة الطموح وأشراطه " (الرواية ص45) ويبدو أن الكاتب في هذا الباب يحاول أن يلج الجانب العملي للمعرفة بعدما أوقع القارئ في الحيرة والسؤال، وتوهّم اللامعقول واللامتحمّل وهو يترك الأعمى ميتا بسبب شهوة غريزية طبيعية في الباب الأول، ليتحول إلى الحديث عن شهوة مختلفة تنتهي إلى فشل ذريع بسبب التفكير المتهور الذي لا يخضع لسلطة المعرفة "... وهذا الذكاء يرقيني لأن أكون إلها... نعم إلها كأنظاري من الآلهة... قد يكون طموحي كبيرا ولكن إذا لم تكن الطموحات كبيرة فلن نستطيع تحقيقها... ولم تحدث، فقد باءت محاولاتي بالفشل، ولكن صراع البقاء يتحكم في مصيري، لقد حاولت أن أحصل على شيء ليس لي أو انه لم يكن لي يوما، وبذلك أكون قد أخللت بنظام الحياة والوجود، فلو أني قبلت بوضعي ومكاني في الحياة لكانت انقلبت حياتي على نحو أفضل، دائما يتعلم الشخص عندما يغرق في الخطأ " (الرواية ص 46-56-57) وعلى هذا تكون خلاصة المآل الذي بلغه (سيزيف) نتيجة للعتبة التي أسلفنا الحديث عنها بعدّها نصا موازيا (para texte) للقصة الضمنية المقصودة. وعلى الرغم من أن الكاتب يكشف بين الحين والآخر ما يرمي إليه من القصة، إلا أن استدراج النص إلى مخزون العتبة يلعب دورا مهما في استكشاف المعالم المرجعية التي تساعد القارئ على التوغل في أدغال النص وبالتالي القدرة على تأويله. وفي الباب الثالث ينتقل الكاتب إلى الكتب المقدسة كي يستلهم منها مكنونات المعرفة، فيصدّر للقصة المتضمنة في هذا الباب بالقول: "أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح، متّى 5: 13" (الرواية ص65) وفي تفسير الإصحاح الخامس من إنجيل (متّى) نجد أنه يشتمل على العظة التي تمثل دستور الحياة المسيحية، وهي التي ألقاها المسيح كي تلتزم بها أمته، وهو بهذا يدعو المؤمنين للذوبان في المجتمع، كما ينص التفسير على أن المسيح حمل خطايا البشر وهو ما نجده مبثوثا بين ثنايا القصة التي تختصر المعرفة الواردة في الباب الثالث " – لقد كان المسيح يعرف أنه سيحمل خطايا البشر، ويعرف أنه سيذوق العذاب، فقد دخل الهيكل وبدأ يبعثر بسطات المبيع ويقول:
- هذا المكان للرب وليس للتجارة، سأهدم هذا الهيكل وسأبنيه في ثلاثة أيام... رد عليه أحد اليهود متهكّما:
- لقد أمضينا في بناء هذا الهيكل ستّا وأربعين سنة فكيف ستبنيه أنت في ثلاثة أيام؟ كان يعني ما يقول، فإن الهيكل هو جسده الماديّ الذي نزل روح القدس فيه، وهو الجسد الذي رأته أعين البشر لتصدق أن الرّب موجود بوجود هذه الروح القدس، ورغم هذا حاولوا هدم الهيكل، ولكنه بناه بعد ثلاثة أيام... نعم بناه فعلا..." (الرواية ص70)ورويدا رويدا يعود الكاتب برحلة الروح إلى مجاهل الزمن حيث أنبياء الله ينشرون رسالات المحبة والسلام عهدا بعد عهد " عندما كان أخي الحبيب يحي بن زكريا يعمّد الناس في نهر الأردن تمهيدا لقدومي..." (الرواية ص 73) وعلى مدار هذه القصة التي لا يخفى أثرها على التاريخ البشري، ينسج الكاتب خيوطا للمعرفة مبدؤها الإنسان الصالح الذي يمثل ملح الحياة المستقيمة مختصرة في شخص المسيح، وملم?

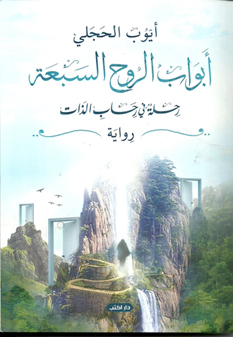


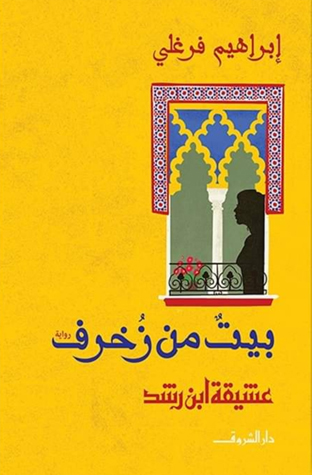


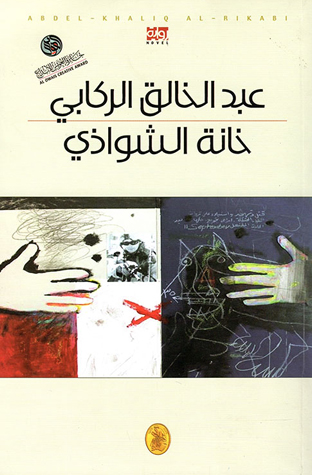

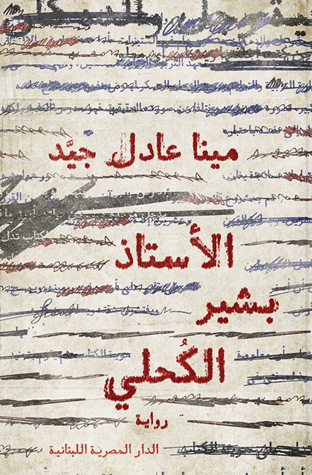

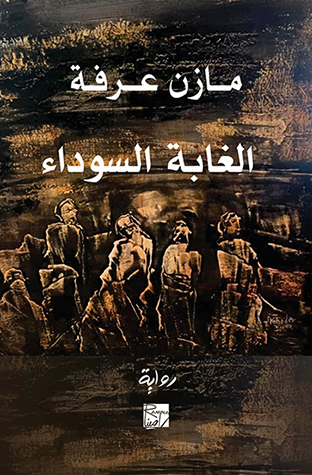


0 تعليقات