ثورة الذات في رواية "الجنين الميت" لـ: ناصر سالم الجاسم
تمهيد: تحمل الكتابة الروائية العربية أصنافا شتّى من التّمثيلات الفنية للهوية الفردية أو الجماعية خارج نطاق الحيز العربي أو الإسلامي، لاعتبارات قيمية وممارسات تقليدية تنزاح بالقومية والدّين عن الأممية والانتماء المطلق. وتحمل الرواية السعودية امتيازات جمالية وخصائص فنية مختلفة اختلافات واضحة عن الرواية العربية، نظرا للخصوصية التي يمتاز بها المجتمع السعودي عن غيره من المجتمعات العربية الإسلامية، هذه الامتيازات نفسها تركت عملية تشكل الرواية السعودية تنفلت من حدود السائد لتندرج وفق متطلبات البيئة الإنسانية متجاوزة الوجود الواقعي حينا ومنضوية تحت سلطته حينا آخر.
1- سلطة الرقيب وأزمة الفحولة:
في رواية "الجنين الميّت" يظهر سؤال الوعي الثقافي الجمعي مرتبطا بأسئلة الهوية الدينية في المجتمع السعودي، وطبيعة الممارسات التي يعتبرها الإنسان من جوهر الدّين بينما يدرك أنها من صميم العادة، خاصة بعدما تحولت بفعل الزمن إلى رقيب يزداد عتيًّا وبطشا ليتحول إلى سلطة لا تتماشى مع طبيعة التطور الذي تشهده الحياة.
يحتدم صراع الثقافة المستحدثة والهوية المأزومة من داخل الرواية ومن خارجها، فالكاتب يحاول أن يتجاوز رقابة المرجع داخل الحكاية ليتمكن من تفادي رقابة المتلقي من خارجها. هذا التشكيل كما يرى عبد المنعم تليمة هو (سبيل الفنان إلى إعادة (ترتيب الأوضاع) في عالمه النفسي، وإلى إعادة بناء العلاقات في عالمه الواقعي للوصول إلى عالم نفسي وروحي واجتماعي أكثر كمالا وتناغما وانسجاما) وهذه الصناعة الفنية المتأزمة، تجعل الكائن والممكن يتلاحمان معا للإعلان عن حالة الأزمة بالفعل وتحويلها إلى مضمر نصي يتجاوز نفسه ليتحول إلى أثر.
إن الحكم الأول الذي يصدره الكاتب في حق استبدال الكائن (الجنين) عبر الرؤية السردية إلى ممكن بالفعل الكتابي أو بالقوة التنبؤية، وهو (الموت) يجعل طبيعة العلاقة بين النص والكاتب وبينه وبين القارئ، تتحول إلى معضلة فنية عصيّة موغلة في الشك ومتوغلة في السؤال.
هذا المآل الحتمي لأحلام التجاوز والتغيير يجعل الحكاية تتحدّى فعل الموت من داخلها لتصنع لنفسها حياة جديدة خارج النص من خلال تحويل السؤال المتضمن طيلة العملية السردية إلى افتراض يتعدى حدود الشخصيات القائمة على رعايته وترسيخه داخل الرواية ( عمر السالم/ دانة الحسن) بأن يستلهم منها فرصة للنجاة من الحلقة الإنسانية المفرغة التي وضعها الكاتب فيها وحكم عليها بأن تظل أسيرتها وحدها، وذلك بأن جعلهما شخصيتين منتهيتين داخل الحكاية لا يتعديان بوجودهما إلى خارجها ولا يمكنهما أن يكونا شخصين آخرين لأنهما لم يواصلا دورة الحياة بالزواج والإنجاب، هذه النهاية لا تقف عند مجرد الرومنسية والوفاء الأفلاطوني لشخصين أحبا بعضهما وافترقا دون زواج، إنما هي رمز لما يريد الكاتب أن يقوله من خلال اجتثاث فعل الاستمرار على المستوى الجسدي الفيزيولوجي والإحالة على الممكن البديل، بالإشارة إلى الاستمرار الفكري المتمثل في تحويل الشخصية إلى مجال الدراسة والعلم ( عمر السالم ينتهي.. موظفا صغيرا في التربية والتعليم... بلغ الثلاثين سنة من عمره ولم يتزوج.. الأيام تأكل من وجهه ومن قلبه.. والزمن يعذبه ويطفئ روحه المرحة ودانة الحسن تكمل دراستها الجامعية على مضض دون زواج ودون أطفال ولا يعرف شيء عنها أكثر من ذلك ) الرواية ص 82. مع تضمين للجانب الروحي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التحول الحضاري المنشود، بل إن الكاتب يجعله المسعف الوحيد للتأزم النهائي الذي يصل إليه البطل في علاقته بالمرأة وهو الحل الوحيد المقنع للمتلقي العربي تجاوزا للطروحات الدخيلة التي لا يمكن الركون إلى شرعيتها ببساطة واقتناع ( أخيرا بقيت لي في هذه الحياة أمنية واحدة.. أتمنى أن أحققها معك قبل أن أموت.. أتمنى يا حبيبي أن أحج معك في قافلة واحدة ) الرواية ص 81.
وهو هنا يشير إلى تغليب المقدس الفعلي موازيا إياه بالمقدس العرفي الذي يعتبره سبب الانهزام الفكري والفشل الثقافي والإنساني معا (وهذا لا يشير -بالضرورة- إلى أن العالم المقدم أو المشكل من خلال النص الروائي، عالم بديل أو مواز للعالم الواقعي الملموس، وإنما هناك حالة من الفعل والانفعال، لا يمكن وصفها أو تحديدها بسهولة، فهي لا تعكس الواقع بشكل مباشر، وإنما تشكل رؤية جدلية تتكون من الفني والمرجعي...) حسب رأي عادل ضرغام؛ حيث تمثّل الفني في تداخل للعناصر المؤدية إلى الانهيار الكلي المعهود في المجتمعات التقليدية، في حين كان الاتكاء على المرجعي (الدّين) وسيلة لغسل أدران الروح والتشبث بالأمل في الاستمرار اللامشروط.
على هذا يثبت الكاتب فحولة فنية اخترقت الهامش الأفقي للفعل المنجز داخل العملية السردية، لتجعله فعلا يتعدى حدود اللغة الوصفية الكاشفة ليستكمل منجزه الفعلي المقصود داخل الوعي القرائي دون أن يثير قواعد الرقابة أو يكسر قوانينها ( فوعي البطل –وهو يهيمن على مجموع عالم الأشياء في الرواية- لا يمكنه إلا أن يجاور وعيا آخر، كما أن حقل رؤيته لا يمكن أن يوضع إلا بجانب حقل آخر للرؤية، أو أيديولوجيته إلا بجانب أيديولوجية أخرى ) كما يرى حميد لحميداني، بل إنه يسخّر قوانينها ليمرّر رفضه ويعلن ثورته من داخل النص بجعلها نسقا مهيمنا وضروريا، ومن خارج النص باستبدال السؤال بالتشكيك.
1- المرأة وإشكالية الصراع: (التبعية /الامتلاك/الانتقاص)
لا يقدم الكاتب في هذه الرواية قصة حب عادية بين رجل وامرأة في بيئة محافظة يسودها الخوف من الآخر وتكبّلها ذكريات الدم المسفوح على أضرحة العشق، بل يقدم موقفا ثوريا يخلخل بنية السائد ويثير حفيظة المألوف. إن الإشكال الذي يعانيه الكاتب في تقديم "جنين ميت" إلى العالم ليس إشكالا متعلقا بالمرأة أو بالدّين كما يبدو من الوهلة الأولى للقراءة، بل هو إشكال يتمدّد عموديا في عمق الوجود القيمي للبناء الاجتماعي المتوارث ( الطين الأخضر.. الكائن الممسوخ.. هو الحائل هو الذي أشخب دماء الحبيبين وعطل ساعة اللقاء.. هو الذي خرب روحي هو الذي جعلني أعدو في دم وأزلق ولا أصل إليها.. أعدو في دم لا أستطيع النهوض منه.. في المقبرة كنت أشم رائحة دم الحبيبين في أنفي وهما مكفنان وهما مدفونان تحت الثرى.. كانت رائحة دم الحبيبين واقفة عند منخريّ أطردها ولا تذهب.. ورائحة النبق تحاول طردها معي وتفشل.. لقد كانت رائحة دم الحبيبين رائحة النهار كله والليل كله ) الرواية ص 29. لهذا فإن طبيعة الأنساق الثقافية والفكرية التي يرتكن إليها هذا النص تتداخل مقوماتها الحاضرة سلبا بمقومات غائبة تحمل دلالات السلب والإيجاب معا، مما يجعل القارئ يقف عاجزا عن السؤال؛ لأن الكاتب يعمل تباعا على تحريف الدلالة المرجعية للديني والعرفي والقيمي تمريرا للنسق البديل دون المساس بما هو كائن ومهيمن وخطير. إن الوصول بالمرأة إلى حالة الفراغ الجسدي والفقد العذري في هذه الرواية لا يتعلق بكونها امرأة بقدر ما يتعلق بالرجل (الفحل) في مجتمع لا يؤمن بغير الذكور، ويحرّف الكاتب فكرة الضعف الذي يعانيه البطل ليجعلها لصيقة بالأنثى بينما يسرّب على هامش الموقف المخزي لها موقف الفشل الجنسي لرجل تتربص بأفكاره ثقافة الفحول خارج نطاقها الإنساني ( في هذه اللحظة المشحونة بالجمال يستيقظ الشيطان يوسف.. يخرج من قبره بعد رقدته الطويلة.. يخرج بنصف جسده العلوي بلا قدمين.. فقدماه قطعتا قبل موته بسبب مرض السكر. يخرج ويدلق سمه في نفسي مثل ثعبان.. يبصق على الأرض ويصيح في وجهي: أنت عنين.. أنت عبد مخصي.. أنت بغل.. أنت امرأة ذات جرس ربطته في مفصل قدمها وبعدما خفت رنينه الملح جلست في خيمة البغاء تنتظر.. أنت امرأة تقبل امرأة.. أنتما الآن فتاتان تتساحقان.. فتاتان تحتاجان إلى ذكر.. أثبت لي أنك رجل.. أنك فحل !!) الرواية ص 69. غير أن المنحى الذي رسمه الكاتب للشخصية في هذه الرواية جعله لا يتحمل عبء الاستمرار بها إلى آفاق المواجهة والتحريض على الثورة المخبوءة داخل كل رجل منهزم أمام سطوة التقاليد والأعراف، ولهذا يفشل البطل في إثبات فحولته أمام امرأة يحبها نظرا لتعالي أصوات الكينونة الممسوخة التي يتناسل منها ممثلة في شخصية (يوسف) المبهمة التي تحيل إلى كائن مشوه جسدا وذكرى، هذا التشوه الذي كان البطل يصوره في أشكال من القسوة والكراهة والابتذال لم يبد أنه لصيق بالشخصية المبهمة التي لم يعرّفها إلا على شكل ومضات تصويرية واصفة، بقدر ما يبدو لصيقا بتكوين اجتماعي يسعى الكاتب إلى تعرية وجهه المنبوذ ليواجه به فلسفته الخاصة، ويحرك من خلاله فلسفة المتلقي دون أن يترك أثرا مباشرا لما قال أو لما ينوي قوله بعد الانتهاء من فعل الكتابة. على هذا ينتهي البطل فاشلا في كل شيء، حتى أن العملية الجراحية التي أجراها تتحول بدورها إلى مزيج من الشك تجاه الجراح من جهة، وإلى مزيد من القذارة التي لا يتخلص من بعضها إلا بشرب كميات كبيرة من ماء زمزم من جهة أخرى، ويرى باختين أن ( الإنسان المتكلم في الرواية هو دائما صاحب أيديولوجيا بقدر أو بآخر، وكلمته –هي دائما- قول أيديولوجي، واللغة الخاصة في الرواية هي دائما وجهة نظر إلى العالم تستدعي قيمة اجتماعية. والكلمة –قولا أيديولوجيا- هي التي تصبح موضوع تصوير في الرواية ) منبها إلى عمق الانعتاق الروحي الذي يسعى إليه البطل ليس على سبيل الزهد الفعلي والندم، بقدر ما هو ركون إلى فشل ذكوري تجاه المرأة ومنها تجاه القبيلة (المجتمع) الذي ينتمي إليه مكبلا بضعفه مادام غير قادر على تغييره أو تغيير مواقفه تجاه الحياة بسببه.
2- اختباء الذات خلف وهم الفحولة:(العجز/ الشك/ العناد)
تتراوح المدركات الحسية التي يقدمها الكاتب على لسان البطل بين الغريبة والمغيبة، غير أن الألفة مع الأحداث تنكسر تباعا بفعل المواجهة الحادة بين الرؤية السردية والحدث الروائي والاصطدام المتكرر بالمواقف والأحداث ( أما أنا فقد غادرت المستشفى وعبارات تحد صريح تكاد تخرج من فمي: سأتزوجها يا يوسف يا إناء الكلب.. سأتزوجها أيها الشماليون القساة حتى لو كسرتم زجاجا على رأسي.. حتى لو دققتم مسامير فيه وفي جسدي كله.. أنتم وحوش كاسرة تتعلم القتل كما يتعلم الزنوج الرقص وهم في بطون أمهاتهم..) الرواية ص 60، 61.
إن تحول الحياة إلى عمل فني ليس سهلا كما نتصور فهو يخلق حالة من الاغتراب بين القارئ (مكتشف الموضوع) وبين الكاتب (مقدم الموضوع) تؤدي إلى التجاهل (وليس الجهل) بأبعاد الحدث، مما يحوّل الحكاية إلى شكل شعوري غريب طافح بالأحاسيس الجديدة التي تكون عادة أقدم من الإنسان نفسه، كما ( يتّخذ الوعي اللغوي المعرفي طابع المضمر، والمسكوت عنه، والمنفي... إنه الهامشي – أو المهمش الذي يعجز عن أن يتمثل خارج مساحاته الزمنية المختزلة، أو خارج أمكنته المحدودة بحكم دوام العيش فيها، وتكرار الحياة وتماثلها، إنه الصمت، أو التأمل، أو العبارة التي تحفر في العمق، لتتخمّر أكثر مما تفصح، كما أنها إيقاعات السرد الحادة التي تحاور هدوء الزمن عله يشي بما يتخزّن داخله ويتهيأ للآتي المختلف) كما تقول يمنى العيد.
فالكاتب في هذه الرواية يبني الحكاية بناء سريعا مما يجعل الإدراك الحسي لأحداثها ينفلت من لحظة القراءة ليكتمل بعدها، ويتجدد من خلال ولوجه أبوابا فتحت أثناء القراءة وظلت إلى حين ( مات بعد تعرض لجلسات كهربائية.. وبعد غمر للجسد في أحواض أسيد.. أضيف إلى ذلك كله مجموعة من الشتائم التي تمس عرض الأم خصوصا .. وعرض الأخت !! ) الرواية ص 72.
هذه العبارات السريعة التي تكشف تفاصيل الثقافة السائدة في مجتمع ينتمي إليه البطل انتماء لا فكاك منه يقوده إلى محاولة جادة للتطهر، لعل الكاتب يحاول بها تخفيف صدمة الانهزام الفحولي الذي وصمَ به مجتمعه من خلال الإيحاء بالفشل الذريع الذي مني به البطل أمام إصرار المرأة على صدق جسدها وصدق مشاعرها بفعل قسمها على القرآن، وإلحاحها على التحدي بقوة غائبة عن الفعل الرجولي المسند إلى غير حامله في هذه الرواية ( بعد ذلك التاريخ الموصوم بالعار والمنطبع على كل خلية من خلايا دمي الشمالي الساخن لم يقبل مخي إلا فكرة واحدة.. فكرة التطهر معا من الذنب.. فكرة الخلاص من إثم ليلة الخامس عشر من شهر شعبان.. خلاص نهائي لا يحتمل الرجوع أو الانتظار ) الرواية ص 74.
يتحول البطل في هذه الرواية من كونه صانعا للأحداث إلى كونه مصنوعا منها، هذه المفعولية الفحولية لا تظهر جليا إلا بعد الانكسار الذي يتعرض له عند لقاء حبيبته التي قطع لأجلها أشواطا من المكابرة والتحدي ( شعرت في غمرة عصياني وفورة شهوتي وعشقي أن خللا ما أكتشفه.. جزء من لعنات يوسف يتبعني.. جزء من لعنات الشماليين مراحيض يوسف التي أستعملها يطاردني.. لقد اكتشفت أن بها نقصا.. عطبا.. شيئا عزيزا مفقودا.. فسال عرقي وبغضي وتكومت أحزاني.. أحزان هبطت عليّ وتراكمت في لحظة ضعف آدمي مسّنا.. اكتشاف الحقارة.. حقارة كل شيء.. الجسد والحناء والريحان والأشواق ونفسي.. امتلأت روحي بالكآبة والقهر.. وتجمع الدمع في عيني !! بكت كثيرا على صدري... أحضرت قرآنا وأقسمت منتحبة.. أقسمت أنه لم يمسها بشر غيري ولكن يوسف حضر ولوث كل شيء.. نفسي وعقلي وصدق الأشياء عندي ) الرواية ص 68.
وهذا ما يكشف الوظيفة الجديدة للإنسان الذي لم يعد قادرا على صناعة حياة يريدها أو مسار يختاره ( فالبطل الجديد يعيش عالما جفت فيه ينابيع التفاؤل والبراءة وتقلصت داخله إمكانات الإنسان... وأصبح ذلك الإنسان الذي يقوم بصنع عالمه مجمدا عند بداية مغلقة وأبدية متشائمة ) كما يرى عبد العزيز حمودة.
ولهذا لم تكن الشخصيات الخارجة عن محتوى القصة الرئيسة في هذه الرواية تعني للكاتب أكثر من وجود آني للحظة عابرة، فاعتمد تعريفها على شكل إشارات تتداخل مع الواقع العيني الرئيس لكنها لا تضيف إليه جديدا وكأنها لا تعنيه، غير أنها بالمقابل تعني المتلقي الذي إن لم يجد مرآة يرى فيها وجهه داخل دائرة العلاقة العاطفية التي قامت عليها إشكالية الصراع القيمية في هذا النص، فإنه سيجد انعكاسا في هذا الأثر أو ذلك وهو ما سيحيله بالضرورة للعودة إلى تفاصيل الوعي بالإشكال المطروح على صعيد القيمة الإنسانية والنسق الثقافي الذي تنتمي إليه، ويرى بول ريكور أن ( استجابة الجمهور لنص ما هي التي تجعل النص مهما ودالا) وتعمل على شيوعه وبلوغه التأثير الفني والفكري الذي يطمح إليه الكاتب، ولا يتأتى هذا المآل لأي نص روائي إلا إذا كان مبنيا على ما يطمح القارئ أن يجده –وغالبا- يطمح القارئ لأن يجد نفسه أو يرى قضيته أو يقرأ معاناته ( أتى إلى غرفتي بابتسامة جماعية النزلاء فريد الحمد وعواد العلي وخالد السفر.. قلت في نفسي لما رأيتهم: المستشفى سلة قمامة تحوي أصنافا عديدة وأجناسا متنوعة.. فقد يكونون شماليين وقد يكونون غير ذلك... غادر فريد الحمد المستشفى يائسا من كل شيء.. أخوه وابنه وشفاء آلام ظهره.. عاد إلى قريته "القرين" ليموت إلى جانب أشجار الأرز التي يزرعها ويحصدها ويتاجر بمحصولها في سوق القيصرية بالهفوف...) الرواية ص 48، 60. وبناء على ذلك يمكننا القول إن الرواية تعتمد في صنع عالمها على المزج بين التفاصيل الصغيرة التي تجمع الناس في المجتمع الواحد، ليصبح التخييل بعدها قيمة تخرج بالمعنى عما يمكن أن يكون (إن لم يكن موجودا بالفعل) وهذا ما يسمح بإنتاج المتلقي أسوة بإنتاج النص ( وكأن الحالة الاجتماعية الثقافية العامة بمجرد أن تتغير- كما يقول سامي عبد اللطيف الجمعان - تكون مهيأة لأن توفر قارئا محليا يمتلك القدرة على التفاعل مع الأشكال الخطابية الجديدة لكتّاب مجتمعه خاصة )
إن الكاتب هنا لا يختار لمقترحه الثوري الحضاري المضمر - الذي يلمح إليه - بطلا مثقفا أو نموذجيا، لأن المثقف عادة يعدّ خارجا عن السرب أو هو مجبول من طينة غير طينة البسطاء، لهذا يختار إنسانا عاديا جغرافية وتوارثا من أجل توسيع دائرة التعاطف القرائي في مجتمع ملتزم بتقاليده حد الحساسية المفرطة، في الوقت نفسه يخفي الكاتب انتماءه إلى دائرة المثقفين الذين يطرحون سؤال التغيير وذلك بأن يتوحد بالبطل منذ بداية الرواية ولا ينفصل عنه إلا في تحديد المآل الذي بلغه في نهايتها ليتحول إلى مجرد ناقل للخبر قاصدا إلى استرجاع صفة الراوي، ليبيّن أنّ الرجل في هذه العلاقة القائمة على اللاتكافؤ الجنسي يمارس ذكورة محرومة من صفة القيادة - على رأي إبراهيم سعدي - المفروض هيمنتها في ثقافة الكاتب والبطل على جميع أنواع الثقافات، لأن دونيته القيمية بما تعنيه من سلبية واستكانة وضعف وانسياق أعمى للممارسات الاجتماعية يجعله يتعلق بالمرأة تعلقا جسديا شهوانيا خاضعا لمفهوم العذرية النازفة دون غيره من المفاهيم، وهو مفهوم ارتبط به دون الأنثى هنا، من خلال النزيف الذي لطخ ثوبه إثر مرضه بالبواسير( فلئن لم يكن رجلا في مضمار الثقافة. فليكن رجلا وأكثر من رجل في مضمار الرجولة الطبيعي) كما يرى جورج طرابيشي.
وهذا ما لم يتحقق أيضا، ولهذا يظهر الكاتب في آخر الرواية ليوضح الأثر الذي ينجم عن مثل هذا النوع من الفشل في المجتمعات العربية كافة.
إذا والحال هذه. ماهو النموذج الذي يقبل القارئ على التفاهم معه وإدراك مقصديته؟
لا بدّ أن الكاتب وهو يرسم ملامح بطله المشكّك المقلاق كان ينظر إلى شريحة اجتماعية لا تفصل القول الديني عن القول الوضعي معتبرة إياهما قولا واحدا، ثم إن مرض البطل يصرف القارئ المشكك عن طبيعة التأويلات التي يشي بها فشل العملية الجراحية لينحاز به إلى دائرة التجاذب الفكري والتعاطف التلقائي مع ردود الفعل الذكورية تجاه البطلة، مما يعزّز قيمة الفحولة كنسق عام تنتشي الذات بإعلانه أمام قارئ لا يفكر خارج دائرة الانتماء لتلك الرموز، بينما يترسخ في وعيه إحساس بالفجيعة، يتنامى تدريجيا مع أزمة البطل وصولا إلى موته الرمزي بموت الحلم الذي ظل يجاهد من أجله انتصارا لتبعيته المقيتة إلى فكر متجذر في ذاته اللاواعية قسرا .
3- شعرية اللغة (الانزياح/ التكثيف):
يبدو أن الكاتب في هذه الرواية لا يقف عند حدود عرض القضية الموضوع أو الحكاية والانتهاء بها إلى الفشل الذريع ليقول كل شيء ويتوقف عنده، بل إن هذا لم يعدُ أن يكون مجرد مواراة للفكرة الرئيسة التي لا يقولها علنا ولكنه يستعيض عنها بأشكال أسلوبية شتى، منها:
أ- اللغة الشعرية:
اللغة كما ترى يسرى مقدم هي ( سر يفشي كل الأسرار... ووجود يمتلئ بوجودنا) وهي المادة التي يبني بها الكاتب عالم النص مستعيرا أدواتها الجمالية من بقايا الإرث اللغوي الذي كانت الشعرية أهم مقوماته، للتعبير عن الكامن في دواخل النفس العربية المسكونة بوجع الحرف منذ الأزل.
إن سقوط أحلام التغيير ومرارة الهزائم العاطفية جعلا لغة الكاتب تنزاح إلى تقنيات الكتابة الشعرية، مازجا بين جنسين أدبيين لا يجتمعان إلا في نصوص لها رؤيتها الخاصة ومواقفها المفعمة بالوجدانية والتأمل فـــــــــــ( العالم مبرمج في اللغة بشكل سابق، لذلك لا نستطيع معرفة العالم إلا من خلال ما يسمح به اللسان ويجيزه، بل إن إمساكنا بالمدرك الواقعي لا يتم إلا من خلال التوسط الرمزي، أي اللسان، وهو أرقى الأشكال الرمزية التي مكنت الإنسان من التخلص من طبيعة خرساء تكتفي بإعادة إنتاج نفسها. لقد استطاع الإنسان من خلال الأشكال الرمزية واللغة في المقام الأول، الانفصال عن الكائنات الأخرى لكي يبني تاريخه الخاص. لذلك، فإن ما تقوله اللغة ليس وصفا لعالم معطى خارج الذات، إنها تمسك بمعرفة تخص هذا الواقع. ذلك أن ما يتسلل إلى اللغة هو رؤيتنا للأشياء لا الأشياء فحسب) كما يرى سعيد بنكراد.
وقد لعبت اللغة الشعرية دورا بالغ الأهمية في تكثيف الدلالة الشعورية المؤثرة على القارئ والمتجاوبة مع المنحى العام للقصة المسرودة ( شقيق يا غانية متزينة بضوء الصباح ها أنذا جالس في سجني أحس كثيبا من الرمل رابضا فوق صدري فاحملي عني بعض الرمل بعض الثقل لأتنفس عطرها ورائحة الصابون في جيدها.. ها أنذا جالس أشعر أن شمسا صغيرة تحرق وجهي.. تشظيه تسلخ جلده المكتئب فتعالي رشي عليه بعض مائك البارد حتى يبرد ... كثيب متماسك الجزئيات مبلول بالماء وبالمطر ثقيل كجبل راس.. وشمس تهدر الوهج.. تريقه تسفحه.. كل هذا يا شقيق والعشب في صباحك يقف وسيما جذابا للعصافير وماؤك يدرج في جداوله الصغيرة منتشيا بالحرية وزهرك في وجه الربيع.. وفي وجوه الفلاحين في أرضك الرمادية... كان ليل الوصول إليك ليلا حربيا.. ليل معارك واغتيالات.. فلقد حاول الطين اغتيالي ورميي في فم المصرف الواسع...) الرواية ص 10، 11.
هذه الانزياحات اللغوية جعلت التداخل بين الشعري والسردي يمثل دور الوسيط العاطفي والجسر الشعوري الذي حوّل دلالة الحدث السردي من سلطة الخبر إلى سلطة التخييل، ويرى بيير زيما أن ( جميع النظريات البلاغية تصبح بلا معنى إذا فقد البناء الدلالي والتركيبي (المادة اللغوية البحتة) للخطاب علاقاته بتأثيراته الاجتماعية ) المنبنية في هذا النص على تهشم العلاقات الإنسانية، واستبدال كل لحظات الحياة بلحظات للموت، بدءا بلحظة التشكل التي يشي بها وجود جنين مقبل على الحياة وانتهاء إلى صدمة موته قبل اكتمال طعم الفرح وصرخة الولادة.
ب- اقتحام خصيصتي التجريب والتجديد:
يستعيد الكاتب من خلال الفقرات الوصفية جزءا من الواقع الذي ينتمي إليه البطل، لكنه في الوقت نفسه يضفي عليه من الشحنات العاطفية ما يجعله يكسب بعدا رمزيا لا يقصد إثباته بقدر ما يقصد تجاوزه؛ هذا التجاوز تلعب فيه البنية الشكلية للنص المسرود دورا مهما، و( إذا كان الهيكل السردي هو صيغة تنظيمية، تعبر –في عمقها- عن وجود أشكال كونية منظمة للنشاط الإنساني منظورا إليها من زاوية فعل النص، فإنه يتحول في حالة الروايات التي تنطلق في صياغة مضامينها من متناص عقائدي، إلى أداة ضابطة ومراقبة لتخوم البناء القيمي. إنه يقوم بالحد من أية محاولة تهدف إلى تفجير المعنى، وجعله يتجاوز إطار المادة التي تغذّيه) وهذا ما يراه سعيد بنكراد. فالتجاوز المعنوي لا يتم إلا بخلخلة النظام التقليدي لبنية العمل الروائي، والإعلاء من شأن الرؤية المتنامية الوعي، وتشظية زوايا الطروحات النفسية، واقتحام فضاءات العوالم التحتية للمجتمع القديم/ الجديد، هذا النمط من التجاوز يجعل المتلقي يستحضر لحظة الحياة الغائبة داخل لحظة الكتابة، يقول عادل ضرغام: ( إن هذا البناء الخاص جعل الرواية منفتحة على عالمين، العالم الآني، والعالم الماضي، ومعاينة الماضي في لحظة آنية تقدم –بالضرورة- وعيا جديدا، لم يكن مطروحا لحظة المرور بالتجربة سابقا، ومن ثم نجد أن معظم القيم، التي تنظم بصورة ضمنية مجموع عالم الرواية، لا تظل على حالها، وإنما تتعرض لمساءلة ولوعي خاص ينبثق من لحظة آنية ) إذ يوفر التقاطع الرمزي للغائب والحاضر مجالا لاستقبال النص الجديد بإمكاناته المبتكرة والتي تحيل إلى ماوراء النص ( ها أنا قد وصلت يا شقيق الخرزة التي تدور في دمي وتذوب في فمي.. وصلت إليك مطرودا يا مذاق النار والخطيئة والفاكهة المحرمة ويا نكهة الإيمان والنوم.. فخذيني إلى صدرك وقوسي أضلاعك عليّ.. اخنقيني بحضنك مرات كثيرة وأنسيني طعم الموت بعيدا عنك. شقيق هل جربت التموج مثلي على طريق طيني يساره مصرف مائي كبير فاتح فمه لابتلاع أي شيء؟ هل عشت هذا النوع من الرعب؟ هل شدّ قوائمك السفلية كائن ممسوخ؟ ) الرواية ص 09.
ج- تحريف الدلالة:
وذلك بالعمل على تجاهل التسميات وأنسنة المكان والزمان، استنادا إلى نظرة ذكورية لا تكترث في ظاهرها إلى موضوعية الحدث، بقدر ما تبني رؤاها على ما توفره المعطيات الملموسة ظاهرا من عوالم رمزية تخييلية تحيل على واقع فعلي ( الفجر والسيجارة ترتجف بين أصابعي والشقيق أنثى بيضاء تفيق من سكرة الليل.. الفجر ونزواتي المعطلة تصحو من رقدة الموت والحزن... فجر الشقيق يغسل دمي من الحزن.. يعقّمه.. يثلجه... شقيق العطش والري.... تنزع الأغطية والغلالات عن جسدها وتصبح امرأة عارية شهية في الفجر.. الشقيق تتجمل بالضوء الأول وتتوضأ بحبات المطر النثناثة..) الرواية ص 08.( عدت في اليوم الموالي إلى الشمال القاسي وكان الصباح فيه خليط فواكه متعفنة، خمرا رديئا نتن الرائحة، سيء الطعم والمذاق خمرا مغشوشا.. وذباب الشمال يتصيد وجهي ويستغل حزني فيغرس إبره في وجهي بحقد ويفلت من يديّ.. ذباب يرضع الحقد من قمامات الشماليين.. ويريد أن يبيض على وجهي ) الرواية ص 29. وهنا تندرج الرواية ضمن قيمة دلالية تشكلها البنية الكلية التي تتلخص في ثنائية (الحياة/ الموت) ويظهر ذلك جليا بداية بجملة العنوان ووصولا إلى أشكال الموت الفعلية والمعنوية التي تظل تتربص بأجزاء الحكاية حتى تنتهي بها إلى أفق مغلق على مستوى السرد ومفتوح على مستوى الرؤية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الرواية نت




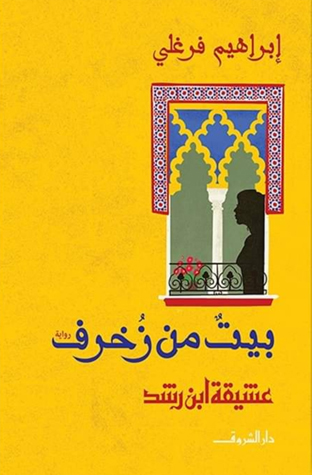


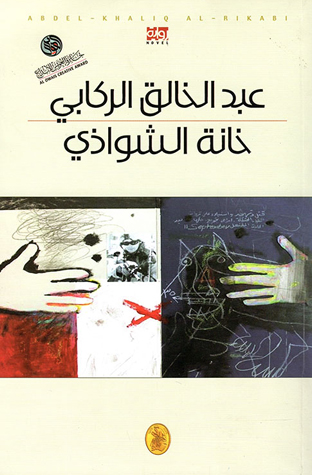

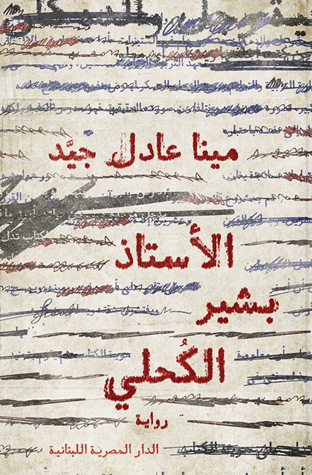

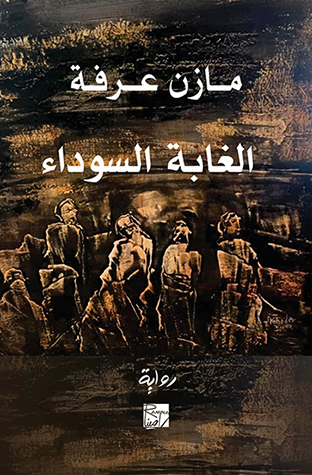


0 تعليقات