"صديقتي... قاتلة" لفاطمة بن محمود.. فقاقيع الصّابون بين السّجن الصّغير والسّجن الكبير
ناجي الخشناوي - ناقد من تونس
عادة ما يجذبنا الفضول للاطّلاع على أدب اليوميّات لمعرفة التّفاصيل الشّخصيّة للكُتّاب، بوصْف هذا النوع من الأدب، أدبَ الأوراق السّريّة وأدبَ السّير المخفيّة وأدبَ الاعتراف والبوح، أدبَ إحراج الذات المتعالية دون قفازات، لكنّه أيضا أدبٌ نتسلّل من شقوقه الشخصّية داخل الجدار الجماعيّ بحثا عن حقائق الوقائع التي يُزيّفها النصّ الرسميّ المهيمنُ درءا لفشله السّلطويّ وإمعانا في كآبتنا المزيّفة.
والكاتبة فاطمة بن محمود في كتابها "صديقتي... قاتلة/ يوميّات زمن الكورونا" الصّادر عن دار الكتاب، لا تتركنا نتسلّل إلى شقُوق الجدار الرسميّ، بل هي تمنحنا كل المعاول لنقف على هذا الجدار الوطني الخَربِ، تستضيفنا في سجنها الصّغير لتشير إلينا بجوارحها أن انتبهوا إلى السّجن الكبير الذي "نعيش" تحت سقفه الآيل للسّقوط، فهذه اليوميّات الشّخصيّة تشبه تماما مجرى وادٍ صافٍ يشقّ بِرْكة مزدحمة بالأدران والمياه الرّاكدة التي تنتعشُ فيها كلّ أنواع الفيروسات: السّياسيّة والأخلاقيّة والدّينيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والنّفسيّة... فتصير أمامها الكورونا رحيمةً بنا، وصداقتُها "شرّا" لابدّ منه لأنه أقلّ وطأة من شرور "رجال" النّظام والكَتبة والواهمين بحلم الخلافة السّادسة والوزيرين البكّائين وكل من لم يتجرّأ على قصف عُقد الذّكورة ومركّبات الاستكانة، ولم يعرف بعدُ أن الحياة "هشّة وضئيلة وخاوية مثل فقّاعة صابون".
"تُغوينا" الكاتبة فاطمة بن محمود عندما تسحبنا منذ البداية إلى المكان الأكثر حميمية، "في مغطس الحمّام"، حيث غمر الماء جسدها وأغوت رغوة الصابون إصبع طفلة لا تحبّ أن تكبر، وتظلّ فقاقيع الصّابون بشكلها الكرويّ الرقيق وألوانها القزحيّة المنعكسة على سطحها، تظلّ عِقْدا متينا بينها وبين القارئ/المتلصّص، إلى نهاية اليوميّات "ليقتنع" فعلا أن "الحياة فقّاعة صابون" وأن أنياب الكلب الأسود، الاكتئاب أو شعور الموت بالحياة، لا تكلّ من نهش ألوان قوس القزح. ومغطس الحمّام -فضلا عن كونه مكانا حميما- هو الذي نتعرّى فيه دون خجل، والكتابة تعرٍّ وتعرية، وهو المكان الذي نتخفّف فيه من الأوساخ والأدران، والكتابة تخفّفٌ من كلّ تكلّف وتزلّف ورياء، وهو أيضا المكان الذي نُصادق فيه أجسادنا ونتأمّل شحوبها أو نضارتها، تماما مثل الكتابة التي تُبرّح شحوب الواقع بنضارة الخيال/الأمل، وهذا ما فعلته فاطمة بن محمود وهي "تستحمّ" بشلاّل شاهق من الرّوايات والأفلام والقصائد والأطروحات الفلسفيّة... تستعين بها لتُحكم صرْفَ سدنة السّيستام الفاسد من السّياسيين الفاشلين والكتبة القوّادين براغي السّاحة الثقافية الذين يكتبون بلعابهم وتجّار الدين ولصوص الأزمات ومواعين المطبخ وفواتير الحياة وبخور الجارة والزوج المستقيل الذي لا يتعب من الغياب وسلطة العادة... تُصرّفهم وسط أحشاء بالوعة المغطس، وصوتها يردّد ما قاله أحد كتّاب جيل 68، الإسباني خوان خوسيه مياس: "إنّنا لا ننتهي أبدا من صنع أنفسنا، أشعر بأنني أواجه نفسي مثل نحّات يقف أمام صخرة يجب أن يحذف منها كلّ ما هو غير جوهريّ".
مثل رهينة متحرّرة، تجعل الكاتبة وباء "كورونا" أسلوبَ حياة وطوقَ نجاة. متاريسُ تحرّرها ونجاتها هي وميضُ القصيدة وخيال السّرد وألق السّينما ورعشة الرّقص في وجه تنّين "هوبز"، وإذا كان العلم يتقدّم على الفلسفة بخطوة وعلى الدّين بأميال، فإن الفنّ بكل تعبيراته يتقدّم عليهم جميعا بآلاف الأميال، فبعد "اندحار رجال الدين وعجز العلماء وحيرة الفلاسفة يجد الإنسان نفسه"، لأنه وحده الذي يبذر الحريّة والشّفافيّة والجرأة، وهذه أيضا سماتُ أدب اليوميّات الذي بدت فيه فاطمة بن محمود غير زاهدة في نثر بذوره على كامل نصوص كتابها الــــ55 وهي تتدرّج في نسق لا يخفتُ فيه الصّوت الفرديّ إلاّ ليعلو في وجه الصّوت الجمعيّ يرجّ مزاليج نوافذه وأبوابه وأسيجته، وبعض عتبات النّصوص خير برهان على هذا الصّوت العالي ومنها: "الدّكتاتوريّة العادلة، تنّين هوبز، الكلب الأسود، الكورونا تقودني إلى السّجن، وجه بشع للملائكة، القاتلة البريئة، البستان الحزين، الكذبة الصّادقة، يوم في السّجن، حرب الكبار مقبرة الصّغار، جثة تتنفّس، سلطة العادة، المخابر العلميّة مطابخ الشّعوب، في داخلي كلب، التّشاؤم حالة عقليّة، اللّغة تخاف أيضا، المؤامرة، حجر على العقول، بلاد في مقبرة، الأوطان المغشوشة، في السّجون الكبيرة، دمية ماتريوشكا...".
تنطلق اليوميّات من يوم 2 مارس 2020 مع إعلان أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس، لتستمرّ إلى غاية يوم 14 جوان من السّنة نفسها، اليوم الذي انتهت فيه المرحلة الثالثة والأخيرة من الحَجر الصحيّ الموجّه، وإذ تبدو هذه الفترة قصيرة نسبيّا لكتابة يوميّات أوتوبيوغرافية لامرأة تغرق في مغطس الحمّام في سجنها الصّغير، إلا أنّها سيرة مرحلة ليست فقط جديرة بالتّوثيق، بل بالتأمّل والتمعّن في قضبان السّجون التي تحوّطنا أنّى ولّينا حياتنا، مرحلة سقط فيها الإله من السّماء وتحوّل إلى تبرير لإرهابي، وفاطمة بن محمود لا تكتب يوميّات في زمن الكورونا، بل هي تقيم في هذه اليوميات وتمنحها من ذاتها، بخيباتها وآلامها وآمالها، ما يجعلها أسلوب حياة وشكلا من أشكال الإقامة في الوجود... في مواجهة صديقتها القاتلة.
ولئن كسرت الكاتبة أهم قواعد كتابة اليوميّات، الانضباط اليوميّ، فإنّها في المقابل تنجح في خلق "حبكة" سرديّة/تخييليّة، يُفترض أيضا أن كتابة اليوميّات غير معنيّة بها، فهذا التّسلسل الزّمني في كتابة النّصوص والذي يشهد انقطاعات تضطرّ إليها الكاتبة، يجد تماسكه الدّاخليّ من خلال فعل الاستحمام/التطهّر/التّطهير/الكتارسيس المتواصل مع كل نصّ، حيث الكاتبة لا تتخلّى عن "ليفة" الكتابة وصابون النّقد والتّعرية وهي تدعك هذا الجسد التّونسي المتورّم في "لذّة مشوبة بانتقام غريب"، وبالتثبّت في تواريخ النّصوص سنكتشف بعض الانقطاعات خاصّة في شهر مارس، وكأنّ الكاتبة ما زالت متردّدة في خوض غمار المغامرة، إذ نجد تباعدا كبيرا بين النّصوص يصل حتى عشرة أيّام، من 2 مارس إلى 8، ثم من 10 مارس إلى 19، لتتقلّص مسافات التّباعد في شهر أفريل فلا تتجاوز أربعة أيام، من1 أفريل إلى 5 أو من 20 أفريل إلى 24، وكأنّ الكاتبة استقرّ رأيها نهائيا وانضبطت لقاعدة الالتزام اليوميّ بالتّدوين، لكنّها في غمرة هذا الالتزام لا تنتبه إلى ترتيب اليوميّات فنجدها مثلا تصفّفُ يوميّات 14 ماي قبل يومي 11 و12 من الشّهر نفسه، ثم تتواصل اليوميّات منتظمة بتباعد أقلّ في شهر جوان لم يتجاوز اليومين فقط، وهذا التّباعد ليس هنة في الكتاب أو سهوا من الكاتبة، ففاطمة بن محمود لا تني تذكّرنا بأن هذه اليوميّات ليست للنّشر رغم أنها نشرت بعضا منها في مجلة الجديد اللبنانيّة وجريدة القدس العربي اللندنيّة، كما أنّها تخشى على هذه اليوميّات أن تصبح "عملا روتينيّا يغلب عليها التكلّف" خاصة أن العادة تقتلُ الشّغف، بل الكتابة عند فاطمة بن محمود مثلما تقول "... الكتابة بالنّسبة إليّ أن أحدث فجوة في العادة ونتوءا في الرّتابة وخربشة في اليوميّ"، ورغم أن زمن اليوميّات كان ملطّخا بدماء ضحايا "كورونا"، إلا أن الكاتبة اقتنصت كل الوقت الذي أصبح ملكها واعتبرته غنيمة حرب لقتل الوقت ذاته.
بعد أن تُخاتلنا الكاتبة بحبكة مشهديّة من خلال فقاعات الصّابون الهشّة والخاوية، تأخذنا في مُخاتلة لغوية تُعلي فيها من شأن اسم كورونا الأنثويّ مقارنة بالطّاعون والكوليرا والجدري والسّلّ حتى لا تخدش كبرياء القارئ، بل هي تبعث في روحه الطّمأنينة عندما تُعلمنا أنها ، ويا للمصادفة، تقطن قبالة بناية فخمة اسمها "إقامة الكورونا"، وهذه حقيقة وليست مجازا، وكأنّها تروّض هلعنا وتخفّف من روعنا من هذه اليوميّات التي تقتل فيها الصّديقة صديقتها، ثم تتدرّج الكاتبة في تقريبنا من هذا الوباء الدكتاتوريّ في تسلّطه والدّيمقراطي في ضحاياه تماما مثلما هو حالنا: مواطنون صالحون في دولة فاسدة كثيرة الفقاقيع المتوحّشة تنتشر تحت قبّة البرلمان وخلف المكاتب الوزارية الوثيرة وفي محلّات الثقافة المعلّبة وأمام الكاميراوات التلفزية والمصادح الإذاعية وخلف الآيات القرآنية وتحت اليافطات الوطنيّة وخلف أزرار الحواسيب الباردة... "دولة فيها البوليس مثل لافتة في الشّارع، حفرة في الطريق، رصيف متآكل...".
وترمي الكاتبة بسهام النّقد والسّخط على ما كشفته أزمة وباء "كورونا" من الأمراض المزمنة في الذّات التونسيّة في كلّ انتماءاتها: الطبقيّة والقطاعيّة والجندريّة والثّقافية والايديولوجيّة والمؤسّساتيّة... بعد هذا الربيع العربي والثورة التي هي فقاعة صابون خاوية وهشّة وبلا معنى، بل الكاتبة تمنحنا "فرجة مجانية على مشهد عبثيّ لدولة فاشلة".
الكتابة معجزة للمرأة في هذا الأفق الذكوريّ الخانق، لكنّ فاطمة بن محمود التي تتنفّس الكتابة وتمشي كأنّها شجرة، تستثمر "هذا الكائن المجهري الضّئيل جدا والخاوي مثل فقاّعة صابون" الذي اسمه كورونا ولا مهمّة له إلاّ ابتلاع المزيد من الضّحايا كأنه خُلق ليفترس، تستثمر قدومه الثّقيل وتحوّله إلى صديقة لدودة سادّة عليها كل منافذ تنفيذ جريمتها المنتظرة وجموحها للقتل بخطّة محكمة قاعدتها: "حياتي التي أحبها أعيشها... وحياتي التي تزعجني أكتبها"، ولذلك حوّلت الكاتبة مغطسها إلى محتشد من المضادات الشّعريّة والحُقن الفلسفيّة والكمّامات السرديّة والفيتامينات السّينمائية والمعقّمات الموسيقيّة... ودعت قُرّاءها إلى حفلة حياة وسباحة حرّة لمواجهة هذه الصّديقة القاتلة التي بدأت تتراجع وتضمر وتخفت نزعتها الإجرامية أمام باولو كويلهو وعلاء الأسواني وسمير درويش ودينزل واشنطن وليوناردو دي كابريو وريتشارد جير وتوماس هوبز وهيمنغواي وامبيرتو طوزي وفرانشيسكا ميلاندري وحافظ محفوظ وفيرجينيا وولف واديث بياف ووردة ولمجد بن رمضان ومونتسكيو وروسو وسارتر وعبد الله المتقي وأدونيس ونجيب محفوظ وحنّا مينا ومحمد شكري والطاهر وطّار وعبد الرحمان منيف وأمين معلوف وشكيب أرسلان وديكارت وأفلاطون وأرسطو وفرويد وجلال برنزجي ومحمود درويش وسعدي يوسف وشيركو بيكه سِ وأمل دنقل وسعود السنعوسي والغربي عمران وطه حسين وبول اوستر وخيرة الشيباني واوغيست كونت وأولغا توكارتشوك ويونس الفنادي ولطيفة الدليمي وايليف شافاق وايزابيل اللاندي ونازك الملائكة وأغاثا كريستي وكاتلين باركر ورينيه ماغريت وبيكاسو ونيتشه وكارل غوستاف يونغ وشوبنهاور ودوستوفسكي والبار كامو وفيكتور هيغو ونورمان ميلر وفيورباخ ونرمين صفر ورشدي بلقاسمي وباتريك زوسكيند ودونالد ري بولوك وريم قمري وميشال فوكو وادغار موران وسهيل ادريس ويفجيني زامباتين وجورج اورويل وجيروم ديفيد سالنجر ومحمد المطرفي ويان مارتيل ومواسير سكليار ومارك توين وتوماس بيكيتي والبارتو مانغويل وادم سميث وسيمون دي بوفوار... وإذ نذكر جميع هذه الأسماء التي استحضرتها الكاتبة على كامل نصوص يوميّاتها إنّما انتصارا لبستان الحياة، ونكاية في الجثث المزدحمة في مقبرة النّفايات البشرية وفي عالم الدرجة السّفلى في قاع السّفينة حيث الأموات يزورون الموتى، والتي تنبّهنا أيضا الكاتبة إلى عطونة رائحتها وتعفّن "آفاقها" مع هذا الحزب الغول الذي أبّدنا في ليل عميق تحت الشّمس السّاطعة بدكتاتوريّته غير الوطنيّة.
تهوّن علينا فاطمة بن محمود وطأة الخوف من "كورونا" القاتلة والمساند الرّسمي للدكتاتوريّة، بهذه اليوميّات التي تتخفّف فيها بدورها من وطأة اليوميّ الذي يحاصرها في سجنها الصّغير وجزيرتها المعزولة عن العالم وتمنحها فسحة من الجرأة على كشف عورات السّجن الكبير/المجتمع بأفراده ومؤسساته وعقلياته وسلوكيّاته دون أن تكون "مضطرّة إلى التّظاهر بالتّوفيق بين هاتين الوظيفتين، وسلوك طريق الرّياء الاجتماعي" وهي التي واجهت، ولا تزال، بشجاعة "ثلاثة أسياد قُساة".
وحدها أمها تلك "الصّديقة الأعظم من الحياة"، البسيطة والعميقة والشّفيفة، تظلّ تسري مثل الماء في عروق تلك الشّجرة التي تمشي واسمها فاطمة بن محمود، وتظلّ أغصانها وارفة تستجير بظلالها وتقتات منها الحلم رفقة رجلها الأول الذي لا يُنسى -الشِّعر- وهي تلعق المثلّجات من لاسيريز أمام البحر، وتقرّب المرآة إلى وجه الطّفلة فيها، وقد تداعب كلب فرجيينيا وولف الإسبانيوليّ اللّطيف أو تدخّن غليون رينيه ماغريت وتبتسم في وجه عم حسن وتقرأ القرآن كما تراه أمّها، ولا تكفّ عن الحلم بمدن بيوتها بلا مطابخ ومقاهٍ مثل الابتسامة، وبتدريس الرياضيات في المساجد، وبعالم تحكمه النّساء بعيدا عن الرّجال المتوحّشين وعن سوس الكلب الأسود والكاتب السّارق والكاتب المسروق، وعن عفونة السّجنين الخانقين، وتعدو في ملعب الرواية دون أن تتعثّر في لغة الشّعر وتسبح في بحيرة السّرد دون أن تعلق قدميها في عُشبة القصيدة... فالحياة ليست فقط فقاعة صابون هشّة وخاوية وبلا معنى... الحياة قصيدة نكتبها ونعيشها... إنها عُشبة الخلود.

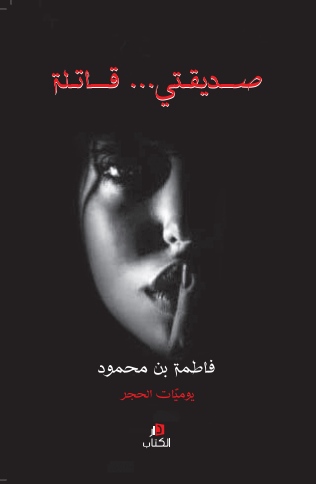


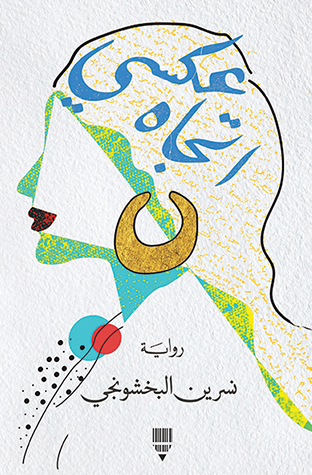



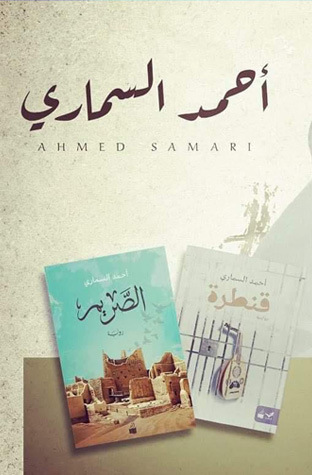
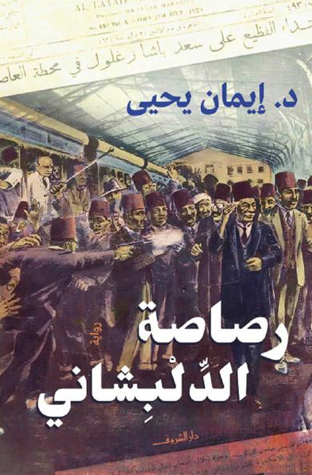
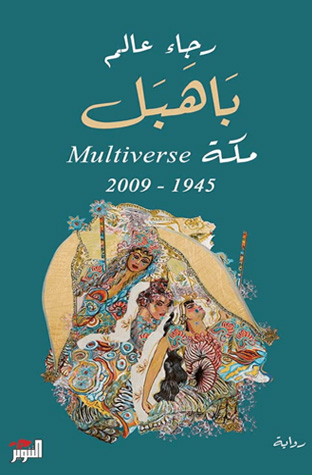



0 تعليقات