رواية لاموغ.. عشق وموت لإيمان أحمد مسلماني رحلة مع عذابات المرأة وقهرِها المتجدِّد
نجيب كيَّالي
يبدو أنَّ العالم العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وربما بعد حرب عام ٦٧ يشهد انتكاسةً اجتماعيَّةً وفكريَّةً وحضاريَّة فضلاً عن انتكاساته العسكريَّة، وهزائمه المتلاحقة! هذه الانتكاسة جعلتْ تحرُّرَ المرأة يتعثر تارةً، وينحرفُ عن مساره إلى تفاهاتٍ وشكليات تارةً أخرى! ومع انفجار الوضع الداخلي في سوريا عام ٢٠١١ زادت الصورةُ قتامة، ودفعَ أبناءُ المجتمع السوري جميعاً، ولا سيما النساءُ أفدحَ الأثمان، وعلى هذا الجانب تُسلِّط رواية: لاموغ ضوءاً يكشف لأعيننا زوايا الألم المعتمة في قلوب النساء، وقهرهن المعلن والصامت.
تبدأ الرواية بحديث شمس- وهي إحدى الشخصيات النسوية- عن الغربة.. غربةٍ سميكةٍ استثنائية صارت جحيماً فتح لعنتَهُ على السوريين الذين اضطر معظمُهم لمغادرة بلده، لكنَّ شمس تسعى للتعايش مع غربتها، وتحاول أن تجني منها بعضَ الثمر! بين شمس وصديقتها: شجون طبيبةِ الأسنان علاقةُ صداقة متينة، وبين حياةِ هذه وتلك، ومَنْ يتصل بهما من النساء تغزل الروايةُ نسيجَ أحداثها. نعرف أنَّ شمس صبيَّة مشحونة بالرهافة، والتوق لعاشقٍ كبيرِ القلب، وهي ذاتُ مزاج ينفر من الروائح غيرِ المستحبَّة نفوراً شديداً.. حتى إنها تتعجب من صديقتها شجون كيف تتحمَّل روائحَ البنج، وأبخرةَ أفواه المرضى! عاشقُ شمس المُشتهَى يظهر من خلال حديث قلبها عنه، وهو حالة بين الحلم والحقيقة. إنه رائع، رائحةُ جسمه ساحرة كما تتمنى، لكنه يختفي كضوءٍ عابر لتبقى شمس دون زواج تقوم بدور روايةِ قسم من الأحداث الموجعة غيرِ العادية التي وقعت لصاحبتها شجون، وللجارة أم دلع، وابنتها.
تظهر أجيالُ النساء في الرواية رازحةً تحت عناء تتغيَّر أشكاله وصورُه. أمَّا قسوتُه فهي هي! جيلُ الأمهات مثلاً عانى الكثير، فوالدةُ شمس مات زوجها، واضطرت لنسيان أنوثتها وإعالةِ الأسرة.. حتى إنها كانت تُصرُّ على النَّوم في سرير صغير ضيق كأنما تخشى لو كان السرير واسعاً أن يتسلل إليه حلمها برفيقِ عمرٍ جديد عاشق! ووالدةُ شجون انصبَّتْ عليها اللعنات، لأنها من طائفة أخرى، وقد اتُهمت أنها- بقلة الاحتشام والملابس المكشوفة- أغوت والدَها حتى تزوجها، ثم تمَّ الطلاقُ بينهما لكثرة الضغط الاجتماعي!
في الجيل التالي الأحدث نرى دلع يمنعها أبوها ذو الفكر اليساري التقدمي من الاقتران بحبيبها، ويختار لها زوجاً ثرياً يعمل في الخليج! فإذا بها تتركه بعد شهرين، وتهرب مع عاشقها القديم، وبين هذا وبين أبيها يجري عراك ذاتَ يوم ينتهي بجريمة قتل تسحب خلفها ذيولاً كثيرة، وتقضي في آخر الأمر على حياة دلع نفسها!
في هذا الجيل الجديد الأحدث نجد شجون يقع لها الحدثُ الأكثرُ إيلاماً المتصل بالزلزال السوري، فهي تُقدِّم العونَ لشاب جريح في أحد الأيام، تمَّ إطلاق النار عليه في مظاهرة، تسحبه لعيادتها وتسعفه، فيجري اعتقالها، وبعد خروجها من السجن بمعونة قريبٍ لها تتحدث عن التنكيل بالنساء هناك، واغتصابهن، وصعودِ أرواحهن بالعشرات! ومع سردِ ما يجري للنساء تقوم الكاتبةُ هنا وهناك عبرَ سيرورة الوقائع بالتقاطاتٍ سريعةٍ ذكية تختصر فيها الحالةَ السورية المزرية بعد سنة ٢٠١١، فالبراميل تسقط، والأمانُ مفقود، والجوع يفتك بأهل المخيمات، والصغارُ بلا تعليم، بل صاروا يشتغلون في مهن قاسية ببلدهم أو في تركيا مهنٍ لا تناسب أعمارَهم لتأمين الرغيفِ لهم ولأهاليهم! صاروا رجالاً مشوَّهين قبل الأوان!
أمَّا أسلوبُ الرواية فهو يستحقُّ التوقفَ عنده. لاحظنا أنَّ الكاتبة لم تلجأ إلى تكنيك السرد التقليدي، بل كانت تتعامل مع مسروداتها من الأحداث بقدر جيد من الحرية، فهي مثلاً تضع قبل الفصول عتباتٍ شعريةً أو شاعرية تمنحها فضاءً تخيلياً جميلاً يجعل القارئَ يفكر في المسرودات وما وراءَها. مثال ذلك ص ٩: (في الغربة.. كلُّ ما حولك غريب.. ترسمُ أحلاماً غريبة عن وطنك الغريب، في الغربة تشتاقُ كلَّ يوم إلى أهلك الغرباء، في الغربة تسمع الجميعَ يصرخ في وجهك دون أي كلام.. دون أي صوت: أيها الغريب!)
وهذا مثال آخر ص ٨٦ (لا تغرَّك يا صديقي نظرةُ البراءة في عيني، لا تغرَّك لغةُ التفاؤل في شفتي، ولا طيرُ العصافير في فكري، وبين جفني، فألمُ السنين قد حفرَ أخاديدَهُ بين خافقي، وأودعَ أحزانَهُ في مقلتي...... لكنْ بين ضلوعي شوق لكل أفراح شعبي المؤجَّلة).
ومن حرية الأسلوب التي أتحدث عنها أنَّ الكاتبة كانت تستعمل طريقةَ مذيعات التلفزيون التي مارستَها بعضَ الوقت في حياتها، فتجعل شخصيةً كشمس مثلاً تُمهِّد لشخصية أخرى كشجون لتقوم برواية ما جرى معها.
كذلك أغنت صاحبةُ الرواية عملَها بالحوارات الفكرية التي شكَّلتْ ممراتٍ إلى أوجاع مزمنة تعيشها المرأة، والمجتمع السوري عموماً، ولا سيما الوجع الطائفي الذي أطلَّ برأسه بصورة فجَّة خلال سنوات الحرب العشر الماضية. من الحوارات الهامة حوار شجون مع الشاعر وحيد الذي تميل إليه، وقد استغرقَ عدةَ صفحات، وبدا طويلاً، ومقاليَّاً في بعض مفاصله، لكنه هامٌ لافت ص ٢٦: (بدلَ أن يَئِدوا النساءَ جسداً كما في الجاهلية بدأوا يقنعونهن بأن يَئِدن أنوثتهن، وكأنَّ الأنوثة عار).
ومن تقنيات الأسلوب أنَّ إيمان مسلماني استعانت بما يشبه طريقةَ المذكرات، فأمُّ دلع بعد موت ابنتها سافرت للسويد، وصارت تُفْرِغُ حرائقَ قلبها على الورق، ومما كتبَتْه: (كيف لشرف أمةٍ أن ينحصرَ هكذا في فرج امرأة؟! مَنْ يتخيَّل أن شرفَ أمةٍ غادر كلَّ الذل والقهر والتخلف، غادر البلادَ المنكسةَ أعلامُها، والرجالَ المطأطئةَ رؤوسُهم...... هل يُعقَلُ لأمةِ الرسل والأنبياء.. أمةِ العلماء والمفكرين.. أمةِ الشعراء والفروسيَّة...... أن يتحوَّلَ شرفُها كلُّه إلى فرج امرأة!)
خاتمةُ الرواية تجيء في فصلٍ صغير مشحونٍ للغاية حيث امرأةٌ سورية لا ندري مَنْ هي بالضبط.. شمس أم شجون؟ تعشق رجلاً عراقياً، ويتحوَّل عشقهما إلى ارتباط بلدين، وشوقِ بلدين، وعذابِ بلدين، وعجزٍ عن التلاقي الدائم في ظل الخراب العامر الغامر إنْ في سوريا أو في العراق. وهكذا.. فالحبُّ، والفراقُ، والموت مفرداتٌ متلاصقة في أعمار السورياتِ والسوريين، بل في أعمار العرب جميعاً في أيام التهاوي هذه!
لا شكَّ أنَّ دار موزاييك أحسنت في انتقاء هذه الرواية التي قامت بتدقيقها، ونشرها في السنة الماضية ٢٠٢٠، وهي- رغمَ صغر حجمها الذي لا يتعدَّى ١٢٤ صفحة- تترك لدى القارئ هزةً داخلية، ورغبةً في العودة سريعاً إلى قراءتها مرةً ثانيةً، وثالثة.




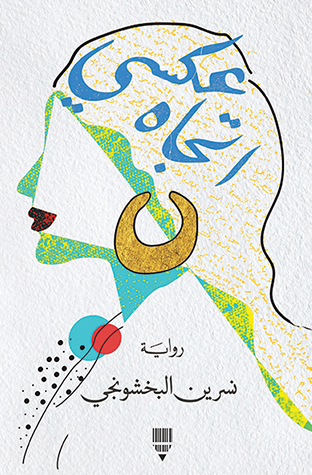



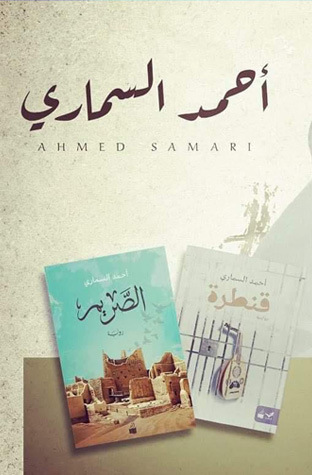
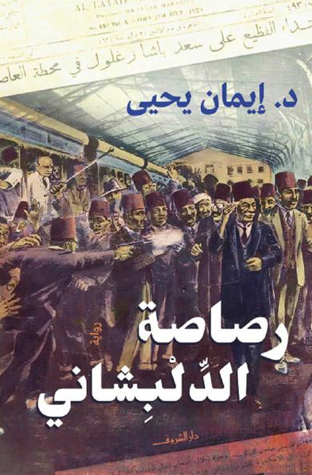
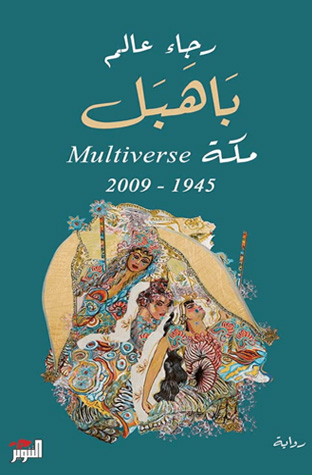



0 تعليقات