ذاكرة الأحلام في «العائلة التي ابتلعت رجالها» لديمة ونّوس
هيثم حسين
تستهلّ السورية ديمة ونّوس روايتها «العائلة التي ابتعلت رجالها» (دار الآداب، بيروت، 2020م)، ببوح راويتها المتماهية معها، بالحديث عن حلم يراود أمّها، وكيف أنها كانت تنتظر ما يشبه الحلم، وتكون صباحاتها متشابهة كأنّها تكرر مشاهد حلمية، أو من حيوات سابقة مستعادة عبر الحلم. تختفي الراوية التي لا تصرّح باسمها خلف شخصية الأمّ الحاضرة بقوّة، وكأنّها تعويض عن الوطن، والأهل جميعًا، تعطيها المركزيّة وتتمحور حولها الحكايات والأحلام، تمنحها الحيّز الذي يليق بدورها في الواقع، وتعيد رسم حياتها البديلة في الرواية، حياتها التي فقدتها، أو تلك التي تتخيّلها وتعيد رسمها بطريقتها الحكائية المثيرة.
تكشف الراوية أنّها توقّفت عن رواية أحلامها منذ زمن، وأنّه لم يعد ثمة متّسع لها مع أحلام أمها. أنّ أحلام كلّ واحدة منهما لم يعد يكمّل بعضها بعضًا كما كانت في السابق، وتعزو سبب ذلك إلى أنّ ذاكرتيهما تعيشان في مكانين مختلفين، وأنّ الأمّ تتكئ على الماضي، مسجونة فيه، بينما تعيش الراوية يومها منتظرة، وتقول: إنّها ربما تنتظر اليوم الذي ستتحرّر فيه من حكايات أمها عن ذلك الماضي المرهق. وتنتظر أيضًا، التسلّل من الحاضر إلى المستقبل.
تكون ونّوس مأسورة لشخصية الأمّ التي تصفها بأنّها تلعب بالذاكرة، تعبث بمنطقة اللاوعي عند الراوية وعندها، وتصف كيف أنّها استبدلت بشغف التمثيل على المسرح، شغفَ تمثيل أحلامها والقصص التي ترويها، وتأثير ذلك في البيت الذي صار مسرحًا يوميًّا لا تتوقّف الحركة فيه إلا في ساعات الليل. الأمّ تمثّل والراوية التي ترصد حركاتها وتكتبها في مخيلتها وروايتها، تتفرّج، تسايرها قدر الإمكان وتحاول أن تصغي وتفكّر وتدوّن في ذاكرتها معظم ما تقول.
تقول الراوية التي تبدو صورة مرآوية؛ روائية، متقاطعة مع الروائية نفسها في محطّات كثيرة من حياتها: إنّها عاشت أربعين عامًا متّكئة على ما ورثته عن أبيها من طباع ومزاج حاد وعناد. وتشير إلى أنّ أمّها كانت تذكّرها كل يوم بمدى الشبه بينها وبين والدها المسرحي الراحل، ولفتت إلى أنّه يسهل اختراع الشبه، وأنّها تفكّر الآن في أنها اخترعت كل تلك الأمور التي تشبهه فيها، لتستبقيه معها، لتصدّق أنها لم تفقده نهائيًّا، وأنّها ربما، اخترعت الشبه، لتروي لها قصصًا كان عليها أن ترويها في حضوره، لتتقاسمها معه.
تقرّر الراوية التي تقيم في لندن مع أمها، والتي تكون مسكونة بالغربة مثلها، أن تسجن الزمن وتوثّقه، فتشتري كاميرا وتبدأ في تصوير الأيام التي تصفها بالثقيلة، وتقول كأنّها أرادت أن تتخلّص من عبء ذاكرتها، أن تجعلها حبيسة ذاكرة منفصلة عنها. هي الوحيدة تمامًا، قررت أن تستقدم من يعيش معها ويشاركها الإصغاء إلى حكاياتها. تقول بتأسّ: إنّها كانت بحاجة إلى عينين تحدّق أمها بهما، وأذنين تروي لهما، فتتقاسم معها ذلك الأسى.
التحوّل الذي يجتاح حياتهما بعد الانتقال من دمشق إلى بيروت بعد انطلاق الثورة السورية، ومن بيروت بعد سنوات إلى لندن، يتحوّل إلى ضغط يومي لا مهرب منه إلا بالحكايات والذكريات والأحلام، والسعي لبناء عالم موازٍ، أو بديل، يستحضر شخصيات نساء العائلة، ويقتفي مصايرهن، عسى أن تساهم في تخفيف حدّة الغربة القاهرة.
تقول الراوية: إنّ أمّها لم تعد تروي ذاكرتها البعيدة كما كانت تفعل، وإنّ الذاكرة القريبة باتت هي حديثها اليومي. وهي تعيشها معها مرات ومرات. تعيش الموت كل يوم، والفقدان، وتلك الأرض الواهية والطرية التي تمشيان فوقها، ضائعتين بين الماضي والحاضر. تعيش كل لحظة، الإحساس بعدم الانتماء والحنين إلى بلاط بيت تملكه، في شارع أليف.
تقرّ الراوية بالأمر الواقع، ولا تحاول تغييره، ترتكن للغربة وتأثيراتها القاسية، وتحاول عبر الحكايات والذكريات والأحلام ترويضها، فتراها تعيش على وقع أحلام أمّها وتخشى أن تختلط عليها الأمور بين الحلم والواقع، وأن تضيع معها في تلك الذاكرة الثالثة التي تعيش معهما. وتصف تلك الذاكرة بذاكرة الأحلام التي تبلور عالمًا متكاملًا بشتّى التفاصيل.
تخترع الأمّ زمنها الخاصّ بها، تعيد تأثيث الأمكنة والأزمنة بالشخصيات التي تستبقيها في ذاكرتها وأحلامها، تعيش زمنها المتخيل الذي يفرض نفسه على الراوية التي تتيه بين الأزمنة بدورها، وتراها تحلم دائمًا باستعارة أمور أخرى، كالطمأنينة مثلًا، إلا أن محاولاتها تتعثّر.
تستذكر حادثة بين أمها وأبيها، تقول: إنه عندما اختفى السرطان فجأة من جسد أبيها، سألته أمها بنبرتها الضاحكة وصوتها الطفولي: «وين راح الكانسر حبيبي؟»، فأجابها: «راح بطمأنينتك». تأسف أنّها لم تستطع استعارة ولو قطرة واحدة من تلك الطمأنينة. وتقول عنها: «أمي التي لا تكبر، لم تبرع بالتمثيل فقط، بل باللعب أيضًا. تلعب بنظرتنا إليها. تجعلني أتوهّم، أنها هي من تحتاج إلى الطمأنينة. وأنا لا أعرف كيف أمنحها الطمأنينة».
شغف، ماريان، هيلانة، نينار، إضافة إلى الأمّ والراوية، يمثّل أركان العائلة التي تصفها الروائية بأنّها ابتلعت رجالها، والابتلاع هنا يكون كناية عن سوء الحظّ الذي يرافقهنّ، وعن اللعنات التي كانت تحلّ على الجميع، سواء الحروب، أو الأمراض، أو الخيبات والنكسات، فتصيب نساء العائلة وتحيلهن إلى الفراق، والرحيل، والوحدة والوحشة.
تجسّد حكاية نينار ذروة الأذى النفسيّ الذي يشكّل رصاصة الرحمة التي يطلقها الزمن، القدر، على الأمّ المسكونة بالراحلين وأصواتهم وروائحهم وجميع تفاصيلهم، فتقع فريسة للأسى والقهر على نينار التي تشبهها إلى حد كبير، نينار الثورية التي تتحدّى ظلم النظام، وتخرج في المظاهرات، ثمّ ترفع صوتها عاليًا متحدية جبروت الطاغية، تقتلها الغربة، وتقضي عليها، تبتلعها بدورها وتبقيها حسرة في قلب الأمّ وقلب الراوية معًا.
الغربة التي تشعر بها الراوية جزء من غربة معشّشة في العائلة؛ إذ تذكر أنّ إحساس الغربة في روح جدّها تعزّز مع قدوم البعثيين إلى السلطة في دمشق، ورحيل صديقه خالد العظم إلى بيروت، ثمّ سجن جدها ستة أشهر بعد انقلاب الثامن من آذار على خلفية علاقته بخالد العظم، وتقول الأمّ الشاهدة على أحداث التاريخ المعاصر: إنّ الجدّ بكى صديقه كما لم تره يبكي من قبل. وتسترسل الراوية في الحديث عن زمن الانقلاب الذي شوّه تاريخ سوريا ومستقبلها، إنّه ليس وحده خالد العظم من رحل مع قدوم البعثيين، بل تبدّلت رائحة ذلك الزمان أيضًا.
وفي النهاية التي لا تخلو من تراجيدية وأسى، تصرّح الراوية بأنّ الأمّ الممثّلة دور البطولة في حياتها، وعلى خشبات المسارح، اكتشفت أنها فقدت مع الزمن قدرتها على التمثيل، تتغير بمرور الزمن، تكتسي ملامحها تأثيرات الزمن والغربة والمآسي، وتبقى الجملة الوحيدة التي لا تعرف ابنتها أين تعلّمتها، إلا أنها تنطقها بإنجليزية صحيحة وواضحة ولا يشوبها أي تلكّؤ: «فقدت كل عائلتي خلال السنتين الماضيتين».
ترمز صاحبة «الخائفون» إلى أنّ الفقدان يكون ملازمًا للراوية وأمّها، كما لغيرهما من السوريات والسوريين الذين اضطروا للخروج من ديارهم عنوة، وعيش الذكريات كأنّها واقع معيش، وأنّ الزمن يبتلع كلّ شيء، والغربة بدورها تمتلك قدرة وحشية فظيعة على ابتلاع الأحداث والشخصيات؛ لتلقي بها على قارعة الأحلام والذكريات، فتبقي الجميع أسرى للخيبات والهزائم، ونزلاء الشعور الدائم بالفقد والرحيل المتجدّد كلّ مرّة.
عن مجلة الفيصل




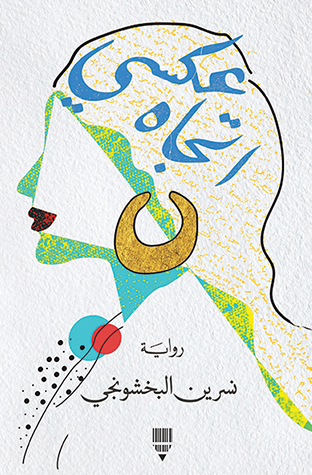



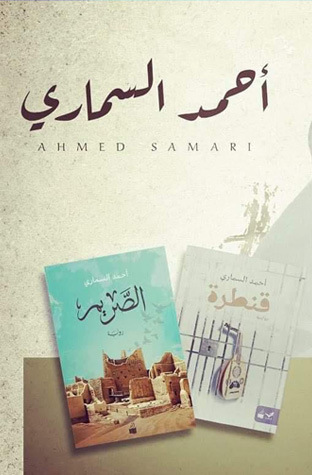
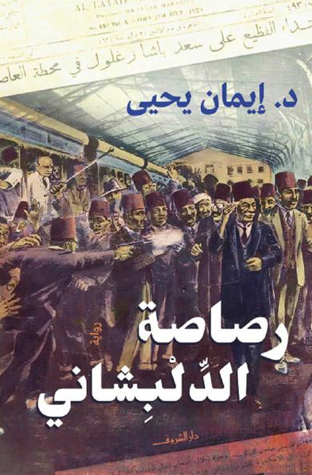
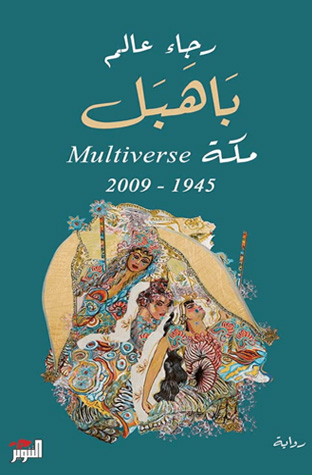



0 تعليقات