"ضوء برتقالي" لنادية الأبرو.. ثنائية الحب والألم
ماذا يعنى أن تبقى حين يهاجر الجميع؟ أن تخلص حتى النهاية في حبّ من لم يأبه بك؟ هي حكاية الأزمنة حتى تتوقف الإرادة وتخبو الخيالات، وتتحول معها الأيام والسنون لأعقاب خاوية لا يجدر بإنسانها إلا الاتكاء بالموت للاطمئنان على نفسه.
ربما يبدو في البدء كتداخل سوداوي بين الحب والألم، أو ارتدادا حميما لآلام الإنسان صوب الاعماق الدكناء، لكنها تؤول لاختزال قصة عذاب الروح وخلاصها بإنصاتها الجواني لأوجاع كل الكائنات مهما تبدلت الأجساد وتشوهت ملامحها البريئة وإن غدت كحوض نشادر تتجمع فيه كل الخطايا والأوبئة.
هكذا يبدو تفسخ الأزمنة عند نادية الأبرو مدخلا للثبات في خضم التدافع الهائل، وإن بدا لنا للوهلة الأولى كضرب من الجنون، لكنه الحكاية حين بدأت كجرح عاطفي في قلب أضرمه الحب لدرجة اللامعقول وسط البصرة جنوبي العراق هيّأت كل الأوهام لدينا بإيغالها مبكرا في أغوار الانتقام، بيد أن صاحبته ظلت رمزا لمضي الخيبات حتى النهاية وبمفارقات نشوء رغبة العيش من غياهب روح متقدة بالحب عند هناء الخصيب، في تعايش محفوف بمغبات النفور الجماعي من المكان، مفعم بكل الإيحاءات القاطعة لتلخيص مايجري من تداع ضمن تمزق دوائر اجتماعية أوسع ،حالة خاصة للانتماء للمكان (أي مكان) دون الاكتراث للوحدة الموحشة حين يغادره الجميع، دكتور رياض، هند ، نور، دكتور حيدر، صالح، كاستدعاءات مكلومة لأسباب جديدة للعيش والإنتماء للوجود مجددا من حبيب ترجل منذ عقود.
رواية ضوء برتقالي، أشتات قلوب اجهدها الجموح وقنوط عقول مافتأت تختزل الانحدار الشامل كمرايا مهمشمة تبرر الخطايا لتذليل السبل لأشباح ليليلة تتحرك بين خذلانات الحرب و الحب على السواء،كأنها ترسم حدودا للأمل بطمسها للأمل المريض المتاح بالإنصات لفيض من الإحساس الصادق لدبيب ساحر، تحدثه نقرات انامل رفيعة بداخل شخصيات خاطفة تمرق للتو بلاملامح وذات ارواح متداخلة ببعضها ،كأنها تكتنز في طياتها فصام الخطيئة حين تتبرعم على اغصان ندية نظرة أشبه بشتلة قد صالحة لمنحهم كل العطاءات الحميدة، توق جامح لرباطة جأش غائرة منوط بها إمتصاص بثورالمآلات قسرية حين تتقيح على محيا مشرق متعافٍ، وتفضي بإنسانه كنزعة وحشية منفلتة تسكن جسد ذاو وتسوقه لمعترك مصيري هوالأقسى والأشد إنحرافا.
رواية تحمل كل المسميات وكل السمات ،اللاحكاية،اللازمن واللامكان اللابطولة ،الحداثة ومابعد الحداثة، السرد وتيار السرد، لكن إيقاعها فريد، لايشبه الميتا سرد الإ من باب إيراد السارد العليم بمواضع لا تذكر لإفراغه من الحاجة الفنية، ولا تشبه تيار الوعي إلّا من سياقها الشكلي الخادع، ومن سكون حاضر الشخصيات وإعتمادها كليا على فلاش باك للعودة للماضي لعقود من الزمن، لكنها من الوهلة الأولى تنحو إبداعا دون الاكتراث لكل تلك التوصيفات،كتابة لاترتئي الإ لإفراغ دفق تيار إحساس حبيس على الورق ،وليس غريبا حين تتشكل بنية الرواية من أشتات لاوزن لها من الوقائع والأحداث،في سرد سلس ذكي لا يحسسك برتم صناعة المشهد بل يباغتك ويحلق بك فوق تيار ساحر خفيف، إنه تيار الإحساس بالأشياء وتيار يغمرنا ثانية كسريان لذيذ لانستفيق منه حتى ينتهي ،سرد غير مباشر وغير متصنع ،لايمكن ان نقتفي أثره كفعل متسلسل او كإرتدادات عكسية مرتبة لذبذات الذاكرة ،بل نقرأ ونسمع شذرات مما تسوقه مخيلة هناء وكأنها تجمع زهرات شتى من اشجار مختلفة تقف يانعة على مسافات متفاوتة بين عشب كثيف مخضر ،وكل ماتقع عليه عيناها تلتقطه وماتلبث حتى تذهب بعيدا لتقطف زهرة متوارية بين الأوراق الكثة، لتعود مجددا لتظهر لنا وردة مكتملة البهاء من ذات الموضع الأول ومن نفس الشجرة التي بدت لنا خالية تماما،بدون ان يداهمها التعب بقدر ماتتاعظم قدرتها على الحركة ،والمضي في التنقل كفراشة تزيد من ملامح الأشياء وتكسبها سحرا فياضا كلما تحط على غصن او زهرة ،هنا اوهناك ، هكذا تأخذنا هناء او بالأحرى تلتقط لنا الاغصان اليابسة من حياتها وحياة العراق وبالأحرى حياة إنسانية مجردة ، بحسب مايبرق للتو بمخيلتها ،تمضي بقص مابعد زواجها بصالح ،ثم تعود بنا بغتة لفقرة بسيطة لماقبله ،ضرب من الحرية واللإلتزام الصادق حينما يبثان في الكتابة شيئا من الألفة تفضيان في تشكيل منظور بللوري مباغت الوقع والتأثير، وحين نتمعن فيه أكثر نجد أن الجمال لم يكن من مباغتات المجسم البراق بل من الأجزاء الصغيرة التي شكلته ،وكأن الوجود يبنى من العدم والحياة من الموت والحب من الألم ،الظاهر من الباطن وهكذا ...
لكن حب الدكتور رياض بقى عامرا بقلب هناء وظل محصنا من طغيان اللامعقول حين ظل يفتك بحيوية الضمائر ،ثبوتا لايشي بجذور الحب كغريزة لبقاء الذات اولا حين تفيض النفوس بعفونة تآكلها اللانهائي ،بل يبدو لنا كحب لاشعوري مركب ،بل هو أقرب لتحول العاطفة وتفسخها بسادية متماهية تتمدد ضمن إبقاء صورة الحب بالذهن بنفس كيفية المنشأ ،لتعيش هناء اطوارا مركبة من الحب وإرتداداته وكأنها تعيش حالة حب لاينته ،ويفضي بها ذلك الوهم الأثير في الإنتقال بسلاسة من أقاصي الإنسانية إلى غياهب السادية المتوحشة في إستيهامات مفرطة لصورة الحب الأول، فارتباطها بصالح تلك الشخصية البسيطة الزاهدة ،يفسر جوهر الحب وتحوله اللامرئي عند هناء وصموده الصوري وسط الطوفان الهائل ،وكأنه ميلا غريزا للنأي بالذات بعيدا عن اطواق نجاة متاحة هيّأتها لها إرادة خفية، لاتزيدها الإ إمعانا في قياس تشظى واقعها وإلتئامه ضمن حنين قوي يتصاعد من الأعماق وليس من خارجها ،أشبه بعودة حميمة لتفسير الخليقة وفق نفور الإنسان من الإرتهان للممكن واللإعتراف بمحدودية الإدراك ،وضربا من محاججة غير معقولة بين الحرية المطلقة والإستبداد المطلق فكليهما يفضي إلى عذابات لاتحتمل ،وكأن حب هناء هو ذات الطاقة البليغة التي تحتاجها للتوغل للألم لمقاومته من ذروة العنفوان ،نكاية بالذات اولا وبالآخر ثانيا ،لمقاومة الآلام الأفظع .
هكذا سعت نادية الأبرو لرسم بطلتها هناء كوجود إنساني مطلق لايندثر، بحيث ظلت شخصيتها تكبر وتتعالى وسط تهافت بقية الشخصيات وإندحارها، بحيث بدت كل الشخصيات كألوان باهتة بات وجودها ضربا من سطوع معالم هناء وملامحها من الداخل، كإصرار لانهائي لبعث الأمل من حطام الخيبات،وإيغال في تفسير الإنسانية مجددا كتعرجات شوهاء للإيمان بمعان ميتافيزيقة عبر التنكر لها بعيش مرارة القسوة والتشبث بها كالأمل الكامل ،وكإنفلاتات حتمية للخطيئة الأولى كجوهر نفيس يشكل كل العصور و الأزمنة، وغدت الرواية بمثابة تجسيد عميق للوحة إدوارد مونخ كتلاق جامح بين توق الأرواح الخلاقة وتفسخ الأجساد المعطوبة بالشهوات وكل النزعات المتوحشة ،إنها لوحة حب وألم أتت كصرخة من الداخل ،أنين مخبوء وسط ارواح وشخصيات متداخلة ،تنصهر وتتحلل بداخل الشخصية الأم هناء الخصيب.
إنها لوحة إنسانية خالصة وقصة ترسم ملامح رجعة الإنسان للداخل ولو اوردت الكاتبة وقائع إجتماعية وسياسية ضمنها ،لكنها كانت سياقات جانبية تظل كبقع لونية باهتة في خضم تلازم رحلة عودة حميمة للأعماق تعكس وبجلاء فريد مدى حاجتنا لها كملاذ غير متخيل او بالأحرى غير متاح للكثيرين لإستبصاره وإستجلاء معانيه البراقه الذائبة في نقطة ما وفي مكان ما بداخلنا او في أية بقعة بعيدة بهذا الكون الفسيح الممتد.
الرواية نت




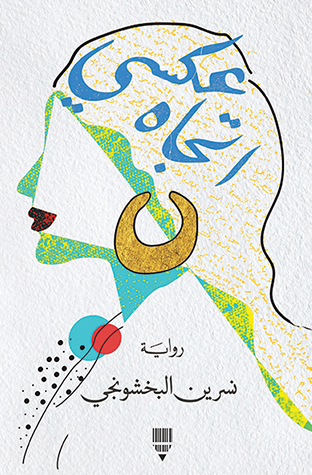



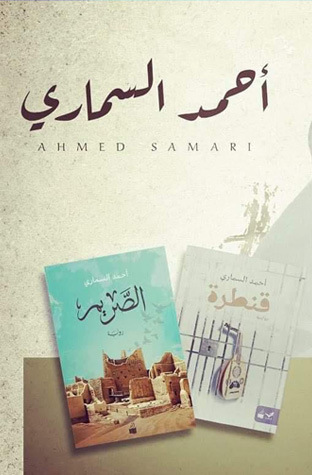
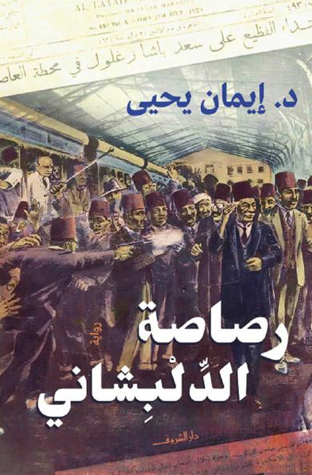
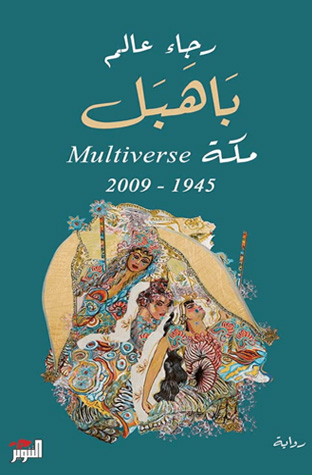



0 تعليقات