رواية سورية بثلاثة أصوات عن الريف الدرزي المجهول
تعتبر رواية “أرواح صخرات العسل”، تتمة لمسيرة الكاتب السوري ممدوح عزام، التي بدأها منذ روايته “معراج الموت”، في الكتابة عن داخل قرى وبلدات منطقة جبل العرب (جبل الدروز، محافظة السويداء جنوب سوريا)، المنطقة التي ينتمي إليها، لكن ما يميزها، هو ذلك الربط، بين داخل القرى الغامض وما يحدث في سوريا حاليا، وهو الحاضر الذي جاء كنتيجة حتمية لما حصل في الماضي.
رغم أن الكاتب السوري ممدوح عزام، قليل الإنتاج نسبيا، إذ في جعبته فقط مجموعتان قصصيتان؛ الأولى بعنوان “نحو الماء” وقد صدرت في العام 1985، والثانية بعنوان “الشراع” التي صدرت في العام 2000، وخمس روايات من ضمنها روايته الأحدث “أرواح صخرات العسل”، إلا أنه يعتبر من الكتّاب السوريين الذين أثاروا الاهتمام والجدل، ليس هذا فحسب، بل وأثاروا النعرات الطائفية على حد قول مشايخ الطائفة الدرزية، وبالنسبة إلى عزام كان ذلك من خلال كتاباته الجريئة التي تخطت حدود الأسرار والكتمان، وقد رسخ ذلك أيضا في روايته الأخيرة.
تدور أحداث رواية أرواح صخرات العسل، الصادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع ودار سرد للنشر، حول ثلاثة شبان (عابد وخالد وحامد) من خلال رحلة طفولتهم وشبابهم. إنها رواية عن الصداقة والحب والتضحية في قرية يعاني شبانها ذكورا وإناثا، من سيطرة قيود وقوانين المجتمع والطائفة على حياتهم، بدءا من سلطة الأب، مرورا بسلطة المدرس، فمدير المدرسة برهان العلمي الملقب بـ”برهان النبريش”، على اعتبار النبريش هو الأداة التي يعاقب المدير تلامذته بها، انتهاء بظلم المجتمع والمرجعيات.
الريف الدرزي
رغم أن الرواية تبدو للقارئ حتى نهاية فصلها الأول الطويل نسبيا، رواية عادية ستكتفي بكشف المستور عن تلك القرى وستعري التخلف والظلم السائد فيها، إلا أنها في الحقيقة ومع بداية فصلها الأخير، ستنحو إلى مكان آخر كليا، لتنقل بالتالي، ليس فقط ما حصل في سوريا منذ العام 2011 ويستمر حتى الآن، وإنما تداعيات تلك الأحداث على شباب ونساء تلك المنطقة، التي ظلت بعيدة إلى حد ما عما يحصل، واكتفت بالاستماع فقط، «بصوت متعب، ترتجف بداخله الحروف “إني سامع أصواتا كثيرة جديدة حوالينا.. أصوات شو هاي؟ عم يقولوا في ثورة يا أبومحمود”».
فمنذ روايتة الأولى (معراج الموت) التي تكشف الظلم والقسوة الواقعة على المرأة، والتي تحولت لاحقا إلى فيلم بعنوان “اللجاة”، مرورا بروايته “قصر المطر”، التي صدرت عن وزارة الثقافة في دمشق في العام 1998، والتي اعتبرها بعض النقاد، واحدة من أهم الروايات العربية في العصر الحديث، تأتي رواية “أرواح صخرات العسل”، لتتابع تلك المسيرة التي أراد الكاتب روايتها ورؤيتها.
لكن ما يميز “أرواح صخرات العسل”، هي قدرة المؤلف على إدخالنا في عوالم تلك المنطقة، إنسانيا وجغرافيا، إنها رواية عن الشوارع، والأماكن، وعن صخرات العسل الثلاث، عن قصص الحياة والحب، عن المرأة التي تقف جنبا إلى جنب مقابل الرجل، إنها الأم، والأخت والحبيبة، والداعرة المجبرة على خطيئتها مقابل عنف الرجل المستبد بضعفها، إنها الجزء المناطة به أسباب المتعة والقهر، إلى درجة أن تلك العوالم تجعلنا كقراء جزءا من تلك الرواية، بل ومتورطين أيضا في صمتها المجتمعي، أولا، كقراء، لا حول لنا ولا قوة، وثانيا، كسوريين وهذا الأهم، لأننا نكتشف كم نجهل ريفنا، فما بالك بالريف الدرزي الذي أغلق الباب على نفسه، كل ذلك، عبر لغة سردية أشبه بالسينمائية منها إلى الشعرية، لا تخدش الحياء مهما تطاولت وتجرأت على وصف الواقع.
السرد كان عبر لغة سردية أشبه بالسينمائية منها إلى الشعرية، تتطاول وتتجرأ على وصف الواقع بدقة عالية، والأهم من كل ذلك قدرة الكاتب على استخدام وسيلة جديدة في السرد، عبر ثلاثة رواة، الأول هو الروائي الأساسي، كاتب الرواية، والناقل الوحيد لها، من اللغة الشفهية إلى المكتوبة، أما الراويان الآخران اللذان ينقل عنهما، فهما نائل الجرف، صديق عائلة عابد أحد أبطال الرواية، وأحمد الشايب الملقب (أحمد لدّي مصادري)، وهو السند الأساسي للراوي نائل الجرف، والشاهد الوحيد على جزء كبير من حياة هؤلاء الثلاثة، رغم أنه يكبرهم سنا، ويبدو أن الكاتب استخدم تلك الحيلة في سرد روايته، لتكون له الحرية في اقتراح عدّة مخرجات لأحداثها وتفاصيلها، والتي لا يمكننا أن نجزم أين الخيال فيها من الحقيقة، وأين الواقع من المتخيل أو المؤلّف.
الحرب والنبوءة
رواية “أرواح صخرات العسل”، المؤلفة من 220 صفحة من القطع الصغير، قسمت إلى 12 فصلا، ومجمل فصولها صغيرة جدا، بعضها لا يتجاوز الصفحة الواحدة، بينما فصلاها الأول والأخير، فيحملان لبّ الرواية وغايتها؛ ففي الفصل الأول، يحاول الكاتب أن يسرد قصة حياة هؤلاء الفتية، وأسرار الصداقة التي جمعتهم إلى يوم الدين، والتي كانوا يبوحون بها عند صخرات العسل، على اعتبارها صخرات لا تمتص الصوت، بل تقسمه وتنحته كما يشرح نائل الجرف أحد رواة العمل، وقصص عشقهم التي ذهبوا بها إلى سهل الزرازير، صارخين هاتفين عاش الحب، تاركين أصواتهم، آملين أن تبقى هناك إلى آخر أعمارهم.
أما الجزء الثاني عشر والأخير، فهناك تحوّل جذري في الرواية وخطوة للخوض في الألم السوري، الذي حل منذ سنوات، والذي أثر بشكل مباشر على هؤلاء الفتية الذين أصبحوا رجالا بشكل مفاجئ، وكأن الكاتب، أراد عبر تلك الرواية أن يقول لنا هناك حرب في سوريا، لكن شخصيات الرواية كما القراء لن يروها، بل سيعرفون فقط تداعياتها على الحياة وعلى أرواح الناس خاصة، فها هي الحرب قد أخذت اثنين من الأصدقاء (خالد وحامد)، بعد أن أصبحا ضمن قوات الاحتياط في الجيش، وماتا بشكل عبثي حتى قبل أن يعرفا ماهية تلك الحرب أو لماذا حصلت.
أما موت الصديق الثالث عابد، الذي لم يجبر على الالتحاق بأي جهة للقتال، فكان موتا حتميا، “إنها النبوءة التي نطق بها فتى في الرابعة عشرة من عمره، ويتابع المشي نحوها بدأب قدري يشبه الشغف، فهل يمكن للمرء أن يكون شغوفا بساعة موته؟”، فها هو مع نهاية الفصل الأخير من الرواية، يسير بقدميه إلى حتفه عند موقع صخرات العسل، الشاهد على أرواح من أحبهم وصادقهم، وكأنه بذلك يستعجل الموت، بل لنقل اللقاء، الذي بات يتمناه كل سوري فارقه أحبابه جراء تلك الحرب أو تداعياتها.
عن صحيفة العرب اللندنية




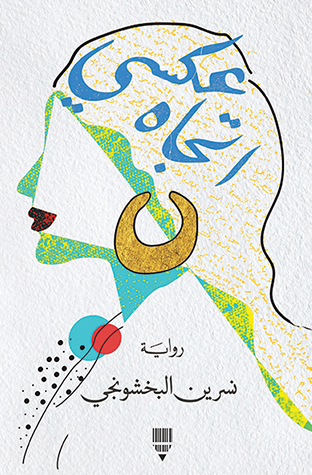



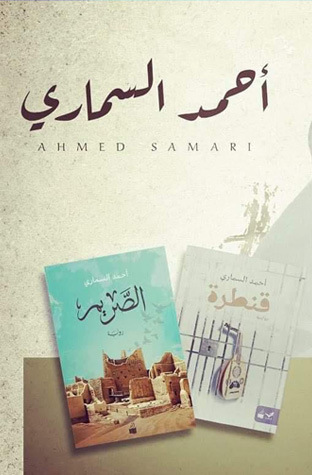
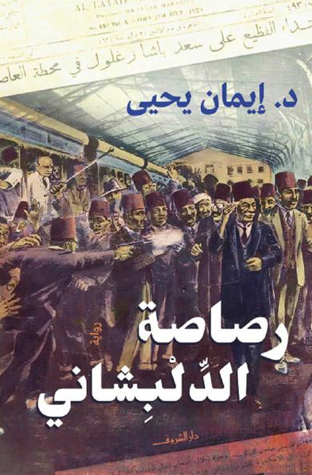
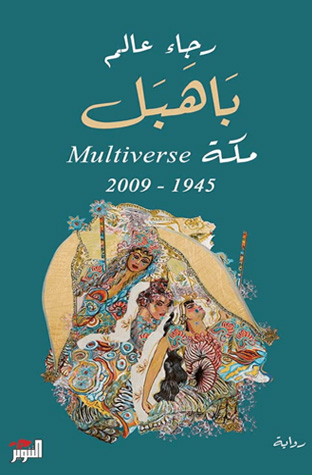



0 تعليقات