«فريج المرر» رواية المآسي السودانية الصغيرة
تعدُّ رواية «فريج المرر» (المركز الثقافي العربي) للكاتب حامد الناظر واحدة من الروايات السُّودانية المحظوظة، فهي حصدت نجاحاً بعد حصولها على جائزتين مرموقتين في عام واحد. فازتْ باكورة الناظر بجائزة الشارقة للإبداع العربي للعام 2014، وحظيت في العام نفسه، بجائزة «فودافون- قطر» للرواية. قسَّم الكاتب روايته إلى ثمانية فصول، وكل فصل إلى وحدات صغيرة تتراوح بين ستّ وتسع وحدات ساهمت في تسهيل متابعة أحداث هذه الرواية الضخمة. وصدَّر مداخل هذه الفصول بعبارات فيها شيء من التأمل والعمق منسوبة إلى واحدة من شخصيات الرواية. تتداخل الشخصيات في رواية «فَريجُ المُررّ»، لكنّ «الطيّب» (وهو اسم سوداني بامتياز) يُمثّل الشخصية المحورية في النصّ، إضافة إلى شخصيات أخرى مثل اَستير، سارا، مجنون ليلى، مجدي، بيتي، عباس، حمد المرّي، جيمي، إيلْسا، وعدد آخر من الشخصيات الثانوية. لكل شخصية من هذه الشخصيات قصة مأسوية لكنها ممتعة ومشوِّقة استطاع الكاتب نسجها بطريقة احترافية غاية في الإمتاع. لكنّ القصة الأساسية تكمن في حيِّ «فريج المرر»، وهي قصة المكان في تحولاته وتبدلاته الجمالية والوجدانية. هو مكان جامد ومحايد، لا يحفل بالغرباء ولا يعبأ بغربتهم كثيراً، طبيعته الحيوية الصاخبة لا تحفل حتى بأبنائه. هكذا يصفه المواطن الإماراتي العريق صديق الراوي، بلسانه البدويِّ: «الحين فَريجُ المُررَ صار وكأنه سوق «ميركاتو» اللي في أديس أبابا. تدري؟ أنا ابن الحي صرت اليوم غريباً فيه، والله، لولا أني أتكلم الأمهرية كان الحبشيات باعوني واشتروني فيه مثل التيس الفحل!».
خدعة «الحدوتة» الواقع أنه على رغم تعدد شخصيات الرواية وثراء حياتها بالتجارب والاختبارات الحياتية الصعبة، يبقى حيّ «فريج المرر»، الذي يبدو محايداً وبارداً تجاه ساكنيه والعاملين فيه، محتوياً أكثر من قصة ساهمت في صنعه وجعله هكذا. فهو حيّ عريق من أحياء مدينة دبي، أشبه بحيّ شعبي وسط مدينة حديثة ناهضة، له قدرة جذب هائلة لكلّ زائريه من مختلف الجنسيات، بما يكتنفه من سحر وغموض وحيوية فائقة تكاد تسير على قدمين في شوارعه المزدحمة. تحكي الرواية بتتابع سردي متصاعد وشيِّق حدوتة متكرِّرة وبسيطة وهي قصة شاب سوداني يقرر الهجرة إلى إمارة دبي، شأنه شأن كثير من الشباب السودانيين. يقول الراوي: «كواحدٍ من أولئك الآلاف الذين يتسربون كل يوم، قررت أن أغادر، تاركاً كل شيء في مكانه، حتى الذكريات». وفي دبي، تحديداً في حيّ «فريج المرر»، يتعرف إلى نفسه وعلى آخرين وأخريات. النساء والفتيات الأثيوبيات اللواتي تعرَّف إليهن في الحيّ العريق عرَّفنه بنموذج جديد ومغاير عن المرأة. اقترب الراوي كثيراً في علاقاته الإنسانية بفتيات أثيوبيات: أستير، بيتي، سارا، إيلْسا، أسهمن في تعقيد حياته بمقدار ما ساهمن في إثرائها وإغنائها بصورة شكلت شخصيته وصقلتها لاحقاً. كما أن علاقة الراوي بشخصية المواطن الإماراتي العريق حمد المرّي وما تتمتع به شخصية المرّي من جمالٍ وعمقٍ ونزق وتيه وجودي. هذا عوضاً عن تعرفه إلى شخصية مجنون ليلى الشاعر الذي يكشف عن هويته الحقيقية كرجل مباحث في نهاية الأمر بعد أن يحكي مأساته الشخصية والغريبة غرابة شخصيته مع فتاة أحبها في بورتسودان والنهاية المأسوية التي انتهت إليها حياتها.
نهايات فاجعة تنتهي معظم شخصيات الرواية نهايات مأسوية فاجعة، سواء أكانت شخصيات نسائية مثل إيلْسا التي تنتحر أمام الراوي في مياه الخليج، أو رجالية مثل المرّي الذي انتهى إلى صمت أبديِّ بعدما فقد النُطق نتيجة عدم تمكنه من معرفة مصير ابنته التي هربت بها أمها إلى أديس أبابا. أما «مجنون ليلى» فتنهار به بناية عتيقة فيتحوّل أشلاءً ممزقة في خاتمة المطاف. لا يوفر المآل المأسوي شخصية مثل أستير التي تجمع كلّ المتناقضات في شخصيتها. إنها مناضلة ومثقفة مهتمة بالتاريخ، ونادلة في مقهى. تختفي في نهاية الأمر في حيّ فقير مترب من أحياء أديس، فيطويها النسيان ولا يبقى منها سوى رسالة تركتها للراوي عند صاحبة المقهى التي كانت تعمل معها. لكنّ الرسالة نفسها تذوب حروفها في مياه الخليج عند محاولة الراوي اليائسة في إنقاذ إيلسا من الغرق، فيضيع آخر خيط كان يمكن من خلاله العثور عليها أو التعرُّف إلى مصيرها الغامض. ولا تفسير لكل هذه المصائر والمآلات المفجعة سوى داخل حيّ «فريج المرر» ذاته. فالراوي يُعبِّر عن هذا المعنى في إحدى تأملاته: «منذ أن عدتُ من أديس أبابا، بدا لي فريج المرر مختلفاً، كما لو كان جداراً شاهقاً بين الناس وماضيهم، أماناً منه، من يدخله ينبغي أن يخلع تاريخه، ذاكرته، وينفض- على عتباته- نعليه من غبار أيامه السّالفة». هكذا إذن. هذه اللعنة الوجودية تكمن هنا. في شوارع هذا الحيّ العتيق الذي جمع متناقضات الحياة الإنسانية في تجلياتها الحميمة. يتميز أسلوب الكاتب الذي اختيرت روايته «نبوءة السقا» ضمن اللائحة الطويلة لبوكر 2016، بلغة سردية ناصعة وجذّابة، تميلُ للوصف والتصوير الشيِّق للأحداث والأماكن، ولا تخلو لغته من طرافة وذكاء فطري مجبول بقوة الملاحظة. يقول الراوي، وهو يصف لقاءه مع إيلْسا، في المقهى، لحظة تحركها من الطاولة التي كانت تجلس عليها وهي تريد أن تنضم إلى طاولته: «قامت من مكانها فجأةً كما تقوم النوافير»، وفي مكانٍ آخر يصف لحظة تعرّفه الأولى على أستير: «تلك الثقة التي كانت تملأ وجهها، ذلك البريق الذي كان يلمع في عينيها بدأ يتقهقر شيئاً فشيئاً أمام نظراتي الجائعة، وسال مكانه أسىً عظيم كجراح معارك غابرة، كآثار هزائم قديمة طفحت بوجهها بغتة، نفضت شعرها إلى الوراء وابتسمتْ، ثم رمشتْ بأهدابها رمشاتٍ قصيرة متتابعة، وكأنما تنفضه من غبارٍ عليل». يبرع الكاتب أيضاً في وصف الأماكن من الداخل، تحديداً عندما يحاول رسم جغرافية المقاهي الداخلية المنتشرة في الحيّ العريق في قلب مدينة دبي، فهو يرسم مشاهد حيّة للناس وحركتهم وروائحهم وأحاديثهم وتبدلات مشاعرهم المختلفة داخل تلك الأماكن الضيِّقة. مشاهد من شدّة دقة الوصف تكاد تشم فيها روائح البخور وتتذوق طعم القهوة الحبشية والفشار المحمّص.
عن صحيفة الحياة

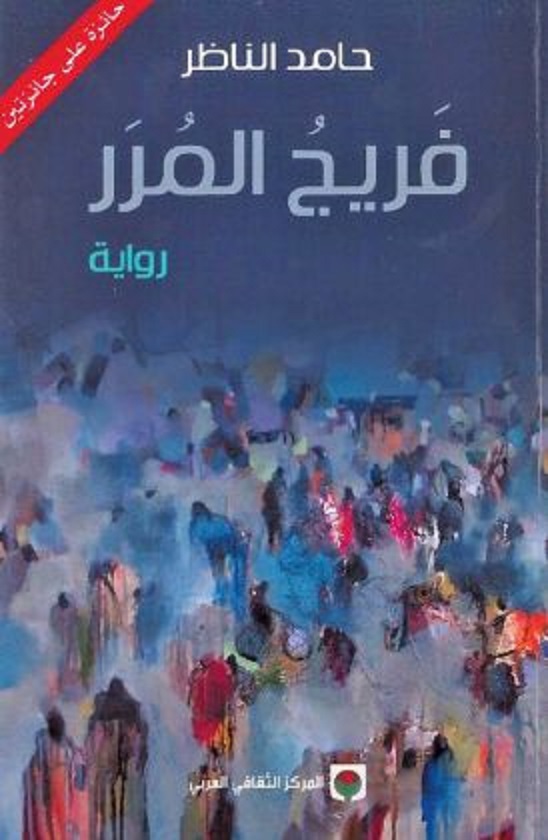


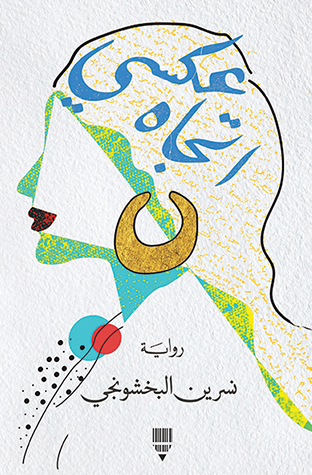



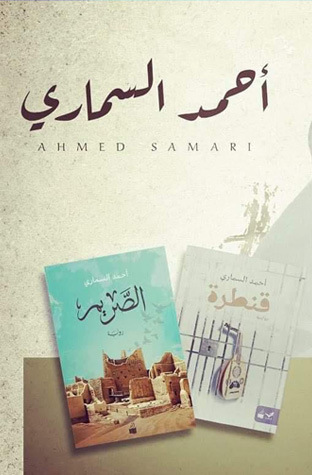
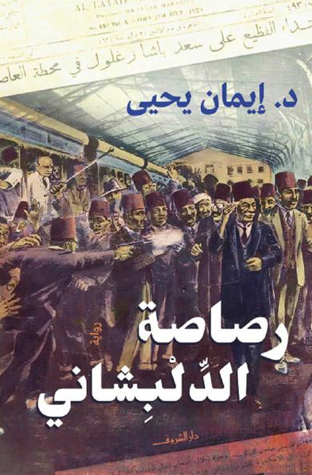
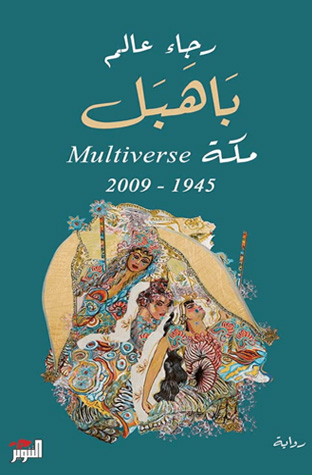



0 تعليقات