أزمة الشعور في رواية 'جسد ضيق' لهويدا صالح
رواية الناقدة هويدا صالح انتصرت للوجع والقهر بطولها عبر سردها الماتع السلس الذي نجده في حكايات العشق في صعيد مصر وعلاقاته الاجتماعية القلقة بعصبيّتها وعقيدتها.
تعودت أن أقرأ أيّ عمل يقع بين يديّ مرة أولى سريعة، وأخرى خالصة مدققة للتعلم أو الملاحظة. في المرة الأولى أخرج كل انفعالاتي بالعمل على هامش المطبوع بتأشيرات للتأمل فيها ومحاولة الحوار معها في قراءتي الأخرى. ربما أفعل ذلك في محاولة للوصول إلى درجة من الحياد حين أكون بصدد الكتابة عن ذلك العمل، فهل نحتاج في قراءاتنا إلى الانفعال أم الحياد؟ أعرف أن الأمر عندي بين بين، وتلك آفتي التي أجتهد -بحثيًا- للانفلات من براثنها. يحمل عنوان هذه الرواية حتى بتصميمه وبنط الكتابة- ثمة تأويلات محتملة نحويًا وبلاغيًا، إذ تأتي كلمة “جسد” ببنط “البولد” الغامق للون “دم الغزال” فاللون تسميته هنا للتقريب- لنكتشف طوال القراءة أن الجسد يمكن أن يتحول إلى أزمة خاصة عكستها تفاصيل الأجساد -الشخوص- التي حكت عنها هويدا صالح وعن ضيقها المحتمل نفسيًا واجتماعيًا، بل وإنسانيًا في تأويل ما، عبر ذلك الضيق من المساحة المتاحة لهذه الأجساد، والتي ضغطتها بأزمات خارجة عن إرادتها، ودفعت بها نحو مزيد من الضيق يُضاف إلى ضيقها الأصيل في الصعيد المصري وثقافاته الشعبية والعقائدية وبعض طائفيته التي نُصرّ على إنكارها، ونحكي عنها ببعض التحفظ والحجل بديلا عن مواجهتها وفضحها.
وأما عتبة الإهداء عند صالح، فكانت لبنتها الأولى المحبة، وفي ظني الشخصي أراها أساس الكتابة لمن يمارسها، والبيت والعائلة، والمتمثل في إهداء العمل إلى “بيت أنتمي إليه وعلمني المحبة” -كما جاء بنص الإهداء- وإلى بعض تفاصيل ذلك البيت من الأب ثم الأم.
هنا ثمة سؤال ضربني لحظة القراءة الثانية المتأنية، إذ كانت الرواية -وهويدا صالح- تحاول فضح أزمة المرأة في صعيد مصر -بغض النظر عن عقيدتها ومستواها الاجتماعي- فكيف لم تنتبه إلى أنها وقعت في نفس الأزمة بتقديم الإهداء إلى الأب مردفًا بالأم؟! وكأنها -وهي ابنة الصعيد بالأساس- وقعت بلا وعي في تلك الأزمة التي تحاول معالجتها بروايتها، والتنبيه على كون المرأة “جسدًا” يساوي الرجل “جسدًا آخر” في حقه من المحبة والحرية. أعرف أنه ربما يرى البعض سؤالي ذلك ساذجًا للغاية، ولكن ما أردت الإشارة إليه هنا، أننا بلا وعي وقعنا في تصدير الرجل وتقديمه على المرأة بلا أسباب عملية أو إنسانية وناجزة لأصالة ذلك التقديم، وأن تلك أزمة أخرى خفية نقع فيها في أحيان كثيرة. وأعيد سؤالي بمباشرة ووضوح “لماذا لم تقدم هويدا صالح في إهداء رواية تكشف عن حال المرأة في الصعيد ببعض النبش المؤلم الجميل، السيدة “صباح محمد مرسي” -الأم- قبل السيد “عبد القادر صالح حسين” -الأب- والموجودان نصًا في نص الإهداء؟!”. وهنا يجب أن اعترف أن كل تأويل أو تبرير تقدمه الكاتبة هو حقها الأصيل، ولكنّي أسأل بشكل عام عن تقديم الرجل على المرأة في رواية -أظنها- تنتصر للمرأة عبر فضح تفاصيل قهرها في صعيد مصر خاصة ومصر على وجه العموم؟! وقبل أن نترك العنوان والإهداء نلفت إلى التصدير التالي للإهداء، والذي تستعيره من نص المزمور 16/50 (وللشرير قال الله “مالك تتحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك؟”). وهنا تأخذنا القراءة إلى عتبة جديدة يمكن أن نفهم منها أن المحبة فرض على المحبين من أهملها أهمله الله المحبّ، وألقى الشرير بشرّه عليه، وكأننا معشر الكتاب -حتى ولو كُنا في بيت للمحبة- سنظل عطاشى للمزيد؛ لنكتشف آفاقًا جديدة للمحبة، ونطمح للوصول إليها والوصول بقارئنا إلى بابها.
وهو ما فعلته الرواية بأول جملة فيها “كان جديرًا به أن يصدّق أننا عبر الخيال يمكن أن نعبر بوابة الأمل..”، ليصبح الخيال والمحبة عكازًا لكل المريدين، وكأنها تقول، أحبوا ثم اسبحوا في الخيال. ذاك الخيال وتلك المحبة ستتخلى عنهما الرواية إذ ترمينا إلى صدمتها الأولى عبر واقع الحكايات التي تترى عبر فردوس وغيرها من هؤلاء اللائي نتابعهن بشغف طوال الرواية.
اللغة والمفردات
لعل تاريخ هويدا صالح المهني واضح في لغة تلك الرواية، والتي استطاعت فيها أن تخلص إلى “توليفة” لغوية خاصة بها، جمعت ما بين بساطة التركيب وسهولته، ووضوح غير مصطنع، إذ ابتعدت عن اللغة المقعّرة دون أن تفقد لغتها طعم الجزالة وحس الجمال عبر تلك التراكيب وتلك اللغة الخاصة بهويدا صالح، دون أن تنسى علاقتها باللغة والكتابة بالأساس بين السطور. وأظن أنها كانت تمتلك من ناصية اللغة ما كان يمكنها من تدوير لغة الحوارات من العامية إلى الفصيحة التي استخدمتها بسلاسة طوال العمل، لكن ليس كل ما نتمناه ندركه، وهنا أنأى بنفسي عن أيّ اتهام للعامية واستخدامها.
لغة الرواية كما قلنا جاءت بسيطة وواضحة وبعيدة عن استعراض عضلات الكاتبة اللغوية واللسانية، وهي سمة بارزة عبر العمل كله، وذلك الوصول إلى هذا المستوى من اللغة والتركيب البسيط ليس سهلا كما يظن البعض إذ هو غاية في الاجهاد كي تكبح جماح قاموسك الفصيح وتروّضه، وهو ما يبرر بعض الملاحظات على اللغة ومفرداتها، فمثلا كلمة “الورود” في الصفحة 15 جاءت جمعًا لكلمة وردة بالخطأ الشائع، وهو ما تكرر في غير موضع ومنه تكراره في الصفحة 169 مرة أخرى.
ورغم بساطة الأمر لكنه له شجون حول مهنة “تحرير النص” وعمل المراجع اللغوي في غالبية دور النشر والمطبوعات حتى الكبرى منها، ففي الصفحة 16 جاءت كلمة “أية” وأظن الأليق لغويًا تذكير الكلمة “أيّ”، وكذلك في الصفحة 17 واستخدام الضمير “هاء الغيبة” للجمع في “عاشتهم”، إذ يعامل غير العاقل باعتبار أولى للمفرد لا الجمع، فتكون “عاشتها” أولى لغويًا منها. كما جاءت ملاحظة تحريرية ولغوية حول استخدام “الفاصلة”، في الصفحة 16 إذ جاءت في أول السطر، وهو خلل إملائي لا يمكن إغفاله، تكرر مصحوبًا بسؤال عن فهم المحرر والمراجع لاستخدام “علامة الاعتراض -….- ” ففي الصفحة 27 جاءت (لا نعرف نحن -الفانين- حكمته)، وأظن احتمال التأويل والتخريج النحوي هو ما يسمح لنا بعدم الخوض في صحة ما بين علامتي الاعتراض “الفانيين” نحويًا، فلكل تأويل وتخريج أسباب يمكن قبولها هنا نحويًا وتأويلا، وهو ما نفعله مع الصفحة 124 مع استخدام الحرف “قد”، وفي الصفحة 125 مع استخدام الضمير في “وأبقى أنا وهي”، كما تفرق لغة هويدا صالح بين المحبة والعشق وتجعلهما أمرين، فتستخدم مفردة “العشق” باستفاضة مقابل مفردة “المحبة والحب” ففي الصفحة 81 تم استخدام مادة “عشق” خمس مرات مقابل مرة واحدة لمادة “حبب”، ووظفت ذلك بمهارة في وصف حال الرجال والنساء من هؤلاء العشاق والمحبين طوال الرواية. وللإنصاف فلغة الرواية الإملائية والنحوية منضبطة بنسبة رائعة -هذا لا يمنع الطموح للانضباط الكامل لغويًا- إذا ما قورنت بمنشورات تصدر عن دور نشر تملأ الدنيا بمطبوعاتها ومنشوراتها طافحة بمهازل لغوية وبنيوية، وهو ما حرصت عليه هويدا صالح، وكما قلت فإن تاريخها المهني وعلاقتها بالتدريس له بعض الأثر الملحوظ هنا على لغتها ومفرداتها الطيّعة غير المراوغة عبر التنويع بين تقنيتي الراوي العليم والراوي المحايد، وإن غلب العليم على المحايد معظم الوقت وفي الصفحة 191 يتضح ذلك التحول بين الراوي العليم والمحايد بشكل ناصع جدًا ومتقن، ورغم ذلك ثمة ملاحظة مع علامات الترقيم المحررة بالنص المنشور.
الأسئلة الأهم
سؤال المحبة والقلق، أبرز الأسئلة تلك، فتقول فردوس في الصفحة 218 “وهل اختارت هي من تحب؟ وهل العشق يأتي بقرار؟” ليكون السؤال هنا أحد أهم أسئلة الرواية وعلامات استفهام كثيرة طرحتها الرواية بوعي عن صعيد مصر والمرأة، هو سؤال المحبة، والذي ضفرت معه عبر نسيج السرد علامات استفهام أخرى حول القهر الذي طال وتمكّن من روح فردوس وغيرها من بطلات الرواية، بل طال الرجل كذلك في بعض موضع، وذلك عبر أزمة المحبة بين شباب المسلمين والمسيحين في مصر كلها والصعيد بوجه خاص.
ففي -مثلاً- الصفحة 190 تضفر القلق بالمحبة بشكل رائع فتقول “حنا زوجها الذي بذل في سبيل إرضائها كل السبل، لماذا لم تسمح لنفسها أن تحبه؟! لماذا لم تسعد معه؟!.. ما الممتع في القلق والحزن جعلها تتخذهما طريقًا لها دون كل طرق بني الإنسان؟!”.
وما دمنا بصدد الأسئلة يأتي سؤال الرواية عن “الشك” وكيف يمكن أن يتحول المرء من خلال ذاك الشك إلى ظلال من يقين يردفه متى أخلص في شكّه عبر تشكك حقيقي في المنسوب سلفًا إلى يقين مطلق لا مبرّر له ولا محاولة لفهم حكمته قبل التسليم به، وأنه إذا ما بدأ سيتتابع بمزيد من الأسئلة والشكوك -والتي أراها حقًا إنسانيًا أصيلا- كتلك التي جاءت في الصفحة 42 حيت تقول البطلة “… لكن يسوع لم يستمع إلى فجيعتي المحتومة، وأمّه لم تخلصني من بين يدي الشرير، ومار جرجس لم ينقذني..” تلك أسئلة وشكوك تطال البعض حول ثوابتها المطلقة في بعض لحظات الألم والإحباط، وهو ما فعلته هويدا صالح عبر أسئلتها على لسان أبطالها بشكل مباشر ومبطّن حول مفاهيم العقيدة والإيمان والوحدة الوطنية والمحبة، بل وكل وجود الإنسان ومختلف علاقاته وتماهياتها وتشعباتها في بيئة صعيد مصر الحادة والمحافظة والمتعصبة في كثير من أحوالها حين تقول على لسان بطلتها في الصفحة 170 “فمن غير المعقول أن يتخلى المسيح عن أبنائه الذين قدموا في محبة أمه البتول ..”.
لا تكتفي بذلك بل تصرخ كيف يمكن أن تكون المحبة فيها جريمة لا تغتفر، بل ويعاقب عليها الدين عبر رجالاته -المسلم والمسيحي- وتأمل ذلك في الصفحة 124 في فصل يحمل عنوان “سلوى” تقول “كنتُ أشفق عليها، فالحب في عرف أهل الجنوب جريمة، فما بالك بحب غير مشروع بين المختلفين دينيًا؟!”. كذلك طرحت سؤالها الشائك حول شجن “الاعتراف” في المسيحية وما يمكن أن يعانيه المعترف من صراع بين حتمية الاعتراف وحقيقة ما يريد كما في الصفحة 167 إذ تقول “لم تخبره عن كراهيتها المكتومة لسارة” في لحظة الاعتراف لتؤكد أن المعترف به أقل كثيرًا من المسكوت عنه، وعن ازدواجيتنا الفطرية في كثير من الأمور. كما تسأل طوال الرواية سؤالا عن علاقتنا بالآخر وكيف يمكن أن ينفي بعضنا بعضًا، وذلك من خلال رصد العلاقة ما بين المسلم والمسيحي، وتفضح ذلك بصراحة ومباشرة وبلا تردد، فتقول في فصل “ماريا” في الصفحة 108 “فالمسلمون ينفون المسيحيين وحقوقهم في بلدهم، وكذلك يفعل المسيحيون، فينعزلون، بل وينظرون إلى المسلمين باعتبارهم ضيوفًا عليهم سرقوا منهم بلدهم في غفلة من التاريخ”، وهو ما وضّحت طبيعته ما بين الصعيد والدلتا في الصفحات السابقة لتلك، ففي الفصل نفسه الصفحة 100 تقول “في محافظات الدلتا لم أكن أعاني كثيرًا من التصنيف النصراني والمسلم، فكلنا نلعب سويًا، وكلنا أطـفال تـمارس البـهجة، ولكن بمجرد وصولي للجنوب، كان الأمر مؤملا..”.
ويأتي السؤال عن الصراع الواقع في مصر بشكل عام وفي الصعيد بخصوصيته فيما بين المسلم والمسيحي، وأزمة الطائفية، والاستنفار المُبطّن الخفيّ الذي يصرّ الجميع على استنكاره، وهو ما استعرضته في فصل “الأخوة” في الصفحة 90 في الحوار بين “العم توادروس″ وابن أخيه “يوحنا” ليطرح سؤالا مسكوتًا عنه، يقينًا يتردد في خاطر المصري عن الحقوق السياسية للمسيحين في مصر، يقول “حين واجهه ابن أخيه يوحنا صارخًا فيه أن الشعب المسيحي لا يأخذ حقه وأنه ممنوع من ممارسة السياسة ومن المناصب القيادية..”.
من المسكوت عنه
لم تقف هويدا صالح في روايتها على رصد مجتمع الصعيد وصراعاته المختلفة، بل فضحت صراعاته بمباشرة وصلت إلى حد الخطابية في بعض فقرات الرواية وجملها اللغوية، وأخذت تضرب بمطرقة استفهامها على باب منغلق على “مسكوتات عنها” في صعيد مصر إنسانيًا ودينيًا وسياسيًا واجتماعيًا، وأفردت مساحة للمرأة وحالها وشجونها في هذا الجسد الذي نكتشف أنّه جسد فضفاض ترهّل بأسئلته حتى ضاقت مساحة التمدد والحرية المسموح بها لهذا الجسد الذي يصير الوطن بكامله في تأويل ما للرواية بطولها، ويأتي قمع هذه الأسئلة وصاحباتها من فردوس والبطلات إلى الكشف عن حقيقة القمع الطاغي ضد المرأة في صعيد مصر، وكيف إن ضاق بها جسد الوطن والشعب والدين، فإنّ رحابة المحبة والروح بخيالها تعطيها متسعًا لا يمكن للرجال أو للدين والمجتمع أن يسلبها إياه أو يُضيّقه عليها، وتأمل قولها في الصفحة 70 في حكاية فردوس ومحمود، والذي يجيء على لسان الوالد “يا ابنتي كُتِب علينا أن نعيش طوال الوقت حياة ليست لنا وليست من اختياراتنا”، وفي زاوية أخرى للقهر بوجع عام الواقع على المرأة في مصر، والذي تأصل في العقل الجمعي حتى عند المرأة ذاتها، تقول في الصفحة 80 “.. وأمي تجعل أخواتي اللائي يكبرنني أن يخضعن لكل كلامي، ويحققن كل طلباتي دون مراجعة، طبعًا فأنا الرجل كما تقول أمّي لمن تعترض منهن”.
الحكمة والخيال
“جسد ضيق” رواية انتصرت للوجع والقهر بطولها عبر سردها الماتع السلس الذي نجده في حكايات العشق في صعيد مصر وعلاقاته الاجتماعية القلقة بعصبيّتها وعقيدتها، وحاولت أن تعالجها الكاتبة عبر بعض الخطابية المباشرة والجمل الحكمية التي أظنها مقبولة بمنطق العقل لا منطق الرواية والسرد -مع الوضع الملتبس في صعيد مصر- وهو ما أقلق قراءتي قليلا حين جاءت مجموعة من الجمل في شكل خطابي مباشر وواضح بلا مواربة أو التفاف حول المعنى، إلا أن الخيال المتولد وراء الحكاية برمتها هدهد قلقي، إذ استطاعت هويدا صالح بخيالها المنفتح أن تغوص في مأثورات الصعيد وتراثها الشعبوي والديني -مسلم ومسيحي- وتبني عليه عملها عبر مجموعة من الأسئلة التي أثارتها الرواية، لعل أبدع ما فعلته أنها قالت لنا لنعترف بها في العلانية كما نعترف بها في سرنا وفي باطن وعينا الجمعي، حتى وإن كان ذلك عبر عالم متخيّل من إبداع خيال الكتابة واستدعاء أبطالنا التراثيين في هروب من ذلك الواقع وفضحه والخلاص منه وحلحلته، وإطلاق الروح خارج جسدها الضيق.
صدرت رواية “جسد ضيق” للروائية والناقدة “د. هويدا صالح”، عن دار الراية في يناير 2016، وتمّ توقيعها في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وجاءت في صفحات من القطع المتوسّط تنتهي بترقيم صفحاتها إلى الرقم 248، وبتصميم غلاف ورسومات “رحاب العمري”، بغلاف ستفهمه بعد صفحات من بداية القراءة، تحمل في ألوانها غلبة للونين “الرمادي والأسود” لصورة طفلة مقربة في زووم مشوش، ثم في خلفيتها الصورة نفسها واضحة لطفلة تحمل عروسها البلاستيكية.
أزمة الغلاف
يعاني الغلاف ولوحته في مجال الطباعة والنشر في مصر من أزمتين، الأولى لها علاقة بإنتاج المطبوع يتشارك فيها الكاتب ودار النشر، والأزمة الأخرى تتعلق بالمتلقّي ما بين النقد والقراءة، فمع انتشار مصطلح “عتبات النص” عند القراءة النقدية للعمل المنشور، نلحظ ثمة إغفالا للحديث عن لوحة الغلاف وتصميمه باعتباره عتبة للعمل، وربما تتم الإشارة إليها في عجالة القراءة، وينصبّ الاهتمام إلى العنوان وما تلاه من إهداء وغيره من تقديمات ظهرت قبل متن النص المطبوع. في رأي متواضع -أعتقد- أن أزمة الأغلفة التي نلاحظها متى نظرنا إلى كثير من أغلفة الأعمال التي تنتشر في سوق القراءة وتتوازى بانتشار دور النشر -وكثير منها غير منضبط- سنلاحظ إهمالا غير واع للغلاف يرمي بنا إلى أزمة جديدة في مجال النشر، يتشارك فيها كل من أخرج لنا المطبوع وقام بقراءته نقديًا، إذ -أرى- الغلاف بلوحته عتبة أولى للقراءة قبل عنوان العمل.
وتلك قضية لها شجون كما قلت يجيء أقلّها في عولمة العمل المنشور وكيف يمكن أن يتحاور المؤلف مع المصمّم مع صاحب لوحة الغلاف مع دار النشر، وكيف يمكن أن يعلّق عليه النقاد ويؤسّسون لأهميته، تلافيًا لما يمكن أن يطلق موجة من السذاجة كتلك التي رأيتها وأنا أقرأ ديوانا لصديق صدر عن واحدة من مؤسسات الدولة الثقافية -ديوان “يوم يكون الراعي” للشاعر كمال على مهدي- بلوحة للغلاف تحمل صورة صبي يرعى الغنم! هي أزمة إذن ولا بد من النظر إليها بجد توازيًا مع أزمة النشر وتسطيح الأشياء بشكل بدا عمدًا. في “جسد ضيق”، جاءت لوحة الغلاف وتصميمه موفّقين إلى درجة كبيرة، وإن كانت دهشته لم تدم طويلا بعد قراءة صفحات قليلة من الرواية وتتبع حكاية “فردوس″ -البطلة- لتفهم لوحة الغلاف التي تحمل صورة تلك الطفلة بوجه مموّه في المقدمة وبوجه واضح هناك بعيدًا في ظل الصورة. أظن أن اللون الرمادي هو أكثر ما يميّز هذا الغلاف ولوحته وهذا ما سيستمر معك طوال القراءة إذ تكتشف سر اختيار هذا اللون الرمادي إضافة إلى اللون الأسود طوال الرواية والحكاية عن بعض المسكوت عنه في عالم الصعيد الزاخر بالألم والوجع على اختلافاته.
كاتب من مصر
عن صحيفة العرب

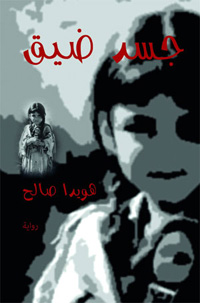


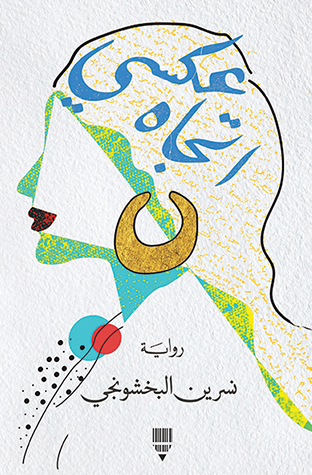



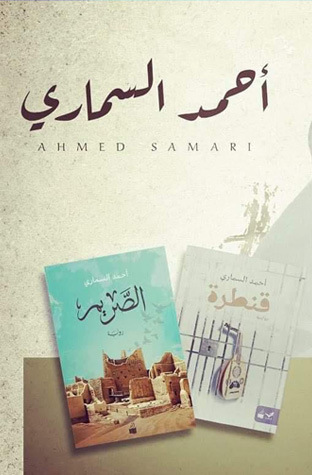
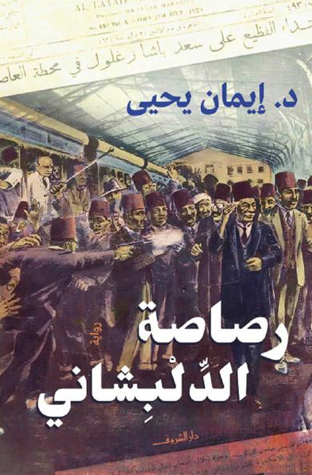
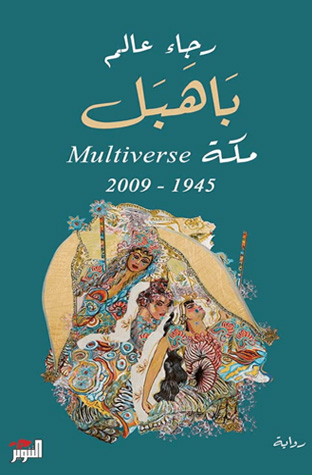



0 تعليقات