جدلية القهر في رواية "جسد ومدينة" لزهور كرام - دراسة سوسيو ثقافية
- تقديم الرواية: تتمحور رواية "جسد ومدينة" حول أربع شخصيات رئيسة، هي: الساردة – سعيد- آمال- إبراهيم، وهي شخصيات مثقفة، تنحدر من أصول طبقية فقيرة، تتمتع بوعي إشكالي، تحدوها الرغبة في العبور بالذات والفضاء إلى مرفأ الكرامة وتحقيق الشروط الموضوعية. يختار سعيد النضال، فيتعرض للإعتقال بين الفينة والأخرى، قبل أن يطول اعتقاله في المرة الأخيرة، وقبل ذلك، كان قد جسد عشقه للمدينة في الساردة، التي راحت منه حاملا. ويرتبط إبراهيم بآمال، ويتجسد العشق نفسه، وكما أعتقل سعيد وابتعد عن فضائه ومعشوقته، يعين إبراهيم في الجنوب في إطار الخدمة المدنية، فينأى عن آمال، وتفتر علاقتهما ولا تبقى سوى الرسائل بينهما جسرا للتواصل، والتي ستنقطع فيما بعد. تختار آمال البحث عن فضاء آخر (الهجرة)، ويكون الحصول عن الجواز، عتبة للدخول إلى فضاء آخر في المدينة صالون الحلاقة (صندوق العجائب) الذي يقودها إلى فضاء آخر : فضاء "عين الذياب"، حيث يباع الجسد. يظل سعيد معتقلا، ينتحر إبراهيم، تهاجر آمال، وتعود أم (سعيد وآمال) إلى القرية، أما الساردة، فهي تحاول بنفس إصرار وعناد سعيد، وصل العلاقة من خلال رغبتها في الحفاظ على "خيار" جنينها لتفتح الدائرة. وتطرح رواية "جسد ومدينة" من خلال تفاعل شخصياتها مع بعضها البعض، ومع العالم من حولها، مجموعة من القضايا التي تؤسس حولها، مفاهيمها الخاصة، وتضع المفاهيم السائدة موضع سؤال. وسنعرض لإحدى أهم هذه القضايا وهي : "قضية المرأة"، التي تميز طرحها بالرواية بالنظر إلى أبعادها، وخلفياتها المعرفية، والوجودية، كاشفة بذلك عن صراع المرأة المزدوج : صراعها مع المفاهيم السائدة في إطار "وضع خاص"، وصراعها داخل المجتمع تخوضه إلى جانب الرجل في إطار" وضع عام"، مؤسسة استراتيجية في السؤال، ليس حول المرأة فقط، ولكن حول الأوضاع العامة بما فيها الرجل. 1 - الوضع الخاص: أ - صراع المرأة مع الرجل : لقد كشفت لنا رواية "جسد ومدينة"، في هذا الإطار، عن صراع المرأة مع الرجل المتشبث بتصورات ومفاهيم تقليدية متوارثة عن الفوارق بين الجنسين، والتي تقلل من مكانة المرأة، وتختزلها إلى مجرد جسد/ مادة، قابل للاستهلاك وتحقيق الرغبة ضدا على مستلزمات إنسانيتها. وتصور لنا الرواية ذلك من خلال ما تعرضت له إحدى شخصياتها النسائية، حينما أغوتها فكرة التبلل والهذيان مع المطر بالخارج : "…لتتخلص من دوامة التفكير والاستفهام أغلقت النافدة، وأخذت شالا خفيفا ملونا غطت به شعرها ثم خرجت تطلب المطر … الفكرة دخلت رأسها …ستشهد بنفسها تعاليم المطر …إنها تريد الهذيان مع المطر …"(ص11).
وإذا كنا سنتطرق فيما سيلي لحضور المطر كقيمة دالة على التطهر والتجدد، فإننا هنا سنقتصر على حضوره كخلفية لتطور الانفعال الحسي والمعنوي (للمرأة)، وقناعا للأزمة الداخلية للذات الساردة، التي تتخذ شكل تدفق للمشاعر والأفكار، يتم ضبطه على وثيرة الانهمار المائي المسترسل الذي يضحى مرتكز التصعيد والتوتر، وكأنما يتعلق الأمر بتهيئة لذهن القارئ لاستيعاب تدرج مماثل في إيقاع البوح بعذابات النأي (نأي سعيد) ما بين السؤال والاحتجاج : "من بعيد يتجمع الضباب، إحساس أقبل ينشد بداخلي بهجة العبور، فالنطفة أشرقت على اللقاء اليتيم … هو لا يدري لأن الخبر انقطع بيننا بفعل فاعل" (ص9)
إن شدة التعلق بهذه اللحظات تكشف عن الولع، بكل ما هو مخبوء وداخلي، مما يتواءم ونفسية المرأة التي أريد لها أن تستظمر عواطفها. ولتعميق هذا الإحساس، توقع نغمة ّّنوستالجيةّّّ مفعمة بالتياع حارق جراء تذكر لحظات حميمية:
"الفكرة دخلت رأسها … هي هكذا، دائما تعاند نفسها وتدخل معها في تحدي فقط مع اللقاء اليتم، كانت اللحظة أكبر من فكرة تدخلها إلى رأسها … بل أكبر منها … لم تكن فكرة … أو حتى كلمة … لا تدري بالضبط … كان انسيابا مفاجئا يختل معه الوعي " (ص 11).
وقد أردفت الحديث عن المطر بالحلم، والتطهير، والإحساس بالنشوة والراحة، وباستحضار الجسد في دلالات لا تخلو من إثارة : "… هي الآن تخترق الطريق وحدها… التصقت الثياب على جسدها، واختلط الشال مع شعرها… إنها تريد الهذيان مع المطر" (ص11).
وإذ يشكل المطر ملاذا، وحاضنا أليفا للمرأة، باعثا على راحتها فإنه سرعان ما يتحول إحساسها بالانطلاق، إلى انزعاج وضيق سببه الرجل المعاكس، الذي يكشف عن عدم حياده بعد أن يصير حاجزا أمام انطلاق المرأة بذريعة اقتحامها الطريق العام : "تستمر السيارة في المعاكسة تسرع هي الخطو وتثبت الشال على شعرها … تكاد تغطي وجهها، هل تريد أن تخفي ملامح امرأة تحرر الشارع مساء، حين تعبث به وتجعله ينصت لهوسها …" (ص 12).
إن الرغبة الجامحة لدى الشخصية إذن، تأتي كرد فعل ضد كل سكونية وتبات، كما أن عدم تبين الاتجاه، يشعر بالتخلص من التقنيات- " القوانين المسطرة" –وممارسة الشرط الوجودي في أن تحيا بالشكل الذي ترضاه، وتتخلص من الشعور بالانسحاق، والانكسار، حيث الإحساس بالضيف والعزلة. لهذا، لم يكن السؤال الإستنكاري الذي تقذف به الشخصية (المرأة) في وجه الرجل المعاكس : "أريد أن أعرف ما الذي يعطيك حق المتابعة؟" (ص12). سوى صرخة، مفعمة بالضيق، والرغبة في تكسير الطوق المفروض عليها في وجه تاريخ رجولي موغل في ذكوريته، وهي تكشف القلق النفسي، والتمزق الداخلي للذات الساردة الراغبة في التحرر من النظرة التي تكرس دونيتها مما جعلها تضيق ذرعا بالرجل ونظرته الاحتقارية، كما أن السؤال في نفس الآن، يحمل وعيا بهذه الوضعية التي يراها الرجل بفعل أنانيته طبيعية، في حين، ليست سوى نتيجة لاعتبارات موضوعة. وهي إذ تسجل استنكارها، تمتلك بذلك وعيا باستلابها، وهي لا تكتفي بامتلاك هذا الوعي فقط، بل تحدد من خلاله مسؤولية الآخر (الرجل) : "كادت أن تبصق في وجهه لولا أن تواجدها مفردة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل …" (ص12).
"…هي التي أغوتها فكرة التبلل والهذيان مع المطر … ألم تعلم مخاطر الطريق" (ص14).
إن مخاطر الطريق التي أشارت إليها الشخصية في قولها، لم تكن تقصد بها، سوى هذا الآخر (الرجل)، الذي اقتحم بفضول عالمها ومنعها من تحقيق رغبتها- فكرتها_ وبالتالي، تحقيق وجودها بالشكل الذي أرادته وتريده: "السيارة تلاحقها… تستفز وجودها (…)…إنها تقرأ الظلم في كيانها … في فكرتها… إنه تدخل سافر في فكرتها، الفكرة التي ألهمتها التسكع ليلا لتعيش الهذيان مع المطر… أو لنقل لتعيش فكرتها … الآن، بفعلته يلوث حياة الفكرة…" (ص13).
تحيلنا الرواية من خلال ما تعرضت له الشخصية، إلى أن علاقة المرأة بالرجل تعاني من انفصام أكيد، ذلك أن ثمة هوة تفصل بينهما، فهي أسيرة المحيط الذي تتواجد فيه على الرغم من توقها لمجاوزته وتجاوزه، لذلك، فحركة المرأة المحدودة في المكان، قد ساهمت بشكل بارز في صياغة هوية متميزة لها مما جعل "سلوك الرجل إزاء المرأة خارج البيت يدل على أنها أصبحت عرضة للاتهام في أخلاقها لمجرد أنها اقتحمت الطريق العام"( ). إن واقعة الاصطدام هاته، مرآة عاكسة لصراع المرأة مع المكان، إذ من غير المسموح للمرأة أن تنتقل فيه بحريتها، وهو ما يعكس صراع المرأة مع السائد، مع السلطة الاجتماعية التي تفرض عليها الانكفاء في المكان الضيق، حائلة بذلك دون جعلها إنسانا منتجا متكافئا، ومنطلقا. وإذا كانت الرواية حاولت أن تبسط "وضع المرأة" في صراعها مع المفاهيم السائدة التي يصدر عنها الرجل، والتي تحد من فعالية المرأة، وتختزلها إلى عنصر أنوثة يؤدي وظيفة الإمتاع والامتداد، فإنها عبرت في نفس الآن، عن وضع الرجل الذي لا يعدو أن يكون في المقابل، وتحت تأثير مفاهيمه التقليدية، سوى كائن تسوقه غرائزه، وهو ما تشير إليه الشخصية في نصيحتها المبطنة بالسخرية والاستخفاف إلى الرجل المعاكس، وهي تعمد فيها إلى نبش رجولته، تقول فيها : "إذا كان سروالك قد تبلل فما عليك إلا أن تسرع لتغييره بآخر، أو أقترح عليك نصيحة قد تدخل في لغة الإشهار، مع ذلك أجدني مجبرة على ذلك ما رأيك بPOm:PERS، الأطفال، إذا كانت هذه هي عادتك …" (ص13).
وتتعرى أيضا حقيقة الرجل الذي لا يرى في المرأة سوى أداة لتحقيق المتعة والرغبة، في خطاب "نساء الصالون"، حيث تنخرطن في وضع أسئلة على بعضهن تقع ضمن المسكوت عنه في بيوتهن، وفي المجتمع. تنطلق الأسئلة المكبوتة لتعبر عما يؤرقهن، وينفتح الحدث على عوالم مستورة يعبرن عنها بلغة جريئة، ومباشرة تكشف عن زيف الرجل، وتربك فحولته، وهي تطرحها موضع سؤال : "تخلع اللغة زيفها اليومي فتأتي عارية تسمي الأشياء بأسمائها… الجسد تتعرى أعضاؤه … الرجل يختزل عضوا … تعطل وظائفه ما عدا الجيب وما تجود به فحولته". (ص66).
وهو ما يعني، خروج الرجل من ّّّلا تاريخيتهّّّ التي تمنع وصول السؤال إليه، من خلال عنصر الخدش والتشكيك في قيمة فحولته الأمر الذي حدا بالساردة لأن تقول عن "امرأة الصالون" : "هذه المرأة حققت ما لم تنجزه المرأة المبدعة، أنها تتغزل به ثم تسخر منه حين يصير بحجم الطفل … تذكرت ديوان قباني "هكذا أكتب تاريخ النساء" ما الفرق بينه وبينهن … إنهن خارج التدوين. لو كان نزار الآن معنا في الصالون واستمع إلى تاريخ الرجال من أفواه النساء…" (ص66).
هكذا إذن، نخلص إلى أن الرجل عندما ينتج شكلا معينا لوضع المرأة، إنما ينتج بذلك وفي نفس الوقت، الشكل ذاته لنفسه، ومن تم، تكون قضيتها هي نفسها قضيته، مادامت طبيعة نظرة هذا الأخير (الرجل) إلى المرأة، وتعامله معها، هما اللذان يمليان نظرة المرأة وتعاملها معه، فالمرأة ليست وحدها المطالبة بتحرير نظرة الرجل لها، فهذا الأخير أحرى بالتحرر من موروثاته تجاه المرأة. فالقضية بهذا، ليست قضيتها وحدها، فكلاهما ضحية تصورات موروثة من أخطر مظاهرها هذا الصراع الثنائي الذي يحتدم بين المرأة والرجل، صراع تدخله المرأة من أجل إتباث إنسانيتها، وكينونتها، ويدخله الرجل من أجل التمسك بوهم "الرجولة" ومبدأ "القوامة"، لذا فالرواية تكشف عن هذا الوهم عندما تطرح رجولته موضوعا للمساءلة والسخرية : "فالرجل يحبو لأن المرأة تصير طعم المصيد في مثل هذه الحالة…" (ص 66).
إن الرجل الذي يستهلك المرأة مثلما تستهلك البضائع الأخرى، ليس حرا ولا يمكن أن يطمح في علاقاته بها إلى مستوى الإنسان، لأنها ستحوله بدوره إلى بضاعة للاستهلاك، ذلك أن "إختناق عقول عدد من النساء والرجال داخل زنزانة الجنس، المحدود المعنى، القاصر على فكرة واحدة ناقصة تختزل كيان الرجل والمرأة إلى مدلولات جنسية فحسب"( ).
وعليه، فالرجل مطالب بأن يتحرر من رواسبه إن هو أراد أن يبني علاقة متكافئة مع المرأة تقوم على الاحترام، والاعتبار المتبادلين.
ب - تيمة : الصراع مع النموذج :
وتثير الرواية دائما في إطار هذا الوضع الخاص، صراع المرأة مع "النموذج" الذي : "يتم تشخصيه عبر صيغ مفهومية وأنماط سلوكية من أجل وضع المرأة في زمن المثالية، وإحاطتها بسياج أخلاقي يجعل من عدم تفاعلها مع الأوضاع وانعدام انفعالها، وكذا تعاملها مع المفاهيم السائدة باعتبارها بديهيات ومعطيات لا تقبل الجدال"( ).
الأمر الذي يعني، أن "النموذج"، يحول دون اندماج المرأة في الجماعة، وممارستها لبعدها الإنساني الذي يجعلها تنفعل وتتأثر، تضعف وتتقوى، وهنا يأتي ذكر ارتباط الساردة بالمطر / الماء كقيمة دالة على التجدد ترفض الموت، والرتابة، والتكرار، فـ "الماء الذي ينساب دعوة إلى السفر بدون رجعة، فنحن لا نستحم في النهر مرتين، والأنهار لا ترجع إلى منابعها… الماء الذي ينساب صورة للارجوع عنه"( ) تقول الساردة :
"أليس رائعا أن تنساب أول قطرة على ثيابنا … تبللها … فتأتي الأخرى لتمتزج بجسدنا وتمنحه نكهته الوجودية… في أن نشعر بما حولنا… في أن نحول الشعور مطرا يغسل المدينة" (ص : 10).
والأمطار كما تقول "جوليا كريستيفا" : "إحالة على التطهير الرمزي، إنه يزيل قاذورة في واقع الأمر ليس مرتبطة بانتفاء النظافة أو غيابها، بل لها علاقة بكل ما يشوش على هوية أو نظام أو نسق، وهي أيضا ما لا يحترم الحدود والمواقع والقواعد"( ) : "ترغب في أن يتبلل جسدها … أن تصير رعشة، تتحول رجفة… فتصبح المدينة قلبا يخفق لحياة كريمة"، (ص : 11).
تمكن هذه الوضعية الذات من السفر عميقا في اللامتناهي. فيتم الانصهار بالوجود، والذوبان في اللحظة في وضعية تتناغم فيها الذات بالعميق والحلمي، ف "من يحلم أمام مياه رائقة، يحلم بصفاءات أولية، فمن العالم إلى الحالم، تتصل تأملات المياه بالصفاء، كم نود أن نبدأ حياتنا من جديد، حياة هي حياة الأحلام الأولى، كل تأملات لها ماضيها، ماض بعيد، وتأملات المياه لها لبعض النفوس امتياز ببساطة"(7). وتوضح الرواية صراع المرأة مع "النموذج" من خلال انتقال الساردة من القرية إلى المدينة لمتابعة الدراسة الجامعية هناك، حين تقول : "لم أكن أعرف ما أرغب فيه وأنا أغادر قريتي لمتابعة الدراسة الجامعية هنا … فقط كنت أشعر أنني أحمل هما تقيلا فوق صدري…" (ص 80). لم يكن هذا الهم الثقيل، سوى النموذج الذي يحول دون اندماج الساردة في الحياة الجديدة : "… حين أعشق التسلل من نموذجي وأنطلق في شوارع المدينة يشمخ نموذج أبي أمامي ويعيدني إلى صوابي كما يعتقد أهل قريتي (…) النموذج الآتي معي من هناك كان يعطل خطوي … (ص 79-80).
يقوم النموذج إذن، على سلطة اجتماعية تراقب وتحصي حركات المرأة، وتصبح هذه السلطة بفعل التكوين والتربية، رقابة ذاتية تقمع وتلغي كل فعل للمرأة ينزع إلى الخروج من النموذج، لهذا، كانت الساردة ترى خروجها من أسر النموذج، وجوبا، وضرورة لإثبات هويتها وإنسانيتها إذ تقول : "من يومها رغبت في قتل النموذج بداخلي …" (ص 80). إن امتلاك الساردة "عنصر الرغبة" الذي أنتج سؤالها حول نفسها : "كيف أحرر نفسي من النموذج : كيف أنطلق" (ص 80)، يعد خطوة أولى : "للدخول في حوار مع النموذج" (ص 80)، في أفق الإنعتاق منه، ثم "عنصر المعرفة"، معرفة الفعل أو الشيء الذي يدفع للفعل تقول الساردة: "لكي أتحرر وأعيش أفكاري لابد وأن يكون لي صوت منفصل" (ص80).
وعنصر القدرة والإنجاز (الإدارة) حين تقول : "اقتحمت كل أمكنة النقاش الصخب… أصل قبل موعد البداية بدقائق، فأسجل ملاحظات أعيد ترتيبها عندما أعود ليلا إلى غرفتي بمقر سكناي … (ص79).
وبالإضافة إلى هذه (العوامل المساعدة)، شكل لديها البعد عن القرية عاملا آخر مساعدا للتخلص من سلطة الأب، الدالة على الثقافة المحافظة المتعالية: "تركتها ورائي قريتي النائية … أراها تبتعد وأنا منتشية في مكاني داخل الحافلة … إن مجرد الركوب في الحافلة يعني تغيير الزمن … زمن قريتي النائية" (ص79).
ويلعب تغيير المكان في الرواية دورا مركزيا في تصعيد مسار الحكي. إذ يعبر الانتقال من القرية مكان تواجد الأسرة، والثقافة المحافظة، إلى المدينة عن نقلة دلالية رمزية، تجسد تحولا مكانيا يوحي ببداية إنجاز أولي في مسار الساردة التحرري. ومن هنا تأتي المرحلة الجامعية بمواضعاتها الهامة عاملا مساعدا وفاعلا بالنسبة للساردة المتطلعة إلى التحرر من السلطة الذكورية (الأبوية) التي تقمع فيها إمكانية الحركة والفعل. تنظر الساردة بهذا إلى البعد عن القرية لحظة بداية، وهنا تبدو الرؤية المستقبلية الثورية للرواية، فهي لا تنظر إلى الماضي كحنين، أولحظة تجسد المثال، وإنما بوصفه إرثا ثقيلا ينبغي قطع الصلة معه وتجاوزه. من هنا نلاحظ الحضور القوي للعلاقة الخاصة بين الساردة، وبين شخصية الأب، ومن خلالها نحس تناولا جديدا للعلاقة بين المرأة والرجل، سواء كان أبا أو حبيبا، وهي العلاقة التي ترتسم في البدء من خلال الارتباط بالأب، غير أن انتقال الساردة من القرية إلى المدينة لمتابعة الدراسة الجامعية يكشف تحولا في هذه العلاقة من الدفاع و التواطؤ مع الأب: "كنت أبصق في وجه من يلمح بكلمة قبيحة في حق والدي … والدي الرجل المحترم .. المثالي .. وكيف أخون هذه الصفات ! لا، لن أفتح عيني، سأترك الرمانة كما هي … والدي كل شيء في حياتي … إنه يختزل حبي …" (ص80).
إلى محاولة التمرد عليه من خلال التمرد على التعاليم التي يمثلها: "صرت أبحث عن خطأ آدم في وجه أبيه، أترصد ملامح السنين في هذا الوجه … أسعى لضبط لحظة سرقة … ألتصق وراء الباب … أركز السمع … علي أضبط انزياحه… كيف يعقل ألا يترك أثرا لجريمته" (ص80).
وهكذا، فبعدما كانت الساردة (المرأة) تحت السلطة التي يمثلها الأب، فإنها أصبحت بعد البعد عن القرية فوقها، حين حررها من قبضة السلطة العمياء، وأفسح لها المجال للحياة، فحضور الأب إذن، كان لغاية الانفصال عنه، والتحرر من هيمنته في أفق تأسيس "أنا" غير ملتبسة، قادرة على الفعل والتفاعل مع محيطها. إلى جانب البعد عن القريبة، نجد عاملا مساعدا آخر تمثل في الآخر (إبراهيم) الذي ألهم الساردة الثقة بضرورة الفطام، تقول عنه، وله: "تعلمت منك كيف أخوض تجربة الفكرة وأكون مسؤولة عن اختياري، كنت صديقا رائعا" (ص78-79).
"كثيرا ما كنت تناقشني عن ضرورة الفطام … شيئا فشيئا ألحقتني بثقة كبيرة في نفسي مهدتني للدخول في حوار مع النموذج…" (ص80).
استطاعت الساردة باجتماع كل هذه العناصر، والعوامل، أن تحسم مع النموذج وتبدو "عامل ذات"، قادرة على تحقيق فعل التحويل (التحرر) الذي تدشنه بقولها : "إنها علامة على بداية تاريخ انحته خارج النموذج" (ص97).
معلنة بذلك، أنها أصبحت ذاتا "حقيقية" ولم تعد مجرد ذاتا "افتراضية"، وهي تصل إلى مرحلة الإنجاز الذي هو "تحديد للمخرج، ورسم لمعالم كون قيمي مخصوص … إنه الحلقة النهائية داخل سلسلة التحولات المسجلة…
ندرك من خلال ما تقدم، أن هناك صراعا من أجل ذاتية حديثة عبر مقاومة شكل الخضوع للسيطرة الاجتماعية، والاستعاضة عنها ببوصلة شخصية هادفة، كما يشير إلى ذلك "سعيد" في حوار داخلي حول "آمال" يقول فيه : "… المهم أن تكون الخطوات محسوبة بإرادتك أنت (ص16).
وهو ما ينم، عن الدعوة إلى تجاوز الثوابت المتجذرة، والتفكير في بدائل لها، من قبيل العقل الموصول، والمنطق الداخلي للأشياء، والنزعة الحيوية الاجتماعية. إن الخروج من النموذج إذن، هو نزعة لتكريس ذاتية حديثة، وإشاعة ثقافة الاختلاف والتنوع، وهو ما لن يتأتى إلا بإنتاج علاقة مغايرة للعلاقة السائدة بين المرأة وذاتها وبين المرأة والرجل كما سنتداول في العنصر الموالي.
ج- المرأة – الرجل : نحو إنتاج علاقة مغايرة : من خلال تفاعل شخصيات الرواية مع بعضها البعض، تقدم رواية "جسد ومدينة" صورة عن علاقة المرأة بالرجل مغايرة لتلك السائدة. إن أول شكل لهذه المغايرة، يتمثل في نظرة الرجل للمرأة، التي لم تقف كما السائد والمألوف عند حدود النظرة الحسية، التي يظل معها نموذج المرأة الجاذبة يركز فيه على الجانب الظاهري عوض الجوانب الباطنية : "… يومها اكتشف في تأملها جمالا وروعة … طريقة تركيزها، طبيعة جلستها، رآها جميلة … ورائعة (ص29).
يبدو من خلال هذا المثال، أن الرواية تكسر خطية إعجاب الرجل بالمرأة حين جعلته ينصب على الصفات الباطنية ليغوص في العمق/الجوهر، فالرجل يمكن أن يعجب بالمرأة ويحبها – كما هو حال "إبراهيم" مع "آمال"-، لطموحها، وجرأتها، وصراحتها : "…طموحة جدا… لذلك تراها تستغل حضورها في كل مجمع لتقول كلمتها بكل جرأة وصراحة … جعلتها تحظى بقلب إبراهيم…" (ص25).
الأمر الذي يعني، أن المرأة يمكن أن تخترق الآخر ثقافيا كما يظهر في الحوار التالي بين "آمال" و "إبراهيم" : -"ألمس وجودي في الحضور الجماعي… أشعر بالانطلاق وممارسة حريتي في الفكرة. -لذا، فأنا مجنون بك "قال إبراهيم مبتسما" (ص25).
وكان، أن أحب "إبراهيم" "آمال" إلى الحد الذي يقول لها في إحدى خطاباته:
"آمال، أنت كل شيء في حياتي، أنت الأمل والدفء … أنت الخلاص…أمال … دعيني أحذف الألف، لأنك صرت الأمل" (ص31).
وبموازاة مع هذه الصورة المغايرة للرجل، استطاعت "جسد ومدينة" أن تبني صورة مغايرة أيضا لنموذج المرأة السائد في علاقتها مع ذاتها ومع الآخر (الرجل). فقد قدمت لنا من خلال "الساردة" و "آمال"، نموذج المرأة التي لم تنخرط في ثقافة تراتبية توفر القيم الأبوية، وتقدسها أو في إنتاج صورة إغرائية للذات، بهدف لفت ونيل الإعجاب ، لم يكن الجسد هو الوسيلة التي تنظم العلاقة بين الذات (المرأة) والآخر (الرجل). تحضر المرأة (الساردة-آمال) في الرواية، ذاتا مشاركة وينخرط همها في الهم العام بعيدا عن الانشغالات الضيقة بالجسد: "كان جسدها ممشوقا، وجسد المدينة مبعثرا ومشوها لكنها أحاطوه بصورة يخفي سر التآكل …" (ص25).
إن فكر المرأة ، يبدو منخرطا في إصلاح جسد المدينة المبعثر، ومنشغلا في أفق تغييره، الأمر الذي يفند الزعم الرائج حول المرأة بكونها كائنا حسيا حبيس أشياء جسده : "لم تكن تنتبه إلى تفصيلته وأنوثته، فقد كان في الأفق حلم يوحدها بأهل المدينة" (ص25).
هكذا إذن، وكما أن المرأة يمكن أن تخترق الآخر بجرأتها، وصراحتها وطموحها، فإن الآخر يمكن أن يخترق بدوره المرأة ثقافيا عوض الشكل الوحيد المعروف وهو : "الاختراق الجنسي"، تقول الساردة : "كنت أمتلئ كلاما غامضا اكتشفت بعدها أن خطاب إبراهيم بدأ يعرف مجراه إلى عقلي" (ص 78).
إن طرح الرواية لهذه الصورة المغايرة لعلاقة الرجل بالمرأة، هو تأسيس لرؤية جديدة تتميز بالنزوع إلى المرأة كجوهر إنساني فاعل لا يكتفي بوظيفة التلقي، بقدر ما ينخرط في علاقة التواصل والمشاركة الحية، ومن تم، تكون الرواية تجاوزت الخطاب التقليدي الذي يبني نظرته إلى المرأة انطلاقا من الرجل، حيث تصبح مرآة المرأة هي الرجل، وأسست مقابل ذلك خطابا حداثيا يقوم أساسا على تلك العلاقة التجاذبية بين المرأة والرجل، رافضة بذلك المنطق البطريركي القائم على الرؤية الذكورية الأحادية. وعليه، فإن كانت الذاكرة المقروئية تختزل مفهومها للآخر ضمن أفعال المواجهة، والصراع، والإقصاء، والإلغاء، فإن الرواية غيرت هذا المفهوم، وألحت على حضور الآخر لتشييد الكينونة المكتملة، كإمكانية ملموسة لمعرفة الذات، وإعادة اكتشافها، وذلك لتطوير وعي الذات بالعالم كما يظهر من قول "الساردة" عن إبراهيم: "تعلمت منك كيف أخوض تجربة الفكرة وأكون مسؤولة عن اختياري" (ص78-79).
هكذا نخلص، أن الرواية تدعو من خلال طرحها المغاير هذا، إلى أخلاقيات جديدة. ومن خلال تتبع تشكل "ضمير المتكلم" في مجريات السرد، يتضح أن الرواية تنطلق من أن الذات لا يتم تحقيقها بمعزل عن الآخر، وبأن خصوصيتها "لا تكتسب صفتها الحقيقة تلك، إلا باقتحامه مجال الحوار مع الآخر كلحظة أساسية لتجاوز الذات والإسهام في تطوير المعرفة بعيدا عن الاستلاب والتبعية"، وهو ما قصدته "آمال" بقولها : "ألمس وجودي في الحضور الجماعي" (ص 25). إن خطاب "آمال"- كما يبدو- بقدر ما ينم عن جرأة لاقتحام الآخر، ومخاطبته للحصول على قيم مشتركة، ينم في نفس الوقت عن وعي بأن تحقيق الوجود لا يتم بمعزل عن الآخر، فهي لا توجد لذاتها، بل تنخرط في وجود ومصير جماعيين، هو الوجود في عالم الجماعة التي تعيش معها. كما أن خطابها، تجسيد لرغبة المرأة في التواجد مع وبالآخر لتبديد إحساسها بالغربة والعزلة، والإلغاء، لذلك فهي تضيف : "أشعر بالانطلاق وممارسة حريتي في الفكرة …" (ص25).
والذات، كما يذهب إلى ذلك "هيغل" : "لتبدو أكثر وضوحا حين تضع نفسها في عمق هذا الآخر الذي يسكننا وندين له بالكثير من مواقفنا وسلوكنا … فلا بد إذن أن يدرك كل وعي ذاتي ذاته في وجه الآخر الذي هو متصل به ومنفصل عنه في آن واحد"( ). تتحدد الذات من خلال الرواية إذن، انطلاقا من هذه العلاقة المتولدة عن قراءة الآخر باعتباره هوية أخرى، بمعنى، كونها ذاتية متصلة بالذات، وهو ما تحيل عليه ضمائر الذات الجمعية المتصلة بالأفعال والأسماء: "ترى لو ضبطوا قلقنا ورموا بنا في المستشفى … ثم تكررت العملية لأكثر منا … لا شك سنصبح كثرا بالقياس إلى القلة الهادئة الرزينة المنضبطة. كما يقولون" (ص10).
"ألا يمكن أن نتخذ جنوننا ذريعة نحن أيضا… منهم نتعلم… وحينها نتأمل قلقنا" (ص10).
"…وأن الحياة مع ذلك تنساب في الإيقاع اليومي الرتيب الذي نجده في كل مكان من العالم … المكان يسكننا نحن … والمدينة بكاملها … دون أن نجزئها… نار تغلي بداخلنا…" (ص24) (التشديد من عندي).
إن ضمائر الذات الجمعية كما وردت في الأمثلة أعلاه، تدل على امتلاك الهوية لخصائص ممتدة في الزمن، فالأمر لا يتعلق بالذات الضيقة الغنائية، وإنما الذات التي تعبرها عدة أصوات وتحل فيها، بأحلامها، وآلامها، وعذاباتها : "…وتتقل رأسي أحزان أبناء مدينتي اللذين قتلهم حلمها… أغراهم مستنقعها بالحلم…" (ص75).
"إنه أنا الأخرى، التي تحاصرني …" (ص 91)،الأمر الذي يعني اعتبار الآخر، أنا ثانية، وتتحول الذات إلى آخر يتواصل في انتشار الخارج/المحيط/الفضاء، ويؤسس هويته، بحيث يصبح هذا الموقع الخارجي (ذاتا أو مكانا)، مكونا أساسيا وحيويا للذات: "فقط أسمع تحركات سعيد بداخلي تجيبني، أنه لا فائدة من متابعة الطرق على الباب" (ص90).
"أشعر بالمدينة تتسرب في جسدي، والطرقات تمتد في جسدي …صار جسدي طريقا تسلكها المدينة" (ص89).
هكذا، تكشف الرواية عن التفاعل المتبادل بين شبكة المواقع بحيث لا توجد الذات في موقع الداخل، ويوجد الآخر في موقع الخارج ضمن حدود فاصلة، بل إن هذه العوامل "الداخل والخارج"، تتبادل المواقع، بحيث تغدو المسافة بين الذات والآخر متشابكة، من الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل، ومعنى هذا، أن "الذات لا تعيد إنتاج لا شعور مغلق على ذاته، بل إنها متجهة بكاملها إلى تجريب كامل التماس بالواقع"( )، على نحو ما نقرأ بالرواية :
-"ترغب في أن يتبلل جسدها … أن تصير رعشة … تتحول رجفة … فتصبح المدينة قلبا يخفق بحياة كريمة" (ص11).
تكشف الرواية عن شبكة التداخل/ التفاعل المتبادل بين المواقع، بحيث "يمكن للخارج أن يصبح أكثر داخلية، وحميمية من الذات، ويكون بإمكان الداخل أن يصبح أكثر خارجية، وعنفا من الخارج، فلا توجد سوى الآثار والتداعيات المتبادلة"(21): - "كل شيء يشدني إلى مدينتنا، كنت أعتبر دائما الخروج من المدينة هروبا من مسؤولية المستنقع… كل شيء يشدني إليه… إلى إبراهيم" (ص 43).
إن مجاز غيرية الذات كما عبر عنه "ضمير المتكلم" في الرواية، يتوازى مع غيرية الفضاء الذي يحضر في النص متماهيا مع الذات، ومفتوحا على فضاءات أخرى تصير في متخيل النص، فضاء للتلقي على نحو ما نقرأ بالرواية :
- "اختزلت فيك كل الفضاءات …والأزمنة… صرت كل المدن العربية التي يتكاثف وحل مستنقعاتها…" (ص48).
الأمر الذي يؤكد أن "المدينة" ليست واحدة، بل مدن متعددة يحضر فيها العالم العربي بعلاماته الصادمة في مجال كل الممارسات. إن حضور "ضمير المتكلم" باعتباره قناة للسرد، وبصوت امرأة لا يعني إطلاقا أن الأمر يتعلق بالذاتية النرجسية التي تجعل منها ذاتها منطوية، منعزلة، مكتفية بذاتها، وإنما يتعلق بذات ما تنفك تعيد بناء ذاتها بتغيير اتجاهها راسمة بذلك فضاء داخل، لكنه يمتد بامتداد الخارج كله
2 - الوضع العام : بالإضافة إلى صراع المرأة في إطار ما أسميناه ب "الوضع الخاص"، تثير رواية "جسد ومدينة" معاناة المرأة ووضعها داخل مجتمع يضعها أمام هموم مشتركة مع الرجل. وتدور هذه الهموم في مجملها حول القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، و تصبح القضية في هذا المستوى من الصراع، قضية واحدة تجعل المرأة والرجل على حد سواء في إطار دوامة التخلف، وحركة التغيير من أجل التنمية، وتحمل مسؤولياتهما اتجاه الوضع المشترك، وذلك لمدى التأثير الحاصل بين الهم الخاص والهم العام، أي : بين قضايا الوطن وهمومه، وبين قضايا وهموم الفرد (رجلا كان أم امرأة). ويظهر لنا هذا التوحد بين المرأة والرجل على مستوى العنوان الذي يوحي مند القراءة الأولى بدرجة التكثيف، والرمز، والإيحاء، وذلك، بابتعاده عن التعيين والتحديد المباشرين للذات (جسد) وللمكان (مدينة)، وهو بهذا لم يكن يعني في تركيبته هاته (جسد ومدينة) سوى الهوية الجماعية والمصير المشترك. وإمعانا من الكتابة في تنوير قراءة النص بهذا الاتجاه تقول في إحدى "مناصاتها" "القضية واحدة : لأن الحلم الذي يكبر في الداخل يتكرر في ذوات مختلفة ولكنه يبقى واحدا" (ص6).
وهو "مناص" معناه ظاهر في تركيبته المنطقية، التي يمكن أن نصوغها كالتالي : وحدة حلم الذوات المختلفة ينتج عنه : وحدة قضية هذه الذوات المختلفة. وعليه، تصبح هذه الأخيرة (الذوات المختلفة)، ذاتا واحدة (جسد)، وتصبح قضيتها، قضية واحدة هي قضية المدينة (باعتبار هذه الأخير اختزالا للوطن) بحيث لا يكون تمة هناك سوى : :"جسد ومدينة".
أ - جدلية القهر : تنطلق الرواية إذن، من منطلق أن السياسي والعام، هو محض الشخصي والخاص، فحكاية شخصياتها الرئيسية (آمال، إبراهيم، سعيد، الساردة)، ليست سوى تمثيلا لحكاية المدينة (الفضاء العام)، لحظة الاختلال، وغياب القيم، وانهيار الأبعاد الإنسانية، على خلفية المنطق المتوحش للمال، والجاه، وعلاقات الغاب، مما جعل من المدينة، فضاء مسكونا بالأزمة، والقلق، والتوجس، والضياع، وطرح الأسئلة المصيرية، وكلها أشكال تجسدت لنا من خلال معاناة الشخصيات السالفة الذكر على مستوى تطلعاتها، ورغباتها الشخصية، حيث وجدت نفسها في ظل هذه الأجواء المأزومة، مرغمة على خوض مغامرة عنيفة على مستوى الجسد والهوية. يرتبط "إبراهيم" ب "آمال" و"سعيد" ب"الساردة"، بيد أن العلاقة بينهم ستظل محكومة بعوامل تتجاوز ذواتهم، ومن تم، ظلت هذه الشخصيات تعيش الارتباط حلما، هي التي وجدت نفسها تعيش داخل مجتمع، لكنها تظل خارجه، أو على الأقل على هامشه، وتحاول الانتماء إليه، غير أنها تفشل في تحقيق ذلك على نحو ما تعبر عنه "السادرة" بقولها : "المدينة انتماء، وحين يكبر فرعك وتطلب اعترافا اسم الانتماء يعطيك حق التوازن في الحياة… يتلقفك صمت الأبواب الموصدة…" (ص55).
أمام هذا الوضع الفارق، يستحيل بناء علاقة إنسانية متكافئة وناحجة، سواء مع الآخر أو مع الذات نفسها، إذ كيف ينمو الحب بين ذوات تعيش أقصى حالات التيه والضياع، بعد أن تكشف زيف العلاقات الإنسانية، وافتقاد كل إمكانية للتواصل وإعادة الانخراط في واقع يسحق كل ما هو حميمي. وما يعيق هذا النجاح هو : انعدام "الحق في الانتماء" الذي على الفضاء الحاضن أن يكفله، وهو حق مبدئي لضمان كرامة الفرد ووجوده، إذ بدونه، تصبح الذات سواء كانت لامرأة أو لرجل، مجرد احتمال، وتصبح العلاقات الإنسانية في غيابه، ناقصة ومشوهة لأنها تسقط في اللاتوازن تحت تأثير العسف الخارجي. وفي هذا المستوى فإن "جسد ومدينة" تمثل ثنائية الذات (المرأة) والآخر (الرجل) من خلال استثمارها العلاقة بين الاثنين عبر دوائر سردية تلتبس فيها الجغرافيا (المدينة) كأنثى رمزية بجسد الأثنى العضوي، فتغدوا الأواصر المركبة التي تصل شخصياتها وما تستثيره من صور التخاطب والتفاعل كناية عن أزمة الانتماء إلى الفضاء. هكذا، فالدوائر السردية المشخصة لأزمة التماهي والتواصل تحكم حبك الأحداث والوظائف التخييلية، وتشكل اغترابا متعددا للذوات داخل الفضاء مما يكرس حالات الالتباس والغموض المفضية إلى نتيجة استحالة اللقاء. لذلك ظل ارتباط الشخصيات عند حدود "العتبة"، فقد كانوا يؤجلون الإقبال على بعضهم إلى حين تهيئ الشروط الموضوعية الملائمة، تقول "السادرة" : "حتى الإقبال على بعضنا صار معلقا حتى إشعار آخر …(ص37).
كانت الشخصيات تحلم بمجتمع لا حرمان فيه، لذلك أجلت راحتها الشخصية في انتظار راحة تتوزع على المجموع، انطلاقا من وعيها باستحالة اللقاء بين الرجل والمرأة إلا في فضاء للحرية، و العدالة الاجتماعية التي تستلزم إنسانا متحررا يمارس حرية العقل، والمحاكمة، والاختيار : "حتى إذا ما التصقت الشفاه بالشفاه يكون عندها الفكر منشغلا باللحظة" (ص37).
ولعل السؤال الاستنكاري الذي أجاب به "سعيد" "إبراهيم"، بعدما أراد هذا الأخير، لمجرد تلطيف الجلسة، الحديث عن الحب والمرأة : "كيف أحب وأنا لا أملك ما أحب؟ " (ص 41). يغني بعد المفارقة لدى الشخصية، التي ترغب في إنجاب هذا الشعور (الحب)، لكن تجد نفسها أمام وضع يولد الرقابة أكثر مما يفتح ذراعيه لانتعاش هذا الإحساس الإنساني، يقول "سعيد" موضحا : "لو منحوني محبوبتي، سأنزوي بها في غرفة، غرفتي أنا، أتفهم، يعني أن أملك الغرفة أنا، نعم هي بسيطة جدا، ولكنها غرفتي أنا، أتفهم يعني أملك الغرفة، ثم أغلق النوافذ، نافدة غرفتي وأيضا الباب، لكن بشرط ألا يشعروني بأن وراء الباب من يعد الثواني" (ص 41) (التشديد من عندي).
هناك إذن، تجاذبا بين الواقع المادي بكل ميكانيزماته، وبين حق الإنسان في إنجاب الشعور بالحب، ففي واقع – مثل واقع شخصيات الرواية، حيث تنعدم الحرية والعدالة الاجتماعية – يفتقد كل شيء هويته الأصلية : الإنسان، الزمن، الفضاء، وتصبح القيمة تعني ضدها، بل الحقيقة ذاتها تسقط في خداع الوهم حيث:
"كل شيء يساوي حقيقة واحدة : الحب، النظافة، القذارة، التنظيم" (ص40). وعليه، يصبح الحب في مثل هذا الشرط مجرد وهم، وتصبح المحبوبة محض سراب وهو ما يقصده "سعيد" بقوله ل "إبراهيم" : "تتحدث عن الحب ! إنه وهم …أنت تتوهم أنك تحب آمال …أمال سراب يا إبراهيم … حان الوقت لكشف الوهم…" (ص 41).
وهو ما ينم عن دعوة لوجوب مقاومة الشرط المولد لهذا الوضع أولا، الذي يقتل أفضل ما في الإنسان، فمن يدري، في واقع يتغير باستمرار نحو الأسوء أن: "يصدر غدا أو بعد بعد غد قانون بموجبه تمنع أنت من حق العشق" (ص41).
هكذا تحدث "سعيد" لإبراهيم، الذي بمجرد دعوة هذا الأخير له بمشاركته الحديث عن الحب أجابه : "يا إبراهيم، زمن الحب قد ولى، زمننا زمن القذراة، أتقول الحب ! يالك من غبي! ! " (ص40).
وما دام الحب الحقيقي لا يحتاج إلى ذوبان شخص في آخر ولا إلى ضياع شخص في آخر، بل يتطلب ندية بين الرجل والمرأة، وتثبيتا للذات لكليهما، فإن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العملي المباشر، وصراعها مع عواطف الحب والاستقرار العائلي تغطي نصيب كل من الجنسين، يقول "سعيد" :
"…أريد أن أشعر أني أملك محبوبتي حقيقة … أو إن صح التعبير أن نشعر نحن الاثنين أننا نملك حق الحب …" (ص41) (التشديد من عندي).
ينم هذا القول، أيضا على أن المساواة شرط أساسي للحب، إذ لا يمكن لأي حب حقيقي أن يعيش دون مساواة صادقة، وهو مفهوم يهز أركان العلاقة التقليدية بين الذكور والإناث القائمة على الخدمية وعدم التكافؤ. لهذا، كانت الرغبة مشتركة بين شخصيات الرواية لاختراق الدائرة ومجاوزة الشرط القاسي، ومن تم فقد انخرطت في الهم العام، وواجهته بالسؤال الذي يحضر تيمة أساسية بالرواية، السؤال بمعنى، الرفض ومواجهة الوضع القائم ومقاومته. "تحدثه نفسه عن ضرورة امتهان السؤال(…) كل شيء يكبر فيه… طموحه، عناده، رفضه، سؤاله، ثم عشقه لها…" (ص 17-18). "السؤال بهذا المعنى يصبح عرضة للخطر والمخاطرة … استباحوا الذاكرة وخنقوا السؤال وهم لا يدرون …" (ص 23). تحضر المدينة في الرواية واقعا ماديا يقدم مشروعا كاملا لمجتمع محلوم به، يهدف إلى اكتشاف نظام اجتماعي جديد أكثر احتمالا وتناسقا ووضوحا، وإيجاد مجتمع جديد هو نقيض للأجواء الخانقة بالأجهزة البيروقراطية، وهو في نفس الآن حلم بالحرية التي تحلم بها النساء والرجال على السواء. من هنا، يصبح الانخراط في الهم الجماعي العام دفاعا حقيقيا عن الحقوق الشخصية، لذلك فقد تبنت كل شخصية قضية الأخرى لوعيها بأن القضية واحدة يقول "إبراهيم" ل "آمال" في إحدى خطاباته لها : "…صرت حبي … أمي، مدينتي … سري … قضيتي، أنت البداية والطريق. (ص48)".
وتتماهى المدينة مع "آمال"، ويخاطب إبراهيم الأولى في شخص الثانية قائلا: "… اختزلت فيك كل الفضاءات … والأزمنة … صرت كل المدن العربية التي يتكثف وحل ومستنقعاتها" (ص48).
الأمر الذي يشير إلى تصور "إبراهيم" لقضيته التي لا يفصل فيها بين قضية "آمال" (المرأة)، وبين قضية المدينة (كاختزال للوطن)، التي يمكن أن نقرأ على مراياها كل المدن العربية. ومن داخل نفس الوعي، تخاطب "الساردة" (المرأة) "سعيد" في شخص جنينها "خيار"، وتخاطب هذا في شخص الأول بقولها :
"… أنت كل ما تبقى لي … أنت الغائب الحاضر… أنت حبي الذي لا يقهر .. أنت، من أنت؟ أنت حكايتي، قضيتي أنت سر بقاء مدينتي في ذاكرتي. "(ص81) (التشديد من عندي).
وصارت قضية المرأة قضية "سعيد" أيضا وهو يرى أن جسدها وحده يشتغل – في إشارة إلى غيابها كذات مفكرة والاقتصار فقط على جسدها – الذي يستغل في ظل الأوضاع المتفاقمة، أداة تخدير، وتسكين : "هي كل تبقى له، وحده يمتص قمة الإحساس بالذل … ما الذي ينسبه حرقة الذل سوى أن يهرع ليلا يختبئ في ثنايا جسدها، هي لا تقاوم … وإنما تصير كوما رمليا ما أن يضع يده حتى ينجرف إلى الداخل يتشتت الكوم دفعة واحدة" (ص55) (التشديد من عندي).
"كلما كثرت هموم الرجل طلب الجسد : الجسد المخدر. الجسد المسكن. الجسد الوكر… إن باتخاذك من جسد المرأة عباءة تنسى مشاكل اليوم بكاملها، هكذا تعلن حكمة مستنقع المدينة … تتكاثر هموم المستنقع … يكثر طلب الجسد، وحينها يمتلئ المستنقع أطفالا … إنها لا تعلم. إنها غائبة. وحده الجسد حاضر…" (ص26-27) (التشديد من عندي).
وضع المرأة – كما يبدو، وكما وعى ذلك "سعيد"- هو نتيجة للوضع العام، ومن تم، فتحريرها منه، لن يتأتى إلا بتحرير شامل كلي للفضاء، وتخليصه من ربقة الشروط المادية القاسية التي أنتجته، ولهذا : "فقد صارت قضيته … وما بعدها انتشاء في الفراغ الوجودي … هكذا حدد هدفه من مفهوم البقاء" (ص27) (التشديد من عندي).
ستظل هذه الرغبة المشتركة للشخصيات في اختراق الدائرة ومجاوزة شرطها محكومة بعوامل تتجاوز ذواتها، وهي عوامل غائرة في واقع لا يمكن أن يكرس سوى التباعد، إذ لا سبيل إلى تحقيق أي فرد في وطن لم تتحقق له فرصة التطور والتحضر الحقيقيين. وتسترسل الصور الروائية في تطريز تنويعها للخيبة والانكسار، التي لم تخص بفجائعها الرجل دون المرأة، ولا المرأة دون الرجل، ف"إبراهيم"، ينتحر احتجاجا على عقلية التآمر والتواطؤ، والمصالحة التي أبان عليها المثقف المتواطئ، والسياسي المتآمر، وهي بصورة أخرى، خيبة المثقف الذي راهن على مبدأ المواجهة والتغيير بحثا عن أفق بديل. إلا أن توجهات السياسي النفعية لا تولي أهمية لما يطرحه المثقف، إن لم نقل تسخرها لخدمة أغراضها وقضاياها بحثا عن مكاسب تكرس التصالح والتواطؤ وغيرهما، وهو ما كان يقصده إبراهيم بقوله المنقول عبر الساردة : "أشكال الحصار أصبحت تنطلق بالقرب منا" (ص 75). أما "آمال"، فقد وجدت نفسها مكرهة لأن تمتهن جسدها وتقدمه مقابلا للحصول على "جواز سفرها" رضوخا للمنطق المعمول به في مجتمع المدينة، منطق البيع والشراء. أما "سعيد"، فقد اختفى في آخر اعتقال له، ليصادر حلم "الساردة"، ويظل "خيار" (جنينها منه)، أملها في تكسير الدائرة، وانتزاع حق الخيار تقول :
"…ويطلقني زغرودة حين يقرر القرار … قرار الخيار … خيار الميلاد… ميلاد الانتماء …" (ص92).
هكذا إذن، تتوحد كل الذوات أمام نفس المصير، مصير الضياع، الأمر الذي يؤكد أن تبعات الواقع الموبوء، تنسحب على كلا الجنسين، وتجعل الرجال شقائق النساء في الهزائم والخيبات، ذلك أنه على عكس مما يذهب إليه الإبداع العربي عامة من أن تأخذ عنده المرأة رمزا للوطن، تذهب رواية "جسد ومدينة" إلى أنه ليست المرأة وحدها هي الرمز، بل الذات بكليتها سواء كانت لرجل أم لامرأة. فالمدينة بالرواية تتماهى مع الرجل كما تتماهى مع المرأة، ومعناه أن الذات الإنسانية كل لا يتجزء، فذات المرأة وذات الرجل كلاهما وجهان لعملة واحدة وهي : الإنسان، وعليه، ف : "القضية واحدة. لأن الحلم الذي يكبر في الداخل يتكرر في ذوات مختلفة ولكنه يبقى واحدا" (ص6).
واضح إذن، أن هناك روابط قوية بين الشخصي، والاجتماعي، والسياسي، وقد تأكد هذا بشكل ملموس عبر تركيبة تجربة الشخصيات، فلم يكن ما حصل ل "آمال" و"سعيد" و"إبراهيم" أحداثا شخصية، بل جوهر ما حدث يكمن فيما يعرضه مجتمع المدينة من ظلم وتخلف، والسرد يكشف عن المحن الصعبة لكل من الرجال والنساء الذين يعانون نتيجة هذا النمط الاجتماعي المشوش. إن مأساة المرأة والرجل- من خلال ما تقدم – تكمن في طبيعة السياسات السائدة بمجتمع المدينة، هذه السياسات التي تقف دون تحقيق الذات – أي ذات- الحلم بالعيش الكريم، ثم الارتباط، لتغدو تحت ضغط واقع المعاناة مجردة من كل قيمها وقضاياها النبيلة، وتظل مجرد هيكل خال من إنسانيته. فالمرأة، تصبح جسدا : "يدفع ثمن التاريخ المعطل" (ص60). والرجل يصبح نفاية : "من النافذة يراها تبتلع نفاياتها، رجل يجر عمره الملطخ بوحل الحاجة …" (ص15).
وتظل بالتالي كينونة كل منهما، مقصاة ومغيبة في ظل القهر والإقصاء.وهو قهر كما يبدو عام، ممارس على الجنسين سواء بسواء، فغياب الحقوق والمساواة والتوزيع العادل حول المرأة "آمال" : "سكة حديد تعبرها البطون القادمة… (ص 72) ودفعت بالرجل "إبراهيم" إلى "أن يرتاح" (ص75) انتحارا. ما تطمح إليه رواية "جسد ومدينة" إذن، هو إثبات رؤية للعالم من منظور مشترك ينبني على أن عملية التحرر عملية شاملة، تمس ما هو اقتصادي، وسياسي، وأخلاقي، ويجب أن تطال كل الفئات المضطهدة في المجتمع رجالا ونساء. وهي، مناقشة علمية لمشكلة المرأة في ظل الإيدولوجيا السائدة التي تحاول فصل المشكلة عن أساسها الاقتصادي، وتموضعها في الطبيعة، متخذة من التناقض البدئي للطبيعة مرتكزا لها في إزاحة الصراع عن أهدافه الحقيقية في التغيير الاجتماعي، حتى يغدو الصراع أفقيا يقوم على الجنس داخل النوع، وتصبح البيولوجيا وسيلة لعقلنة السياسة وتبرير التسلط والقهر. لاتنبني "قضية المرأة" في الرواية إذن، من منطلق ذاتي، خاص، وإنما من منطلق إدراك ثوري، ووعي ناضج، بأبعادها التي لا يمكن فصلها عن مجموع العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بمعنى أن الأمر يرتبط بالمجتمع بكل ما يعكسه من مصاعب على الرجل والمرأة. الأمر الذي، نستشفه من خلال هذا التجاذب في النقاش بين "آمال" وصوتها الداخلي (أناها الآخرى)- والذي اتخذ موضوعا له، واقعة موت إحدى الشابات "في الفندق الشاطئي" : "…إنها مسكينة. وتستحق الشفقة… أنت تدافعين عن نفسك يا آمال، بل أدافع عن قضية … أتعتبرينها قضية ! أتدافعين عن أخلاق فاسدة ! وبنات الشاعر وانتشار الفساد ؟ أين هي الأخلاق ؟ وأنت أين هي الحقوق والمساواة والتوزيع العادل؟ عن أي أخلاق تتحدث وعن أي حقيقة نظيفة تتحدث" (ص 72).
هناك إذن، صوتان يتجاذبان النقاش، إزاء موت تلك الشابة : صوت لا يتعاطف معها، ويحملها المسؤولية فيما وقع لها كونها فاسدة أخلاق، وصوت "آمال" الذي يكشف عن حقيقة الأمر ويلقي باللائمة على الوضع السائد- الفاسد- الذي أنتج مصير هذه الفتاة- ومصيرها هي نفسها- لتعيد السؤال كالتالي : "لماذا نسأل في موتها …. لماذا لم نسأ عن حياتها كيف كانت" (ص72).
"آمال" تضع نفسها- من خلال هذا التجاذب الداخلي للحوار- موضع المقارنة الطبقية مع الآخر، هذا الآخر، الذي ليس في حقيقته سوى : "الأنا" وقد انشطرت إلى "أنا" مضاعف، متعدد بتعدد الطبقات الاجتماعية وشساعة المسافة بينها. التعامل إذن مع مسألة المرأة كما تطرح الرواية، لابد وأن يعالج من منظور نضالي، يستهدف تغيير الأوضاع العامة التي أنتجت استلاب الرجل وا?




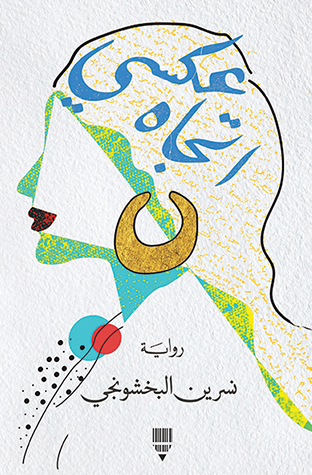



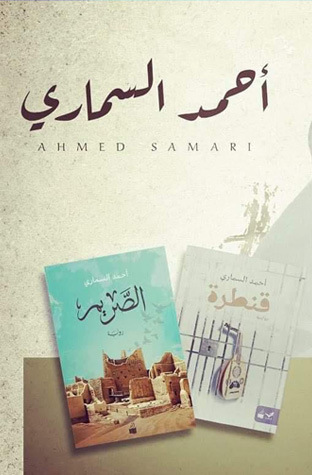
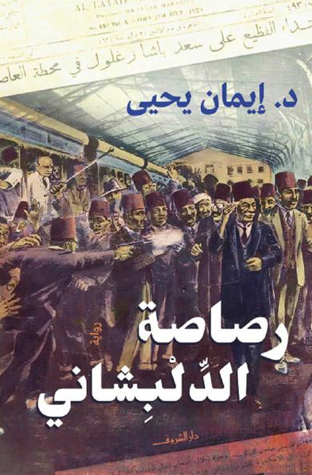
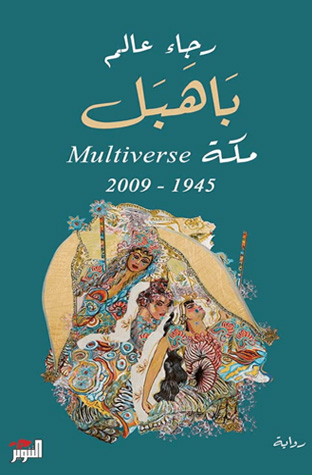



0 تعليقات