أشعر وكأنني أحمل مبضع جرّاح أشرّح به النفس البشرية
حين أتحدّث عن تجربتي الأولى في الكتابة الأدبيّة أرى نفسي مباشرة أمام حقيقة أن الكتابة الأولى على الورق هي الكتابة العاشرة في الذهن وربما أكثر. الكاتب في حالة دائمة من التفكير سواء دوّن ذلك أم لم يفعل، ثم تأتي الكتابة على الورق ثم النشر ليتجسّد ذلك مكثّفًا. ومما لاشك فيه، أنه ليس هناك من كتابة أدبية تنطلق من العدم، القراءة شرط للكتابة وهذه القراءة برأيي تنقسم إلى أنواع ثلاث قراءة الأدب وقراءة حيوات الآخرين وقراءة نتاج الفن.
أقول دومًا إنّ من يكتب كتابا واحدا جيدا فهو بالتأكيد قرأ عشرات الكتب الجيّدة، فالموهبة وحدها غير كافية ولابد من قراءات تصقلها. فالكاتب الجيد برأيي هو قارئ جيد بالضرورة. قال طه حسين: "ليس كل قارئ بقارئ". وأعتقد أن القراءة التي تتجاوز السطور إلى ما بينها من أحاسيس عصفت بالكاتب حين كتب هي القراءة التي تحفز على ممارسة فعل الكتابة، بل هي التي تجعلنا لا نقاوم إغراء بياض الورق لفضّ بكارته بالحبر. حين كتبت، شعرت بتأثير عدة روايات لا سيّما أعمال ديستويفسكي التي لامست شغفي بعلم النفس والفلسفة (مجال دراستي الجامعية) وحين كتبت روايتي (إيميسا) الصادرة عن دار التكوين بدمشق أبريل المنصرم 2019، شعرت بتأثير أعماله، فصرت حين أحلل شخوص روايتي وأصفهم وأدرس أفعالهم وردودها، أشعر وكأنني أحمل مبضع جراح أشرّح به النفس البشرية بغرض الكشف عن تناقضاتها ومفارقاتها ومحاولة فكّ شيفراتها وألغازها.
متى كانت شرارة الكتابة؟
رغم تأثير عدد من الأعمال الأدبية، غير أن فتيل الكتابة أشعله عملٌ أدبيٌّ واحد بلحظة غير محسوبة وغير متوقعة ربما، وهذا ما فعلَتْه رواية خالد الحسيني (ألف شمس مشرقة)، كنت بصدد إعداد دراسة أكاديمية لنشرها في كتاب حول الحرب في سورية ومسبباتها وعلاقتها بمفهوم القوة الناعمة، لكن الرواية غيّرت مسار عملي حينها وفسرّت لديّ واقعيًا مقولة نيتشه: "ما كُتبَ بالدم يُقرَأ بالدم" فكنت لا أقرأ فحسب وإنما أعيش في سطوره وبينها. وأعتقد أن هذا يعود لأسباب عديدة منها أن روايته تناولت الحرب في أفغانستان حيث استطاع في توصيفه لها وتحليله حيثياتها وشخوصها أن يعبر بي إلى هناك ثم يعود بي إلى الحرب السورية التي أحياها لحظات قراءتي له، فرأيت النار والدمار والتدمير والتخريب وشممت من كلماته رائحة البارود التي التقت بما تنشقته سنوات هنا على أرض سوريا، التفجيرات التي دمرت مدنًا، القذائف والصواريخ كنت أسمعها يوميا فيأتينا صداها من صفحات الحسيني، المهجّرون ذكروني بمهجّرين، المصابون الذين بكيتهم، الفقد، جدلية الحياة والموت، جدلية الوجود والعدم، النسبي والمطلق، ضرورة الالتفاف لحل المشكلات بهدف النجاة كل ذلك عشته أيام الحرب ومجددًا في صفحات الحسيني.
وهكذا بلحظة واحدة تفجّر بداخلي بركانٌ من الأفكار والشخوص والأحداث وشعرت كما يقول بوكوفسكي أن الفكرة "انطلقت كما الصاروخ ويجب أن تُكتبَ" كل ذلك صرخ بي: "اكتبي!" وأذكر تماما أنني تواصلت مع أحد الأصدقاء وهو كاتب قصص قصيرة فاستغرب جرأتي، وقال إنه يكتب منذ سنوات ولم يتجرأ مرة على كتابة رواية لأن كتابة الرواية أمر مهيب، لكنني لم أنصت إلا لصوت داخلي يحثني على عدم مساءلة رغبتي في الكتابة. وهكذا أمسكت بقلمي وحدث سيلٌ من أربعمائة صفحة من الدموع والضحك والصراخ، ووددتُ حقيقةً، وأعلم أنّه محالٌ، أن أمتلك الوقت والقدرة الجسدية والنفسية والعصبية على البقاء مع قلمي والورق إلى أن أنهي الرواية لأنها حاضرة في ذهني كلها، إلى الحدّ الذي كنت أبقى فيه ساعات طوال دون أن أشعر بمرور الوقت. كان صداع الفكرة يؤلمني ولا يشفيه إلا رؤيتها متجسدةً على الورق أمامي، حينها فقط أتنفس الصعداء وأبتسم.
 علاقتي بشخوص الرواية:
علاقتي بشخوص الرواية:
الطريف بالأمر أن ما كنت أسمعه على لسان كتّاب وروائيين حول حالة التوحّد بشخوص رواياتهم وعشقهم لأبطالهم وحنقهم من آخرين وحزنهم على موت شخصية، كلّ ذلك كنت أظنه ضرباً من التهويل والمبالغة إلى أن عشت ذلك تماما فصرت أحادث أم هشام (الشخصية الأحب إلى قلبي في الرواية) وأشتم ماهر (شخصية أخرى) وأواسي سلاف (شخصية ثالثة) على جرحها وأشعر بهم جميعا حولي حين أخرج وحين أشاهد التلفاز وفي العمل وأثناء قيادتي سيارتي، وفي المطبخ حين أطهو. الغريب حقا أن الكاتب يرسم المصائر ويخلق ويعدم ويحيي ويميت ينحتُ شخصية لئيمة ويغضبه ذلك ويرسم أخرى مسالمة فيتعاطف معها، الكاتب أشبه بالإله وأحيانا كما الشيطان الذي يوسوس للشخصية ليتصاعد الحدث فيأتي الانفراج. الكتابة فعلُ خلقٍ بلا شك.
حين أنهيت كتابة الرواية، كانت المفارقة في سعادة ممزوجة بغصة، لقد انتابني حزن شديد حين ودّعت شخوصي. بكيت وكنت أظن أن هذا لن يحدث، لكني بكيت بحرقة. من جهة أخرى تملكتني سعادة كبرى برؤية وليدي الأول وقد تجسّد أمام عيني وعلمت حينها كم هي عزيزة بنات الأفكار التي لا تشبه في خصوصيتها حتى الأبناء لأنها ثمرة محض فردية، لا يشاركنا في تكوينها أحد.
قراءة الواقع
ثمة قراءة أخرى ضرورية لفعل الكتابة، ألا وهي قراءة الواقع. حيوات الآخرين تشكّل مادةً غنية للكتابة ولذلك أرى أنّ الانخراط في الواقع شرطٌ آخر لا محيد عنه للكتابة الصادقة على نحو لا تعود معه العزلة التامة المطلقة بكافية لممارسة فعل لكتابة. المشاهدات شرط آخر هام للكتابة ففي كل ما نشاهده من أعمال درامية ومسرحية وسينما وأي نتاج جماليّ، كل ذلك يصب في العمل الأدبيّ فيجعله أكثر اكتمالا ونضجًا. اعتزال الناس والضجيج وعوامل التشتيت الذهني أمور هامة إذ لا بد من الغياب أو الغروب على حد تعبير نيتشه، ليثمر ذلك عن عودة الغارب عودةً جمالية غنيةً إلا أن إنضاج بذرة الكتابة يتطلب تجارب حيّة وكأنها الماء الذي يرويها فتنمو شيئا فشيئا بما يتلاءم مع خصوصية العصر. وبرأيي الكتابة المعزولة تماما عما هو حيوي كتابة غير مقنعة أو على الأقل ستندرج تحت عنوان اليوتوبيا أو الخيال المحض والصدق هو البعد الذي يكون معه الأدب شجاعًا جريئًا لا سابحًا في ملكوت الفكرة وحدها.
وفي الختام أقول إن السؤال الذي شغل الكتّاب والنقّاد: لماذا نكتب؟ الإجابة عنه إجابة عريضة وواسعة جدا، فالكتابة صرخة احتجاج وتمرد، والكتابة حلم يتحقق في تجسيد الفكرة، في الكتابة يهرب كلا الكاتب والقارئ إلى عوالم لايمكن أن نسافر إليها إلا عبر الأدب، هذه العوالم الجميلة بما تخلفه في النفس، يقول القارئ: كيف عرفت أنّ هذا ما أعانيه؟! وكيف عبّرت عما بداخلي بكلماتك؟ والكاتب يعلم أنه نطق بلسان كثيرين فالكتابة تطهّر حقيقيّ لا يشبهه فعل آخر. بالإضافة إلى ذلك فالكتابة حدثٌ مفاجئ كما الحب يخطفك ويعصف بك عصفًا، سيلُ لا سبيل إلى وقفه أو ردّه، والتردد هو العدوّ اللدود للكتابة، فالشجاعة أهم أدوات الكاتب إذ أن الفكرة تعشق العقل المقدام دون تردد، وحين يجبن عن كتابتها ستفارقه إلى غير رجعة، ولن تزوره مجددًا.
*روائية سوريّة
الرواية نت - خاصّ







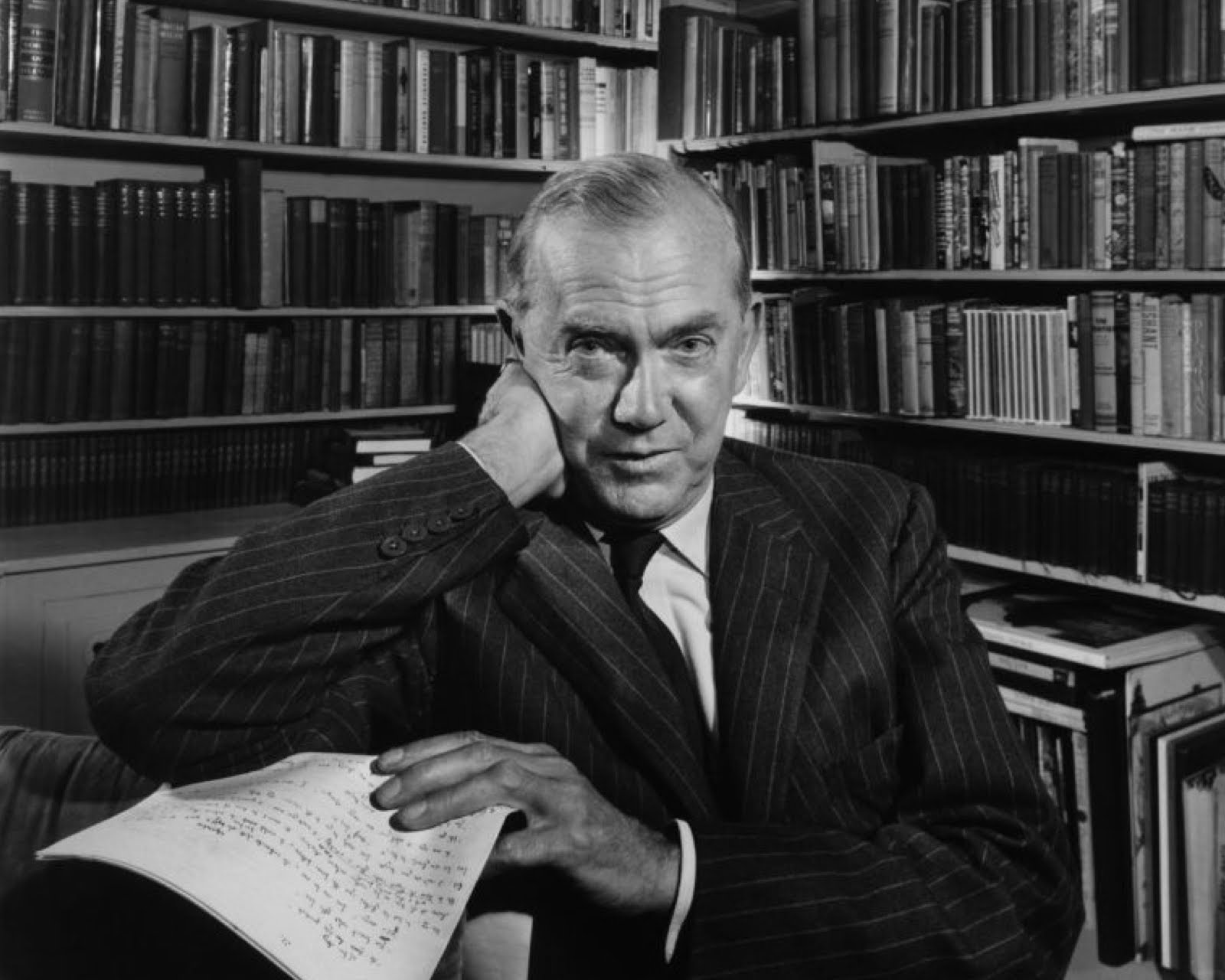


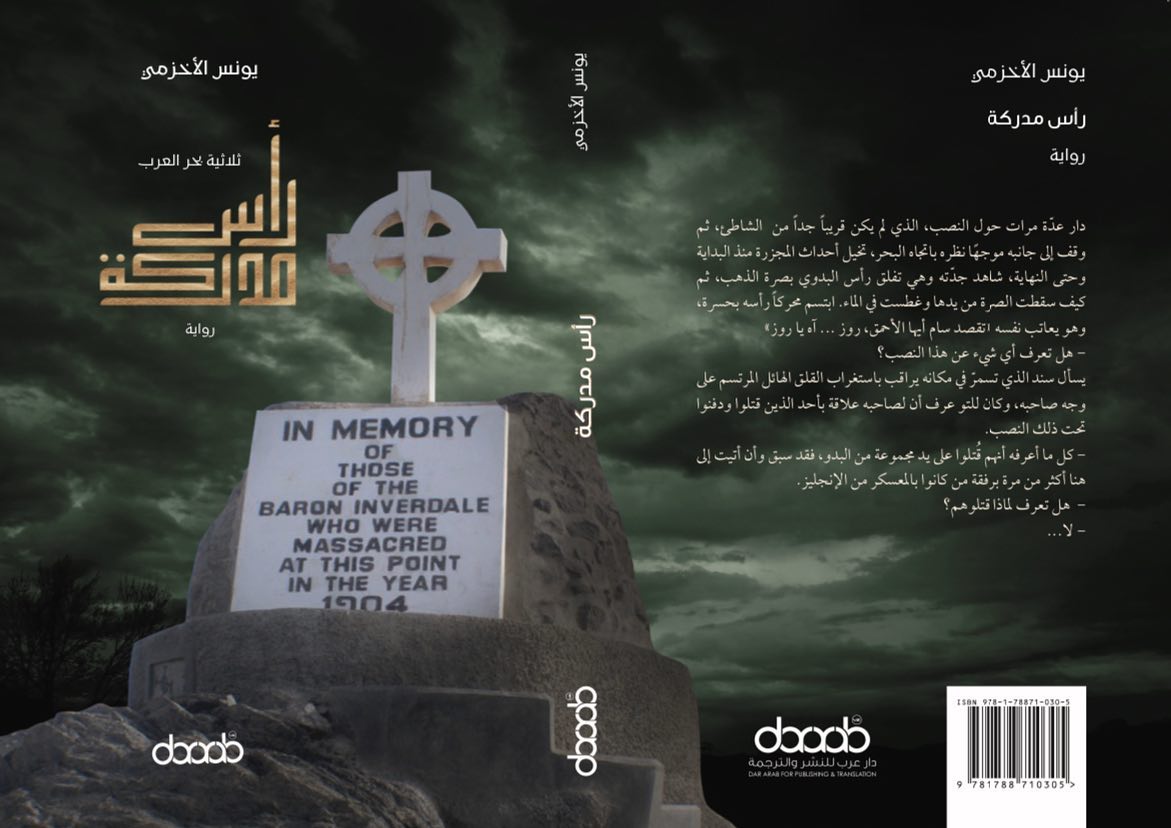



0 تعليقات