نيروز مالك: لا مردّ لكلمة الزمن إنها كالقدر
الرواية نت – لندن
أمضى الكاتب والروائي السوري نيروز مالك عقوداً في عالم الكتابة والإبداع، نشر عدة مجموعات قصصية قبل أن يكتب روايته الأولى "زهور كافكا" سنة 1993، وقبل ذلك كان درس الفن والرسم، وأبحر في عوالم اللوحات والألوان، ثمّ نقلها إلى أعماله الأدبية ليمزج بين الفنون بطريقة إبداعية لافتة.
في حواره مع الرواية نت، يؤكّد نيروز مالك، المقيم في حلب، أنّ همّه كان ومازال أن يكتب قصة ورواية وحكاية ومقالة.. أن يكتب فقط. أما المآلات، فهذه لم يفكر بها.. ويؤكّد أنّه سيترك الأمر للمستقبل، لأن الزمن هو خير مغربل للإبداع.
يستعيد مبدع "تحت سماء الحرب" في هذا الحوار جوانب من رحلته في عالم الإبداع، ويحكي عن بعض انشغالاته الأدبية والفكرية، ويشير بجرأة إلى بعض ما يتخلل عالم الكتابة والنقد والنشر والترجمة من إشكالات.
- كيف تقيّم تجربتك مع القراء؟
لي تجربتان مع القراء.. عرب وأجانب.. مع الأسف لست مطلعاً على تفاصيل تجربة القراء العرب، فليس لدّي علاقات معهم، فلم أتلق في يوم من الأيام رسائلاً منهم، أو بعض آرائهم في قراءة هذا العمل أو ذاك من أعمالي الروائية والقصصية، حتى من أقرب الأصدقاء، وإن وجِد من حدثني عنها، فأجد في كلامه المجاملة أكثر من القراءة الواعية، والرأي المقنع، والفهم الصحيح لما قرأه.
أما تجربتي الثانية مع أعمالي المترجمة إلى أربع لغات اوربية (روايتان ومجموعة قصص) فأعرفها جيداً. لقد تلقيت منهم كثيراً من الرسائل، ومما كتبوه على حيطانهم في الفيسبوك، أو في بعض المواقع الإلكترونية، وفي الصحف والاذاعة والتلفزيون، وفي اختيار بعض نصوصها، خاصة من رواية (تحت سماء الحرب) وتقديمها كلوحات عبر فرق موسيقية ومسرحية، وفي اختيارها كمادة درسية للطلبة في المانيا والسويد، وتم ترشيحها إلى أكثر من جائزة، وحصولها على بعضها. وقد كانت كل القراءات إشادة بالأعمال.. وسأنتهي من جوابي هذا بما قاله الكاتب السويدي الذي ترجم روايتي (تحت سماء الحرب) إلى السويدية، قال عن روايتي (ظلال الليالي) التي قرأها عبر ترجمتها الفرنسية قبل أن تصدر طبعتها العربية في العام الفائت 2020 في القاهرة عن دار ببلومانيا: "من يقرأ ظلال الليالي سيعرف أسباب الحرب القائمة اليوم في سوريا".
بالمناسبة الرواية ليست لها علاقة بالحرب، وما جري في سوريا في أثنائها، لأنها مكتوبة في سنة 2007، وتم نشرها مترجمة إلى الفرنسية في 2017 وصدرت طبعتها العربية كما قلت في 2020 هذه هي تجربتي مع القراء عامة.
- ما هي أهم الأعمال التي أثرت في تجربتك الإبداعية؟
بالمناسبة.. لقد بدأت فناناً تشكيلياً. درست الفنون الجميلة، وأقمت معارض فردية وثنائية مع بعض الأصدقاء الفنانين، منهم المرحوم الدكتور حيدر يازجي والدكتور مأمون فنصة المقيم في المانيا منذ عقود، وهو مدير المتحف الإسلامي في برلين على ما أعتقد. كما أنني شاركت في المعارض الجماعية الرسمية (معرض الربيع في دمشق ومعرض الخريف قي حلب) إلى أن توقفت عن الرسم بعد حرب حزيران 1967 التي هُزمنا فيها شر هزيمة، والتجأت إلى عالم الكتابة، ظناً مني أن للكتابة صدراً أوسع من الرسم للتعبير عن المأساة الحزيرانية في تلك السنوات..
طبعاً هذا لا يعني أنني لم أتأثر ببعض الكتّاب على كبر، كما يقولون.. بالعموم تأثرت بالأدب الروسي، خاصة في القرن التاسع عشر، وببعض الكتّاب في العهد السوفييتي الذين كانت لهم نظرة انتقادية للنظام والسلطة (آيتماتوف، شوكشين، راسبوتين، بولغاكوف) إلى جانب كتّاب آخرين من الغرب.
أما الأعمال التي وقفت أمامها بدهشة، في أثناء قراءاتي الأولى فكثيرة، منها الكلاسيكي، دون كيخوتة لسرفانتس، وموبي ديك لملفيل، واليوغسلافي ايفو أندريفيتش في روايته، جسر على نهر درينا، وشولوخوف في ملحمته (الدون الهادئ) وآخرين كثر. ولكن هناك نقطة، كنت دائماً حريصاً عليها في كل ما كتبت، أن أكون أنا وليس أحداً غيري، وهذه القناعة التي عملت بها استعرتها من مفاهيم المرحلة التشكيلية في حياتي.. ففي عالم الفن التشكيلي، إن لم يكن لك طريقة في التعبير وأسلوب خاص بك يميّزك عن الآخرين فلن تكون أصلاً أبداً.. هذا ما حاولت أن أكونه في كل ما كتبت.

- ما الرواية التي كنت تتمنى لو كنت مؤلفها؟
مصير إنسان، للكاتب الروسي شولوخوف، وهي رواية بالرغم من أنها قصيرة، ويمكن أن نضعها في خانة القصة الطويلة.. هذه الرواية بالنسبة لي تأتي في نتاج شولوخوف الذي حصل على جائزة نوبل في 1965 على ما أعتقد، تأتي بعد ملحمته (والدون الهادئ.. هذه الرواية القصيرة تلخص كامل معنى الدفء الإنساني والتعاون والتعاضد والموقف الذي لا بد للإنسان، حتى يكون إنساناً، لا بد له، أن يقف ما وقفه أندريه سوكولوف بطل الرواية تجاه ذاك الصبي اليتيم الذي فقد في الحرب كل شيء، فتبناه كابن له.. وقد أخذت هذه التيمة لأنهي بها روايتي (وقائع الحرب اليومية) التي صدرت عن دار(ورد) في عمان الأردن 2020 في فصلها الأخير الذي كان بعنوان (اليد الصغيرة)، فكرة أن الحرب هي أقسى ما يمكن أن يحدث للإنسان والمجتمع، وهي أيضاً كشف عن روح الإنسان وضميره ووجدانه، وكل السلوك الخيّر أو الشرير الذي يمكن له أن يتبناه ويختاره. لقد أنهيت روايتي بفصل قريب من تيمة مصير إنسان، والتي أعتبرها أجمل خاتمة يمكن للكاتب أن ينهي بها أعماله عن موقف الإنسان من الحرب.
- هل من رواية تندم على كتابتها أو تشعر أنك تسرعت في نشرها، ولماذا؟
هناك عمل قصصي، وهو من بين أعمالي القصصية الثمانية المنشورة بعنوان" المغامرة السابعة" صدرت في 1994 عن دار الذاكرة.. والعمل مؤلف من ست قصص، ومجموع أوراقها بحدود 75 صفحة إذا استثنينا المقدمة التعريفية بالتجربة القصصية التي غامرت في كتابتها.. والعمل فريد، لأنه إعادة كتابة قصص لكتّاب آخرين (عرب وأجانب)، ففي أثناء قراءاتي، كنت أُعجب في بعض الأحيان بقصة لكاتب ما فأتمنى لو كانت لي، وبعد زمن تولدت لدي فكرة أن أكتب تلك القصص التي كنت معجباً بها. وبالفعل كتبت ست قصص منها. مثال (قصتي البحيرة مستوحاة من قصة" الصديقان" للفرنسي موباسان.. وكنت قد ثبّت الملاحظة التالية في مقدمة القصة، تحت هذه الجملة (البحيرة. بعد قراءة قصة الصديقان للكاتب الفرنسي موباسان) لكي لا ينبري أحد لي من الذين يبحثون عن لصوص الأدب، ويقول لي: كمشتك يا لص. فكنت بذلك التمهيد أقطع الطريق على مكتشفي لصوص الأدب.
على الرغم من أن" المغامرة السابعة" عمل قصصي جميل، إلا أنني ندمت على نشره، لأنه صغير ومؤَلف من ست قصص فقط.. وبالتالي لم أستطع أن أوضح الفكرة بشكل جلي عن التجربة التي عشتها في كتابة" قصص" لكتّاب آخرين. كان من المفروض أن أضيف قصصاً أخرى للكتاب، لكي لا تقل مجموعة صفحاته عن ثمانية ملازم على الأقل، أي بحدود 128 صفحة.
- كيف ترى مستقبل الرواية في عالم متسارع نحو ثقافة الصورة؟
بصراحة لم أفكر في يوم من الأيام بهذا الأمر. كان ومازال كل همي أن أكتب قصة ورواية وحكاية ومقالة.. أن أكتب فقط. أما المآلات، فهذه لم أفكر بها، وإن حاولت الآن الجواب على سؤالك، فأقول: لا أعرف.. سأترك هذا الأمر للمستقبل، لأن الزمن هو خير مغربل للإبداع. فإن كانت الصورة تستطيع أن تزيح الرواية عن المشهد الثقافي فهذا يعني أن الزمن قال كلمته.. وما أعرفه أن، لا مرد لكلمة الزمن إنها كالقدر.
- كيف تنظر إلى واقع النقد في العالم العربي؟
لا أدري! لقد شعرت لمدة طويلة، قد تبلغ سنوات أن لا نقد لدينا. وإن وجد فهو يقتصر على بعض النجوم، حتى تلك التي أفلت، كأنه – الناقد - يريد بذلك أن يكتسب شهرة على حساب الكاتب النجم. يريد أن يكسب القراء بظنه إن كتب عن النجم سيصبح بدوره نجماً، مشهوراً. أما الناقد الجاد الذي يعمل كناقد، وليس كمروّج للنجوم، عليه أن يجد ضالته وصوته النقدي، ويبني تجربته على الكتّاب الذين لم يصبحوا نجوماً بعد، أو عليه، بالأصل، أن لا يفكر بهذه الطريقة، لأن القارئ سينسى الناقد ولن يتذكر سوى الكاتب النجم.. لهذا أعتقد لا نقد لدينا كنتاج وأسماء كما نعرفه بالغرب. ناقدنا يستعير ثوب النجومية من بعض الكتّاب ويلبسه لعلى وعسى أن يجد ثوب الكاتب النجم على قدّ مقاسه، ولكي يجد هذا المقاس، برأيي عليه أن يذهب، كما أشرت، إلى الأعمال الإبداعية ويقرؤها، ثم يبدي رأيه النزيه والموضوعي فيها.. عند هذا سيجد أن خياطاً قد قاس له ثوباً على قدّ مقاسه، سيجد نفسه ناقداً لا يرميه أحد بحجر
- إلى أي حدّ تعتبر أن تجربتك أخذت حقها في النقد؟
كما قات سابقاً، لا نقد في هذه البلاد! هناك قراءات وتعريفات بالعمل الأدبي، وهي عادة تقتصر على طلب المجلة أو الجريدة أو الموقع الإلكتروني.. وأن لا تتعدى المقالة عن 300 كلمة، حتى إن بعض النقاد لا يستوفون حق العمل الأدبي في الاطلاع والتحليل والنقد، إنما يخضعون لمعايير الأمكنة التي ينشرون فيها.. لهذا أقول، لم تأخذ تجربتي وتجربة أبناء جيلي (السبعينيات) من القرن الماضي حقها في النقد.. وأيضاً في القراءة.

- كيف تجد فكرة تسويق الأعمال الإبداعية، وهل تبلورت سوق عربية للرواية؟
كفكرة، طبعا إيجابية، ولكنني لم ألمس حتى اليوم نتائج هذه الفكرة إلا في حدّها الأدنى.. وأرى أنه من الصعب الجواب الدقيق عليه في ظل تمزق وصراعات الدول العربية.. أعتقد، هذا السؤال يجب أن يُطرح على أصحاب دور النشر ليجيبوا عليه من موقع علاقة المصلحة المادية قبل المعرفية على الأقل، لأنهم في النهاية هم تجار. هم الذين عليهم أن يفكروا ويبحثوا ويعملوا من أجل إنجاح مشروعهم في تسويق بضاعتهم.. وهي الكتب.
- هل تحدثنا عن خيط البداية الذي شكّل شرارة لأعمالك الروائية؟
بصراحة من الصعب أن أتحدث عن هذه النقطة بوضوح، لأنني منذ البداية، كما قلت سابقاً، كنت أحضّر نفسي لأكون فناناً تشكيلياً. درست الفن، وحلمت بأن أكون فناناً ذات يوم. أما عندما أجبرتني ظروف الهزيمة الحزيرانية في 1967 على ترك الرسم واللجوء إلى الكتابة، كانت ذخيرتي من القراءة هي الكتب المتعلقة بشكل عام بالفنون وببعض الروايات البوليسية والتاريخية. ولكنني أستطيع القول، وهذا كان بعد سنوات، أن الأدب الروسي هو الخيط والشرارة الأولى. أما أعمالي الروائية فقد جاءت متأخرة، جاءت بعد أن أصدرت ثمانية من المجموعات القصصية، لأنشر بعدها روايتي (زهور كافكا) التي كنت قد انتهيت من كتابتها في سنة 1993 وقد تأخر نشرها إلى سنة 2000، وسبب تأخري في كتابة الرواية، على الرغم من أن كتابي الأول (الصدَفة والبحر) الذي صدر في 1977هو مؤلف من قصتين طويلتين، أو روايتين قصيرتين.. لم أفكر بأن هناك ضرورة لأن يؤلف الكاتب رواية ما.. وتشيخوف كان مثالي، وهو أيضا لم يكتب رواية بالمعنى الكلاسيكي المعروف عن شكل الرواية ومضمونها، وكان الكاتب الروسي ليو تولستوي يسأله كلما التقاه: متى ستؤلف لنا رواية؟ ولكن الأحداث والأيام جاءت لتؤكد لي خطأ هذا الموقف، لأنني ذات سنة شعرت بعد ثمانية مجموعة قصصية، أن أي قصة قصيرة سأكتبها لن تكون سوى تنويعاً لقصصي السابقة، لن يجد فيها القارئ جديداً ومبتكراً. لهذا كتبت روايتي (زهور كافكا). ومنذ ذلك الوقت لم أكتب سوى الرواية. وكان آخرها (سنوات خمس) التي نشرتها في العام الفائت لدى دار ببلومانيا في القاهرة.. هذا وقد أنجزت رواية جديدة في السنة الماضية بعنوان (نصف قرن) تتحدث عن أبناء جيلي وانكسار أحلامهم على مستوى الشخصي والوطني.
- إلى أي حدّ تلعب الجوائز دوراً في تصدير الأعمال الروائية، أو التعتيم على روايات أخرى؟
لعل حكاية الناشر الالماني مع نجيب محفوظ الشهيرة تلخص الإجابة على السؤال، وهي أن ناشراً المانياً أراد نشر رواية عربية بعد ترجمتها فوقع الاختيار على نجيب محفوظ.. إلا أن الرواية المترجمة لم تبع خلال سنوات سوى عدد قليل منها، فما كان الناشر إلا أن فكر بإتلاف بقية الرواية ليفسح المجال لأعمال أخرى جديدة في مستودعاته. وقبل أن ينفذ فكرته حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل فما كان من الناشر سوى أن أعاد الرواية إلى واجهة المكتبات لتباع جميع نسخها خلال أيام.
الجوائز ما هي سوى إلقاء الضوء على كاتب لم يحصل على فرصة كافية ليعرفه القارئ. والجائزة عادة تكون عامل بحث من قبل القراء والنقاد عن الكاتب وأعماله الإبداعية أي أن تضعه في بؤرة البحث والضوء وتعطيه مزيداً من الشهرة، وزيادة في عدد القراء لأعماله الإبداعية.. وهي عوامل محفّزة للكاتب لتدفعه إلى الأمام.
- كيف تجد واقع ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى؟
ليست لدي معلومات دقيقة، لأنني لم أتابع هذا الأمر في يوم من الأيام، ولكن القراءات وبعض الأخبار التي تسعى إليك من هنا وهنالك تشير إلى أن الأدب العربي غير معروف بشكل واسع في الغرب كما هو أدب أمريكا اللاتينية مثلا.. ولعل أهم الأسباب هو غياب المؤسسات الثقافية الناشطة واختصار دور النشر على النشر فقط من دون الترويج لما ينشر على المنصات الدعائية المرئية والمسموعة والمقروءة.. ومع الأسف لا تقوم بالترويج لها إلا في أضيق نطاق ممكن لأن العمل الترويجي، الدعائي لأي عمل إبداعي بحاجة إلى المال. مثلاً عندما صدرت روايتي (تحت سماء الحرب) مترجمة إلى اللغة الالمانية، قامت الدار الناشرة بالإعلان عنها عبر محطات المترو وداخل عرباتها، وأجرت مقابلة تلفزيونية معي، مع الأسف، لم تعرضها بطلب مني.. سأوضح أسباب ذلك في سؤال قادم، فنفذت طبعتها الأولى خلال أقل من شهر.. فألحقها الناشر بطبعة ثانية.. هذا هو الفرق بين الناشر الاجنبي والعربي. لهذا تصدر كثير من الأعمال الروائية من دون أن نسمع عنها إلا عن طريق المصادفة.
- يعاني المبدع من سلطة الرقابة خاصة (الاجتماعية والسياسية والدينية) إلى أي درجة تشعر بهيمنتها على أعمالك؟ وهل تحدّ في إيصال رسالتك الإبداعية؟ وهل أنت مع نسف جميع السلطات الرقابية؟
كلام صحيح ودقيق، وبرأيي لولا هذه الرقابة، كما ذكرت، لكتب المبدع في البلدان العربية بشكل أفضل، لأن خوف السيوف المسلطة على عنقه يحاول بكل الوسائل أن يخفي تحت مجازات اللغة كثيراً من الحقائق التي عليه أن يتحدث عنها، ويقوم بنقدها، ولكن مع الأسف، بعد مرور أكثر من خمسين سنة اشتدت هذه الرقابة وكثرت السيوف المسلطة على رقاب المبدعين.
أما بالنسبة لي، فقد عانيت منها عبر واقع وليس شعور واحساس بها. فمنذ سنة 1975 كان لي أول لقاء مع أحد المساعدين في جهاز أمن الدولة للتحقيق معي.. ثم كان هذا الأمر يجري في كل سنة تقريباً، وكأن الأجهزة الأمنية كانت تريد أن تقول: إياك فنحن هنا. ففي سنة 1996 تم توقيفي في فرع أمن الدولة في حلب بسبب قصة كنت قد أرسلتها إلى ملحق جريدة الثورة الجديد بناءً على طلب محرريها، ثم تم إطلاق سراحي في اليوم التالي بعد أن طُلب مني التواجد اليومي لدى الفرع من الساعة العاشرة حتى نهاية الدوام في الساعة الثانية بعد الظهر.. وظللت على هذا الأمر لمدة شهر، ثم حمّلني الفرع رسالة لأراجع فرع أمن الدولة في دمشق.. وفي دمشق تم توقيفي في منفردة متر بمترين لمدة اسبوعين، وكان هذا في شهر تشرين الأول أو الثاني لم أعد أذكر. أجرى معي الفرع ثلاثة تحقيقات تتعلق بأمر القصة. ثم أطلقوا سراحي. وعلى مستوى الكتابة، لقد نشرت ثمانية مجموعة قصصية تم سحب بعضها من قبل الرقيب الأدبي، فتكونت لدي مجموعة قصص منها، أسميتها (أحجاري الكريمة) لم أنشرها بعد. أما حول اللقاءات الإعلامية بكافة أنواعه فقد تلقيت عدة تهديدات بالاعتقال منذ 2011 وكان آخرها تهديد رسمي من قبل ما يسمى الجيش الإلكتروني، لأن محطة ألمانية أجرت معي لقاء حول روايتي (تحت سماء الحرب) التي ترجمت إلى الألمانية وصدرت في مارس 2017 في برلين، بعد أن عرضت المحطة التلفزيونية مقتطفات منها وأعلنت عن يوم، وساعة عرض اللقاء بالكامل. كانت الرسالة على المسنجر التي تلقيتها بعد ذلك بيومين مما اضطررت الاتصال بالمحطة مخبراً إياها بالواقعة، ثم طلبت منها مشكوراً عدم عرض المقابلة لأنها تشكل تهديداً لحياتي وحريتي، فالتزمت المحطة التلفزيونية بما طلبت، وطوي اللقاء حتى الآن.
أما اقتراحك حول الغاء جميع أنواع الرقابة، طبعاً أنا معه. لأن الرقابة لا تحد من الحرية فقط إنما تقتل الإبداع أيضاً.
- ماهي رسالتك لقرائك؟
ليس لدي أية رسالة، فأنا أكتب ما أحلم به لهذا البلد الذي أعيش فيه، أحلم بأن يكون جميلاً مثله مثل كل بلدان العالم، وأن يكون الناس الذين يعيشون بين ظهرانيه باختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، آمنين فيه.. لن أقول عن البلد، وطن. ولن أقول عن الناس، شعب بعد أن جعلت السلطة الحاكمة منذ أكثر من خمسين سنة من هاتين الكلمتين أكثر ابتذالاً من الابتذال نفسه. ثم.. لست نبياً لأكون صاحب رسالة.










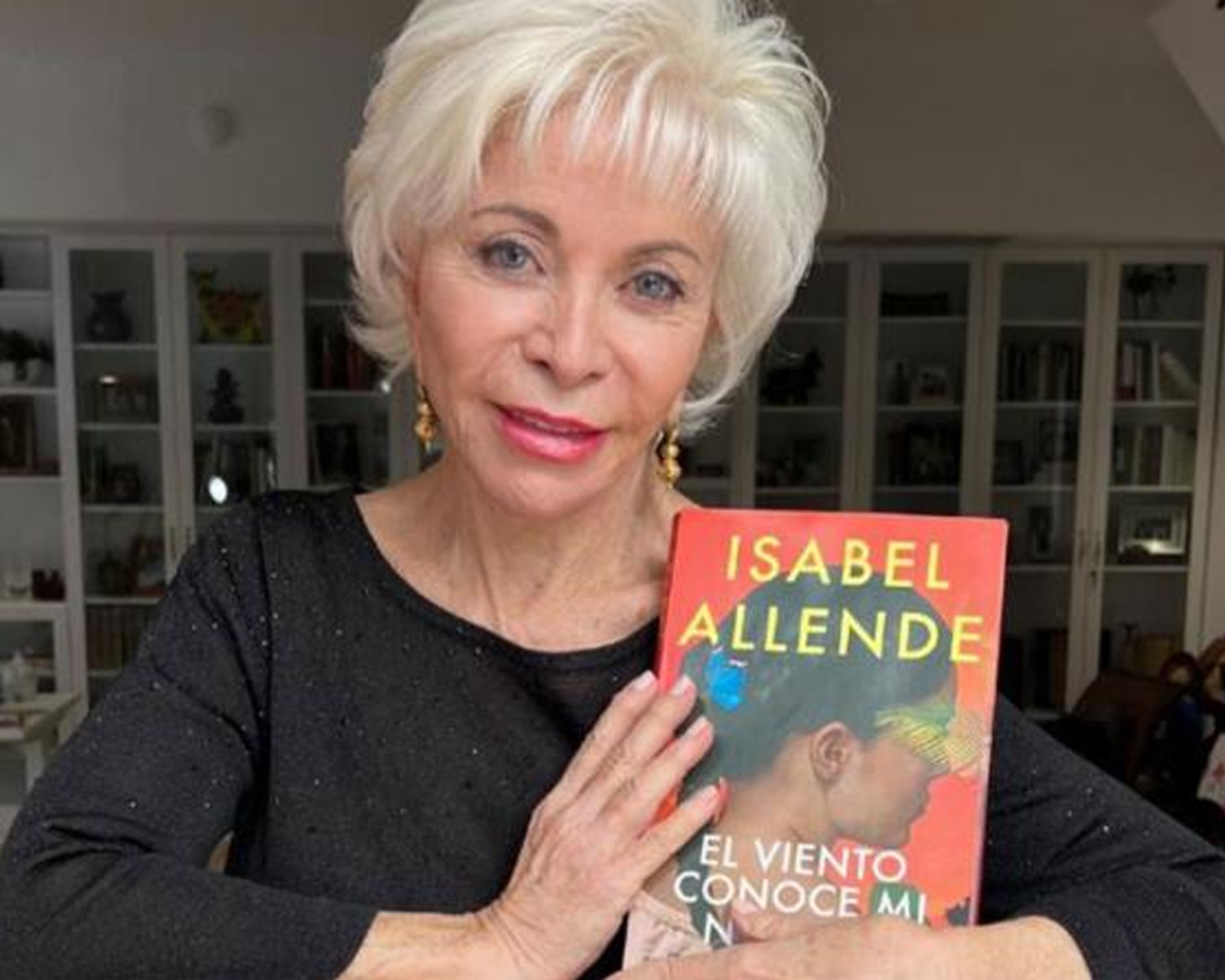



0 تعليقات