أكتب لنفسي طريقاً للهروب
أي. أم. هومز - ترجمة ميادة خليل
أي. أم (آمي) هومز (واشنطن العاصمة، 1961) هي الكاتبة الأمريكية الأكثر إشادة في الوقت الحاضر. كتبت في التاسعة من عمرها كتابها الأول "جاك" والذي صدر حين بلغت الثلاثين. صدر لها بعد ذلك قصصاً قصيرة وروايات، من بينها "هذا الكتاب سينقذ حياتك" و"اغفر لنا" التي حصلت من خلالها على جائزة المرأة للآداب عام 2013، كما قدمته فرقة أمستردام المسرحية في عرض مسرحي فيما بعد. مجموعتها القصصية الجديدة تحمل عنوان "أيام التوبة". مذكرات هومز "ابنة العشيقة" التي تناولت لقاءها بوالديها الحقيقيين (البايولوجيين) عند بلوغها عامها الثلاثين، أصبحت من الكتب الأكثر مبيعاً. بالإضافة إلى ذلك تكتب هومز الحلقات التجريبية للمسلسلات والبرامج في كل من HBO و FX وCBS. ومؤخراً عملت مساعدة مخرج في المسلسلين التلفزيونيين "السيد مرسيدس" و"ڨيلا فولينوتر". تعيش هومز حالياً مع ابنتها في نيويورك وتقدم دروساً في الكتابة الإبداعية في جامعة برنستون.
التالي حديث الكاتبة هومز مع مجلة "فلو" الهولندية عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
الماضي
لقد نشأت في واشنطن العاصمة حيث في ذلك الوقت؛ سنوات الستينيات وحتى الثمانينات، كان الوضع غير مريح؛ البيض يعيشون منفصلين عن السود في المدينة. عمل أبي فناناً ووالدتي مستشارة تعليم. كانا تقدميان ومهتمان بالسياسة والفن. أبي نباتي ولديه هوس في كل ما يخص الصحة. لكن حين أذهب معه إلى متحف، يدعوني لتناول الكيك. والمتحف هو المكان الوحيد الذي أحصل فيه على هدايا منه: بإمكاني دائماً اختيار أي كتاب أريد. لذا في عطلة نهاية الأسبوع أُفضّل الخروج معه. ونتيجة لذلك تعرفت على تاريخ الفن الذي أثر تأثيراً كبيراً على تربيتي.
لم تمض لحظة قط لم أعرف فيها بأني متبناة. لقد كبرت مع حقيقة أن والدتي الحقيقية (البايولوجية) تورطت في علاقة مع رجل متزوج يكبرها في السن وأني "ابنة العشيقة". أنا سعيدة كوني عرفت دائماً الكيفية التي وصلت بها إلى عائلتي. يمكنني تصور حال الطفل الذي لا يعرف أي شيء عن أبويه الحقيقيين ثم يسمع الحقيقة عنهما لاحقاً، فتصبح حياته منذ تلك اللحظة منقسمة إلى "قبل" و"بعد". مثلت لي تلك المعلومات جزء من هويتي؛ فالعائلة التي نشأت فيها فقدت طفلاً قبل ولادتي بعام ونصف، كان في التاسعة ومريض منذ ولادته، مات نتيجة فشل كلوي في نهاية المطاف. لدي أخ يكبرني بعامين. فبعد ولادته لم يعد بإمكان والدتي الحمل مرة أخرى، لذا تبنتني. لا يتحدث والداي عن حزنهما على نحو مباشر، إلا أنه يقطر من كل كلمة ينطقونها. وبسبب السحابة المظلمة التي خيّمت على المنزل، أدركت منذ طفولتي معنى الفقد والحزن، واللذان ينسجمان أيضاً مع ثيمة التبني. إنها أمور معقدة للغاية، لكنها أثرت حياتي بمشاعر عميقة تُعد لطفل في مثل عمري حينئذ أمر استثنائي حسب اعتقادي. أرى الأطفال الآخرين يلعبون لعبة الأب والأم، فيما نلعب أنا وأخي لعبة الدفان.
كنت غالباً ما أتشاجر مع أمي. لم أكن طفلة سهلة المراس، وغاضبة من كوني طفلة متبناة. ما زلت أتذكر خوفي من فكرة أني بعد انتهاء الدوام المدرسي سأعود إلى البيت، وأن البيت لم يعد موجوداً. لم يكن لدي ذلك الشعور الفطري بالأمان. فحين تخرج والدتي من المنزل، دائماً ما أسألها: "إلى أين أنتِ ذاهبة؟" فترد عندئذ: "سأخرج. لا حاجة لمعرفة إلى أين أذهب. أحتاج إلى الحرية". يرغب الطفل ببساطة سماع والدته تقول له: "سأذهب إلى المكان الفلاني والفلاني، وخلال ساعة أعود إلى المنزل". الأم في وقتنا الحاضر ستقول: "أحتاج إلى ساعة واحدة لنفسي". لكن في تلك الأيام لا تقول الأمهات مثل هذا الكلام.
ثمة شعور دائم لدى المتبنى بأنه ستتم إعادته إلى حيث جاء إذا فعل شيئاً لا يغتفر، لذا هو شغوف بمعرفة حدود المسموح والممنوع. إذ لديه إحساس كامن في دواخله دوماً بأن شخص ما قد تخلى عنه. وأنا كنت غاضبة جداً من ذلك الشخص الذي تنازل عني قبل حتى أن يتعرف عليّ. لذا تقتُ في طفولتي إلى أمنيات بعيدة المنال في الحصول على شيء ظننت بأن الآخرين يمتلكونه، شيء من الصعب الحصول عليه.
أدركت الآن وأنا امرأة بالغة بأن تلك المشاعر لا تخص الأشخاص المتبنين فحسب؛ ذاك إن التوق، أو الاحتياج إلى شيء يضفي بعض المعنى أو الرغبة في أن تكون معروفاً، هي من مقتضيات الطبيعة البشرية. وتشتد تلك المشاعر لدى الطفل المتبني. عدا اضطرار والدي مواصلة الحياة بعد فقدهما لطفليهما، كانا شديدا الانتقاد وسلبيان حول ما يمكن تحقيقه في العالم. لم يكن باستطاعتهما الوثوق بي. وحين أعود بذاكرتي إلى تلك الفترة، أدرك بأنهما كانا خائفين ولا يريدان التعرض لمخاطر الفشل. فكرت دائماً بمغادرة المنزل. كتبت لنفسي، حرفياً، طريقاً للهروب. فلقد كتبت روايتي الأولى "جاك" في التاسعة من عمري على أنها واجب مدرسي بادئ الأمر، غير أني سألت معلمي حينئذ إن كان يمكن أن يصبح رواية. رد المعلم: "لماذا تعتقدين أن بإمكانك فعل ذلك؟" فأجبته: "لا أعلم إن كان بإمكاني فعل ذلك، لكني أعرف بأني لا أستطيع كتابة بحث مدرسي".
مهدت كذلك الطريق للخروج من منزل العائلة بالتواصل مع غرباء شعرت معهم بالأمان. من بينهم پيت تاونسند من فرقة "The Who" الموسيقية والمخرج جون سايلس اللذان أصبحا أصدقاء القلم. فلقد كتبنا إلى بعضنا رسائل مطولة لسنوات، وكانت بمثابة طريقة لإيجاد أسلوبي الخاص في الكتابة. عمدت إلى إرسال قصائدي إلى پيت تاونسند وهو بدوره يرسل نصائحه حول ما قرأه. كما راسلت المسرحيين آرثر ميلر وهارولد پينتر.
واشنطن مدينة محافظة وشعرت دوماً بأنها ليست كبيرة بالقدر الذي يرضيني. ففكرت باستمرار في كيفية الخروج منها والذهاب إلى نيويورك. ظننت بأني إذا سكنت هناك، لن أعد تلك الطفلة الغير شرعية مطلقاً. مجرد التفكير بتلك الفكرة قلل من معاناتي وأراحني بشكل لا يُصدق.
أجمل الأيام في مراهقتي هو يوم أرسم فيه وأكتب وأؤلف الموسيقى.
الحاضر
عدت للتو من الجولة الترويجية لكتابي الجديد "أيام التوبة"، تطلبت مني كتابة مثل هذه المجموعة القصصية وقتاً طويلاً. ليس الأمر كما لو أنك تجلس وتكتب قصصاً قصيرة دفعة واحدة. بل أنت تجمعها على مرور السنوات. ما يستهويني ويسعدني هو لقاء قرّاء يرددون عبارات من مثل: "أنا اقرأ قصصك وكتبك منذ ثلاثين عاماً". أمر لا يصدق! إنه عمر طويل. مثل هذه الأمور تمنحك رؤيا أخرى نحو نفسك.
قصص هذه المجموعة فلسفية، تتناول القصص نظريات عن الكيفية التي تم بها تداول الصدمات الجسدية جيل بعد جيل. عن ضحايا الحروب والفرق بين من نحن وكيف نتصرف تجاه العالم الخارجي. إنها مواضيع شغلتني دائماً. وأن يقدر الناس ذلك، أمر يعني لي الكثير. حينئذ أشعر بأني أقل عزلة. الكتّاب ليسوا غريبي الأطوار، لكننا نمضي أوقاتاً طويلة وحيدين مع أنفسنا. في الواقع أنا خجولة جداً وأحياناً يرهقني القرب الشديد من الناس.
تعمقت منذ زمن طويل في نهج الوعي التام (العقلانية). لم أعد أعرف الدافع لذلك، لكني بدأت في ممارسة التأمل خلال سني المراهقة. اشتريت كتاباً حول التأمل الفائق وإحدى تمارينه مازلت أمارسه حتى الآن: تغلق عينيك وتتخيّل مساحة مائية حيث تسمح لمخاوفك الارتقاء منها إلى أعلى. في حالتي تتراكم المشاكل فوق بعضها مثل صخور جبل طارق والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً: كيف أهدم هذه الصخور؟ تعلمت تمارين متنوعة في التنفس والتأمل العقلاني، كما أني أمارس التأمل كل يوم على أية حال؛ غالباً فور النهوض من النوم أو مساءً في بعض الأحيان، وأفضل القيام بها مرتان في اليوم. فمنذ فترة قصيرة تمر بي أيام أشعر فيها بمشاعر فظيعة: يحدث كل شيء دفعة واحدة، رأسي يكاد ينفجر واتساءل: ماذا أفعل؟ عرفت حينئذ بأن ثمة مركز للتأمل قد تم افتتاحه أخيراً في گرينويچ ڨاليج؛ حي في مانهاتن حيث أسكن، وذهبت إلى هناك بقصد التدرب على ممارسة تأمل "المحبة – اللطف". إذ تركز مثل هذه الدروس على تخفيف وتلطيف مشاعر الكراهية تجاه الآخرين، لكنها تركز أكثر هذه المرة على تقبل اللطف. الأمر الذي لا أجيده عادة، لأحمي نفسي. لأني حين أتعامل بطيبة مع شخص ما أكون سريعة التأثر وضعيفة، ويمكن لذلك الشخص نفسه أن يسبب لي الألم. أشعر ببعض الراحة بعد ساعة من التأمل، إنه شعور لذيذ.
ابنتي ذات الخمسة عشر عاماً تسافر معي في جولتي الترويجية. لذا يسألني كثيرون: كيف حصلتِ عليها؟ كما لو أنها أدة للاستخدام الشخصي، أو أريكة تركتها جانباً لبعض الوقت. ربما جاء ذلك لأني كنت عزباء حين ولدتها. جوابي دائماً على مثل تلك الأسئلة: "عملياً هي إنسانة مئة بالمئة" يزعجني الحديث عن ابنتي في الحوارات التي تجرى معي. لقد اخترت لنفسي حياة تحظى باهتمام العامة، لكن لأبنتي الحق في الاستمتاع بحياتها الشخصية. يمكنها الحديث عن نفسها بطريقتها الخاصة، متى ما تشاء وإلى من تشاء. للناس رؤيتهم الخاصة عني وعنها، وأستطيع القول بأن كل تلك الرؤى غير صحيحة.
توفي والداي البايولوجيان في غضون ذلك. سعت والدتي البايولوجية إلى التواصل معي حين بلغت الثلاثين. كان اللقاء بها مشوقاً ومحمل بالكثير. أدركت حينئذ بأني كنت محظوظة بتخليها عني. إنه أفضل ما حدث لي في حياتي. ذاك أن أمي البايولوجية لم تكن مؤهلة لتربية طفل، فلقد عاشت حياة قاسية، وحين وجدتني تصورت أن بإمكانها العودة في الزمن إلى الوراء، أن بإمكانها المطالبة باستعادة طفلتها وعلاقتها بأبي البايولوجي أيضاً. وهذا غير ممكن بطبيعة الحال. توفيت نتيجة فشل كلوي بعد لقائي بها بوقت قصير. أما أبي البايولوجي ... وزوجته وأولاده فلقد وجدوا صعوبة في تقبل تسليط الضوء على الماضي، ولم يكن أبي يعرف الكيفية التي يجب أن يتعامل بها بهذا الخصوص. ومن ثم كتبت قصة أخرى "ابنة العشيقة" نشرت في النيويوركر العام 2004، عن محاولات أمي بناء علاقة معي واللقاءات الغريبة مع أبي في المطاعم والفنادق. قررت استخدام أسماءهم الحقيقية الأمر الذي أدى إلى انزعاجهم؛ لأني كشفت هوياتهم وقصتهم أيضاً. كان قرارا صعباً لكني أردت أن أكون عادلة في نهاية المطاف. فلو أني اختلقت أسماءا مزيفة، سأكون قد أكدت فكرة وجوب خجلي من وجودي. لقد عملت بمثابرة حتى أجد لي مكاناً في هذا العالم، وبعد كل هذا الجهد، هل يتوجب عليّ الآن الخجل من الماضي؟
لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار؛ فلقد بدأت حياتي بالفعل وحققت بعض النجاح والشهرة كاتبةٌ. لذا لن أواصل حياتي مع أسئلة بلا إجابة حول هويتي.
المستقبل
غريب جداً أن أنظر إلى ماضيّ كمتفرجة من خلال ما رواه لي والداي البايولوجيين؛ عن حياة لا أعرف عنها أي شيء. هذا مشوق بالنسبة لكاتب. فلقد شكلتُ جزءاً من حياتهما، في حين أني لا أعرف عنهما أي شيء ويظهر بأني كنت مجرد بيدق في قصتهم بشكل أو بآخر. سعيت بالتأكيد لمعرفة المزيد عن أمي وأبي وما جذبهما إلى بعضهما. أعرف ما أبعدهما عن بعضهما، ذاك هو أنا. إلا أني لا أعرف ما الذي جمعهما ببعضهما.
أجدادي يهود ـ ألمان وروس ـ يهود، إيرلنديون وإنگليزيون – انجيليكيون. لذا أنا مزيج حقيقي. المضحك هو أني أكثر يهودية من عائلتي المتبنية. أحب زيارة الكنيس أو الكنيسة أو مكان لممارسة التأمل. أشعر بالراحة في مثل تلك الأماكن، ذات الشعور عند زيارتي متحفاً أو قاعة الموسيقى؛ كلها أماكن ينال فيها الناس وقتاً للتفكير. فحين أكون في رحلة، أزور متحفاً قبل كل شيء، تماماً كما كنت أفعل مع والدي.
التقدم في السن أمر لا يهمني. وأشعر بالأسف من أننا نعيش في جسد يستلزم منا الأعتناء به. فأنا أعيش في رأسي وأتساءل أحياناً: لحظة، لماذا يؤلمني كاحلي؟
إذا اخترت كونك كاتب كتابة الروايات، فإن هذا يمنحك حرية أكثر، لأنك حينئذ تحدد بنفسك الشروط؛ يمكنك أن تجرب ولديك مساحة لعب كبيرة. أنا أكتب للتلفزيون أيضاً، والجميل في هذا العمل هو أن التلفزيون وسيلة سريعة؛ كمثل الصحافة سابقاً؛ فما تكتبه تراه فوراً. لكن يتوجب عليك المرور بالكثير من المطبات قبل أن تنتج برنامجاً وتذيعه. إنه أمر في غاية الصعوبة. إلى جانب الكتابة أُدرّس في جامعة برينستون لطلاب البكالوريوس، ومن دواعي سروري القيام بهذا العمل. أحب الناس في مثل أعمارهم، فهم على أهبّة الأستعداد. أدرس على طريقة معلميني المفضلين في السابق: لا أعلمهم الكيفية التي يجب أن يكتبون بها، بل أعلمهم الكيفية التي يعيشون بها.
يحصل الطلاب مني على برنامج متكامل: أطلب منهم الاجتهاد والنجاح في عامهم الدراسي الأول وبعد انتهائهم من الدراسة أساعدهم في الحصول على وظيفة؛ أنا استثمرهم في حقيقة الأمر. فهم لا يدركون حجم العالم ولا كل الإمكانيات المتاحة، وبدوري أساعدهم على الاستعداد لذلك. في الواقع أنا أعلمهم ليصبحوا مبدعين.
لا أحكم وفقاً للعمر، فلدي أصدقاء يكبرونني سناً، كما تواعدت مع أشخاص يكبرونني بعشرين عاماً. توفي والدي، على نحو غير متوقع بالنسبة لي، أثناء نومه حين بلغ الرابعة والتسعين، وأمي بلغت الثانية والتسعين الآن. أتواصل معها يومياً، وغالباً مرتان في اليوم. أصبحت علاقتنا جيدة للغاية. فلقد قررت في لحظة ما بألاّ أتشاجر معها أبداً، لأنها شجارات عقيمة ولا توصلنا إلى أي شيء. كنا دوماً قريبتان جداً من بعضنا، سواء تشاجرنا أم لا. أنا أحبها كثيراً.
أجد أن كل مرحلة من دورة الحياة مهمة؛ وددتُ لو أني أنجبت المزيد من الأطفال بعد أن رُزقت بابنتي. أظن أن إحاطة نفسك بأناس من أعمار مختلفة أمر حَسن. أحب كل مراحل الوجود الإنساني؛ إذ أن الأولاد رائعون بطريقتهم الخاصة: هم يكبرون وأنت تصبح مدركاً لكيفية السيطرة والإشراف على الأمور؛ ومن ثمَّ يغضبون ويسعون إلى تحسين العالم؛ ومن ثمَّ يصبحون راضين عن أنفسهم ويصلون إلى نتيجة أنهم قد بذلوا قصارى جهدهم لكن العالم لا يمكن تحسينه. وفي النهاية يفقدون هويتهم إذا جاز التعبير: لأن كبار السن لا يتذكرون شيئاً، عدا بعض الأشياء المهمة التي يظلون يتذكرونها جيداً.
ما أفعله هو دراسة السلوك الإنساني؛ من جميع جوانبه. غير أني لست مهتمة بسلوكي الشخصي. الحياة تأتي وتذهب على نحو يشبه حركة المد والجزر، لذا أود الانفتاح عليها بوعي تام، لأني أحب التعرف على عوالم الأفكار التي تتداخل مع بعضها في بعض المستويات، مثل العلوم والتاريخ والسياسة والفن. الحديث مع أناس يشبهونك ويرون أوجه التشابه القائمة أمر مشوق للغاية.
أنا مفكّرة وأنظر باهتمام إلى العالم من حولي. أجد أن السفر مدهش، كما أني متعطشة إلى مُدخلات جديدة من أجل إثراء روحي. أود رؤية المزيد من الفن، وقراءة المزيد من الكتب ولقاء المزيد من الناس.
ثمة الكثير من المواضيع التي أرغب في الكتابة عنها. في الواقع أنا ما زلت في البداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مجلة فلو الهولندية. 2018









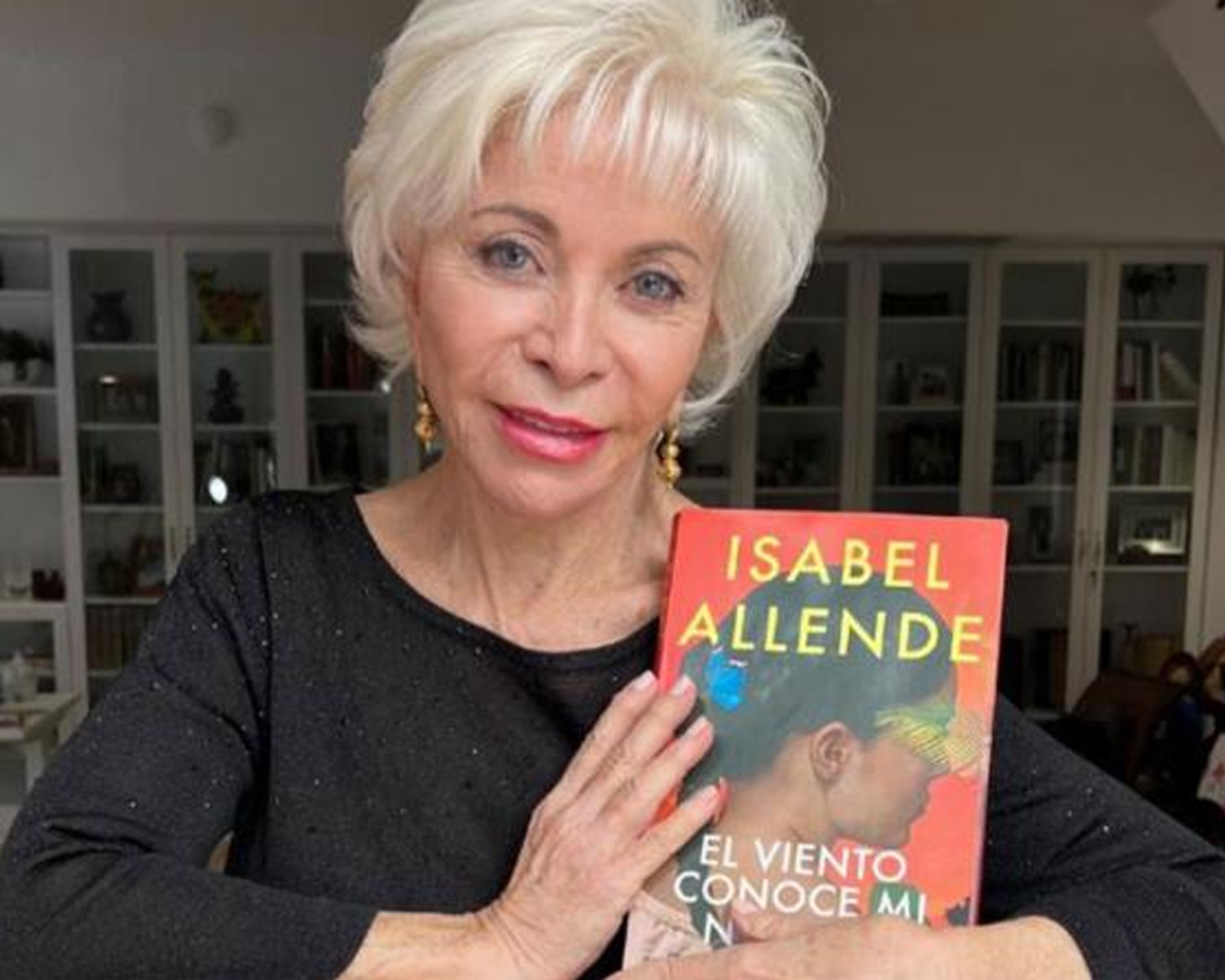



0 تعليقات