التفاصيل الصغيرة في "سيمفونية الجنوب"
طاهر النور[1]
يمكنني القول في البدء، بأنني كتبتُ نص "سيمفونية الجنوب" لنفسي أوّلا، فعلاقتي به ذات طابع خاص، طابع حميمي إن صحّ التعبير. طابع يحوطه السأم، أكثر مما طُبع في نفسي من الحزن والشجن. ولا أدر كم يدوم هذا الأمر؟ كنتُ قد انتهيتُ من كتابة "رماد الجذور" وهي نص طويل وموحش، بدأ في الريف وانتهى في المدينة، عن عدة حروب ثورية. شعرتُ بأنّ داخلي يحترق، وأنّ روحي تمزّقت؛ مع كل الذين مزّقتهم الحرب، وأكلتهُم بأوارها. كل شيء حولي، كان يثير استيائي. عزلتي كانت تامة، ومحبطة، وصامتة. كنتُ أدرك جيّداً أنني أمشي في طريق وعِر، وليس هناك هاديا يقودني، نحو طريق السلامة؛ التي شقّها أرباب السرد قبلي. وبما أنّ تجربتي في الكتابة الصحفية، التي تقارب العقد من الزمن حينها، غير كافية، فعليّ أن استعد نفسيّاً، كي أكون قادراُ على المُضِي قُدماً. لهذا قررتُ؛ أن أبحث عن السلام بنفسي ولنفسي. لكن كيف يتم هذا الأمر؟ وما التكنيك الذي يمكنني استخدامه لإنجاح ما أنا بصدده؟ هل انتظر أن يقوم الجن النائمون من قِيعان الأنهار، ومن ثم أضع القلم في المذكرة؛ وأقول لهم أعينوني، كي أعبر هذه المخاضات العسيرة؟
أضع الفكرة برمّتها جانباً، وأغادر الغرفة. أقف في الشارع المؤدي إلى السوق، وأشاهد الناس وأساليبهم في الكلام، أو المضاربات التجارية حسب الدارج. فتلك العادات الأرضية لا تخلو من السفاسِف. هناك هرج ومرج، وكرنفال من زعيق وعزيف. فضلا عن المساومة، والمطاردة، والصمود. يتدانى النخيل المطروح، يلتصق ببعضه، وتتحجّر أنساغه. يرغوا الجَمل المُحمّل بالبضاعة من العطش والجوع وطول السفر. يفعل الناس مثله بطريقتهم. مع ذلك أشعر بالقلق. أحاول مواراة القلق، والقلق لا يوارى، حتى لو حاولت.
غادرتُ الشارع والسوق برماً، وقرّرتُ أن أترك الأمر يسير على عواهِنه. لن أقوم بأيّ خطوة مضطربة، أو مندفعة بلا إرادتها. وإن كانت جملة منفلتة، تبحث عن مساحة خاصة بها.
وعلى هذا النحو، وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، قمتُ اعتباطا بثلاث خطوات:
الخطوة الأولى: سأكتب رواية للفتيان. هكذا قلتُ لنفسي. لم أكن أعرف الطريقة التي يكتب بها الناس روايات الفتيان، وإن كنتُ بلا شك؛ قرأتُ العشرات منها. لكني لا أذكر منها إلا القليل. وهذا القليل لا يستهويني. ربما لشعوري بأني أحتاج لحمل أخف من الحمل الثقيل، الذي تمخّضت به سردية "رماد الجذور". وربما لاعتقادي، بأنّ كتابة رواية للفتيان، ستكون طريقة ناجعة للاستشفاء الذاتي. وسأكون قد قدمتُ خدمة لنفسي ولغيري، عبر ما اعتقده الوسيلة المثلى؛ للنظر إلى الأشياء.
الخطوة الثانية: أن أكتب رواية بوليسية. اعتقد أنّ هذا صحيح، وإن كان النص ليس نصا بوليسيا. مع ذلك وبعيداً عن النّص، أنا أحب روايات التحرّي، وكلما استعصتْ عليّ القراءة أو الكتابة في مجالات معينة، ألجأ إلى الروايات البوليسية. أزعج عيني بمطالعتها؛ حتى ساعات متأخرة من الليل. أو في ساعات باكرة جدا من المساء. لأني أعتقد أنّ فيها الكثير من العُقد والحبكات، التي تحتاج إلى تفكير حر وجامح. ربما يكون رياضة مفيدة للذهن. وشخصيا أفادني هذا كثيراً، ومراراً أخرجني من معضلة حبسة الكاتِب، وأعادني إلى سِكّة النصوص، التي أعمل عليها، بعد ما تباعدتْ العلاقة بيني؛ وبين الكتابة وتراكمت، وألغت أيّ نشاط ذهني فعّال.
بهذه الخطوة، ازدادتْ قناعتي؛ بضرورة أن تحمل روايتي طابعا بوليسياً. أوّلا لأني أحب قراءة الروايات البوليسية، على غرار روايات هيركيول بوارو، وألجأ إليها؛ ليس في حالات العجز عن الكتابة فحسب، بل وأيضا في حالة عدم تمكني من مواصلة القراءة. وثانياً، لأنّ الفتيان يحبّون هذا النوع من السرد المثير، الذي يحرّك أذهانهم، ويمنحهم فرصة المشاركة في المعضلات المرتقبة، ومحاولة حل كل إشكال، في نهاية المطاف.
الخطوة الثالثة: هي رواية تجريبية. أعني كتابة نص سردي، لا علاقة له بأيّ خط سردي آخر. لقد أردتُ التغيير في حياتي الأدبية، التي لا تزال في طور البناء والتشيِيد. لذا يتحتّم أن يكون التجديد الآتي، ذا طابع خاص. لا يستفيد مما كتبه الآخرون، ولا يشبه في تفاصيله، ما حدث في النص الأول. مع أني اقرأ كثيراً، حتى أثناء كتابة نص ما، في الرواية، وفي مجالات معرفية أخرى. وبرأيي، أنتَ تحتاج إلى أشياء عديدة، لتكتب رواية أو حتى قصة قصيرة من ثلاث صفحات. الأمر يحتاج منك، إلى الاستقاء من أكثر من معِين معرفي أو تجريبي. وأحيانا، الإصغاء إلى تجارب الآخرين، وحكاياتهم عن مجالات حياتية، بعيدة تماماً عن النص الذي أمامك. لكنّكَ وكيفما كان الأمر، ستكون في حاجةٍ لتجارب الآخرين، وأن تفسح مجالا للصمت، كي تستمع إليهم دون مقاطعة، أو تراقبهم دون تدخل، بينما هم مستغرقين في عمل منجزٍ، أو حكاية شدّدتهم من أول وهلة.
الآن، ما هي الخطوة التالية، بعد تبيان هذا التفصيل الصغير؟ إنه مجرد لغو لا أساس له، وحتى نظريّاً، ربما يحتاج إلى إعادة نظر. بيد أنّه في النهاية، ليس سوى مخطط صغير، يتيح لي إمكانية الكتابة بوعيٍ يصل إلى درجة معيّنة. درجة قد تكون ضبابية بالنسبة للآخرين.
مع كل الشطحات الموجودة، بدأت الكتابة دون تروٍ، ودون أن أصغي كثيراً للمدارس الأدبية المعروفة. لقد كتبتُ بعفوية أدهشتني أنا نفسي، وكتبتُ بالطريقة التجريبية التي توصلتُ إليها في النهاية، مع مسحة بوليسية تتقاطع مع الفلاش باك، في بعض أجزاء الرواية. والأهم من ذلك، جاءت أفكار الرواية قريبة من الطبيعة التي كتبتُ عنها، وكذلك الشخصيات. وعند ما صغتُ الكلمة الأخيرة في "سيمفونية الجنوب" شعرتُ إلى حدٍ كبير بأنني على ما يرام.
وبشكل أكثر وضوحاً أقول، إن "سيمفونية الجنوب" هي الميدالية الأخيرة التي أحصدها وأضمّها إلى مجموعتي السردية، التي لم تكتمل بعد. وإذا كان القول الشائع، بأنّ لكل إنسان قصة واحدة خاصة به، وعليه أن يكتبها صحيحا، فأنا قد كتبتُ قصتي الخاصة، وما يليها بعد ذلك من أعمال سردية؛ إنما هي قصص الآخرين.
[1] - روائي وصحفي تشادي







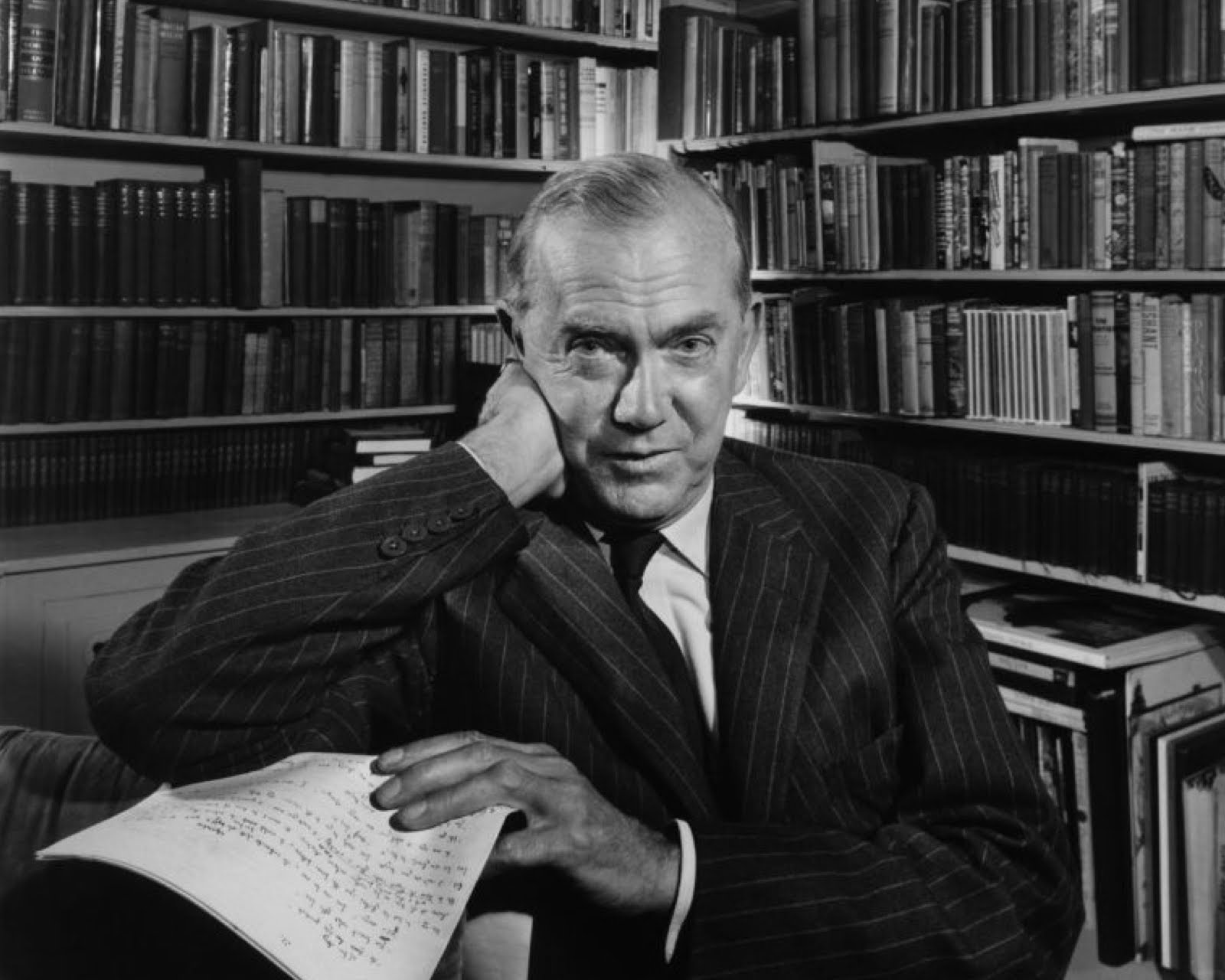


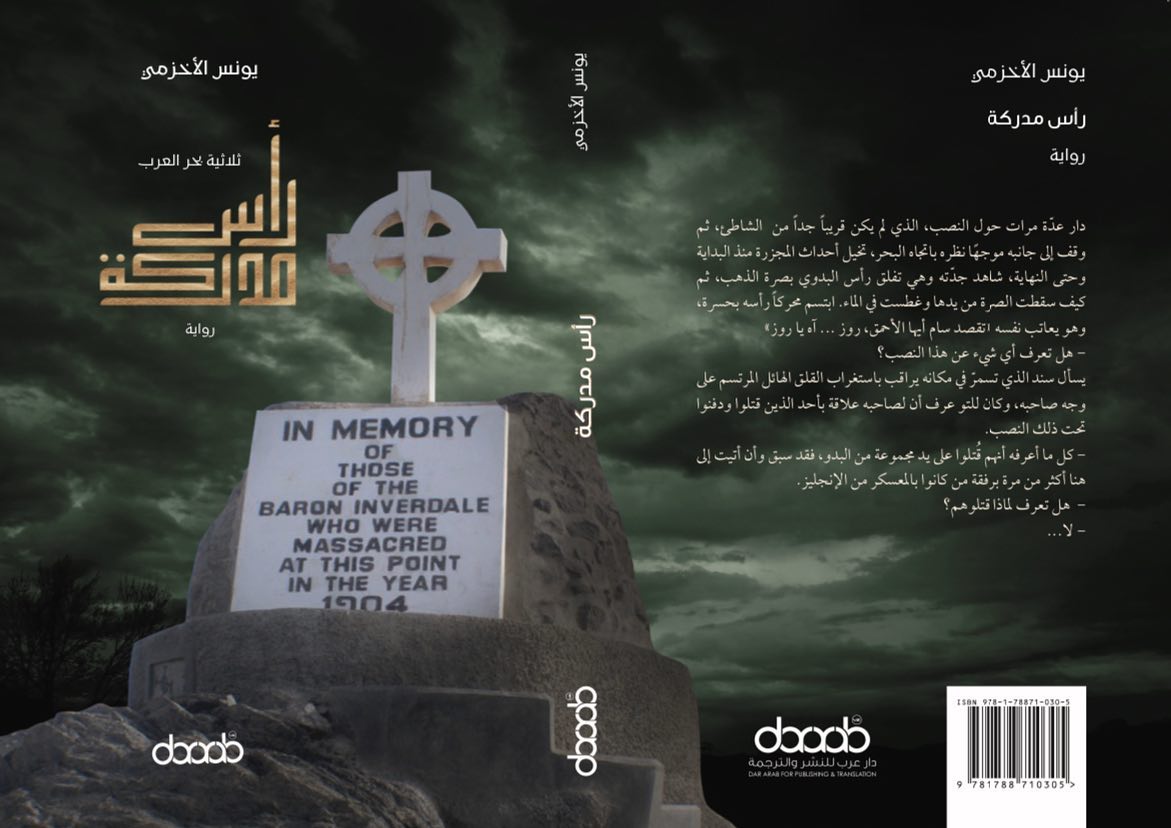


0 تعليقات