كنتُ خيالاً موجوعاً وبطلي واقعٌ مُوجع
تمهّلت ما يكفي لأكتبَ عن روايتي الأولى، ما من مانع سوى أنّي لا أذكر تماماً إن كانت "باردة كأنثى" حقّا روايتي الأولى؟ كنتُ أعيش طفولتي ومراهقتي معتقداً أنّي بطل رواية ما، أمشي وأنا على يقين أنّ خطوتي القادمة جملة يقرأها أحدهم، أقفُ وأحرس جيّداً وقفتي، كُنت حريصا جدّاً طوال سنوات كوني مراقباً من قبل هذا القارئ، ولم أتساءل أبدا لم كنت الكاتب والبطل والقارئ المتوهّم في آن؟ استفدتُ من هذا في عمليّة الكتابة، تلك التجربة النفسيّة جعلتني أتعامل برفق مع شخوصي، وأدخلتني في لبس النصّ الأول. "الرّواية هي أن تحبّ الحياة" هكذا قلت لصديقي الرّوائي عبد القادر برغوث في بداياتنا، قبل أزيد من عشرين سنة في مقهى العروسي بمدينة الجلفة، ثمّ أعجبتني العبارة فعدتُ أردّدها، يومها بدأت أتملّص من كوني شخصاً وأجد لي شخوصاً آخرين أتمرّن عليهم، لكنّ الكاتب فيّ تغوّل وأصبح ديكتاتوراً يرهقني، كنت أكتب قصيدة وحين فراغي أو تصوّري أنّي فرغت منها أشرعُ في قصّة قصيرة، وقبل أن أكملها ألجأ إلى الرّواية التمرين، ما كان عنوان تلك الرّواية؟ لا أذكر ولا أحسبني وضعت لها عنوانا، كانت حكاية حبّ بين رسّام هو سمير وفتاة أحبّها لا أعرف كيف غاب اسمها، أخذت منّي الرّواية التمرين أسبوعا وربّما أكثر، وحين انتهيت من تسويد أوراقي وضعت لها ما يشبه الغلاف، ثمّ التقيت بعض الرّفاق لأقدّم لهم أوّل رواية أكتبها، وقتها انفجر في وجهي أحدهم وطلب منّى أن أترك السّرد وأهتم بمجال محدّد، الشعر أو المسرح أو الرّواية؟ ولسبب ما شعرت أنّ شيئا تكسّر داخلي، أكنت دعيّاً في كلّ هذا؟ وهل أنا طفل ساذج يبحث عن سبب للبقاء؟ أحرقت المخطوطة واعتزلت الرّفاق إلا عبد القادر برغوث الذي ظلّ أقرب إليّ من كلّ أعمالي وأحلامي إلى غاية اليوم، لكنّها لم تكن أبدا روايتي الأولى، فأنا الكاتب الدّائم للرّوايات الأولى. في كلّ تجربة أشعر أنّي أبدأ مجدّدا، حتّى في رواياتي التي تتقاطع وتشكّل مشروعا مشتركا ظلّ هذا الشّعور ينتابني، أنا كاتب يكابد ويعاني ويكتب بدم الكبد، أتلمّس خبرة الكتابة داخلي لكنّها لا تنقذني أبدا من شعوري المفرط بمأزق أنّ كتابة نصّ مبرّر وأقرب إلى الإكتمال، مع إدراكي المسبق لاستحالة اكتمال المعنى. سأكلّم النّاس دائما عن "باردة كأنثى" كأولى رواياتي، وسأعدّها كذلك لمجموعة اعتبارات من بينها أنّي كتبت النصّ وضيّعته وأعدته كأنّي حفظته؟ يحفظ الرّوائيون روايتهم كما يحفظ الشّعراء قصائدهم، ولا مجال هنا لتفسير الأمر، لا لشرح الشعرية السريّة للرّواية والحياة. بدأتُ كتابة الرّواية في غابة بالجزائر العاصمة، اختفت الآن أحراشها وبوهيميّتها وجمالها المخيف، هذّبتها السّنوات وتحوّل جزء منها إلى حديقة، وقتها كنتُ أملك بيتاً في تلك الغابة، ليس بيتا بالمفهوم المتعارف عليه، لكنّها زاوية تليقُ ببدائيّة وهمجيّة ألمي حينها، كان البرد يحكم الجزائر لسنوات، المدن ميّتة والشّوارع لا تمنحك أيّ وعد أو أمل، وكنت أعيش مرتدّاً كبطل لرواية ما؟ استرجعت وضعي الطّفوليّ وبدأت أشعر أنّي حالة مسيّرة، أنّ كاتبي الذي كنته يراقبني، هل كنت مجنونا؟ ربّما ما أزال، قرّرت حين اكتشفت المكان أن أهرب إليه، هكذا أفشل مخطّطي الرّقابي، ولم أتجهّز بالكثير فقط أوراق بيضاء وأقلام، بدأت أكتب تجربة مختلفة وكنت وقتها لا أملك رصيداً، كتبت بضع قصص، ثلاثة دواوين شعر غير منشورة، ومسرحية "الإزميل والمعنى"، لم أعثر على الرّواية أوّلا بل على العنوان، خاطبت الحياة والمدن والغابة والمرأة، جميعهن كنّ باردات، من هنا قرّرت أنّ نصّي غير المجنّس بعد سيكون بعنوان "باردة كأنثى"، كنت أكتب كمريض يخضع لعلاج مكثّف -وهنا لا يخيفني تشخيص الكتابة كعلاج فهو أفضل من الاعتداء الذي ساد وقتها وما يزال- اخترت اسم "إدريس نعيم" لأعذّبه عذابات عميقة لا تشبه عذاباتي إلا في درجة الإيلام، وكان لهذا الاسم حكاية في سنوات الجامعة، حيث حصلت على علامة 2 في إحدى المواد، بينما حصل إدريس نعيم على علامة 12، والواقع أنّ شريكتي البحث حصلتا على نقطة إدريس نعيم ذاتها، وبدأتُ رحلة لإقناع الأستاذ أنّي مظلوم، بينما هو يصرّ على غيابي يوم إلقاء البحث، وفي النّهاية وبشهادة الزّميلتين أصبح علينا أن نحضر إدريس نعيم ليشهد أنّه لم يقم بالبحث، والمأزق أنّه لا يوجد شخص بهذا الاسم في الجامعة! كان إدريس هو موسيقى أو صدى لاسمى في أذن الأستاذ، واخترعَهُ خياله المتقاعد ليساعد الحياة على تعذيبي، هكذا إذن بدا لي أنّ الشخص الخيالي إدريس نعيم يعذّبني أنا الواقعيّ المعذّب بانتمائي ووجودي سلفا، وما أدراك أنّك واقعيّ؟ حقّا، أيكون إدريس نعيم هو الواقعيّ ونحن الكائنات الضالّة في الخيال؟ في بيتي الافتراضيّ وتحت سقف السّماء كتبتُ "باردة كأنثى" مقرفصاً، دفعة واحدة كأنّ يدا أخرى ترتدي يدي، وتركتها حين اكتملت في الغابة، بقيت أوراق الرّواية تنتظر لمدّة سنة كاملة، وحين عدت مرفقا بحبيبتي آنذاك وزوجتي الآن الرّوائية أمينة شيخ، لم نعثر على الشّيء الكثير، أوراق محا المطرُ كلماتها، وتصلّبت وفقدت بياضها، بعضها كان أزرقاً، رغم أنّي كتبت بحبر أسود على بياض، وبعضُها ترابيّ اللّون. ضاعت الرّواية قصدا، وهو ثاني إعدام لها، فقد كتبتُ بعض فصولها وأطعمتها الماء وأنا جالس أعلى "صخرة الموت" في ضواحي الجزائر العاصمة، تلذّذتُ وأنا أُبيد إدريس نعيم وألقي بمصيره إلى الماء، لقد كان بطلي الأثير/ كنت بطله الأثير، والذي فعلتهُ هو انتحار معنويّ، إذ يتعذّر عليّ إلقاء جسدي في الماء، لم أبكه، وحين عدت فارغ اليدين إلى مدينتي الجلفة قرّرتُ فجأة أن أكتب رواية أخرى، وبدأتُ مجدّدا لأجدني أمامها، أنهيتها بسرعة، وأودعتها الدّرج، بعدها بسنوات قليلة قدّمتها لجائزة مالك حدّاد التي وُئدت باكرا، وتركت الرّواية انطباعاً حسناً لدى اللّجنة أو هكذا بلغني، قرّرت رابطة الاختلاف (مُنظّمة الجائزة) أن تنشر الرّواية منذ 2006، وانتظرت حتّى 2013 لتنشرها منشورات الاختلاف التي انبثقت عن الرّابطة بالشّراكة مع منشورات ضفاف اللّبنانية، إثر فوزي بجائزة الطّيب صالح عن رواية أخرى، وحين صدرت لم أعد أعرفها تماما، ولم يبق بحوزتي منها إلا إدريس نعيم، لم يمت في تلك الرّواية، لقد بعثته مجدّدا في رواية "وصيّة المعتوه، كتاب الموتى ضدّ الأحياء"، منحته صفات أخرى حالات أخرى وحياة مختلفة، هل أمعنتُ في تعذيبه؟ لا أعتقد، وهل كنتُ بصدده رؤوفا؟ لا اعتقد، لقد تكرّست الكتابة الرّوائيّة في ثالث رواياتي بعد "ملائكة لافران" لهذا فقد استعدت إدريسا في وضع مختلف، ومن سؤاله الوجوديّ الحارق، أودعته دعة وطمأنينة المعتوه، وجعلته يُشفى دون أن ينتبه إلى ذلك أحد في آخر رواياتي "مولى الحيرة"، هكذا تخلّصت منه تماما، بل تخلّصت من الرّواية الأولى لأكتب أخرى وأخرى. وأنا الآن أشتغلُ على روايتي الخامسة "نمائم العشّاق" أنأى عن تجربة أغلقتها بمولى الحيرة، وأستعيد الرّواية الأولى فأجزمُ أنّها رواية الظلّ، الرّواية التي تصّاعدُ كلّما اعتقد الرّوائيّ أنّه تمرّسَ وقضى على ارتباك الكتاب الناشئ. كنتُ سُلطة ومحكوماً، ثمّ تعلّمت بعد الرّواية الأولى أنّي أقلّ من سلطة وأعلى من محكوم، أنّي كاتب روايات، كيف أفلتَ أبطالي؟ بسهولة؛ لقد توهّمت وجعلتهم يتوهّمون الحريّة، يلبسوني إلا قليلا فيصيرون أنا، وألبسهم إلا قليلا فأصير هم، وأحافظ في ذاك على خياراتهم التي قد لا تناسبني، ويحترمُون خياراتي التي تناسبني، لو أنّ القدر القليل من الصّرامة والرّقابة يغيب عنّي لغيّبت مبرّرات الكتابة كلّها، الرّواية الأولى هي الرّواية التي أكتبها الآن طالما أعتقد أنّي أفصلها عن سابقاتها، أما الرّواية التي أسّست لي روائيّا فهي "باردة كأنثى" التي تشعرني الآن بالدّفء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسماعيل يبرير: إسماعيل يبرير روائي وإعلامي جزائري، كانت روايته "وصية المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحياء" قد فازت بجائزة الطيب صالح العالمية في الروايةفي 2013، كما كانت روايته "ملائكة لافران" قد فازت بجائزة الرئيس الجزائري سنة 2008، ومسرحيته "الراوي في الحكاية" بجائزة الشارقة للإصدار الأول العام 2012.
smailyabrir@gmail.com







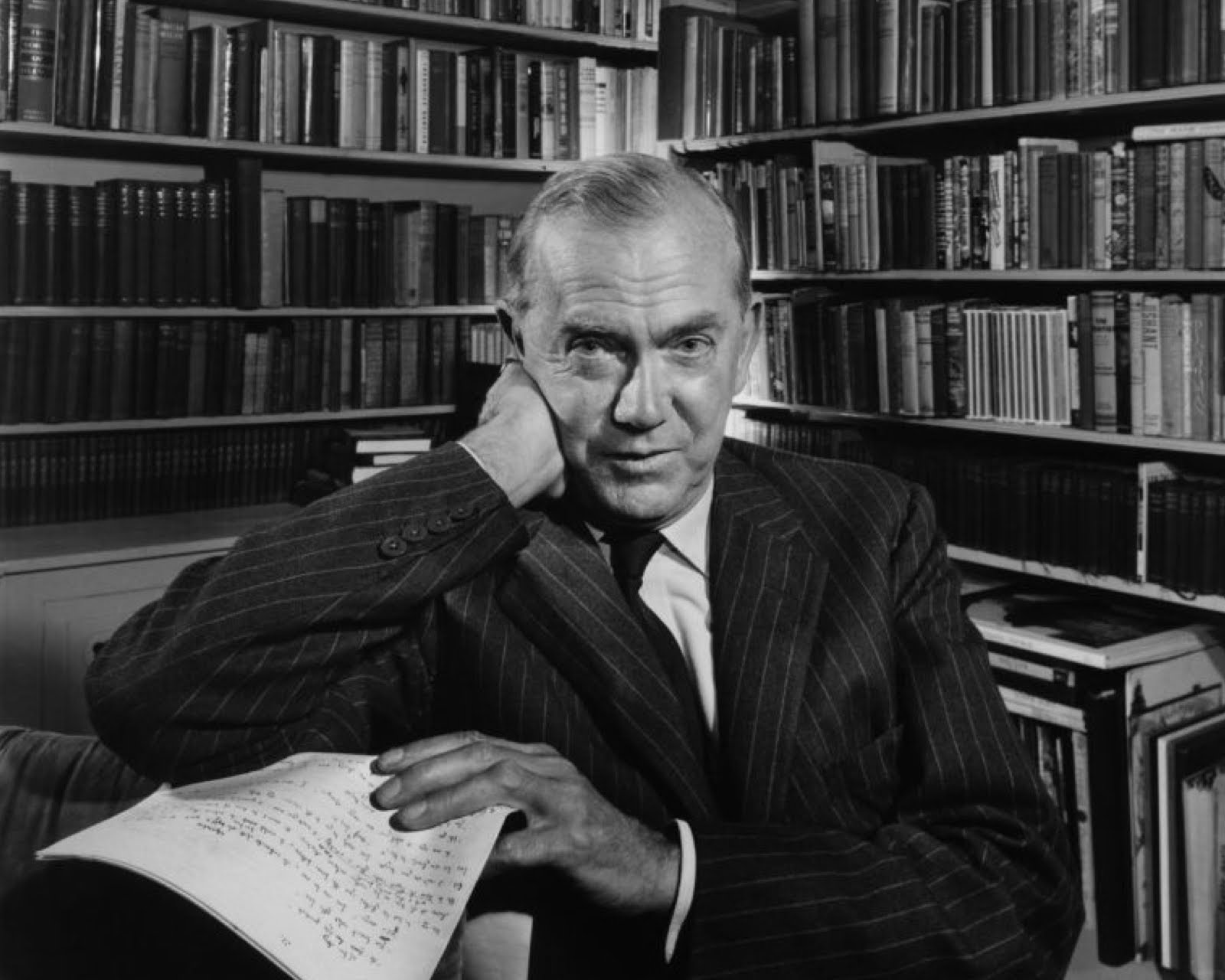


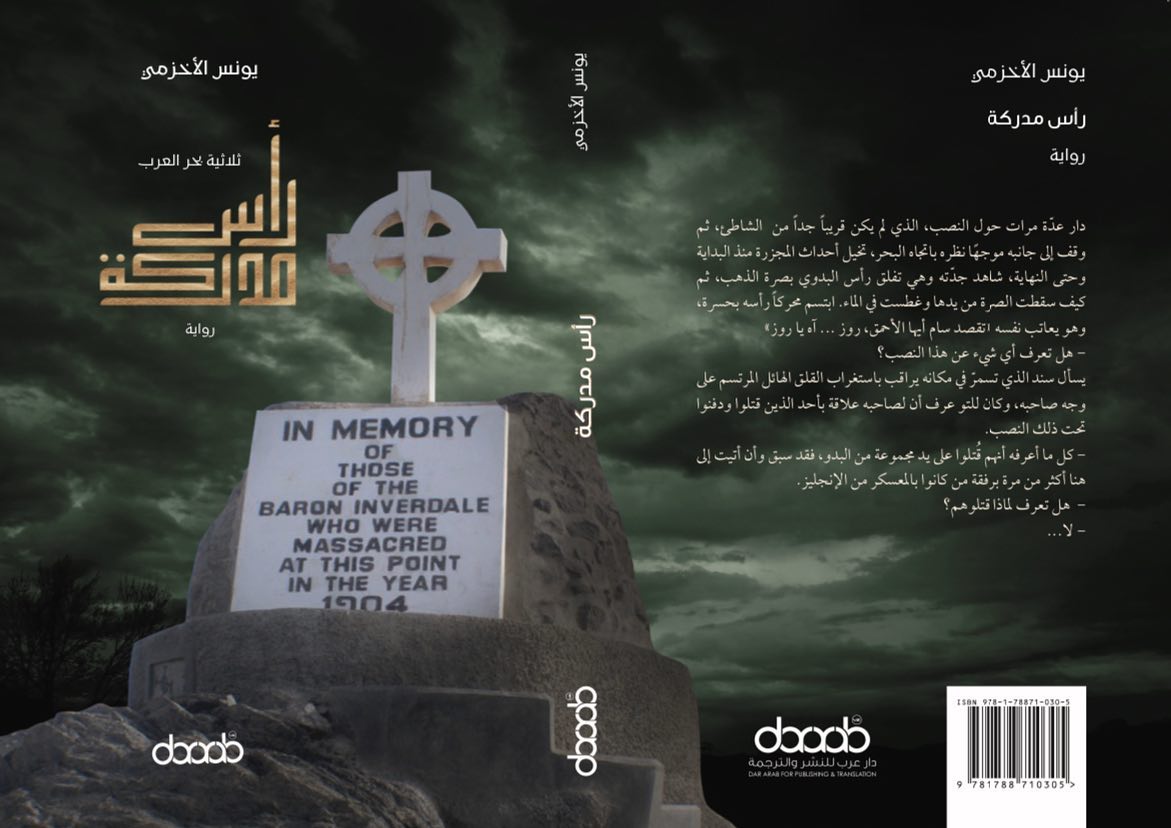



0 تعليقات