انتزاعُ الأملِ من براثن الإحباط
ليست لروايتي الأولى حكاية مخصوصة، فقد كتبتها في سياق سعيي إلى تطوير قدراتي الكتابية، لكن الأهم منها هو حكاية ما قبل كتابتي لها، فقد كنت طالبا في القسم الأول من الثانوية عندما قررت بوعي أن أصير كاتب قصة، في وقت لم تكن فيه القصة رائجة في موريتانا، ولم تعرف بعد بشكل واسع، وكان الشعر هو أكثر الفنون الأدبية التي تستهوي الطلاب في نهاية المرحلة الإعدادية عندما يمرون على دروس العروض، ويكتشفون أنظمة الشعر الإيقاعية، وكان انتشار الثقافة الشعرية التقليدية في المجتمع بشكل واسع يعزّز هذا التوجّه ويشجعه، وكثيراً ما يبدأ شعراء موريتانيا الحديثة مسيرتهم مع الشعر من هذه المرحلة، وقتها فكّرت في أنّ الاتّجاه إلى الشعر لن يعطيني أية خصوصيّة أو ميزة، نظراً لأنّ كلّ الذين يمتلكون ميولاً أدبية يتّجهون لممارسة الشعر، فمن الصعب التميّز في ما هو رائج، لذلك قرّرت أن أصرف نفسي لكتابة القصة. لم يكن البحث عن خصوصية وحده هو الباعث لي على هذا القرار، فقد كان هوى القصة رسخ في وجداني من خلال قراءاتي على مدى السنوات السابقة ومنذ المرحلة الابتدائية من خلال قصص الأطفال، مثل سلسلة "المغامرون الثلاثة"، و"كليلة ودمنة"، وقصص أغاتا كريستي، وقد اكتشفت في جوار مدرستي الإعدادية مكتبة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وكانت تحتوي على كتب أدبية قيمة، ومجموعات من القصص القصيرة من ضمنها مجموعة "حبّ تحت المطر" لنجيب محفوظ، ومجموعات من مسرحيات توفيق الحكيم، ومن خلال هذه المكتبة توطدت علاقتي بالقصة، وبالمطالعة بشكل عام، وهي العلاقة التي ستتوسّع بعد ذلك لتشمل كلّ المكتبات العامة والمراكز الثقافية في نواكشوط، كالمركز الثقافي السوري، والمكتبة الوطنية، والمركز الثقافي العراقي، والمركز الثقافي الليبي، والمركز الثقافي المغربي، ثم المركز الثقافي المصري بعد إعادة فتحه، ومكتبة جامعة نواكشوط، فقد كانت تلك المكتبات سنداً لي في تكوين ثقافتي بشكل حرّ يتجاوز قاعات الدرس. منذ لحظة القرار تلك، بدأت أكتب القصة القصيرة، وأذكر أنّ أول قصة كانت بعنوان "الدرس المفهوم" وكتبتها في بداية السنة الدراسية، وكانت حول تلميذ تتملّكه الدهشة والإعجاب من أول درس أدبيّ يقدّمه لهم أستاذ اللغة العربية، ثمّ واظبت على الكتابة، ومكثت مرحلة الثانوية متردّداً بين المسرح والقصة، فقد كان المسرح رائجاً في تلك الأيام، وكانت خشبة دار الثقافة في نواكشوط مسرحاً لكثير من المسرحيات والاستكتشات التي يقدّمها شبّان مفعمون بالحماس للفنّ، ولتغيير أوضاع المجتمع والسياسة، وكنت على صلة ببعض أولئك الشباب، لكنني لاحظت أن المسرح لا يُقرأ، ونصوصه لا قيمة لها ما لم تمثّل على الخشبة، فاخترت الانصراف إلى القصّة القصيرة التي لا تنتظر من يمثّلها، ومكثت سنوات الجامعة أتدرّب على كتابة القصة القصيرة، وأعمل على تطوير قدراتي الذاتية. عندما تخرّجت بدأت التطلّع إلى كتابة رواية، واعتبرت أنّ كتابة القصة كانت تمهيداً للرواية، ومرحلة تدريب ضروريّة لها، وبرغم أنّ دراستي الجامعية هي دراسة أدبية، وأنّني كنت أتمتّع بأساس نظريّ جيّد عن الرواية، وقد قرأت كثيراً من الروايات إلا أنّ عملية كتابة الرواية كانت لا تزال شيئاً غامضا بالنسبة لي، ولم أكن أعرف بالضبط ما الذي ينبغي عليّ القيام به لكي أكتب رواية، ولكنّني تسلّحت بالحلم وبدأت أضع الخطط لكتابة رواية، وكنت حينها قد انتقلت للتدريس في إحدى المدن الداخلية، وبعد عدد من المحاولات نجحت أخيراً في كتابة رواية "قرية الطيحة"، حاولت فيها رصد واقع المجتمع متناولاً أشكالاً من الممارسات والاستغلال كانت سائدة، ثم واصلت محاولاتي في كتابة الرواية، فكنت تارة أكتب فصولاً من رواية ثم لا أعجب بها، فأهجرها قبل أن أكملها، وتارة أخرى أكمل رواية، وكانت فترة التدريس بالنسبة لي فترة فتور انخفض فيها حماسي، بسبب انسداد الأجواء الأدبية آنذاك، فقد اصطدمت بواقع غياب النشر في موريتانيا، وعدم وجود أية إمكانية للنشر في الخارج، ما يجعل كتابة الرواية نوعاً من العبث الذي لا طائل من ورائه، ورغم هذا الجو فإنّني لم أتخلَّ عن الكتابة، فكنت دائما أمتلك مخططاً لمشروع رواية، أعمل على كتابته، ولو بتراخٍ شديد قد يدوم شهوراً بل سنوات.. كانت إحدى عشرة سنة من الإحباط، لكنني ظللت متشبّثاً بالأمل.. وواظبت حتى كتبت سنة 1997 رواية قصيرة بعنوان "أشياء من عالم قديم" اعتبرتها البداية الفعلية لمسيرتي الروائية الحقيقية، التي تضعني على طريق الاحتراف، وأحسب أنّ عناصر السرد مكتملة فيها، وأنّها قدمت رؤية متكاملة واتّسمت بطابع إدهاش وتشويق، هذا رغم أنّها قصيرة، لم تتجاوز عند طباعتها لاحقا ثمانين صفحة. حكاية "أشياء من عالم قديم" بسيطة، وهي في الأصل حكاية رواها لي صديق عن رجل يعرفه، قضى ربع قرن يبيع الفحم في سوق شعبيّ مبنيّ من أكواخ الخشب، واستطاع بعمله المتواضع تربية أولاده، وتدريسهم حتّى حصلوا على شهادات عليا، وعندما توظّفوا وظائف مرموقة أصبح عمل والدهم معرّة بالنسبة لهم، فراودوه لكي يترك ذلك العمل، وافتتحوا له محلّ بقالة على أحدث نمط، لكنّه لم يستطع التكيّف مع طريقة البيع في المحلّ وظروف الشارع الذي يقع فيه فتركه. عندما سمعت هذه الحكاية لأوّل وهلة قدرت أنها تصلح للبناء عليها كرواية، ووجدت فيها عمقاً يكشف عن أبعاد اجتماعية وإنسانية عميقة، وعنصر إدهاش جاذب، فبدأت بوضع تصوّر لبنيتها، وتخيّلت تفاصيلها، بطريقة تجعل أزمة ذلك الرجل مظهرا لأزمة مجتمع قديم، بدأت قيمه تتداعى تحت غزو الحداثة، لكنّني ظللت حريصاً على أن أعطي الأولوية لقصة الرجل كشخصية حقيقية تعيش واقعها بكل تشابكاته، فلا يظهر المجتمع وتجلياته إلا من خلال حياة الرجل، وما زلت أعتقد أنه في كتابة الرواية ينبغي أن تعطى الأولوية للشخصية حتى تأخذ أبعادها الإنسانية بكل توافقاتها وتمايزاتها وانسجامها وتناقضها. كانت الانطباعات التي عبّر عنها بعض الأصدقاء والزملاء الذين قرؤوا مخطوطة الرواية مشجعة، فقد كانت في المجمل تميل إلى الإعجاب بها، ما شجعني على مواصلة المحاولة وأعطاني دفعاً جديداً في وقت كنت في أمسّ الحاجة إليه، فاستمررت في المحاولات، وفي عام 2002 كتبت رواية جديدة قصيرة هي الأخرى، لكنها سوف تبقى إحدى أهم النصوص التي كتبتها، وهي "دروب عبد البركة"، وقد استوحيتها هي الأخرى من قصة سمعتها عن شاب تركه والده في بطن أمه، ولم يره، حتى شبّ الولد واشتدّ عوده، فبدأ رحلة البحث عن والده، من أقصى الشرق الموريتانيّ حتّى أقصى الغرب حيث عثر عليه في قرية غافية على دلتا النهر. طيلة تلك الفترة لم أنشر شيئاً، غير قصّتين قصيرتين أو ثلاث نشرت في بعض الصحف الموريتانية، ولم أكن في البداية مشغولاً بالنشر، لأنّني أعطيت الأولوية للتدريب وتطوير قدراتي، وكنت أعتبر ما أكتبه مجرد محاولات، كما أنّ النشر كما ذكرت آنفاً كان شبه معدوم، وما هو موجود منه رديء ومكلف، ولم أكن - وأنا مدرّس تعليم ثانوي أتقاضى راتباً زهيداً جدا، لا يكفي لسد أبسط ضروريات حياتي - أستطيع أن أفكّر في النشر، فحتّى شراء كتاب كنت عاجزاً عنه، فكيف بنشر كتاب، لكنّ الأمل سوف يتجدّد عندما حظيت بفرصة للإقامة في الإمارات، والعمل فيها، ما أتاح لي فرصة مواصلة الكتابة بوتيرة أحسن وأسرع، فكتبت عدة روايات، ونشرت حتى الآن أربعاً منها.. حين أتأمّل الآن تلك المسيرة أجد أنّني استطعت في النهاية أن أتغلّب على كلّ تلك الإحباطات، وأن أنتزع أملاً عزيز المنال من براثن كلّ المثبطات التي اكتنفت بداياتي الأدبية، والتي كانت ستجعهلها - لولا الإصرار الذي تحلّيت به - حلماً عابراً لا أمل في عودته. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صحافي وروائيّ موريتانيّ مقيم في الإمارات. صدر له: أشياء من عالم قديم 2007 وذاكرة الرمل 2008 ودروب عبد البركة 2010. "دحّان" 2016
الرواية نت







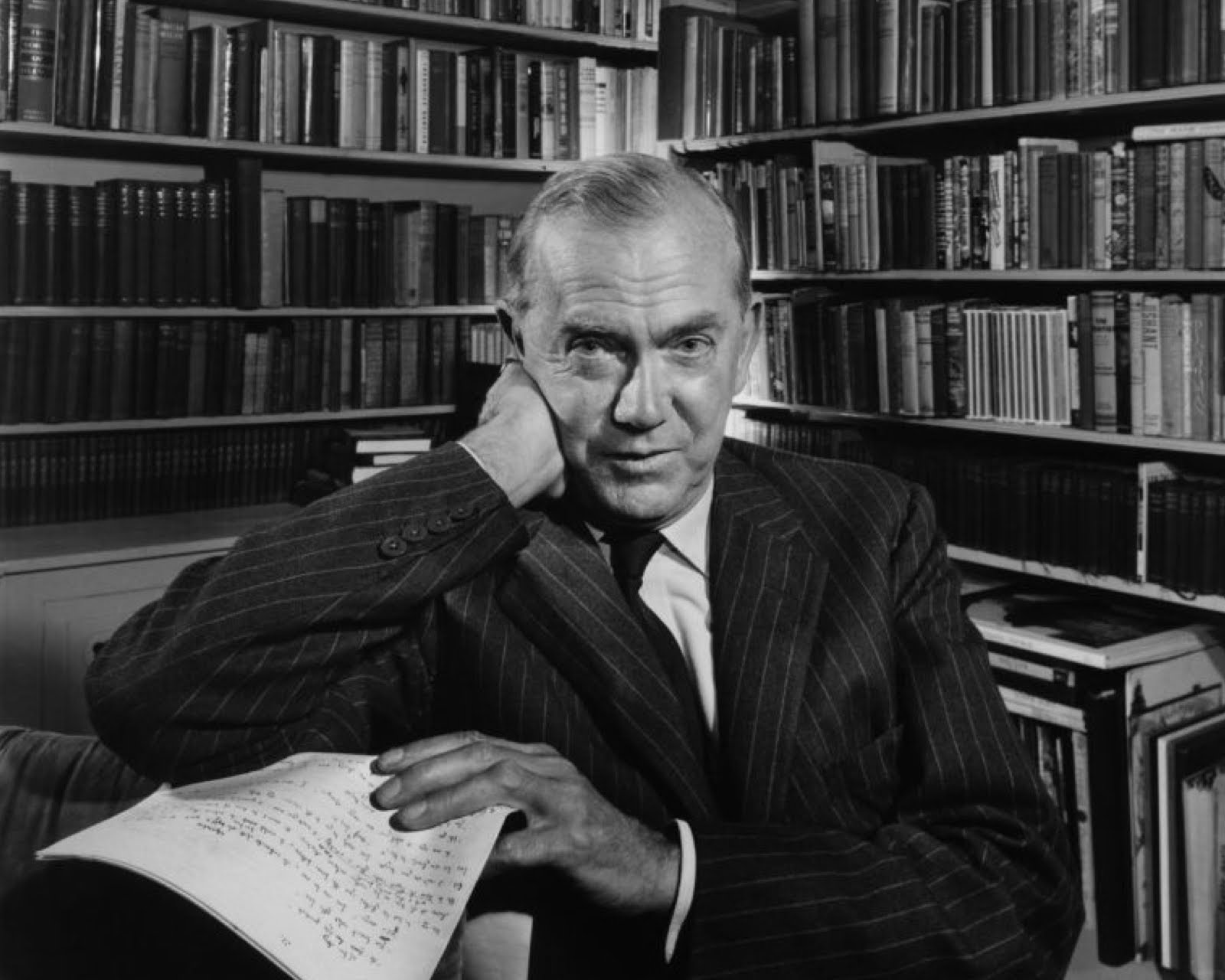


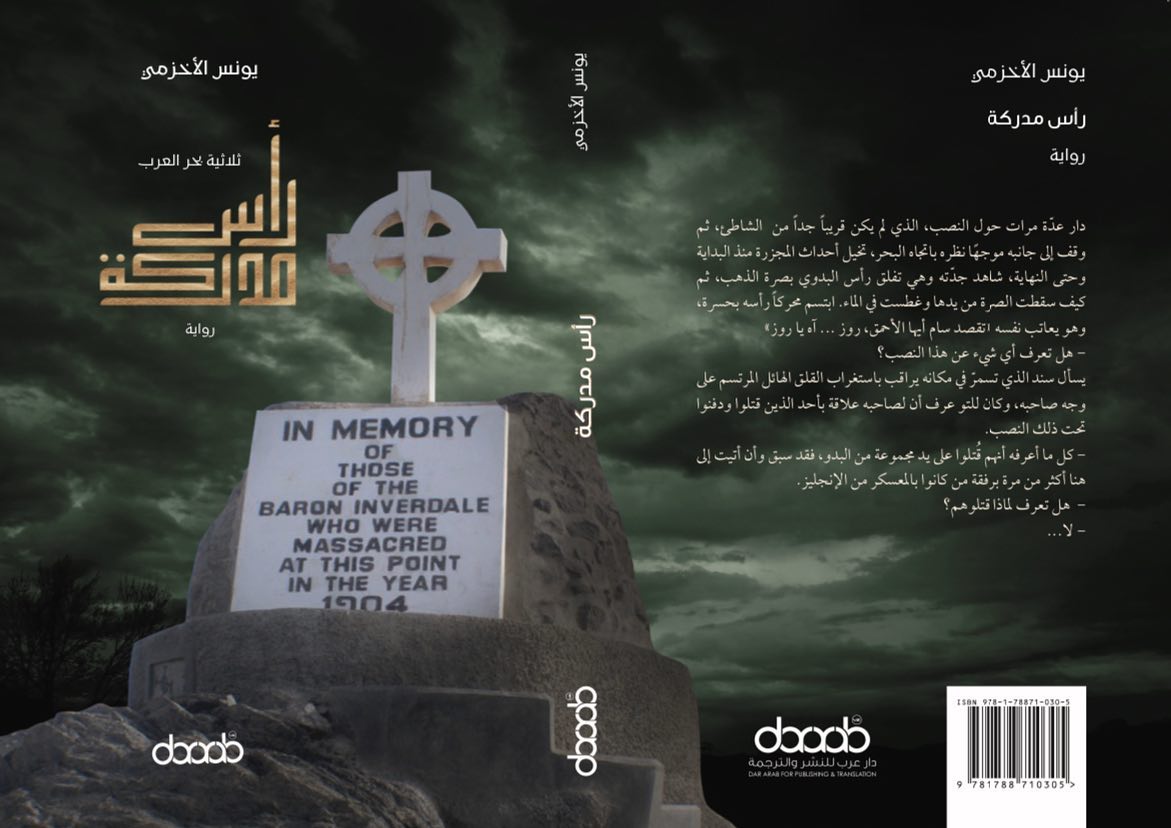



0 تعليقات