الظلّ لا صوت له..
أول التسعينات النصف الأول من العام - البصرة الخروج من المدينة إثر قمع انتفاضة الجنوب، مروراً بالجثث التي تمّ إعدامها وقرار منع رفعها في دوار الشارع الأول من البيت، يرافقها هلع استجوابات المفارز التي لم نعرف هويتها كل عشرة أمتار، في جوٍ علقت به رائحة البارود. النصف الثاني من العام - كوبنهاجن حط الرحال؛ أجواء إسكندنافية ساكنة، ودكنة شديدة الخصوصية. يكشف ضوء العتمة عن فوضى لا مثيل لها؛ صفاء مضاعف في الرؤية تأتى من التضادات ابنة وقتها. اصطدام بأذهان لا تعقيد في طرحها للفكرة أو في صياغة سؤال؛ بساطة متناهية قابلها غموض ومتاهة داخل أدمغتنا المتعبة، حيرة وتأتأة في تكوين جملة بسيطة. حتى أواخر التسعينات تتوالى الاكتشافات المتأخرة بفعل الانزياح. الانتقالة الكبرى دفعت إلى التمرن الجواني من أجل النجاح في صف كلمات مترابطة، والتدرب على نطقها، ولكن من دون صوت! الظل لا صوت له ولكنه الخزانة والمنهل الذي يرافق كل منا، يحتشد بالأفكار والنصوص المعدة لمرافعات وهمية. من هنا بدء الحكاية، لحظة الانتباهة الأولى إلى الظل، وإن انحسرت الشمس. التضاد بين الحشود الغفيرة وقيادتها من خلفي هناك، والأفراد الطلقاء هنا أفرز تلك المساحة المشروعة من الفراغ خاصتي. والحديث ليس عن حصول امرأة أخيراً على حق ما إطلاقاً. وفي لحظة اطمئنان تدافعت أوجهي التي لا أعرفها، مع شخوص لها ارتباط، ولا شكّ بي، لتوكل إلي بمهمة العناية بـ"القلوب التي بلغت الحناجر"، بينما الأعين جميعها اشتركت في النظر صوب نقطة. لتصدر حكاية "النقطة الأبعد" في العام 2000، دار المدى. دمشق. النصوص الأولى التي صدرت في أول كتاب لي "حرب نامة" في العام 1998 من إصدار دار المدى، كانت من ضمن المران الذي بدأته أول وصولي لاجتياز أزمة الانتقالة. احتشدت الصور وازدحمت المخيلة. طال الانتظار بسبب العراقيل الأولى من أجل التأقلم وكانت لصالح النص قبل صدوره، ولكن رغم ذلك لم يخل الكتاب من الانفعال، حتى أنني لم أرجع إلى هذه المجموعة، برغم أنها كتابي الأول بنبضه السريع ودمه الحار وصوره المتقدة، وقد كان بالفعل بمثابة كتاب حرب أو يوميات حرب جمعتُ فيها صوراً عشتها على مدى سنوات الحرب واستعرت عبرها لسان نساء كنت على مقربة منهم. لم أكن واعية لما كتبت ولم أعرّف شيئاً. لم أكن أريد إلا أن أكتب طالما كنت بمنجى عن السلطة التي اعتمدت في سياستها البطش والعنف. المختصون في الأدب هم الذين كتبوا إلي ينصحونني في خوض غمار الرواية من دون تردد فالجملة التي كتبتها كانت روائية. أسعدني ذلك. الملاحظة اختصرت الطريق علي بظني، ولاسيما أني قد بدأت بالشعر أولاً وخشيته لأن "الصغار" لا يجب أن يكتبوا الشعر. هذا ما كان الوسط الذي نشأت فيه يوصي به وهو وسط أدبي فني. ليس الشعر حسب، إنما التأني في الكتابة خوفاً من الإخفاق، تلافياً للأخطاء واستكمالاً للتجربة. لا غبار على اتفاق الجميع حول أهمية النصيحة هذه. لكني لمست العكس في الجانب الآخر من العالم فلا سبيل للتقدم إن لم تكتب وتواصل إن توفرت الموهبة، فالكتابة تدرّس في مدارس هنا يتخرج منها شابات كاتبات وشباب كتّاب، وخلال فترة الدراسة يتلقى الطالب عصارة خبرة أستاذ مارس الكتابة لمدة لاتقل عن 10-15 سنة. من ناحية أخرى فلا يمكن تجاوز الأخطاء ونجاح كتاب يصدر لنا اليوم لا يعني نجاح كتابنا القادم، ببساطة. الآن وبعد مرور ما يزيد على الخمسة عشرة سنة حدث بتصوري تغيير بشأن هذه المفاهيم في أوطاننا، ومن جهة أخرى دخل سوق الكتاب الاقتصاد كسلعة أسوة بالسوق الغربي الذي تحكمه مقاييس أخرى. النقطة الأبعد كانت روايتي الأولى وفيها لهاث ثلاثة من الأساتذة الأكاديميين، في مقتبل العمر وسط مرحلة متأزمة وضمن مجتمع تمزقت فيه الطبقة الوسطى وعليه اقتضت الحياة أن يمتلكوا أدوات إضافية تعينهم في تدبر حياتهم. أصوات زوجاتهم أعلى بكثير وهم يؤخذون بجريرة المجتمع والنظام السياسي الذي كان قائماً. كنت أكتب بوهم الاقتراب من النقطة الأبعد التي كانوا يرومون الوصول إليها، لربما لتضمن لهم الانعتاق التام أو استحصال حالة من الأمان سواء بالاستسلام أو التمرد. الطريق خلالها كان سالكاً مرة ووعراً في مرات أخرى. لكن هذا الوهم حقق نشوة وسعادة لا متناهية خلال مراحل كتابة الرواية. وفي مقابلتي لكاتبة دنماركية قديرة قمت بترجمة عملين لها بعد سنوات من إقامتي في الدنمارك، وجدت نفسي أحدّثها عن مخاوفي بشأن الثيمة التي وكأنها تُفرض علي كلما شرعت بكتابة عمل جديد ألا وهي الحرب، فالثلاثة في "النقطة الأبعد" كانوا ولادة "حرب نامة" وعندما تركتهم في العراق وغادرت، لاحقني ثلاثة منهم إلى الدنمارك في عندما "تستيقظ الرائحة". وإن كنت قد تجاوزتهم في "منازل الوحشة" وعملي الروائي الأخير- لم يصدر بعد- فلم أستطع ان أتجاوز موضوعة الحرب في كل منهما. ابتسمت الكاتبة مدركة تماماً ما أعني وأخذت بتعداد كتّاب ما بين الحربين وكتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين لم يكتبوا طيلة سنوات إنتاجهم عن مادة سوى الحرب التي عاشوها وظلت أجواؤها مهيمنة ملازمة لهم باقي حياتهم. ولأن عالم الرواية بحاجة الى سكوت وتعمق في التفكير، ومواصلة في العمل ولملمة خيوط لا حصر لها، لذا يهمني في النهاية أن أعود إلى المساحة الخاصة بي التي بتّ أرعاها، مساحة مقترنة بهدوء الطبيعة ومهادنتها هنا، والتي تتيح للفرد الانصات جيداً إلى ما يدور سواء في الداخل أو إلى ما حوله. بفضل هذه المساحة تنبهت إلى ذلك الظل الأمين الجريء الوحيد والغريب والمقصي، الناكر لمعرفته واعترافه بكل ما يدور من حوله. روائية عراقية مقيمة في الدنمارك







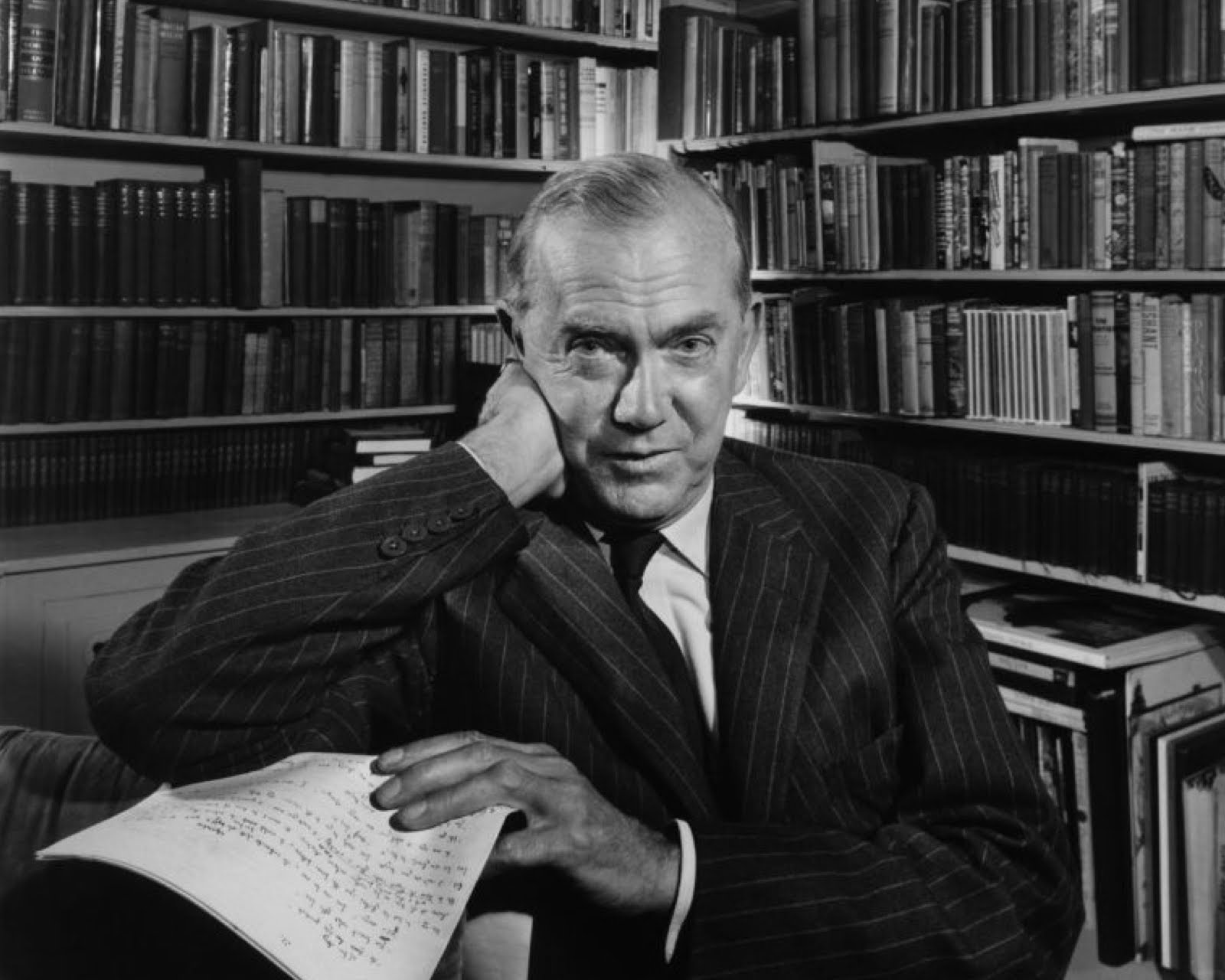


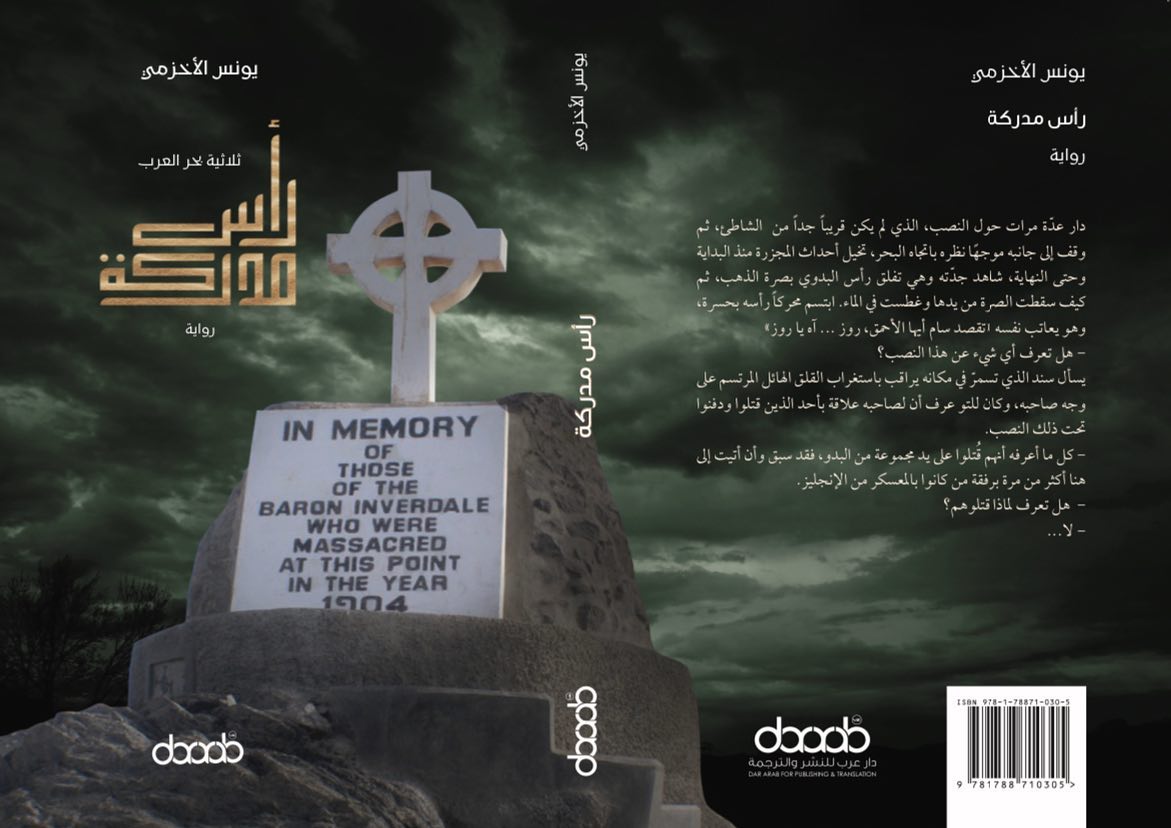



0 تعليقات