ليس الظلام دامساً، ثمة ضوء فيه
كان المنظر الذي جاءني عفو الخاطر، قد رسم بدايات روايتي الأولى. المنظر هو: امرأة تقف عند مدخل دكان في سوق قديم، تصوب نظراتها إلى مجرد ظل يتململ في عمق المكان، تتبادل معه بضع كلمات يبعثرها الهواء الراكد، ثم أرى الظل يتقدم نحوها مشطوراً بالضوء، بينما العتمة أسدلت أستارها على رأسه وكتفه. من هذه المرأة، أو هذا الظل الذي أصبح رجلاً؟! ما الكلمات التي قيلت؟! كأن ما تراءى لي كان هبة من الخيال، ولقد أظهرت امتناني له بكتابة روايتي "موزاييك" خلالها لم يتخلَّ عني.
لم تكن "موزاييك" عملي الأول، سبقته قصص وروايات، شكلت مجموعة تجاربي طوال سنوات عديدة، لم أنشر أياً منها. كانت غير صالحة للنشر، فلم أحفل بها، فيما بعد تخلصت منها. وإذا كنت اعتبرت "موزاييك" روايتي الأولى، فليس لأنها حظيت بالنشر، بل لأنني اكتشفت أسلوبي في كتابة الرواية، وهو الأسلوب الذي سيحمل بصمتي، وتحت غطائه ستكون محاولاتي التالية في التجريب، كما أفهمه، مع كل رواية.
كنت قد كتبت المشهد الذي اتحفني به الخيال على أنه مطلع لقصة قصيرة، بدأت معه رحلتي، من دون معرفة إلى اين سيقودني، لمجرد خاطرة أنني سأكتب عن حب مستحيل، لم أكن أدري هل سيتحقق؟ كانت جاذبيته في استحالته. لا يُشترط أن يبدأ الكاتب من فكرة منجزة، ربما كما حصل معي من لمحة استهوتني، وكان لها ألا تؤدي إلى رواية ولا إلى قصة قصيرة، لكنني تعلقت بها، ربما لعدم توفر غيرها.
تراءى لي أنه لا يمكن أن يكون هذا المشهد في تسعينات القرن الماضي، لا الزمن ولا البيئة تحتمل هذا الحب، الحب المستحيل لا يحدث إلا في بيئة مغلقة لها تقاليدها الراسخة، بينما كانت دمشق في تسعينيات القرن الماضي تشكو من عدم استقرار أخلاقي، الفساد ضارب أشبه بجائحة، والصراع على العمولات والمنافع، الأجواء المخابراتية طاغية على بيئة أصابها الخلل وتعاني من التغيير، وتجهد في المحافظة على أخلاقياتها. فراوحت في ظلام، وتوقف عملي عليها. بالمصادفة البحتة كنت أقرأ عن تاريخ سورية أيام الانتداب الفرنسي، فاستوقفني دخول المندوب السامي "بيو" إلى دمشق في يوم صقيعي، تسبقه فرسان التجريدة المغاربية قاصداً مبنى المندوبية الفرنسية في الصالحية، يمر في طريقه على ساحة المرجة، المحلات مغلقة، لا حركة سير، حركة المارة تكاد أن تكون معدومة. الإضراب شامل، كان استقبالاً بارداً.
شكل دخول "بيو" إضاءة للمشهد المظلم، وأصبح لما بدا أنه رواية في طريق البزوغ، إحداثيات تأطرت زمانياً في عام 1939، أما المكان فدمشق، عشية الحرب العالمية الثانية، ما شكل الخلفية التاريخية، التي ستلعب دورا في تحريك الحدث السياسي من حيث انعكاسه على الحدث الروائي وشخصيات الرواية.. مع أن التاريخ لم يكن في حسباني أبداً، كما أن الروايات التي لها علاقة بالتاريخ، لم تكن تروق لي. أتخيل أن للعقل الباطن دوراً في خياراتنا، لو كان عقلي الواعي شغالاً لما تورطت إلا في الراهن.
اليوم أدرك أن تشكل الخطوط الأولى للرواية لم يكن بإرادتي، كان تكونها مديناً للمكان الدمشقي، ولذاكرة خشيت أن تتلاشى في زمن كان النظام السياسي يقطع مع ما قبله، وكأن تاريخ سورية يبدأ مع هيمنة البعث على السلطة، ويترسخ إلى الأبد مع "الحركة التصحيحية". ذلك ما فسر ظهور الرواية مختمرة، كانت فعل تأكيد للذات السورية من خلال البشر والمكان والأشياء. كانت إحياء لدمشق في عام 1939، وإشارة إلى تاريخ معتّم عليه آن له أن يظهر، لا أن يبقى أسير الأقاويل، كأنه لم يكن إلا في تداعيات ذاكرة أجهدها الزمن والخفاء، لتاريخ مهمل، وقد يضيع، لكنه كان عسيراً على النسيان.
ما استهواني في زمن الرواية هو إمكانية تمريرها في الرقابة، كان كل ما كتبته من قبل، يستحيل نشره لتعرضه إلى آلية النظام في تكميم الأنفاس، وتدخل أجهزة الأمن في الكبيرة والصغيرة، كان أي رواية عن الحاضر تكتب إما في تبجيل النظام ودوره في الوحدة والحرية والاشتراكية والنضال ضد الإمبريالية العالمية، أو استعمال الرمز في نقد مظاهر السلطة القمعية.
أعتقد أن الرواية الأولى، إن كانت ناضجة، سوف تكون التجربة الكبرى والأهم في مسيرة الكاتب الروائية، فهو لا يكتشف أسلوبه فقط، بل ويدرك أهمية التعامل مع اللغة، وتكوين الشخصية، وتصاعد الحدث، وتشابك الأحداث والخطوط.. كل هذا وغيره، لا يتجسّد إلا في القدرة على تشييد معمار روائي يشبكها كلها على أنه المعنى الأعمق للرواية الذي لا يكتمل إلا في اجتماع الكل، كمظهر من مظاهر الحياة نفسها التي لا تتشكل عناصرها كل على حدة.
لا يضع الروائي أفضليات ولا أولويات، يكتب بالحدس وبالخيال، وعينه على الواقع، يستشعر كل ما يعترضه، وينجزه حسبما يتصوره في ذهنه.. الرواية فرصة لا تتكرر، في هذه الفسحة عليه أن يعي ما يريد كتابته، وما يريد التعبير عنه.
في عزلته يتعايش الروائي مع شخصيات، لا يتملكها تماماً، يشعر بأنها تتمرد عليه، وقد تنمو بمعزل عنه، شخصيات لديها حياتها وأفكارها ونوازعها ونزواتها، الكاتب ليس بديلاً عنها، مهما حاول التماهي معها، بقدر ما ينبغي أن تكون هي نفسها، وليس من الغريب ان يقول الكاتب إن شخصيات روايته تفاجئه، أو إنه يلهث وراءها ليدركها، أو يحاول تفسير تصرفاتها، وأنها تضعه في حيرة، وربما مآزق إزاء خياراتها، بل ويصل الأمر إلى محاولة التكهن بما تفكر فيه، هي أيضاً تخفي نواياها عن كاتبها، لذلك لا بد من التحاور معها بحرية مطلقة، إلا إذا أراد الكاتب التحكم بالرواية، ويُسيّر الحدث كيفما يشاء، ويضع الكلام في أفواه أبطاله، ما يحولها إلى رواية ذهنية.
لا يعني ما أنتهجه في رواياتي أنه الطريقة المثلى، وإنما الطريقة التي أتحسس بها صناعة الرواية، وأتفهم ما يطرأ عليها. هناك روائيون اعتادوا أن تختمر الرواية في أذهانهم، وعندما تصبح جاهزة يكتبونها، وحصلوا على نتائج ممتازة. بالنسبة إلي، حاولت هذه الطريقة مراراً، وفكرت بالرواية على هذا المنوال، بحيث اكتملت وجهزت بشكل كامل. عندما بدأت بالكتابة أحسست أنني مجرد منفذ لما فكرت فيه، لا مفاجآت، ولم أكتشف شيئاً، بدا كل ما أكتبه عبارة عن تسويد صفحات، وفي الوقت نفسه مغلق تماماً.
علمتني روايتي الأولى، ألا تكون الرواية منجزة في رأسي، مجرد أنّ لديّ فكرة غائمة غير واضحة، وشخصية أو شخصيتين، بالكاد أستطيع تلمّسهم، وشيء ما عن المشهد الذي سيتحرّكون في داخله، وعلى دراية نوعاً ما بالمناخ الاجتماعي والفكري، وشيء ما أريد قوله وليس على بصيرة كاملة به، لكنه ضروري.. ما يشكل بداية رائعة، ليس الظلام دامساً، ثمة ضوء فيه، على هديه لابد سأجد طريقي.
الرواية رحلة في المجهول، لذلك تحفل بالكشوف، وبأحداث تستدعي بعضها بعضاً، ومصادفات لا أصنعها بقدر ما تفرض عليّ. بهذا المعنى تصبح الرواية اكتشاف صاحبها، سواء الأفكار، أو الأحداث، أو الأشخاص.. اكتشاف العلم في سيرورته، ماضيه وحاضره بالدرجة الأولى. وفي هذا ميزة، إذا كانت تجذبني فهي ستجذب القارئ، وإذا كانت تهمني فهي ستهم القارئ. لذلك لا خسارة في الانكباب على كتابتها سنة أو سنتين، وربما ثلاثة أو أربعة، لا يهمني قارئ معين. أنأ أمام قارئ مجهول، لذلك وبالضرورة أنا القارئ، ولكي ترضيني لابد من بذل ما أعتقد أنه أقل ما يمكن، بذله في عملية الكتابة المشرعة على الحياة والبشر.. إنه الإخلاص.
روائيّ سوري







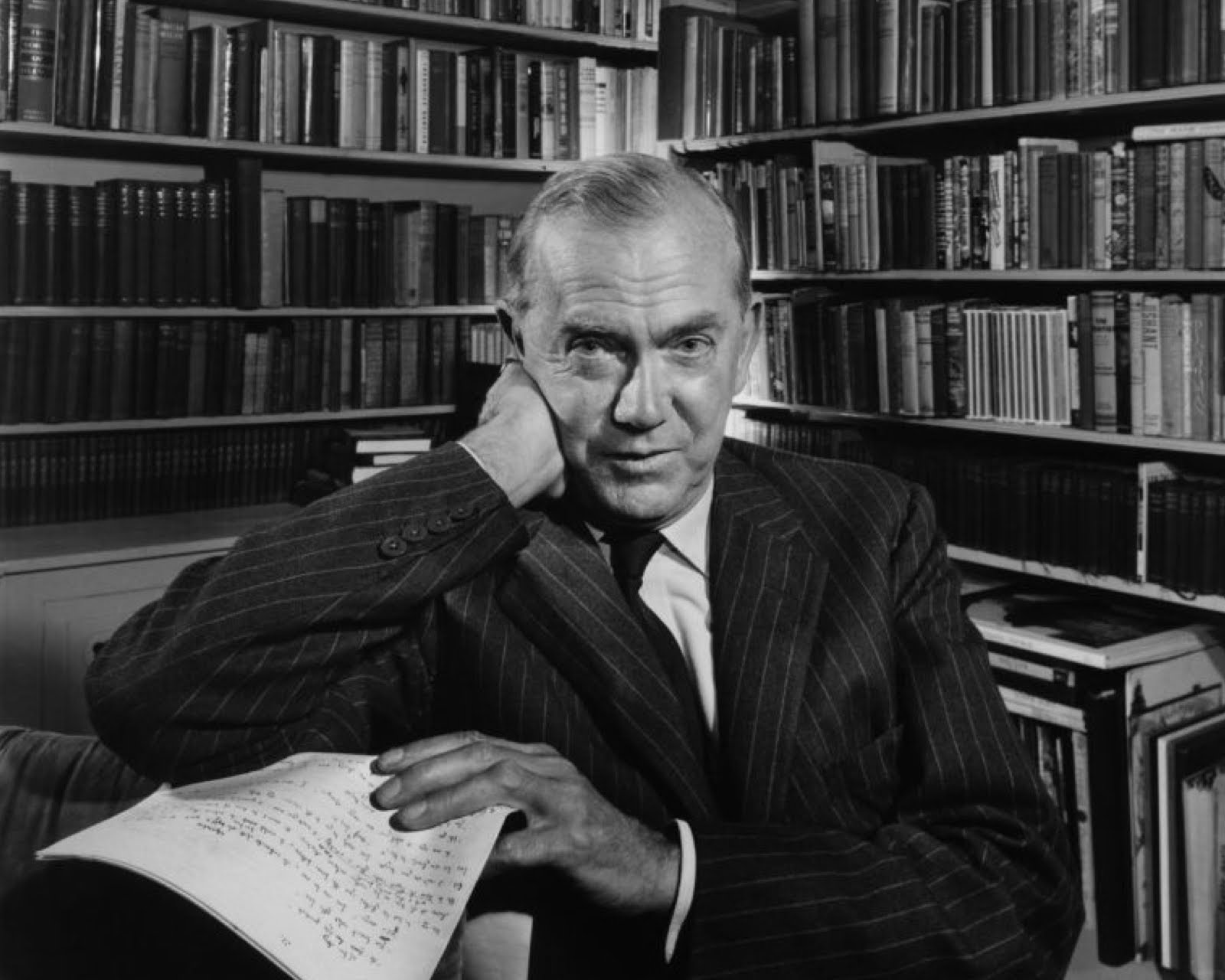


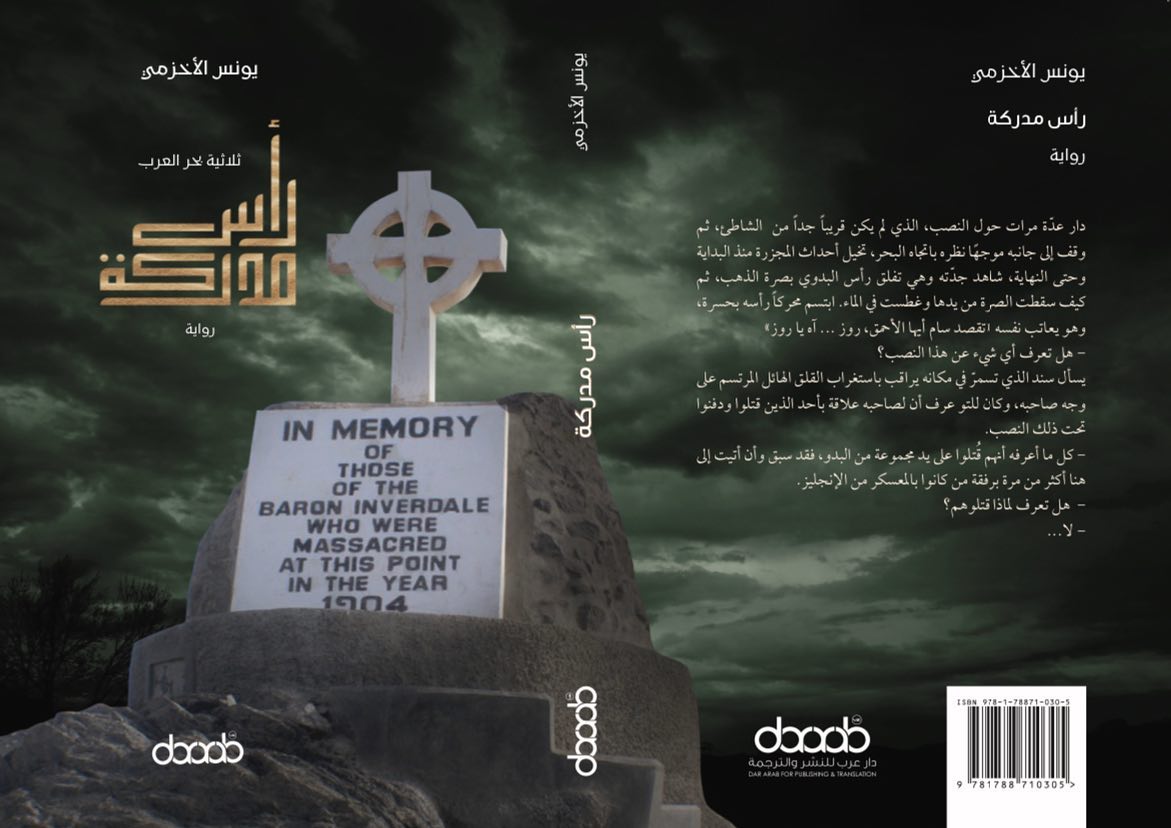



0 تعليقات