الصّريم لأحمد السمّاري.. انبعاثات فينيق الصحراء
رواية الصريم لأحمد السماري رواية اجتماعية وثائقية ترصد حياة قسم من جزيرة العرب، وصراعها من أجل الحياة، معتمدة أسلوب أدب الرحلات، وتضمين الحكايات المتفرقة بطريقة أقرب إلى ألف ليلة وليلة لتقديم منظوراتها السرديّة.
الحكاية ورُوَاتها: زيدُ بن عثمان شابٌ نجدي عصفت به وبمحيطه أعاصير الحياة منذ نعومة أظفاره، فوجد نفسه المسؤول الوحيد عن أسرته بعد موت أبيه، فكان عليه أن يكون الأب والأخ ثم الزوج، وحين تراكمت عليه الديون، وطغى على مشاعره جفاء وجشع بعض أقاربه (عمّه)، وتواطأت معهم الطبيعة التي حولت قريتَهم بما فيها مزرعته إلى ما يشبه الصريم، فوجد نفسه مضطراً إلى الهجرة للعمل في الكويت مُضحياً بأحلامه الشخصيّة وخاصة رغبته في طلب العلم، من أجل الآخرين، يقضي ثلاث سنوات هناك عاملاً ناجحاً محبوباً، يضجّ به الحنين إلى أمه وأخوته وزوجه وولده، فيقرر العودة إلى دياره، ومع بداية رحلة العودة يبدأ الفصلُ الأول من الرواية حيث يترافق مع (ويليم) الرّحالة البريطاني، المولع بالشرق وحكاياته، ولتشكل هذه الرحلة متن الرواية بأكملها وتستغرق كلّ أوراقها، حيث يتداخل السرد المتزامن مع الحدث مع استدعاء الماضي واسترجاع ما سبق من أحداث، ويأتي الفصل الثاني مُقحماً في وسط الرحلة لاستدعاء كلّ الحلقات المفقودة من ذلك الماضي الذي كان سبباً لتلك الرحلة ذهاباً وإياباً من الكويت، ومن الممكن وضعه مكانَ الفصل الأول دون أن يختل أي شيء في البناء الروائي؛ لأن الرحلة احتلت مساحة الفصل الأول والثالث، وأما الفصل الرابع، فهو فصل خطابي مباشر تضعف فيه الحكاية إلى حد الاضمحلال لتطغى عليه نبرة خطابية وعظية تتضمن خلاصة تجارب زيد الحياتية، وما تضمنته من حكم ومواعظ ودروس. وكان من الممكن نثر هذا الفصل وتضمين رؤاه في الفصول السابقة دون أي خلل في البناء الروائي.
وقد تعددت أصوات الرواة واختلف مدى علمهم لتقديم هذه الحكاية فالفصل الأول يُروى بضمير الغائب من قبل راوٍ عالم لكن علمه محدود بزمن الحدث، وبما يرى ويسمع ويشعر، ولا يتجاوزه ويتكرر هذا الراوي في الفصل الثالث، ويتضح مدى علم هذا الراوي في قوله:
" كمن يسير نحو المجهول كان يغمرهما شعور متباين؛ وليم يراوده إحساس ذلك الطائر عندما يتحرر من قفصه بالرغم من موجات خوف وحذر إلى حد ما، أما زيد فإحساسه الارتياب والقلق، وقلبه ينقبض وقولونه العصبي يتقلص" ص 139.
وهنا نلاحظ أن الراوي عالم بما يدور داخل الشخصية إضافة إلى ما يحدث لها وحولها.
أما المقطع الثاني فهو مروي بلسان المتكلم (أنا) حيث يرويه زيد وبأسلوب أقرب إلى المذكرات الشخصية التي تسيطر عليها حالة نوستاليجية وبطريقة الخطف خلفاً حيث يسترجع كل ماضية وذكرياته التي آلت به إلى ما صل إليه فيبدؤه بقوله:
"كلما تذكرت قريتي يشتعل لهيب في روحي كم أتمنى أن ينطفئ ويخمد إلى الأبد لكنه برغم ألمه استحال مع الزمن جذوة نور في قلبي ينير بصيرتي". ص89
وبالضمير ذاته يروي لنا الفصل الأخير وبطريقة الراوي الكلي المعرفة ومن مسافة زمنية تجاوزت الثلاثين عاما عن زمن الرواية. فزيد كان في المقطع الأخير قد تجاوز السبعين من عمره.
ويبدو أن الكاتب قد خلط سهواً بين الراوي بضمير المتكلم والراوي بضمير الغائب في مقدمة المقطع الثاني من الفصل الثالث حيث بدأه بقوله "نهض الجميع من مخيمنا المؤقت فجراً وكان الوضع أكثر راحة مقارنة برحلة الكويت..." وواضح هنا أنه يستعمل ضمير (أنا) و(نحن) والمتوقع أن المتكلم هو إحدى الشخصيات، والمتوقع أن يكون زيداً أو وليم ولكن يتابع كل القسم وحتى نهاية الفصل بضمير (هو) الراوي الغائب عن كل الشخصيات كقوله: "كانت كاميرا وليم تلتقط اللحظات والحركات الإنسانية والحيوانية في حالة من السرور والحبور، وإن كان يعد رحلة الكويت الهفوف أكثر حميمية كما ذكر لصديقه زيد" وهنا يتضح أن الراوي ليس زيداً ولا وليم، بل هو راو يروي بضمير الغائب، وهو غير الذي قال في بداية المقطع "نهض الجميع من مخيمنا المؤقت" وكان الصواب أن يقول: "نهض الجميع من مخيمهم.
العتبات النصّية:
ترصد الرواية فكرة عامة تتمحور حول معاناة سكان نجد في منتصف القرن الماضي من خلال صراعهم مع البيئة الصحراوية التي فرضوا وجودهم فيها مصارعين تناقضاتها التي لا ترحم. ويصرح الكاتب من أول عتباته النصيّة وهو الإهداء بأنه أرد من وراء عمله الوفاء "للأسلاف الذين عاشوا تلك الفترة العصيبة من الكوارث والعوز من تاريخ نجد والجزيرة العربية ولم يتذكرهم إلا القليل من الناس"
وكذلك تأتي العتبة النصية الأولى وهي عنوان الرواية (الصريم) لتخلق حالة تنبئيّة بذاك الشقاء والابتلاء حيث اقتبس هذا العنوان من القرآن الكريم من سورة القلم (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا يستثنون* فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون* فأصبحت كالصريم) أي أنها أصبحت بعد احتراقها سوداء كقِطع من الليل. وفي حال هذه الجنة معادلٌ لما حل بديار بطل الرواية زيد حيث داهمتها الأمطار والسيول وتركتها أثراً بعد عين، وهو ما توضحه لوحة الغلاف كأول فضاء بصري لدخول هذا النص حيث رسمت فيها أطلال خربة لبيوت طينية، يلفت النظر فيها ثنائية (الإتقان) و(العبث) فالإتقان واضح فيما صنعته يد الإنسان والتي نراها في قواعد تلك البيوت المرسومة بدقة هندسية، وأما العبثية فتتجلى فيما فعلته يد الطبيعة في جدران تلك البيوت المتهدمة المتآكلة، واللافت فيها أنها كلها مفتوحة على السماء بلا أسقف تحجب ما يأتي منها من ابتلاء (الحر أو الأعاصير) عمن يسكنها. ومع خلو الغلاف من أي إشارة لوجود البشر ومظاهر الحياة، إلا أننا نلمح في السماء حركة لطيور مهاجرة نحو اتساعات السماء بعيداً عن هذا الخراب.
كما يبدأ الكاتب بعتبة نصية أخرى لكريستوفر شولز تقول: حكاية تبدأ وحكاية تنتهي والأيام تمضي ولا شيء يدوم. موحياً بحركة الحياة وتتابع حكاياتها وحتمية عدم دوام الأشياء على حال.
وباختصار استطاعت العتبات النصية الأولى (الغلاف، العنوان، الإهداء، وقول شولز، توليد استشعار بموضوع الرواية ورؤيتها وبعض من أجوائها.
بناء النص والثنائيات الضديّة:
اعتمد بناء الرواية على الثنائيات الضدية لتقديم منظورها السردي وذلك بدءاً من البطلين الرئيسين زيد (الشرق) ووليم (الغرب)، ثم نجد أنفسنا من خلالهما ندخل في شبكة متداخلة من تلك الثنائيات، (الماضي والحاضر) (الغربة والوطن) (الحَل والتَرحال) (الصحراء والحديقة) (الجدب والخصب) (الفقر والغنى) (الكرم والبخل) (العلم والجهل) ..الخ هذه المتناقضات ولّدت حركة دائبة على امتداد الرواية، نستشف من خلالها أن الحياة كلها رحلة، تحركها وتتجاذبها تلك الثنائيات المتحكمة بمصائر المجتمع، وتجسّد هذا في الخيط الحكائي الناظم للرواية من أولها حتى آخرها، فهي رحلة ذهاب وإياب لزيد بن عثمان بين نجد والكويت، دافعها الفقر وغايتها الغنى والرخاء، وخلال تلك الرحلة التي تمر بحفر الباطن والهفوف وغيرهما من المدن والقرى ثم بالربع والخالي وصحارى الموت وواحات الحياة، وخلال ذلك تبدو جلية كل تلك المتناقضات المتحكمة بحياة ومصائر كل الموجودات بين أقطابها.
وخلال رحلة زيد من الكويت إلى الرياض يقدم الكاتب صورة دقيقة ووثائقية وبطريقة الرحالة عن كل ما يمر به من أسماء للقرى والمدن والنباتات والحيوانات حتى تفاصيل الأسواق والمواسم إضافة إلى التفاصيل البيئيّة بكل ما فيها من تناقضات جغرافية وبشرية، راصداً ثقافة تلك المنطقة بكل ما يعنيه تعريف غرامشي للثقافة بأنها: تدلّ على مجموعة من السمات التي تميّز أيّ مجتمع عن غيره، منها: العلوم والفنون، والموسيقى التي تشتهر بها، والدين، والأعراف، والعادات والتقاليد السائدة، والقيم، وغيرها". ومن ذلك قوله:
" هكذا هي زواجاتنا تهدف إلى ترويضنا للتسلط المجتمعي، وليس لإخضاعنا لسلطان الحب، أو البحث عن ملكوت السعادة". ص118
وفي هذا تحليل عميق لأهم الروابط الاجتماعية وهي رابطة الزواج.
وفي تحليل طبيعة ذلك المجتمع يقول "يغضب بسرعة وينسى بسرعة، الصراخ والضرب أفضل الطرق للتنفيس عن غضبهم، والكرم وذبح الخراف أحسن وسيلة لجبر الخواطر ونسيان غلّهم وتغيير آرائهم" ص117.
وقد يتضمن الوصف نقداً لاذعاً لحالة البؤس والجهل التي عاشها أولئك الناس كقوله:
"في قريتنا لا يوجد مشفى أو حتى مركز صحي أولي؛ ولكن هناك عشرة مساجد للصلاة على من تحين ساعة موته" ص91.
. وضمّن الكاتب روايته أبياتاً شعريّة من الفصيح والمحكي ومن القديم والحديث مما يكشف طبيعة أولئك الناس ونمط ثقافتهم.
كما يضمّن الكاتب خلال تلك الرحلة ثنائية أخرى من حكايات الشرق والغرب، الأولى يرويها زيد والتي كان هدفها استحضار عادات وتقاليد وقيم سكان تلك المنطقة، ليقابلها بحكايات وليم التي تضيف الرؤية الغربية المقابلة لذلك الشرق وتوضح هوس الرحالة والمستشرقين بكشفه واستبطان أغواره. ومع أن تلك الحكايات قدمت الوجه الناصع فقط لسكان تلك المنطقة بشكل خاص وللعرب بشكل عام إلا أن الكاتب بقي موضوعياً في توثيق أخلاقيات ذاك المجتمع فمع كل صفات الكرم والجود والشجاعة والمروءة والوفاء وإغاثة الملهوف التي تضمنتها تلك الحكايات نجد ما يقابلها من قيم سلبية عند البعض كالجشع الذي يسيطر على بعض النفوس ومنهم عم زيد الذي كان طامعاً في سلب أولاد أخيه الأيتام ميراثهم، وشخصية صاحب الدكان الذي يرفض أن يدين محتاجاً لا يملك قوت عياله.
وبهذا فإن الرواية تقدم لنا من خلال هذه الثنائيات وثيقة واقعية عن حياة نجد ما بين الخمسينيات والستينيات وما حصل فيها حيث تبرز الثنائية الأهم وهي التحول من حياة الشقاء إلى النعيم، مسقطاً ذلك أيضا من خلال نموذج زيد الذي عاد من الكويت غانماً غنياً.
رؤى غير مباشرة: إضافة إلى الرؤى والأفكار السابقة والتي جاءت واضحة جلية في سطور الرواية إلا إننا نستطيع أن نلمح رؤى أخرى أشارت إليها أحياناً بعض التراكيب اللافتة للنظر بتفرد الكاتب بها، ومنها أكثر ما جاء في الفصل الأخير الذي كان دعوة لعدم الاستسلام لمصاعب الحياة، والتضحية من أجل تغيير الواقع نحو الأفضل كقوله: قناعتي أنّ المستقبل غير مدون في أي مكان وأنّ المستقبل سيكون ما نصنعه نحن منه" ص189. وقوله: خلف كل قصة نجاح هناك شخص اتخذ قراراً ص188. وقوله: "هناك قول بليد يردده البعض الحاجة أم الاختراع فالقول الصائب هو القدرة أم الاختراع" ص188. كما نقرأ أحياناً رؤى غير مباشرة جاءت بين السطور كالدعوة إلى طلب العلم فهو الوسيلة الأمثل للخلاص لتلك البلاد وليس المال والثروة لأنها مهددة بالزوال في أية لحظة وهذا ما نلمحه في إصرار زيد على تعلم أخيه وإرساله إلى أوربا لذلك الغرض. كما يمكننا القول أن هذه الرواية التي أراد منها الكاتب كما قال الوفاء لأولئك الأسلاف ومعاناتهم التي كانت جسراً لتبدل أحوال بلادهم، هي تنبيه وتذكير لذلك الخلف اليوم، لما كان عليه آباؤهم من عوز فلا تأخذهم حالة العزة بالإثم وبضرورة الحفاظ على ما هم فيه من نعيم، وكان في شخصية أخي زيد مثالاً لإحدى طرق الحفاظ التي يراها الكاتب.
خلاصة القول: رواية الصريم عمل أدبي يفرض بصمته الخاصة من خلال موضوعه وخاصة التوثيقي الذي حفظ لنا الكثير من الأسماء والأحداث الحقيقية التي تضمنتها بيئة العمل في مرحلة ما، كذلك من خلال طريقة بنائه وثنائياته الضدية، إضافة إلى أسلوبه الشائق الذي يمضي بالقارئ عبر رحلة مشوّقة فيها الكثير من الإثارة والمعرفة، ولعلها قد تغنيه عن رحلة حقيقية لتلك المسارات التي سلكها زيد ووليم، كما أضافت الحكايات والاشعار عبقاً من الماضي واستحضاراً معاصراً لأساليب كتب القص التراثي وخاصة ألف ليلة وليلة، كما أننا نستطيع أن نشمّ رائحة احتراق طائر الفينيق وانبعاثه من جديد ولكن هذه المرة من صحارى الجزيرة العربية.

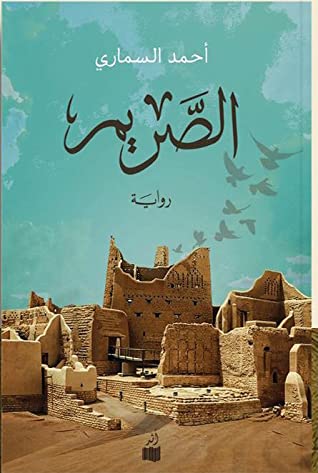



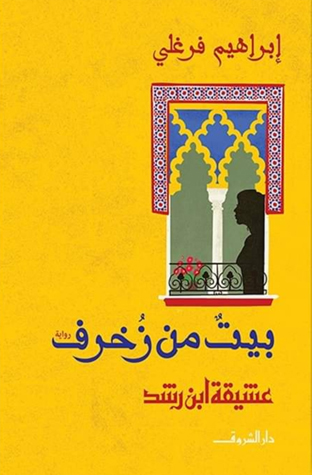


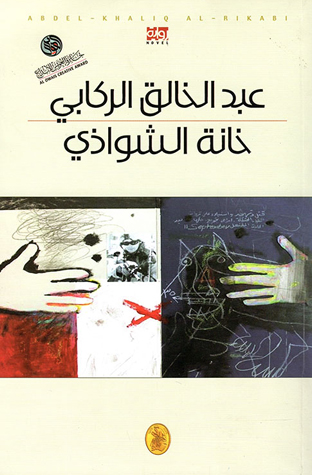

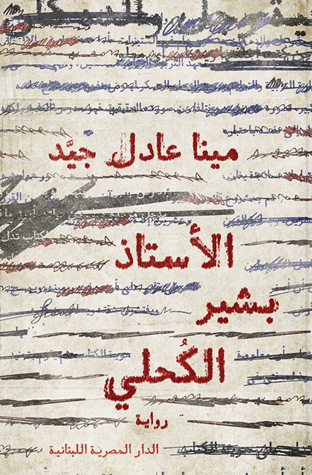

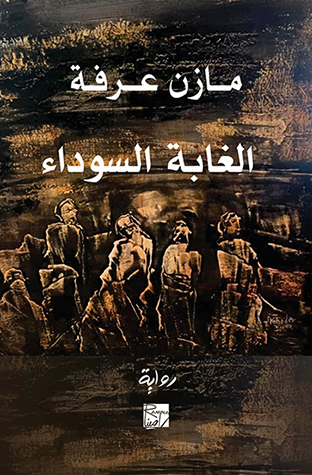


0 تعليقات