جُرأةُ الاختيارِ ومُتْعَةُ السَّردِ في مُوَاجَهَةِ التَّطَرُف
يونس شعبان الفنادي(*)
أُهدٍي مقالتي هذه إلى أستاذي الفاضل/ الحبيب بوزكورة، أصيل مدينة قليبية بتونس ومعلمي بالصف الثاني الأعدادي في ليبيا
مناقشاتٌ حول (الملائكة لا تطير):
أجادت الكاتبة بعث اللهفة فينا وشد عقولنا ومشاعرنا في كل مسارات روايتها الشيقة، وجعلتنا أسرى فكرها بكل ما يتعزز به من تحديات وقوى معرفية، ومفاهيم مستنيرة تعشق الضوء والنهار. إلاّ أننا بكل أسف نجدها قد جعلت نهاية بطلتها "نور" بإقدامها على الانتحار هزيمةً للفكر المستنير الرافض لأشكال التطرف والعنف كافةً، وانتصاراً للتيار الظلامي في تحقيق -على الأقل- بعض أهدافه، وهذا لا يكون منطقياً، وفق غاية وهدف ورسالة الرواية ذاتها، التي ظلت طوال فصولها، صامدة ومتحدية ومنددة بكل ممارسات التخلف والعنف في الفكر المتطرف، ولكنها اختارت في خاتمتها أن تتخلى عن كلّ ذاك النضال والمبدأ والموقف، وتستكين لغايات التطرف، أو تهادنه، أو ربما حتى تقبل به، خوفاً من ذاك المآل الباهض الثمن. فهل كان من الضروري أن تموت "نور" وتغيب بهذا الشكل الدرامي المأساوي لتعطي الغلبة للقتلة الظلاميين وتمنحهم هذا الانتصار؟
أجد أنّ نهاية بطلة الرواية (نور) لو جاءت مفتوحةً سواء بهروبها أو تغييبها، فستجعل الخاتمة قابلة لكل التأويلات والتوقعات الايجابية، عنذاك، في ذهن وخيال القاريء، ولعل من بينها زرع براح من الأمل في حياةٍ بلا تطرف.
أما بخصوص تعاطي الرواية مع "سيف" في فصلها الختامي فقد كان صادماً عندما أبانت الساردة بعضاً من سلوكه الماضوي، وكشفت شذوذه الجنسي من خلال استحضار شخصية "عم الطيب" الذي كان شاهداً على واقعة جنسية مثيرة تنغص على "سيف" حياته (كان يبكي كثيراً كلما اختلى به الغريب يعرف أنه يفعل به أشياء لا تُحْكَى. ويحمد الله على أنه لم يحدِّث بها أحداً، لو فعل سيلازمه عارٌ لن يزول. وقد انتقم الله له فأخذ الغريب، الذي لم يكن سوى جارهم "عم الطيب")(21).
وهنا لابد من التأكيد بكل وضوح بأن "سيف" ليس ضرورياً أن يكون شاذاً أو سكيراّ أو متوحشاً حتى يتبنى الفكر السلفي المتطرف، كما أن خلافنا معه لا يتأسس على نوعية أخلاقه وماضي سلوكه المشين وسوء علاقاته بالناس والمجتمع، بل نحن نعارضه، الآن، في ذات فكره المنغلق المتطرف الذي يتبناه في الوقت الراهن، ويؤمن به، ويفعّله في ممارسات حياته اليومية داخل الأسرة والمجتمع، مما يجعله خطراً عليه شخصياً وعائلته التي تشردت بسببه.
تعرض الرواية في خاتمتها تلميحاً للنفور من الدين بشكل عام، وإن كان خفياً متستراً، وهو ما لا يمكن القبول به، لأنه يتعارض مع منهج التوازن والانفتاح الفكري، والسمو بالعقيدة والتعاليم الاسلامية السمحاء، الذي تأسس عليه مضمون الرواية منذ بدايتها. كما أنه يتعارض مع التركيبة الفكرية الممتلئة باليقين والإيمان بالعقيدة الإسلامية لبطلة الرواية "نور" حيث نجدها تمارس فرائضها الدينية وتؤدي صلواتها (كنتُ أحبُّ أن أصلّي فأُحدِّثُّ الله في صلاتي وأبثُّه شكواي وضعفي. كنتُ، في الحقيقة، أحبُّ ربي لأنني أظن أنه لطيف لا يؤذي البنات الصغيرات وأنه طاهر لن يخلق في عباده نجاسة وأنه طيب لا يؤذي أصدقاءه الأطفال. كنتُ أحبُّ أنْ أسأله لماذا خذلني؟ لماذا ترك أبي يفعل ذلك بي؟ لماذا لم يمنع عني مقص الغريب؟ ومازلتُ لا أدري لماذا يعذِّبُني دائماً بأسئلتي التي لا أجدُ لها أجوبةً؟)(22)، ويتعارض أيضاً مع فكر الكاتبة الأستاذة فاطمة بن محمود وموقفها الديني التي أكدته قائلة (لا أنتصرُ للحداثيين وإن بدوتُ كذلك وإنما حاولتُ أن أنتصرَ للانسان، وفي هذه الرواية لستُ ضد الدين، وهناك من سيفهم ذلك، ولكن كنتُ ضد التفكير المتشدد، وضد العادات الاجتماعية البالية، وضد الجهل المركّب الذي يصنع إنساناً كسيحاً)(23).
إذاً من أين جاءت الساردة بهذا التلميح الانقلابي في خاتمة الرواية؟
ولم تتوقف حالة الإحباط التي صبغت بها الساردة خاتمة الرواية عند ذاك الحد، بل واصلت بث مشاعر الانهزام أمام غول التطرف وقالت في أخر فقراتها (هذه البلاد تحولت فعلاً إلى غرفة صغيرة بنافذة لا تفتح. لا بأس. سأكتبُ هذه الرواية مجدداً، وبعد ذلك سأرحلُ عن هذه البلاد.! الحياةُ هنا لم تعد تطاق.!!)(24)
نهايةٌ صادمةٌ للرواية الشيقة الممتعة تمثل العجز واليأس، والهروب من البلاد والواقع، بعد انهيار كل قوى التصدي والمواجهة. ولكن لابد من التأكيد والتطمين بأن الحياة هنا هي حياتنا .. وتونس لن يتركها التونسيون أبناؤها الخلّص رهينة أفكار هدامة، وأيديولوجيات ظلامية منغلقة. تونس للنهار والخير والمحبة. والحياة ستظل عامرة هنا ... حتى وإن تركتها "نور" وانتحرت، والساردة ورحلت، وكل الشخوص المتخيلة، والقراء كذلك، فإن الأوفياء الذين أنجبتهم الخضراء سينتصرون لها... وسيظلون كما عهدتهم تونس ... لأنهم على ثقة بأنَّ الله لن يخذلهم.. ولن يتخلى عنها.
الخاتمة:
(الملائكةُ لا تطير) نصٌّ أدبيٌّ يحملُ رسالةً فكريةً، ومنجزٌ انسانيٌّ زاخرٌ بالإبداع، وانشغالٌ وغيرةٌ وطنية تظهرها الكاتبة في نصّها السردي الجميل، تزيل به الكثير من الغشاوات عن الوطن والمعتقدات الفاسدة، وتعري السلوكيات والممارسات الفكرية المتناقضة، المتسمة بالانغلاق والاضطراب والعنف، لعدم قدرتها على العيش في النور والهواء النقي الطلق، والتنفس في ضوء الشمس بكل حرية واطمئنان.
أؤمنُ تماماً بأن براعة الحكي التي صاغت هذه الرواية لم تكن استثنائية أو غريبة على المرأة العربية المبدعة، ذاك الجنس الأنثوي الرقيق، والكائن الإنساني النسوي المعزز بالثقة والمثابرة، التي أسستْ ووطَّنتْ المنهج السردي في تراثنا الاجتماعي وأدبياتنا المعاصرة، ممثلاً في حكايات الجدات الفُضليات وعذوبة قصّهنًّ الشيقة، وتطريزهن لفضاء الكلام بالكثير من الجماليات، وقدرتهن على شحن خيالاتنا بالعديد من الصور القصصية الجميلة البارعة، التي لن ينساها جيلنا، وسنظل نعترف لهن جميعاً بإشباع أرواحنا الطفولية البريئة السابحة في عوالم التشويق والجاذبية بفيوض البهجة والفرح والإمتاع.
وبالتأكيد فإننا لن ننسى أنّهُنَّ امتدادٌ زمنيٌّ لشخصية "شهرزاد" الشهيرة التي أطَّرت، منذ البواكير، تقنيات السرد العربي في (ألف ليلة وليلة) وحتى صدور أول رواية عربية في التاريخ المعاصر بعنوان (حسن العواقب) أو (غادة الزهراء) للكاتبة اللبنانية زينب فواز سنة 1899م بالعاصمة اللبنانية بيروت، فكانت هي الرواية الأولى عربياً، تسبق رواية (زينب) للأديب الراحل محمد حسين هيكل الصادرة سنة 1914م بخمسة عشرة سنة، وهو ما يؤكد، تاريخياً، أن المرأة هي رائدة الحكي والسرد والرواية العربية في العصر الحديث.(25)
ولا شك فإن الكاتبة التونسية فاطمة بن محمود هي حلقة أصيلة في تلك السلسلة الإبداعية لمسيرة المرأة العربية المثابرة ومكابداتها وتحدياتها لكل الدروب الوعرة، وظروف المعاناة الصعبة، لإثبات قدراتها على الصمود، وترسيخ هويتها وبصمتها الأنثوبة الخاصة، في التعبير بكل حرية، بصوتها الجريء، عن مشاعرها وقناعاتها وفكرها المستنير، وإحساسها بهموم الوطن، والمشاركة بكل ما تملك من فكرٍ، ومحبةٍ، ورؤى، لتأسيس أركان بنيانه، وتطريز عالمه بالسمو والبهاء والازدهار والجمال والمحافظة والدفاع على مكتسباته التاريخية والحضارية.
كما تؤكد الأستاذة فاطمة بن محمود بمنجزها الروائي المهم (الملائكة لا تطير) أن الروايات النسائية العربية لا تكتب في أغراض ضيقة محدودة مقتصرة على العلاقات العاطفية والأسرية فحسب، بل صار المجال متسعاً للمرأة العربية المبدعة للكتابة في السياسة والاجتماع والعلوم والأغراض والمجالات كافة، وخير مثال هو هذه الرواية (الملائكة لا تطير) التي تبرهن على ذلك بكل إنصاف ووضوح.
(*) أديب وكاتب صدرت له مجموعة كتب أدبية، وصحفي نشر العديد من المقالات في الصحف الليبية والعربية، وإعلامي مستقل من ليبيا أعد وقدم برامج إذاعية مسموعة ومرئية تلفزيونية، يحمل درجة الماجستير في علوم الغلاف الجوي والمناخ والأرصاد الجوية من جامعة ريدينج ببريطانيا. fenadi@yahoo.com
(21) الملائكة لا تطير، ص 281
(22) الملائكة لا تطير، ص 143-144
(23) لقاء مع الكاتبة نشر بصحيفة النهار الكويتية، مصدر سبق ذكره
(24) الملائكة لا تطير، ص 289
(25) انظر: 100 عام من الرواية النسائية العربية، د. بثينة شعبان، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م




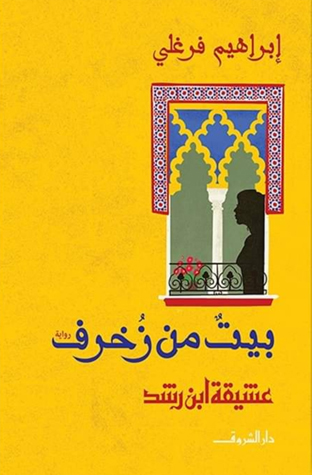


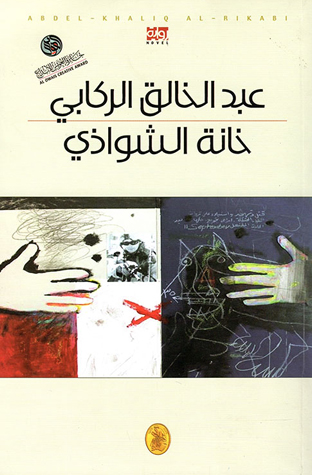

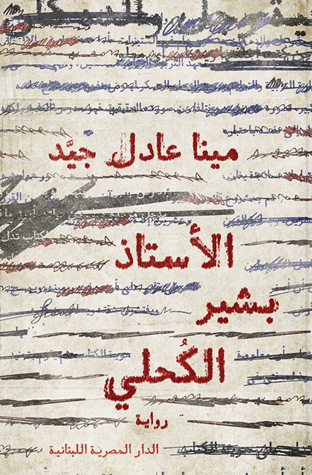

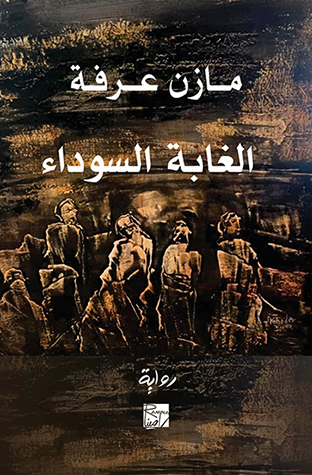


0 تعليقات