وسادة الموت لعبد الحفيظ عمريو.. من التفاعل إلى التداعي، قراءة في التأثيث الفني والفكري
محمد الأمين بحري*
بسرد أفقي (تسلسل أحداث دون تشعب معرفي أوسع من أطوار القصة)، ولغة سليمة إلى حد كبير، تبدو رواية "وسادة الموت" لعبد الحفيظ عمريو، رواية وجودية، تأملية، تميزها كثرة التناص مع مدونات عالمية سابقة، وقد تكون هذه التناصّات عن وعي من الكاتب أو مجرد تقاطع حوادثي عابر دون وعي منه.
أولاً- التفاعل النصي.
*- لعل أول تناص يقابلنا هو تناص أدبي (داخلي= بين نصين أدبيين)، تمثل ذلك القائم بين الراوي شيخ متشرد (اسماعيل) وشاب جامعي مجهول الاسم، وهو المروي له داخل النص، ومحرض الشيخ اسماعيل على الاسترسال في الحكي. يفتتحان النص حين يلتقيان ليلاً دون معرفة سابقة، فيجلسان على كرسي عمومي (في محطة ترامواي وهران)، وهي وضعية تذكرنا في هيكلها السردي بقصة النبي لخليل جبران، حيث يتحدث كل من الراوي والمروي له بصوت داخلي (سراَ) ثم ينتقلان إلى الجهر من في الحديث، كأنما يكملان خارجياً صوت الوجدان الداخلي وهو تماماً ما يحدث في هذا النص، ونقطة التقاطع الثانية مع نص النبي هي حديثهما في الموضوع نفسه (أسرار الإنسان ووجودياته). منذ بداية النصين إلى نهايتهما.
*- أما التناص الثاني فكان من النوع الأسطوري، حيث يحدث في مقدمة الرواية ما حدث في مقدمة أسطورة أوديب (في مسرحية أوديب لسوفوكليس)، حيث تُخبِر النبوءة للملك لايوس بأنه سيلد ابناً ملعوناً سيكون شؤماً عليه، ويكون سبباً لكل الخراب الذي سيلحق مملكته بما فيه مقتله هو. وهو نفس المشهد الذي تفتتح به الرواية حيث تقول تلتقي عجوز عرافة بوالد البطل الراوي (اسماعيل) قبل ولادته، وتخبره أنه سيولد له ابن سيكون شؤماً عليه وسبب ما سيلحقه من خراب.
وبهذا تنفتح الرواية على سلسلة من أفعال إسماعيل وسنسميه هنا: [صاحب الوسادة] التي يحارب بها عدوه الأول؛ وهو الألم البشري، عن طريق كتم أنفاس البشر المستضعفين والمرضى، رأفة بهم، كي يخلصهم من آلامهم ومعاناتهم، وهو لا يفعل ذلك إلا مع أحب الناس إليه، فيقوم بقتل أخته الصغرى منهياً آلام مرضها الذي نخر جسدها فتستريح أخيراً من العذاب وتريه أمها من الشقاء، وكذلك فعل مع أمه، حين أنهكها المرض الخبيث وطرحها أرضاً.
*- التناص الثالث في هذا النص كان أسطورياً أيضاً، لكن هذه المرة مع ملحمة كلكامش، باعتبارها نصاُ وجودياً في موضوعه (صراع مع الموت، وأسئلة عميقة حول جدوى الوجود والفناء).
وهي الأسئلة نفسها التي يطرحها البطل منذ صغره، فتصنع مأساته وحيرته الوجودية، التي تخلخل مكانته في الكون. ويتجسد التناص بكل أوضح؛ في الرحلة التي يقوم بها كلكامش في حربه مع الموت ليصل إلى العالم العلوي للخالدين (جده أوتا نابشتم) ليسألهم سر الخلود، ولا يعبر بين العالم السفلي (الأرض) والعالم العلوي (السماء) إلا عبر الحانة (حيث وجد المرأة سيدوري التي تعظه). ليصل إلى عالم الخلاص الدي قاده إلى الفناء أخيراً.
وهو نفس المسلك الذي اجتازه بطل الرواية (إسماعيل) الذي يرافقنا محملاً بأسئلته، ليعبر إلى العالم الآخر (الخلاص من مأساته في الفصل الثالث= السجن ظلماً ثم الموت)، ولا يعبر إلى ذلك الخلاص إلا عبر الحانة، ولقاء صديقته الفتاة هناك (الفصل الثاني). فسلكت الرواية في فصولها الثلاثة نفس مسلك ملحمة كلكامش في فصولها الثلاثة: 1- الفصل الأول: مرحلة الأسئلة الوجودية الحائرة والبحث عن السر-2- الفصل الثالث: مرحلة العبور إلى الخلاص عبر الحانة حيث يجد المرأة 3- الفصل الثالث الخلاص بفشل المسعى والموت.
وإن كان عدو كلكامش في الملحمة وخصمه في صراعه الوحيد هو الموت، فإن عدو البطل إسماعيل هو الألم الذي يقود إلى الموت.
فكلكامش يحارب الموت بالألم، بينما يحارب البطل إسماعيل الألم بالموت الذي يقود إليه أعز الناس على قلبه (أخته الصغرى مريم، وأمه المريضتان)، وحين يذيقهما طعم الموت عن طريق كتم أنفاسهما بوسادته: [كنت أنام على الوسادة نفسها، لأنها تذكرني بآخر أنفاس شقيقتي، لقد تعلقت بها بشكل يوشك أن يكون غريباً] (ص82)، ويحس بانتشاء النصر على الأم: [هل تعلم أني لما نمت جنبها شعرت بنشوة لذيذة؟.. أجل هي لذة الانتصار على الألم والموت معاً] (ص40)، ألم استطاع وقفه وإيصال المتألمين إلى الراحة والخلاص منه، محدداً موعد الموت، الذي انتصر عليه وجعله ملك يده.
ثانياً- المسار العمودي- التأملات النفسية والوجودية:
يبرز لنا بطل رواية "وسادة الموت" بأسئلته الوجودية الكلكامشية منذ أن كان متعلما في الكُتّاب حيث ظهرت صراعاته مع معلم القرآن، حول خلق الكون وجدوى وجود الإنسان وموته في النهاية: [الموت.. هذا السلطان المتجبر، هو الحقيقة المطلقة التي تتسلى بالجميع، تماماً كما يتسلى الصغار بألعابهم فيرمونها هنا وهناك دون أية مبالاة(...) أليس الموت هو جوهر الوجود؟] (ص48)، لترافقه هذه الأسئلة صانعة مأساته في كل أطوار الدراسة التي أوقفها في المرحلة الثانوية، بعد سجاله العنيف مع أستاذ الشريعة في الثانوية، حول وقضية المصير الفاني للبشر، وعلل وجود الشيطان والدفاع عنه كأول معارض سياسي. وكذا حول الشر المبثوث في الإنسان الذي خلقه الله عليه ثم يعذبه من أجله، إلى غيرها من الأسئلة التي تشكك في جدوى التدين: [لماذا نعبده؟ وهو الخالد ونحن الفانون؟... مادام غنياً عنا فلم نعبده؟ ولم خلقنا ثم يحاسبنا؟] (ص84)، كما يشكك في تفسير القرآن: [كتب التفسير لا تعنيني لأنها لم توفق في فهم معنى النص القرآني، والقرآن أصلاً ليس في حاجة لمن يفسره] (ص84)، وسجالات عديدة بين العقل المتسائل والمشكك والباحث عن اليقين الذي يمثله إسماعيل، والنقل الحرفي الجامد، الذي يمثله شيوخ الدين من معلميه المنغلقين (شيخ المسجد مقران، وأستاذ الشريعة في الثانوية، جلال الدين). وتأتي هده السجالات متفرقة وطويلة في شكل حوارات بين عقل حي متشكك، ونقل ميت لا يتجدد.
والملاحظ أن تيمة الموت المركزية والمكررة، قد صاغها الكاتب في هالات سردية مطولة جداً، تجسد ذلك الصراع النفسي والوجودي الذي بنيت عليه الرواية التي يتحدث عنوانها عن الموت، ويهجس بطلها بالموت التي يسكنه هاجسها الذي تحول إلى وسواس قهري يطارده في زمنه، وحتى في مكانه، حيث إن المكان الأكثر توارداً هو ذلك الطريق المتصاعد من بيته إلى المقبرة التي دفن فيها جميع أفراد عائلته، الذين تحققت فيهم نبوءة العرافة، حيث لعب هذا المخلوق الملعون دور حاصد الأرواح، ليس بسيفه كما تحدثنا الأفلام بل بوسادة ناعمة يكتم بها أنفاس أعز الناس إليه ليخلصهم من الألم عدوه الوحيد. ليوصلهم إلى الموت الذي يشعر بالانتصار عليه.
ثاثاً- المسار الأفقي – الإكراهات الفنية في الحبك والتعقيد
من حيث الشكل السردي، تبدو الرواية بطيئة الحركة، حيث تبدأ بسرد دوراني لا يكاد يغادر موصوفاته، ولا يكاد يبرز فيه أي شيء عدا مقتل الصغيرة مريم على يد أخيها البطل إسماعيل خنقاً بالوسادة، ليتواصل بطء السرد ودورانه في الحلقة نفسها طيلة سبعين صفحة، ولا تتحرك الحداث إلا بعد 100 صفحة، ولا نعرف اسم البطل إسماعيل إلا بعد 175 صفحة، (إشكال في تقديم الشخصيات: مادام قد قرر تسميتها فلماذا أخر تلقيها عند القارئ إلى هذا الحد؟) فيما يبقى اسم المروي له الطالب الجامعي الذي يسمع حكاية إسماعيل، مجهولاً حتى نهاية الرواية.
تبني الرواية حبكتها على مأساة قاتل رحيم. البطل/ الراوي إسماعيل (وهو الشيخ المتشرد) الذي يرى في نفسه المُخلّص من العذاب، حاملاً وسادة الموت التي يخنق بها أخته وأمه لترافقه أرواحهما في كل مكان: سواء في الخدمة العسكرية، أو في السجن 30 عاماً بعد اتهامه ظلماً بقتل الفتاة هاجر ابنة معلمه في الشريعة "جلال الدين"، بعدما وجدها تشتغل في الحانة التي يرتادها. بوهران.
يبدو البطل محارباً أسطورياً حاملاً: وسادته سلاحاً ضد خصمه الألم، وحاملاً أفكاره سلاحاً ضد الجمود الفكري والتدين النقلي الزائف الذي صوره الكاتب بأبشع الحالات، حين جعل ابنة أستاذ الشريعة جلال الدين، نادلة في حانة بوهران. وهي التي هربت من طغيانه وجموده ونفاقه. واستعباده للمرأة بعدما تسبب بقتل أمها، وحرمانها هي من الدراسة وضربها الهستيري المتواصل.
تبدو هذه الحبكة متسلسلة ومنطقية، ومنسجمة، لولا ذلك التفكك الذي أصابها من خلال زرع الكاتب لبعض الصدف التي لم تكن مقنعة ولا مبررة لها على الإطلاق. بل إن تلك المصادفات المزروعة في القصة تبدو مقحمة بتعسف كبير. وصعب التقبل.
كأن يكون البطل إسماعيل جاراً لسارة التي يرتاد معها الحانة نفسها، ليجد أنها تسكن تحته في العمارة نفسها التي ترتكب فيها جريمة قتل الفتاة هاجر بنت معلمه في الشريعة الذي كان سبب توقفه عن الدراسة، وهرجته للقرية. وإذا بالبطل يلتقي بابنة أستاذه ذاك في مدينة وهران، كأنما جاءت من أجله، ثم يجدها تشتغل في الحانة التي يرتادها، بعد أن فرت من منزل والدها الإسلاموي المتحجر.
رابعاً – تداعي البنيات، وإشكالات التأثيث الفني والفكري.
*- اصطناع أقدار الشخصيات/
في ومضة من الذاكرة يحكي لنا البطل الراوي إسماعيل: أنه وبعد توقفه عن الدراسة بسبب نقاش حاد مع أستاذه في الشريعة في شبابه، يهرب من القرية إلى مدينة وهران، ليلتحق فيها بثكنة للجيش، حيث استأنس لحانة منعزلة يحتسي فيها بعض الخمر، ليجد ابنة أستاذه في الشريعة نادلة في نفس الحانة، وبعد أن يتعرف عليها البطل، يرافقها إلى عمارته، حيث تُقتل في نفس العمارة التي يسكن بها، في شقة رفيقته سارة.
هكذا، ودون أن يكلف الروائي نفسه إنشاء مساراً وفضاءً لأقدار شخصياته، اكتفى فقط بجمعهم في فضاء مكاني وزمني واحد ككتلة. مصمتة وبشكل غير منطقي ولا سلس، إذ لا تبدو هذه الأقدار الروائية مجرد مصادفات بقدر ما تبدو واضحة الاصطناع، وكأن الروائي، بعدما جمع أفراد روايته في القرية ذاتها، قام بجمعهم مرة ثانية في المدينة ذاتها. بل وفي نفس الأمكنة والزوايا التي يرتادونها، بصورة فجة تظهر للقارئ وكأن ليس في مدينة شاسعة كوهران غيرهم، وكأن ليس فيها من مكان سوى تلك العمارة التي يقطنونها وتلك الحانة التي يسكنونها، إن انعدام الاشتغال على الفضاء القدري من خلال توسيع الفضاء المكاني، جعل من وهران في الرواية شارعاً واحداً يمتد بين هذه الأماكن الثلاثة فقط، وتسكنها هذه الشخصيات الثلاثة. وهذا منتهى التكلف والاصطناع الذي لم أشعر فيه بتاتاً بأن أقدار الشخصيات، بقدر ما وجدت الروائي يقتاد شخصياته عنوة لنفس الأماكن التي اختزل فيها المدينة، ليصنع مصائرهم عن قرب. ومعلوم أن مشكلة مصائر السرد دوماً في التقارب والضيق الفضائي، بينما تقترب مصائر الشخصيات من تجسيدها السردي عند توسيع الرؤية، ليكون تتقاطع المصائر أكثر تدليلاً. ذلك أن أقدار الشخصيات تتعطل في المساحات والفضاءات الضيقة، وتتطلب صفحات من الرحابة وتوسيع البناء فكرياً وجسدياً، والانتقال الرمزي بين عديد الأمكنة والأزمنة. لأن منطقها، يرتبط بنوع الرواية. فإن كانت عبثية كان عبثياً وإن كانت سيرية أو واقعية فعلى الأقدار أن تنطبع بذلك الطابع.
وهذا الاختلال راجع أساساً، وبشكل واضح، إلى عدم إحاطة الكاتب بالقدرة على صناعة أقدار شخصياته من خلال الفضاءات الجسدية والفكرية والرمزية والمكانية. مما جعل التكلف بارزاً والاصطناع (la simulation)، هو السمة الأبرز لموقعة وإدارة الشخصيات.
*- ارتباك الحبكة- تفاوت ريتم الأحداث والأفكار/
المشكلة الكبرى التي تعانيها هذه الرواية هي عدم التوافق بين سيرورة فكرتها وسيرورة أحداثها، فالأحداث تسير وتتقدم. بينما الفكرة الوجودية للبطل بقيت تكرر نفس الأسئلة والمقولات الحكيمة التي قيد بها الكاتب بطلة وأسره في شرنقتها، مما جعل سير الأحداث يتم في الفراغ.. مادامت فكرة النص وأسئلته الوجودية تدور حول نفسها وتكرر نفسها، من أول الرواية إلى آخرها.. وهذه علة بطء السرد. ونشازه. حينما لا تتوافق السيرورتان "الحدثية" التي تتقدم و"الفكرية" التي تدور حول نفسها وتتجمد في ذات أسئلتها.
*- إغلاق أفق القراءة بتقديم الإجابات التقريرية/
من أكبر عيوب السرد لدى الأقلام الجديدة، هو لجوؤها إلى الأساليب الإنشائية في تقديم إجابات حاسمة عن مسائل فكرية كبرى لم يفصل فيها كبار مفكري البشر وفلاسفتهم، (كالعواطف والمشاعر كالحب والصداقة، والمبادئ كالحرية، والأفكار كالوجود...)
لتجد الروائي يقدم لك الإجابة مباشرة، وكأنه خرج من العمل الإبداعي إلى التنظير وتقرير مصير الكون والأشياء أمام قارئه، يقول الكاتب في إحدى إجاباته القاطعة: [الإنسان هو أول الموجودات التي تسعى لتحقيق الخلود، لأنه ببساطة يخاف الموت.. هذه الكلمة لوحدها كفيلة بجعله يرتعد خوفاً] (ص54)، إنها إجابة تعرض نفسها ونصها للرفض، لأن القارئ قصد النص لتشوقه الإشكالات والأسئلة الإبداعية، لا أن يتم تلقينه إجابات قد تتعارض مع إجابته وفكره. وهنا سيحدث حتماً ذلك الصدام المقيت بين فكر الكاتب وفكر القارئ، وقد يفضي في الناهية إلى طلاقهما عند هذه اللحظة التي قرر فيها الكاتب حسم إجابات عن أسئلة يملك كل إنسان رأيه الخاص فيها.
وتارة أخرى نجد الرواية تقدم إجابات غريبة على أفكار قد يختلف فيها الكل ضد الكل، في قوله: [كل إنسان يخشى الحقيقة، حتى إن البشر يتناسون ويتجاهلون مصيرهم المحتوم] (ص67)، من يمكنه الاتفاق مع إجابة كهذه قد تبدو سخيفة لدى كثير من القراء؟ أو قد تجاوزها الكثير منهم؟ فهل هذه نظرية تخص الجميع؟ أو تعني الكاتب وحده دون القارئ الذي قد لا يتفق معها تماماً؟ وهذا أكبر أخطاء الخطابات التقريرية في السرد أو الشعر أو الفن والأبداع عموماً، حين يلجأ المبدعون إلى تقرير الإجابات وتقديمها جاهزة للقراء الذين قد يرفضونها، وإن رفض القارئ، فكر النص تنازل عنه كفن، وفقد القدرة على مواصلة القراءة لأن ذائقة القراءة تتعارض مع فكرة التلقين، فالكاتب جاء ليُبدع ويُمتع لا ليلقن قراءه الحقائق، ويقدم لهم الإجابات.
وعلينا أن نشير أخيراً بأن تقديم الإجابات، وخاصة الحاسمة منهاـ من أكبر خطايا الإبداع، وأكبر أسباب الخروج منه، وأسباب هجرة القراء لتلك الأعمال الأدبية ونفورهم منها، بينما في الجهة المعاكسة، ستبقى أذهانهم منجذبة ومتعلقة بالنص، كلما طرح عليهم أسئلته وإشكالاته، وتركها معلقة ومفتوحة، لتبقى ترافقهم حتى بعد الانتهاء من قراءة النص بأزمنة قد تطول وقد تقصر. ذلك أن الإبداع في جوهره لم يأت ليقدم إجابات في الحياة لقرّائه، كما تفعل النظريات والقوانين والدساتير والتقريرية، التي تغلق مجال الاجتهاد والتفكير، بل سمي الإبداع إبداعاً بمدى براعته في طرح التساؤل، وصناعة الاستشكال من مُساءلاته للإنسان والكون، وإبقاء علامات استفهام عديدة في ذهن قارئه، التي كلما كثرت زادت حيرته وتعلقه بالنص، كي يجيب عنها كل قارئ بطريقته بشكل مفتوح، وهذا ما يسمى بإشراك القارئ في النص، أما حين تقدم له إجابتك عن كبرى الأسئلة، قد أغلقت مجال النص، وهنا ستصطدم بنوعية فكر هذا القارئ التي قد لا تتوافق أبداً إجابته مع إجابتك، فيغلق النص بدوره كما أغلق النص إجاباته التي قدمها لقارئه. الذي من حقه أن يُسقط الإبداعية عن هذا النص الذي ترك الفن وخرج إلى التنظير والتقرير وحسم إجابات الأصل فيها أن تفتح أكثر وتشرع استشكالاتها، لا أن تغلق. وتحسم المسائل الإنسانية التي تناقضها في النص.
*- خلاصة/
وعموماً فإن رواية وسادة الموت بعيداً عن إكراهات البطء السردي الكبير الذي يبعث على الملل في كثير من زواياها، ومشكلة المصائر التي يشعر القارئ باصطناعها وافتعالها، ومشكلة غلق أفق النص بالإجابات الحاسمة، وتقرير الحقائق الكونية، فإنها رواية مكتملة فنياً رغم هشاشة الكثير من البنيات التي ذكرناها كالتعقيد مثلا، بل تحمل حساً درامياً، ورؤية فكرية وفلسفية، حتى وإن كانت غير متطورة ولا مواكبة لسيرورة الأحداث، ورغم كشفها المعلن عن التوجه الإيديولوجي للكاتب المعادي للتيار الإسلاموي المتكلس، ونزوعه النقلي السلفي، فإنها تتناول عوالم الشخصية الإشكالية، الغارقة في أزماتها الإنسانية، التي ترهن مكانة الإنسان في الكون، وتنقل إليها حيرته الأنطولوجية، ومصيره الأزلي الذي يتقاسمه عبر مسار جدلي مع أبطال أسطوريين طرحوا الأسئلة نفسها وسلكوا عبر المسارات نفسها، لكن كلٌ فعل ذلك بطريقه ووسائل عصره، التي صنع بها الكاتب رواية تصدم القارئ بتناقضاتها العاطفية والفكرية، حيث يعيش الحب بقتل الحبيب، ويعالج الأخت والأم بالموت، ويحصل السلام الفكري والنفسي بالإجرام، وهي حالات سردية صنعت شعرية هذه الرواية، حين أطرتها بمنطق خاص لن يكون صالحاً لغيرها، بمجرد الخروج منها، كأننا حين نقرأ النص أمام تطبيق إلكتروني، يشتغل بحيوية مادام في جهازه، ويفقد صلاحيته فور تغيير هذا الجهاز. وهذا ما يسمى صناعة الشعرية في السرد، حين يخلق الكاتب قوانين خاصة ومنطقاً ذاتياً يُشكِّل بصمة شخصية لنصه، ولا يقبل السير على سواه.
----------------------
*- عبد الحفيظ عمريو: وسادة الموت، دار ميم للنشر- الجزئر، ط1، 2019.
*- محمد الأمين بحري، ناقد وأكاديمي جزائري

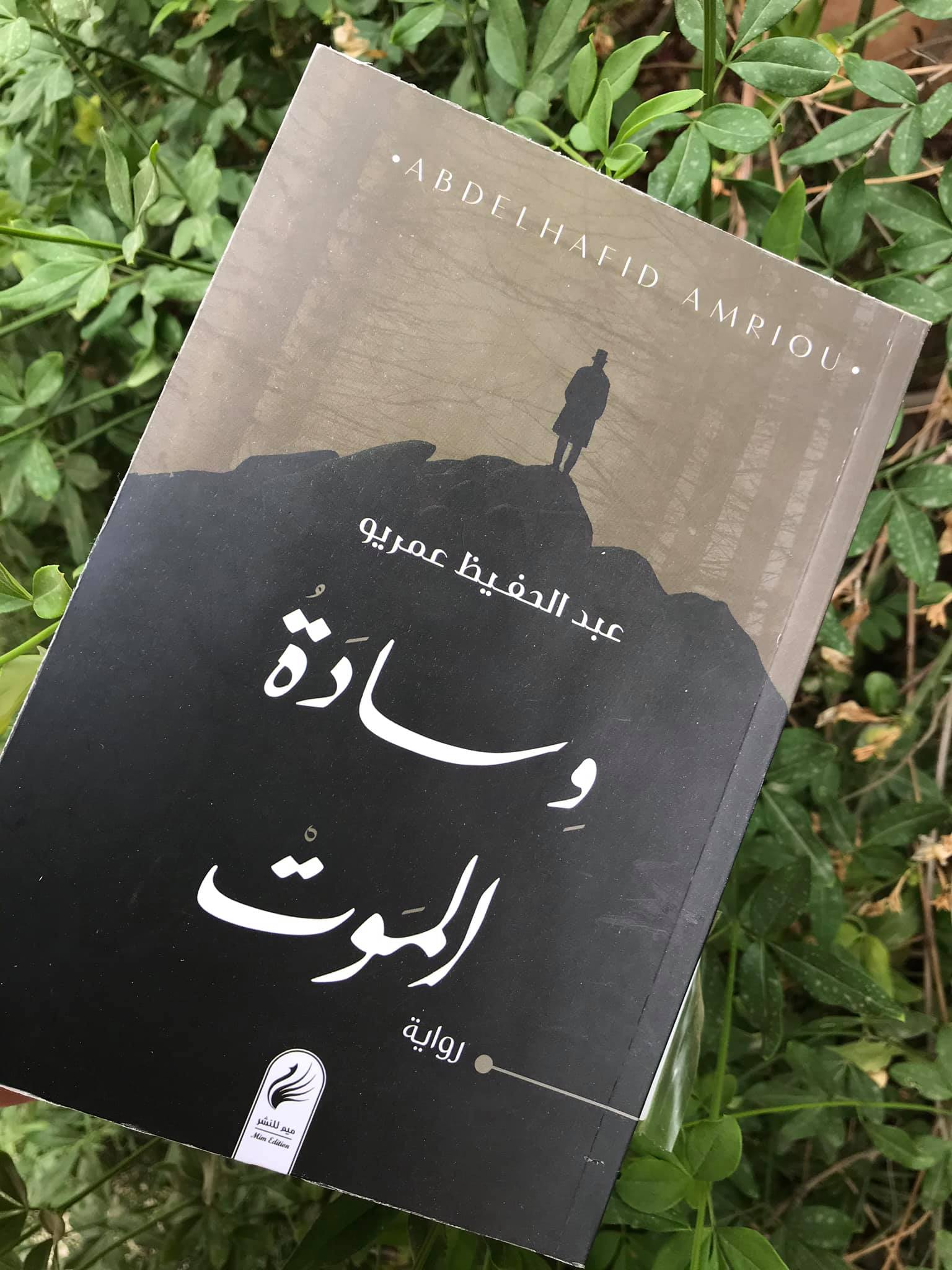


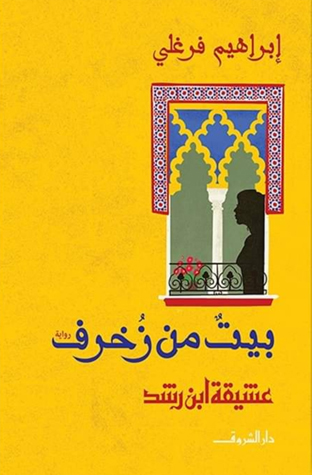


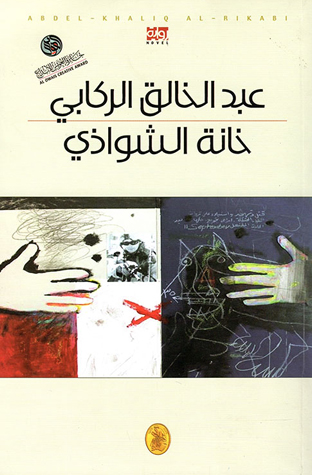

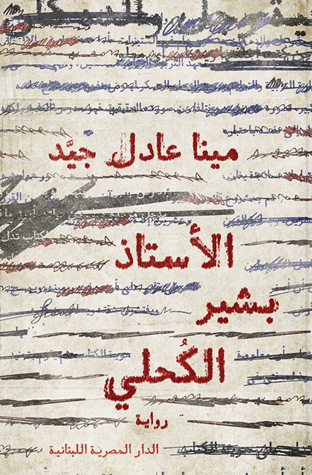

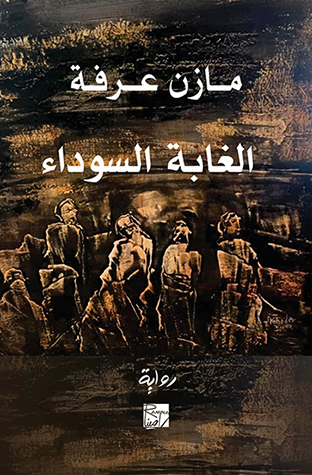


0 تعليقات