ما بين نبوءة المفكر وخيال الأديب.. قراءة تحليلية في "دير الجسور" لميشيل كيلو
زياد الأحمد
عنوانٌ يعجُّ برائحة مأساةٍ، وقهرٍ إلهيّ، ووجعٍ سجين، وكلّ هذا يشفّ عنه التركيبُ الإضافيّ (ديرُ الجسورِ) الذي أُضيفَت فيه كلمة "الدير" بصيغة الإفراد إلى "الجسور" بصيغة الجمع.
فالديرُ مُعْتزَل الدنيا ومُتَعها، والجسورُ معابرُ مضائقِ الحياة وعقباتِها نحو اتساعاتها، فأيّ إله هذا الذي تَتَرهبنُ الجسور له مُجتمعةً في دير مُفرَد، وأيّ سجن سيعيشه البشرُ الذين تترهبنُ جسورُ حركتهم وانطلاقهم؟ وأيّ قهر حينها سيعيشه البشر والجسور في دير... كل هذه الأسئلة تطرحها العتبة النصية الأولى لرواية ميشيل كيلو، والتي تشكل عتبة إغرائية للتغلغل في نصّ تتشابك أدغاله المرعبة، لكنه يتكفل بالإجابة عنها.
ترتكز الروايةُ على الواقع السياسي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين الذي فرضه النظام الحاكم على سوريا، تخترقُ أعماقه برؤيا المفكر المتبصّر، وخيال الأديب المُجنّح، لينسجَ منه عالماً تخييلياً روائياً موازياً له، يمكن تصنيفه في عوالم الواقعية السحرية، فهو يعتمدُ الإيحاءَ ورمزيةَ أسماء الأشخاص والأمكنة والمشاهد الغرائبية والسريالية حيناً، والمباشرة والواقعية حيناً آخر، وليرصدَ من خلال ذلك العالم التخييلي الأسسَ التي اعتمدها النظامُ لفرض وجوده القائم على تغييب مواطنيه، ولينطلق منها إلى رؤيا تنبئيّةٍ تؤكدها ما وصلت إليه سورية اليوم بعد ثورة 2011.
فبعد معركة "الكرامة" مع العدو الصهيونيّ سنة 1968 والتي استشهد فيها عرباوي الجسري، بدأ التخطيطُ لقتل "الحالة العرباويّة" التي كانت تسكن العربي في الستينيّات، وتلخّصها الروايةُ بأن العرباوي:
أكثرنا علماً وأعظمنا أخلاقاً، وأشدنا شعوراً بالواجب الوطني، وتفانياً، ودفاعاً عن حقوق المساكين والضعفاء، وأنه عمل لإخراج "الدير" (مكان رمزي يختصر ما آلت إليه البلاد) من البؤس، ونشر أفكاره في كل مكانٍ قبلَ أنْ يقدّم روحَه لفلسطين.
ولا تخفى هنا دلالة الاسم عرباوي التي تلتقي في جذرها اللغوي مع كلمة عربي، ليراد بها الشمول للمنتمين إلى العروبة.
وبدأ النظام الجديد الذي يرى "جذوره في القيادة لا في الشعب" بتحصين نفسه بجهاز أمني يعتمد الجيشَ والمخابرات خوفاً من هذه الظاهرة، فكان هدفه الأسمى "مواطن بلا مشاعر"
يبدأ الجدار الأمني من فراش الزوجيّة، وحيطان بيت المواطن إلى باصات النقل العام وانتهاء بالتجسس على كبار ضباط الأمن المكلّفين بأمن النظام.
تقارير عن الحالة العرباوية:
نقرأ في القسم الأول من الرواية "تقاريرعن الحالة العَرباويّة" تذكرنا برواية "عشبة ضارة في الفردوس" للروائي والناقد هيثم حسين، حيث اعتمد مبناها التقاريرَ الأمنية التي كان يكتبها رجل الأمن بمنتهى الإخلاص والعبوديّة لمرؤوسية ويتكشّف من خلالها اعتماد النظام القبضةَ الأمنية لإرساء حكمه، وهدفَه النهائيّ المُتمثّل في إذلال المجتمع، وتفتيت نسيجه .. وكما في هذا النص تكون نتيجة إخلاص كتاب التقارير وبالاً عليهم حين تنتهي مَهمتهم، ويُحَوّلون مُتّهمين مخربين لأمن البلاد.
تبدأ الرواية بتلك التقارير الأمنية المُتسلسلة بدءاً من تقرير عنصر مخابرات مندوب "باص القساطل" الذي يتوهم من حديث دار بين راكبين؛ يتحدثان بشكل عفوي عن سوء الأحوال المعيشيّة، وإمكانية الفرج، فيكتب لرئيسه عن اجتماع خطير عُقد بين عسكريين في الباص أحدهما يُظنّ اسمُه "عرباوي"، يخططان فيه لمؤامرة كبرى ضد الوطن، وقد تواطأ معهما زمور سائق الباص الذي كان يتعمد التزمير للتشويش على سماع تفاصيل المؤامرة.
وتتضخم التقارير لتنهيَ بالأمن القوميّ. ويُعتقل كلُّ من يَمتّ اسمه بشبه لاسم "عرباوي" وتُمارس عليهم شتّى فنون التعذيب التي تمعن الرواية في تفاصيل وحشيتها، من جلادين آكاديميين يفخر رئيسهم بأنهم:
"يعمر قلوبهم حقد مقدّس على الأعداء، يحثهم على تهشيم رؤوسهم المُطأطَأة وأعناقهم المحنية، وتستفزّهم استغاثاتهم وتوسلاتهم"
والمفاجأةُ على الرغم من شتى صنوف التعذيب اللاإنسانية أنهم لا يعترفون بشيء، بل يصفهم التقرير بـ
" أنهم واصلوا الاستهانة بحياتهم، وأمعنوا في تحدّينا بصمتهم، شنقناهم وأدخلنا زجاجاتٍ مكسورة الأعناق في مؤخراتهم، ثم ألقيناهم فوق صفائحَ من حديد مُحمى، بقَوا فوقها إلى أن تصاعدت رائحةُ لحمهم المحروق، غير أنّ جهودَنا ذهبت عبثاً."
هذه المقاومة والتحدي بالصمت تذكرنا برواية "صمت البحر" للكاتب الفرنسي فيركور التي كتبت أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، وصورت لنا كيف فرض الاحتلال على الأهالي إقامة الضباط الألمان في منازلهم، ومنهم الضابط "فرانز فون غبرناك" الذي سكن مع شيخ وابنته، ورغم كل محاولاته لإقناعهم بوجوده لكنهما تحدوه بالصمت، ولم يبادلاه أيّ عبارة، وكانت النتيجة أنْ هُزم أمام صمتهما.
وكذلك جلادو النظام الأمني هنا يُقرّون بهزيمتهم أمام صمت العرباويين، وكان تقريرهم النهائي أن " عرباوي كائنٌ بلا ملامحَ أو صفاتٍ أو مشاعر"
ويأتي تقرير الردّ على هذا التقرير النهائي كاشفاً مراميَ النظام الحاكم التي يتغيّاها في مواطنيه، فيؤكد "أن هذا النوع من البشر هو إنجازه الأكبر"، مصرّحاً أنّ مواطنه المثالي مواطنٌ بلا فكر، ولا مشاعر ولا إحساس ولا حواس. فيقول
"كان همنا الوحيد دوماً أن يكون بلا هم، وفكرتنا الأساسية أن يكون بلا فكر، غيابه هو علامة حضوره الفارقة، يحدّق في الدنيا فلا يراها..... فهو كما أردنا له أن يكون: طَهورا ليست عينُه على هذه الدنيا ومتعها الزائلة، بل يعيش في عالم من الخواء الروحي صنعناه له فوجد فيه ملاذه.... لقد وجهنا دائماً بالتركيز على إفراغ حياة المواطنين الخاصة من أي اهتمامات عامة، ليُقلعوا عن التدخّل في ما لا يعنيهم من الشؤون العامة، ويغرقوا في توافه فردياتهم."
واضح أن هذا المواطن لا يختلف عمن أعتزل الدنيا وترهبن في دير بعيد عن صخب الحياة والمشاركة فيها.
دير الجسور:
وفي القسم الثاني تحت عنوان "من تحقيقات العقيد عاصي الخالد في بلدة دير الجسور"، ترسم لنا الرواية وطناً يُختصَر كلُّه في قريةٍ مُغيّبةٍ عن الخارطة لا يَعرف أهلها النهار، تُسمّى "دير الجسور" يكلّف العقيدُ عاصي بمهمة متابعة منشأ الحالة العرباوية فيها.
وإضافة إلى الترميز الذي رأيناه في اسم القرية سنقرأ في هذا القسم ترميزاً لأسماء الأشخاص والأماكن؛ تتضمن إحالات لمنشأ الأسرة الحاكمة، ورجالاتها الذين انحدروا من بيئة فقيرة مضطهدة كانت تتحصن بالأودية والخرافات.
فضابط المخابرات العسكرية "عاصي" يحمل اسمُه تمرداً ضمنيا سيتكشف في نهاية الرواية، واسم قريته الاصلية مزار "الوحش" إشارةً إلى نسبة حكام سوريا قبل أن تكون "الأسد" وقد هربوا من تلك القرية إلى الوادي ومزار الدب من بطش العثمانيين، وفي هذا إشارة إلى طائفة النظام التي تحصنت بالجبال منذ أيام السلطان سليم الأول العثماني، ومن تلك القرية يخرج "حمدان الأبرص" - وكلمة الأبرص تحيلنا إلى ضعف الرؤية في الشمس، وبالتالي قصرِ النظر- ليدفع بشباب الطائفة إلى الجيش والأمن جاعلاً منهم أصحاب نفوذ على البلاد والعباد، وأولهم أهلهم وأخوتهم ليكونوا أعداء لهم..
بعد عودة العقيد من مهمة فاشلة في قريته "مزار الدب" يكلف بمتابعة الحالة العرباوية ودراسة منشئها في قرية "دير الجسور"، ويحمل اسمُها المركب دلالتين، الأولى عبوديّةٌ تتجلى في "الدير" الذي يرمز لاعتزال الحياة والعكوف عن متعها الزائلة والثانية تحرريّة في "الجسور" بصيغة جمع جسر التي ترمز إلى العبور والانتقال فوق عقبات الطبيعة كالأودية والأنهار، ومن اقتران صيغة إفراد (الدير) بجمع (الجسور) نستشف نبوءة طغيان الحالة التحرريّة على العبوديّة، وبذلك تكون دير الجسور رمزاً لما أراده النظام للبلاد من سجن، وفي الوقت ذاته حالة مخاض وانتقال إلى الضفة الأخرى من الحياة الحرة.
 يكتشف العقيد عاصي أن دير الجسور مُغيبة حتى عن الخارطة، موجودة في سجلات خاصة، لا يسمح له بالاطلاع عليها، فحين طلب معلومات عنها:
يكتشف العقيد عاصي أن دير الجسور مُغيبة حتى عن الخارطة، موجودة في سجلات خاصة، لا يسمح له بالاطلاع عليها، فحين طلب معلومات عنها:
"أحد الضباط توجّه إلى خزانة مصفّحة، فتحها وأخرج منها كتاباً فتحه، وأخذ يقرأ فيه بصوت خافت يصعب سماعه، وهو مكب عليه ليحجبه عن أنظاري. وكأنها سر من الأسرار الأمنية
ويعرف بعدها أنها أقرب إلى مَعزِل، تقع على حدود (الدولة المعادية) - بال التعريف العهدية- منسيةً حتى من مياه الشرب، ولكن يُشرف عليها فرع الأمن من فوق تلة "أشبه بنسر يحوم في أجوائها، يوشك أن ينقض في أية لحظة عليها كما ينقض نسر حقيقي على فريسة" بيوتها متراصة لا مساحة للهواء بينها وسقوفها من الصفيح لا يعرف أهلها ضوء النهار، لأنهم ينامونه كلَّه ويخرجون ليلاً للعمل في التهريب الى الدولة المعادية.
والمفاجآت التي سيكتشفها العاصي كادت تدفع به إلى الانتحار، ثم أودت به إلى السجن.
فقد جاء مندفعا بحرصه على سلامة الوطن، وإنقاذه من المؤامرة، التي قد تقوّض أركانه؛ ليكتشف أن الخطر الأصلي على الوطن لا ينبع من "دير الجسور" بل من موطنه هو في "مزار الدب"
سيكتشف أن رؤوس النظام في العاصمة هم وراء إيجاد حالة (دير الجسور) كما كانوا وراء إيجاد الحالة العرباوية، وأن رئيس الفرع ليس إلا جابياً صغيرا لأرباح التهريب مع الدولة المعادية، وزراعة أراضي البادية المخصصة للرعي، يحصلها لسادته الذين لا يستطيع أحدٌ اقتلاعهم من كراسيهم في العاصمة، وهم رؤوس التعامل مع الدولة المعادية.
ويكتشف أن عرباوي الحقيقي الذي تخافه الدولة هو مناضل ضد الدولة المعادية واستشهد في أثناء صدّها في معركة "الكرامة" بالأردن، وقد استبدل بجثمانه جثة معتقل سياسي هو ابن أخيه الذي تمرد على شرائه لأرضهم فطلب من المخابرات أن يؤدبوه ومات تحت التعذيب.
يكتشف أن لا فرق بين شهيد للكرامة استشهد في ساحة النضال ضد العدو الصهيوني، ومعتقل سياسي، فهما شخصان لكن صورتهما واحدة، كما أنهما معاديان لدولتين، لكن نظامهما واحد.
ويكتشف أن "مهمته كضابط أمن تقتصر على منع المواطنين من طرح أسئلة" وليس كشف المتعاملين مع الدولة المعادية.
ويكتشف أن مرشده الروحي:" حمدان الأبرص"، هاديهم الذي أخرجهم من مزار الدب ونشرهم في البلاد ضباط جيش، حولهم إلى رجال أمن لحمايته، وليكونوا أزلاما لنظامه الساعي إلى الحالة العرباوية، ووطن اسمه دير الجسور، وطن يتحول إلى " مزار كبير "، يقبل أناسه "حمدان" ميتاً كما قبلوه وانصاعوا له حياً؟.
وبذلك يكون حمدان قد جعلهم بلا جذور فقد نسف النسيج المجتمعي الذي كان يربطهم بمزار الدب، وجعل من الولد عاقاً لأبيه، ومن العم واشياً بابن أخيه. وتبدو هذه القطيعة مع الجذور الاجتماعية واضحة في إعلان عاصي عدم عودته إلى المزار، وفشل مهمته الأخيرة التي كلف بها هناك.
لكن عاصي الذي خسر منبته ليبني لسادته وطناً اسمه "دير الجسور" سيكتشف العلاقة بين مزار الدب ودير الجسور، ويقينيات حول حقيقة العرباوية التي ستكون رد فعل وتمرد وثورة على ما أسس في مزار الدب:
"أيقن أن التحقيق في العلّة الكامنة وراء العرباوية هو ما يستحق الاهتمام، وأن تفتيشاً جديّاً عن هذه العلة سيتوصل إلى أن منبعها الحقيقي يتخطى "الدير"، إلى جميع أمكنة البلاد، وخاصة منها " المزار "، الموضع الذي جاءت العرباوية رداً عليه "
ويقول مؤكداً هذا الاكتشاف:
"كنت موقناً الآن أن البلاء الأكبر ليس في "الدير"، بل في "المزار"، وإن عرباوياً ليس غير إفراز من إفرازاته الكثيرة المدمرة. فالنظام قد أفرز من المزار ما هو كفيل بتدميره.
ومنه فنجاةُ البلاد لا تكمنُ بالخلاص من الدير أو العرباوية بل الخلاص من منبع البلاء" وإفرازات المزار" تخلصوا من "المزار" قبل ان تتخلص " الدير" منكم !."
ونلاحظ قوله هنا "تخلصوا من المزار" ويقصد بها فكر حمدان الأبرص الذي يقدسه قصار النصر، فالحالة "البرصاوية" ستكون وبالاً على الجميع لأنها في سبيل بقائها لا تفرق بين موال ومعارض، أو بين ابن مزار الدب وابن دير الجسور؛ إذا لم يذعن لها ففي مشهد استحضار العقيد عاصي لأبيه الميّت يقول:
وقال أبي: استغربت أن يدفن أحد أبناء "مزار الدب "في "دير الجسور"؟، ما الفرق بين "المزار" و"الدير"، وبين ابن أخيك وعرباوي؟. لقد قتلتم الأول تحت التعذيب، ثم جئتم به في تابوت حديدي إلى أم عرباوي، وقلتم لها: هو ذا ابنك الشهيد، ادفنيه دون أن تفتحي تابوته.
ويؤكد ذلك نهاية العقيد عاصي حين اكتشف تلك الحقائق فأصبح في نظر النظام عرباوياً يجب التخلص منه فاعتقل باسم عاصي العرباوي.
نبوءات الرواية:
وتتأكد نبوءة الرواية المتجسدة في اكتشافات عاصي من خلال الواقع السوري اليوم:
فعرباوي هو الروح العربية التي كان هاجس النظام قتلها، واستخدم لهذا ثلة من الفاسدين من ضباط الجيش والأمن، وخاصة من أبناء جلدته، ومنحهم صلاحيات لا حدود لها إلا حدود كرسيه، وحقنهم بذهنية المؤامرة التي آمنوا بها، جاعلا من الوطن كلّه مجسماً مختصراً يسمى "دير الجسور" بكل ما تعنيه رمزية هذا الاسم، وطن معتقل الحركة والحلم، مُفرّغاً من محتواه العرباوي والإنساني، لكنّ هذا الوطن هو ذاته الذي سيتخلى عن نصف اسمه العبودي الاعتقالي "الدير" وليثور من أجل النصف الآخر التحرّري "الجسور"
فما تشهده سوريا اليوم حذرت منه الرواية التي كتبت في العقد الأخير من القرن العشرين. فبعد ثورة 2011 سقط القناع عن المتآمر الحقيقي على الوطن والمتعامل مع أعدائه، وهو النظام الحاكم الأبرص القصير النظر، وليس غيره، وكان المفترض أن يًجتثّ من جذوره هو من "مزار الدبّ" لا أن يُجتَثّ الوطنُ من أجل بقائه. فهو لن يتورع عن تقديم البلاد بكل مكوناتها وانتماءاتها وطوائفها موالية قبل المعارضة قرباناً لكرسي حكمه، وهذا ما حدث في سورية، ولا شك في النهاية أنّ الدير ستتخلص فيها من المزار وتحرّرَ جسورَها ليعبر عليها الوطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية نت




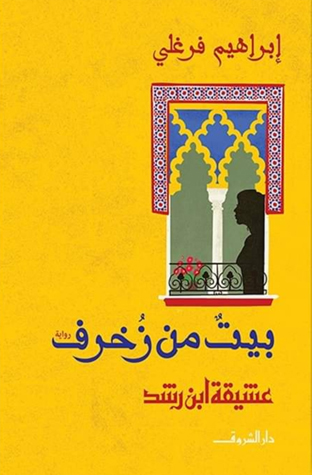


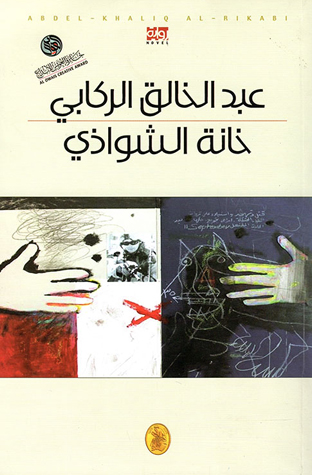

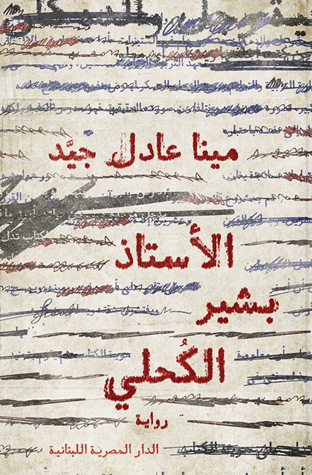

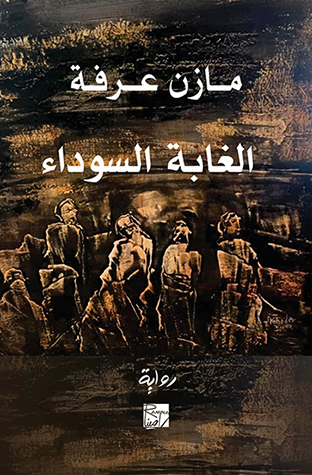


0 تعليقات