خبايا مخيمات اللاجئين في (لاجئة بين زوجين) لمحمود حسن الجاسم
ما بين قصص بديع حقي عن مذبحة دير ياسين، والطين الذي يُغرق المخيمات في قصص غسّان كنفاني، وبين سجون الصحراء في (الآن هنا) لعبد الرحمن منيف؛ تطوّح رواية (لاجئة بين زوجين) بقارئها، وترميه في أجواء تلك الأعمال؛ ليعيش تفاصيل آلامها الإنسانية، ولكن ليس في فلسطين حيث يهرب الناسُ من مجازر الصهاينة الى المخيمات، ولا في سجون شرق المتوسط، وإنما في عالم جديد لا تتجاوز حدودُه أسوارَ مخيَّم (بلا اسم ولا عنوان) من مخيمات اللجوء التي فرضت على الشعب السوري الهارب من بطش النظام الحاكم.
رواية لاجئة بين زوجين هي متابعةٌ من الروائي محمود حسن الجاسم – بعد رواية نزوح مريم – في رصد مأساة الهجرة، وتسليط الرؤية على خفايا عالم المُهجَّرين النفسية الخفيّة، قبلَ المادية والظاهرة، ولتكشف بذلك أفظع تداعيات الحرب على الإنسان الذي تقتلعه رياحها من كلّ جذوره، لترميه عارياً إلى رياح المخيماتُ أشبهَ بشجرة اقتُلِعَت من ترابها، ورميت إلى موت محتّم بطيء.
تُسْرَدُ الروايةُ عبرَ فضاء زمني يمتدّ من أيلول 2012 وحتى الربع الأول من عام 2014 أي العام الثالث للثورة السورية، وتُروى من خلال رؤية خاصة براوية واحدة، لكنها تتقاطع مع منظورات الشخصيات الأخرى لتشمل الهمّ الجَمعيّ للمهجرين، رغم أنها تقدم بشكلٍ أقربَ إلى المذكّرات الشخصية المؤرخة غالباً باليوم والشهر والسنة.
وتمضي الرواية وفق سردٍ متزامن مع الحدث، متسلسلٍ تاريخياً، تربطه علاقاتٌ سببيةٌ، وقلّما يتخلّله شيءٌ من تداعيات الماضي، وتربط بينه حبكةٌ شائقة تمسك بعيني القارئ؛ فلا يكاد يفلت منها حتى نهاية العمل.
تبدأ الرواية من بلدة (أم الحمام) حيث تعيش الراوية (فاطمة أم صفوان) وهي معلمة تحلُم بمتابعة الماجستير في الأدب العربي، كما تحلُم بحَمْل جديد يمسك إليها زوجَها حمزة، ويأتي بأخٍ لوحيدها صفوان، تجاورها رفيقة دراستها وزميلتها في المدرسة (حسنا أم عماد) التي تعود بأصولها إلى قرية (أم الكروم) وإلى أسرة موالية للنظام ومنها زعيم شبيحته (أبو شاهين) ...
تتزلزل تلك الحياة الحالمة الوادعة بحادثة إسقاط الثوار مروحية للنظام؛ كانت تلقي براميلها المتفجرة على (أم الرمان) بلدةِ أهل فاطمة، ويأتي رد النظام في اليوم التالي باجتياح الجيش للبلدة تتقدمه شبيحةُ أم الكروم، وعلى رأسهم أبو شاهين بساطوره، لتُرتَكَب مجزرةٌ مروِّعة راح ضحيتها العشرات من أهل البلدة ذبحاً، ومنهم أخوا فاطمة وأمُّها...
وأمام هواجس رعب مداهمات النظام وشبيحته ومجازرهم التي تتكرر كلّ يوم ما كان أمام الثوار إلا أن يرسلوا بأسرهم إلى مخيمات اللجوء ليتابعوا هم ثورتهم.
وهكذا تبدأ الراوية فاطمة خطوتها الأولى على طريق النزوح بعد أن ودعها زوجها، وأوصاها بولدهما صفوان، واستدار إلى جماعته الثورية تاركاً إيّاها في عهدة أخيه خالد، لتمضي مع القافلة المهاجرة إلى عالم مجهول...
الظاهر والباطن في المخيمات:
قبل أن يهدأ لهيبُ دمامل الأرجل التي أدماها طريق الهجرة إلى ما وراء الحدود؛ تجد فاطمةُ نفسَها مرمية في مخيم يفتقر لأدنى مقومات الحياة.
عالم كل ما فيه يمارِسُ إذلالَه الخاصَّ على المهجرين؛ بدءاً من شربة الماء المصفر كبول الإبل وزحام الوصول اليها، إلى المطبخ الجماعي المقرف، إلى الانتظار المُهين في طابور المرحاض، والتعري في حمام محاصر بالعيون، وصرخات الاستعجال. وكل هذا تحت سياط إهانات الحرّاس والمسؤولين عن المخيم.
حتى الطبيعةُ ولكل فصل منها فنونُ عذاباتِه وإذلالِه؛ الشتاءُ برياحه التي تقتلع الخيام، وأمطارِه التي تغرق المخيّم، وصقيعه الذي يزهقُ أرواح الأطفال، وطينه الذي يغرق الصغار ويهين وقار الشيوخ.
والصيفُ بسَمومه وزوابعه، وقيظه الخانق، وما يحمله من عقاربَ وأفاعٍ وجرذانٍ وقمل وذباب وحشرات وروائحَ حفر مراحيض مكشوفةٍ، وكما تصفه فاطمة:
(نصارع غبار العاصفة بصبر الجمال، تهبّ ذرات الرمال الممزوجة بذرات الغائط المتيبس على أطراف المستنقعات تهب ملحاحة خبيثة تدخل في العيون في الآذان في الافواه ...) ص195
ولكل فصل أمراضُه وآفاته من الجرب إلى الإسهالات وضيق التنفس، وفوق كلّ هذا الغازاتُ المسيّلةُ للدموع التي ترمى لتفريق المحتجين على هذا الواقع، إضافة إلى تهديد المسؤولين والحراس المتغطرسين برمي المُحتجّين خارج الحدود إلى سكاكين شبيحة النظام.
ولعلّ كلّ ما سبق من رصد ظاهري لحياة المخيمات لا يمنح الرواية خصوصيتها، فتميزها يكمن في مقدرة الرؤيا على الغوص في الأعماق النفسية الخفية لحياة اللجوء، وأولها العطبُ الأخلاقي الذي يصيب النفوس هناك، فبعد أن تصف فاطمة تكالبَ الناس على سيارات المعونات وقبولهم الذلَّ والمهانة تقول:
(دوّد ضمير البشر مثلما تدود الفطيسة وتفوح جيفتها .... إن للجوء ثمناً أخلاقياً باهظاً ضريبة، إنسانية وضيعة مؤلمة تسلب المرء قيماً وجدانية نبيلة من الصعب أن تعوّض) ص 83
ثمّ يأتي رصدها لأثر المخيم على سلوكيّات الأطفال وصحتهم النفسية قبل الجسدية، فصفوان الذي كان يتوق لبداية المدرسة أصبح في المخيّم لا يأبه لها، كما أنه أصبح يعود إلى البيت بألفاظٍ بذيئة لم تسمع من قبل. تصفه أمه بقولها:
(بدا عليه حزنٌ يشبه الحقد المجبولَ بحنين محبوس ... يكبت ألمه المتراكم، وفجأة يثور، يبدو عصبي المزاج، حاداً مُتأهّباً للشتائم والمقاتلة، حوّله الواقع المؤلم إلى طفل غريب... بدأ يتردد وينفعل ويرفض ويجادل ... ويخرج) ص 161
ولا تقف الراويةُ عند المظهر الخارجي لزوار النوايا الحسنة والمحسنين الذين يترددون على المخيم، بل تغوص في أعماق نواياهم، تتغلغل في عيونهم التي تتظاهر بالشفقة والألم، لتفضح في دموعهم المشفقةِ لعابَ الذئابِ المتشهيّة لافتراس أجساد النساء السوريات، ولتعرّيَ من خلالهم أولئك المتاجرين بالدين والإنسانية؛ لإشباع غرائزهم الدونية، مستغلين حاجة ومصائب المنكوبين. تقول (دنيا) حين جاءها أحد أولئك الزوّار خاطباً:
(هذا البهيمة أبو عباية يخطّطُ حتى يعبث بي ويلهو، ثم يتركني مع فضلاته، ويعود إلى بلده وهل هذا العجوز النجس يميز ملمسَ الرجل من ملمس المرأة حتى أقْبَله) ص 158
ودنيا لاجئة مطلقة لعوب في أوج صباها، تمور بشبق الحياة وحبّها، وتمتلئ أسى لما وصل إليه السوريون، ولها رؤياها الخاصة فيما أوصلهم إلى ما هم فيه، وطرقها في إذلال من يحاول الدنو منها. وهو ما فعلته بالشيخ (خميس) إذ جعلته يمصّ قدمها بدعوى أنها ملدوغة ...
ولا تنسى الراوية الشيخ خميس وأمثاله من ظواهر فساد مجتمع اللجوء، الذي لم تغفل عنه، فهو واحد من الطحالب المتسلقة التي تنمو ويصبح لها وجودها على قمامة مجتمعات اللجوء، بعد أن يفشلوا في أن يكون لهم شأن يذكر في مجتمعاتهم السليمة، فأصبح منهم السمسار، والشيخ، والوجيه الذي يتكلم باسم الجميع ليسرق وينهب ويحتال كما يشاء.
ولعلّ أهمّ ما يميز هذه الرواية هو تغلغلها في الجانب الإنساني من العالم السريّ للآلام الخاصة بالأنثى، وخاصة التي وجدت نفسها أرملة في أوج صباها مرميةً وحيدةً في ظلمة خيمة وفراش بارد، محاصرةً بذئاب جسدِها وذئابِ المخيّم، وهو ما تسهب فاطمةُ في رصده وخاصة بعد نبأ استشهاد زوجها. فيوماً بعد يوم بدأت الأنثى الكامنة فيها بالتمرد على وحشة الخيمة وظلماتها حتى وجدت نفسَها غيرَ قادرةٍ على كبحها. تقول:
(ذات مرة في آخر الليل على نسيم الربيع تململت الحياة بداخلي، فكرت في خالد، وهو في الخيمة كنت أتمنى أن يهشم الكرفانة فوقي، ويلتهم جسدي، أتشهى، وأتقلّب بآهات محرومة، لم تتركني ولم ترحم، ومن دون تفكير بدأت أعبث بجسدي، أقبض على صدري بألم أغمض عينيّ ثم أتجه إلى الطرف الثاني حتى أغوص في خفايا جسدي، وأخيراً تأوهت وأنا أغوص في امتهان إنسانيتي) ص 160
وما كان أمامها إلا أن فكرت بالزواج من خالد شقيق زوجها، متوهمةً فيه الخلاص من معاناتها، لكن الأمر ازداد سوءاً حين اكتشفت أنه غير قادر على إشباع ما يعتمل داخلها، فإذا بها تنتقل إلى حالةٍ أكثرَ إيلاماً؛ من جلد للذات وإحساس بالخطيئة، وارتكابِ العار الأبديّ، وخاصة حين كانت تتخيل زوجها السابق حمزة، ومما زاد الطين بِلّة وصولُ خبر عن تبادل للأسرى، وبينهم حمزة الذي كان معتقلاً ولم يكن شهيداً كما أُخْبِروا من قبل.
الوصف والتشبيه عماد البنية الفنية:
يلاحظ طغيان الأسلوب الوصفي على الرواية، وخاصة مشاهد وصف الطبيعة التي لم تكن حيادية قطّ، بل كانت منفعلة وتنبئية بالأحداث.
فقبيل مشهد النزوح القسري الذي أجبرت عليه فاطمة يأتي وصف الطبيعة، وكأنها تمهّد وتتنبأ لهم بما سيحدث:
(كان يوم الخميس أواخر أيلول من عام 2012 تلوي الرياح القوية رؤوس الأشجار وتهزها بعنف فتتمايل الاغصان ويبوح حفيفها حزيناً وتتساقط الأوراق مودعة بلا رجعة ....) ص 7
كما كانت الطبيعة عدائية ومشاركاً في عذابات المهجّرين:
(تبدو الخيمة مثل كوخ منسي لحارس حقل من حقول البلدة، تخفق وتهتزّ غاطسة في الطين وكلما ضربها الهواء القارس لطمتْ، وصرخت، وفجأت، تُصدر أصواتا بين العواء والأنين والصراخ) ص65
وتطول صفحات الوصف في نقل الانفعالات، والعوالم الداخلية للشخصيات، ويُبرِّرُ ذاك الطول بأنها تصور عالماً يقل فيه الحدث، ويتكرر ذاتُه في حياة المخيم الروتينية، ولكن تتعدد أبعادُ رؤيته، وأوصافه الظاهرية والخفية. ولهذا سنرى لجوء الراوية إلى التشبيه والتشبيه التمثيلي خاصة؛ لتصوير الحالات المستعصية على الوصف في أعماق النفوس لتَبْرُزَ للمتلقي واضحة جليّة، ويلاحظ أن تلك الصور تستعين غالباً بالحيوانات والحشرات (الكلب – الحمار– البقرة – الجرو -الدجاج – الفأر -الجراد – السلحفاة – الخنفس– الذباب) مما يساعد على تصوير انحطاط الواقع الذي وصل إليه الإنسان، أما مصدر تلك الصور فهو إما من البيئة الصحراوية التي تبتلع المخيم، وإما من الذاكرة المشحونة بأيام الوطن.
فحين تصف فاطمة صراعها بين شهوتها وبين شعورها بالذنب تقول:
(أتكوّر كلصّة جائعة) ص 166، أو (كأنّي ملوثةٌ أغوصُ بزَرق الدجاج في الخم) 185، وتعبر عن احتقارها لنفسها وضيقها (كنت أتعرّقُ، ألهث مثلَ كلبة بيتٍ أم أسعد) ص 194
(وجهي كأنه وجه بقرة مسلوخة لدى الجزار) 208 (شكلي أشبه براعية إبل من العصر الحديث) ص 145
وحين تعبر عن تشاؤمها من الغيم تقول (غيوم أشبه بسحابات جراد) ص 58
وحين تصف برودة خالد تقول هو (كالسلحفاة الكسولة المريضة) أو (تحوّل خالد إلى خنفس صحراوي) و (خالد يرتجف متل فأر خرج من بالوعة) ص 252 و(انسل مثل جرو مهزوم يضع ذيله بين ساقيه) ص 227 أو (كذبابة وقعت في فم خنفساء) ص 257
وفي وصف زائر المخيم دعبول تقول (كأنه حمار مخصي) 143 .
العلاقة بين الروائي وشخصياته:
تمكن الروائي من الاختفاء تماماً خلفَ عالمه التخييليّ، وترك كلّ شخصية من شخصياته تتصرف بكامل حريتها، تلك التصرفات التي جاءت نتيجة طبيعة لمكنوناتها وللظروف التي وضعت، فيها فحمزة لم يكن قاتلاً بل زوجاً وأباً، ولكن رؤية الدم والثأر والنظام هي دفعته ليكون قاتلاً، وانتهى به الأمر إلى قتل أخيه خالد، وواقع الذلّ الذي يعيشه الرجالُ في المخيم حول خالد البارد بطبيعته إلى عنين، إضافة إلى أن فاطمة هي زوجة أخيه، وعُمْر فاطمة وأنوثتها الكامنة الظامئة، وأجواء المخيم وخاصة زعرانه وزواره المتصيدين للنساء إضافة رغبتها بالإنجاب كل هذه المكونات جعلت من رغبتها بالزواج امراً طبعياً.
ولعلّ ما غفل عنه الكاتب في تكوين شخصياته هو عدم الغوص إلى الأعماق النفسية التي حكمت علاقة الزواج بين خالد وفاطمة، ليبرّر أنه من الطبيعي ألا يكون خالد الفحل الذي يملأ فراشها فهو في أعماقه النفسية يدرك أنها زوجة أخيه الشهيد، وكذلك هي لن تجد فيه الرجل الذي تحلم به لإشباع غريزتها؛ لأن وجودها في فراشه سيحرك فيها ذكرى حمزة الذي كان يملأ بقوته جسدها قبل حياتها.
وبمعنى آخر كان سيبدو طبيعياً فشل هذا الزواج لو مُهّد له بالأسباب النفسّية التي كانت تحول بينهما. خاصة وأن عنوان الرواية الذي يُعَدُّ العتبة التنبئية الأولى للنص قد بني على هذا الزواج.
آفاق الرؤية السردية في الرواية:
يلاحظ من عدم تحديد الكاتب أسماء حقيقية للفضاء المكاني لا في البلد المُهاجَر منه، ولا إليه أنه أراد أن يرسم لوحة عامة للجوء، فقد تجاهل نسبة المُهجّرين إلى بلداتهم السورية الحقيقية، مكتفيا بنسبتهم إلى سوريتهم كما فعلت دنيا حين سُئلت: من أي بلد أنت؟ فتهربت من الإجابة واكتفت بالقول (من بلدك سوريا) كما أنه لم يحدد البلد المهاجَر إليه، مكتفياً بأنه مٌخيّم وراء حدود الوطن، وبهذا تصبح لوحة اللجوء لوحة عامة لا خاصة، تروي معاناة تلك الكارثة الإنسانية في كل مخيم بلا اسم ولا عنوان، خارج حدود الوطن بغض النظر عن الدولة التي تحتويه.
وربّ سائل يسأل عن سرّ ذكره في البداية أسماء أم الكروم وأم الحمام وتل الرمان؟ وأعتقد انّ الهدف منها إبراز حالة الاندماج الاجتماعي بين تلك القرى المتآلفة والمتزاوجة من بعضها البعض قبل الثورة، وكيف حولّها النظام بعد ذلك على وسيلة لحرب طائفية أهلية.
ومن جهة أخرى نرى تجاوز الرؤية التي ترصد من خلالها فاطمة الأحداث إلى حقائقَ خفيةٍ وأبعادٍ مستقبليةٍ أحياناً.
فإضافة إلى كون الرواية وثيقة وصفية أمينة متعددة الأبعاد لمخيمات اللجوء، لكنها لم تنسَ أن تُحمّل النظام مسؤوليةَ ما حدث، وذلك من البداية حين كانت مروحيّاته ترمي براميلها المتفجرة على المدنيين.
ومن البداية أيضاً نقرأ تلميحاً إلى تحوّل الثورة من مواجهة النظام إلى حرب أهلية بين البلدات الموالية والمعارضة، فبعد مقتل أهل الراوية في تل الرمان ذبحاً بسكاكين الشبيحة من جماعة أبي شاهين من أم الكروم، نلمح شرارة ذاك التحول في توهّج عيني حمزة، وهو يشاهد الطعنات في جسد صديق عمره وأخي زوجته المهندس عمر، وفي صرخة فاطمة التي تعود إلى بيتها ودماء أهلها تغشي عينيها فتجد صديقة عمرها حسنا؛ قريبة أبي شاهين؛ مستجيرة ببيتها فتقذفها بكومة المفاتيح صارخة:
(أهلك ذبحوا أهلي يا حسنا)
كما أنها لا تبرئ الأطراف التي حرّضت الشعب السوري ثم تخلت عنه ففي حوار بين دنيا واللواتي يحاولن إقناعها بخير تلك الأطراف على اللاجئين، تصرخ قائلة:
(أي خير وهل توريطنا وتشريدنا خير؟ كلاب يهمهم مصالحهم. لك زيارة لبلدانهم يرفضونها وشعبنا تشرد بكل العالم، ولك حتى أسماك البحر أكلت من لحمنا) ص 144
وكما بدأت الرواية بتأكيد المثل القائل ( من خرج من داره قلّ مقداره) تصل إلى رؤية نهائية تقريرية؛ تجزم بخسارة كل الأطراف في هذه الحرب (الكل خسران يا حسنا الكل خسران)ص267، وأن لا بديل عن الوطن، ومنه جاءت خاتمة الرواية كدعوة غيرِ مباشرة لرفض هذا الواقع المذلّ والعودة إلى الوطن الذي ما زالت فيه احتمالات العيش والتعايش قائمة، على الأقل بين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أوبين الجيل القادم من أبنائهم، وهذا ما لمّح إليه الكاتب من خلال عودة فاطمة في نهاية الرواية لتجد (حسنا) لا تزال هناك وكل منهما قد خسرت أهلها مع اختلاف مواقعهم في تلك الحرب، وليتعانق الطفلان (عماد وصفوان)، ويستأنفا علاقتهما ولعبهما من جديد.
وبهذه الرؤية الاستشرافية تتميز الرواية عن الكثير من روايات الحرب السورية التي لم تستطع تقديم أية رؤية مستقبلية تتجاوز واقعَ الحرب، رغم أنها رؤية مشروطة، فلو كان العائد أيّ شاب من شباب المخيم لما استطاع الوصول بوجود النظام الحاكم الذي جرّ جميع البلاد إلى تلك الكوارث حفاظاً على كرسيه.
خاتمة:
قيل إن مهمة الروائي أن يكتب التاريخ المسكوت عنه، أو ما يسقط من كتب التاريخ، واليوم أرى أنّ مهمة الروائي السوري أو من يكتب عن الحرب السورية إضافة إلى المهمة المذكورة أن ينقل ما تعجز عن نقله الأقمار الصناعية، ووسائل الميديا من التفاصيل غير القابلة للتصوير الفوتوغرافي، فتلك الوسائل قد تستطيع إحصاء أعداد الضحايا وخسائر العتاد، لكنها تعجز عن تصوير كَمّ الألم والقهر في صرخة امرأة ترى أهلها قد ذبحوا جميعاً، أو أمّ خسرت أولادها في لحظة واحدة، أو أطفال وجدوا أنفسهم في غمضة عين بلا أبٍ ولا أمّ مرميين في خيمة لجوء...
قد تصور وسائل التكنولوجيا حمرة الدماء وسواد الحرائق لكنها تقف عاجزة أمام لون القهر المترقرق في دمعة ثكلى تطفو على كلّ الألوان.
قد تستطيع تصوير العواصف التي تعبث بخيام النازحين، والطين الذي تغوص فيه أرجلهم لكنها تعجز عن تصوير البرد الذي يسري في قدمي طفل، أو الألم الذي يسري في روح شيخ يسقط في مستنقع ذاك الطين، أو ثقل الصقيع الذي يرقد على صدر طفلة حتى الموت؛ في ظلمة تلك الخيام ...
قد تستطيع تصوير صراع بين جيشين لكنها تقف عاجزة أمام صراعٍ بين الزمهرير الكامن في فراش أرملة حرب وبين السعير المرابض في أنوثتها الطرية.
وكل ما سبق كان في مرمى رؤية رواية (لاجئة بين زوجين) التي وفقت في التغلغل إلى أعماق الألم الإنساني في حياة اللاجئين بشكل عام، والألم المسكوت عنه في حياة الأنثى اللاجئة بشكل خاص.
[1] لاجئة بين زوجين – رواية محمود حسن الجاسم – دار الآداب بيروت ط1/ 2016
الرواية نت

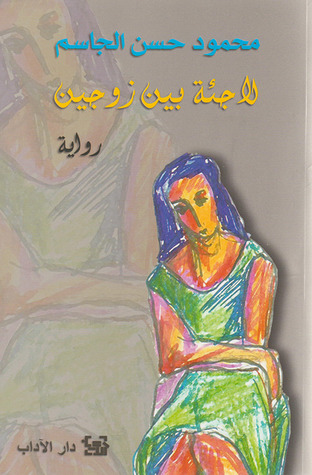


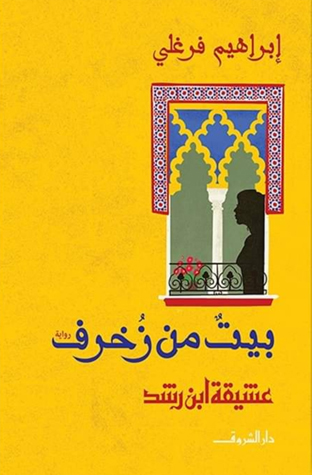


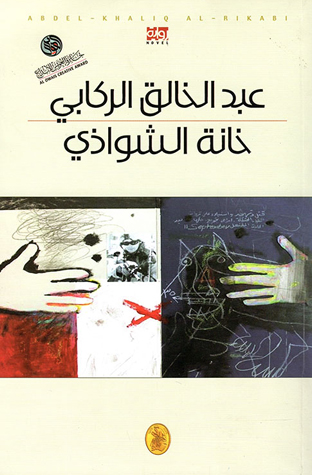

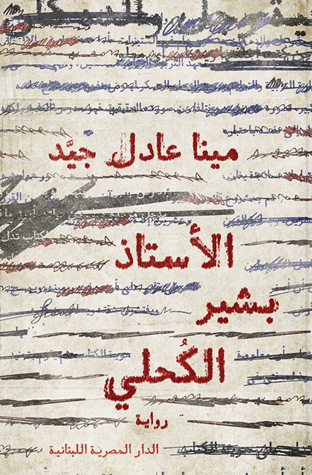

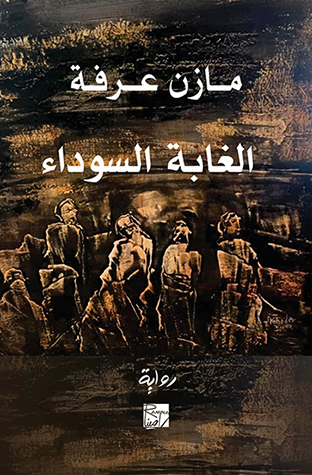


0 تعليقات