رواية الهامش: الكتابة عند تخوم التاريخ
قراءة في رواية "أشباح المدينة المقتولة" للروائي الجزائريّ بشير مفتي أشباح الكتابة: الكتابة هي مواجهة تلك الذاكرة اللعينة، ذاكرة بشر خرجوا من الهامش، من جحيم حيّ ضائع في قلب مدينة مسكونة بالخوف. كما لو أنّ هذا الخوف أزلي، ويدوم إلى ما لانهاية، يستنسخ نفسه بشكل لا نهائي، إنه "العود الأبدي". المواجهة دموية، الكتابة التي لا تمتزج بالدم لن تخرج من هذه المعركة سالمة. ((من أين لي بذلك، والكلمات التي تتكلم داخلي تحتاج أن تمتزج بالدم كي تصل لغايتها المنشودة، وتقول ما سكت عنه الآخرون خشية وريبة)) . الكتابة هي ضد صمت الآخرين، لكنها أيضا ضد الخوف. فالصمت مرادف للخوف من المجهول، من المجرمين، من الجميع، الآخر كما يقول سارتر هو الجحيم. جحيم الحرب الأهلية، جحيم الذاكرة، لمّا يتحوّل الماضي إلى جرح عميق في جسد الذاكرة المريضة. هذا هو مصير الكتابة وقدرها، هو الخروج من الصمت بأيّ ثمن كان، هي إعدام الصمت، وتفجير الكبت الداخلي الذي يرزخ على النفوس مثل وحش مفترس. أشباح المدينة، هم كل هؤلاء الهامشيين الذين يعيشون خارج توقيت التاريخ، ينبعثون من كل مكان ليحكوا حكاياتهم المريرة مع الوجود. هذه الرواية هي بمثابة بانوراما تجمع فسيفساء من الأصوات المكبوتة، تلك التي تريد أن تنفجر في وجه الوجود. السرد يساوي الوجود، أنا أسرد فأنا موجود، إنه كوجيتو السرد. العالم هو كتاب مفتوح على الحكايات، وبقدر ما ينغمس العالم في السرد كلما تهاوت الأسوار بين الحقيقة والوهم، بين التاريخ والخيال، بين الكلي والخاص... عبر الذاكرة، تنبعث الحياة، الموت يعني إعدام الكلمة، لا شيء أفظع من أن تظل الكلمات حبيسة خوفها البدائي من العالم. رواية مفتي تحاول ان تخرج هذه الشخصيات الهامشية من وضعية الكهف، إلى العالم الفسيح، لتواجه أشد كوابيسها رعبا. السرد هو الطريق إلى التجاوز، تجاوز منطقة الظلال المخيفة، إلى العالم الفسيح، عالم مسكون بالألغاز، وبالأسئلة. يطرح السارد سؤالا مهما: (( ولماذا علي أن أكون ذاكرتهم الوحيدة التي تريد أن تصمد أطول وقت ممكن؟ )) . وكأنّ السارد يتحسّس ثقل هذه المسؤولية الموكلة له، مسؤولية أن يكون ناطقا باسم كل هؤلاء الهامشيين. هل سينجح؟ ما الذي يمكن أن يقوله؟ هل ستسعفه اللغة لأن ينزل إلى قعر الألم والضياع، إلى دهاليز حي " مارشي تناش "؟ ثم يضيف: ((ما فائدة ذلك؟)). السؤال يشكّل في حدّ ذاته مأزقا يرهن الكتابة ومستقبلها. ربما السؤال الذي طرحه السارد يمثل ضربة استباق لسؤال سيطرحه قارئ الرواية: ما الفائدة من سرد كل هذه الحكايات؟ ما الذي يمكن أن يضيفه السرد إلى هذا الواقع؟ ما الذي سيضيفه التخييل للذاكرة؟ تتوزّع أحداث الرواية بين مرحلتين، ما قبل الثمانينات، وما بعد الثمانينات. وهذا عبر مسرود الشخصيات. فكل شخصية في الرواية شاهدة على ما يسمى بلحظة التحوّل العميقة في المجتمع الجزائري. من الأهمية بمكان أن تقف الرواية عند مراحل التحوّل، لكن الأساس في كل هذا الكشف عن قانون التحوّل، وآلياته. ما حدث في حي مارشي أتناش أنّ وتيرة الحياة تبدّلت فجأة، وانقلب الزمن الجميل إلى زمن التناقض، زمن الشكوك الكبيرة، مع تفشي ظاهرة العنف الدموي. فضاء الهامشية: الهامش هو عكس المركز، هو الذي يمثّل الأطراف، لا بمعنى التموقع المكاني، بل بمعنى الموضعة الأنطولوجية. الثقافة تأسّست على هذه التراتبية، أي على تقسيم ثنائي للعالم كما تمثّلها العقل الميتافيزيقي الأوروبي الذي موضع مقولاته وفق النظام التالي: عقل/ لاعقل، الخير/الشر، الجمال/ القبح، السيد/العبد، القوي/الضعيف...ومن بين أهم الثنائيات نذكر« المركز/الهامش»، طبعا مع الانحياز إلى الأطراف الأولى التي تشكّل مقولات التأسيس للوجود الإنساني، وهي مقولات التعالي التي تحقّق شرطية الوجود، في حين أقامت الحجّة على الطرف الثاني، لأنه يضم ما يشكّل تشويها لحقيقة الوجود. غير أنّ الفيلسوف الألماني« فريدريك نيتشه» قد آذن بأفول أصنام هذه المقولات، مقولات المركز، ومقولات التعالي لأنّها لا تمثّل إلاّ المنظر المشوّه لجوهر الحقيقة الإنسانية. لقد أطاح «فيلسوف القوة» بمكانة العقل، وأقام عليه الحجّة، وكشف إلى أيّ مدى بلغه العقل من تحريف لوجه الحقيقة، التي لم تكن أكثر من وسيلة في يد أصحاب السلطة والقوّة لتبرير ممارساتهم ومصالحهم الأنانية. كان صاحب كتاب «أفول الأصنام»، و «هكذا قال زرادشت» يؤمن بأنّ الحقيقة مكانها ليس العقل، وليس عالم النظريات والمُثل، بل في العالم الأرضي، والدنيوي الذي لا سلطة فيه إلاّ لذلك الهامش الذي ظل لقرون حبيس ميتافيزيقا النسيان، ويقصد به الجسد، والأحاسيس، والغرائز، وكلّ ما ينبثق منها من تجارب الألم واللذة. لقد دعا إلى ثقافة «ديونيزوسية» كبديل عن الثقافة «الأبولونية»، فالأولى تتخّذ من الفن والجمال خطابها للبحث عن الحقيقة عارية من تشويهات الأخلاق والقواعد الاجتماعية. الهامش هو إخراج الإنسان من السبات الميتافيزيقي، من« نسيان الكائن» إلى الوجود بما هو تعبير عن «إرادة القوة»، عن القيمة بما هي إنتاج لصيرورة تاريخية وإنسانية. في رواية مفتي شيء من هذه الديونيزوسية، فشخصيات رواياته مهوسة بالفن، وبالحياة، وهي متمرّدة على واقعها بكل الوسائل. قد تختلف النهايات، والمآلات لكنّها اتخذت من الحكاية طريقة للوجود. السرد بمعنى الانكتاب داخل تجربة نصية، تتجه خارج زمنها السردي نحو زمن القراءة، زمن التلقي الذي يتعامل مع وجودها كعلامات سيميائية أو كأعراض مفتوحة على حدود تأويلية لا متناهية. أليس هذا ما نبّهنا إليه نيتشه لمّا عرّف العالم بأنّه علامة، وأنّ كلّ حقيقة هي في آخر المطاف نتيجة لعملية تأويلية؟ تتجلّى أيضا هذه الديونيزوسية في هوية الشخصيات الروائية، فهي شخصيات الهامش، عاشت ونشأت وماتت في الهامش. فلا يمكن قراءتها خارج هذه المقولة كحالة مفهومية، وكدلالة أساسية اشتغلت عليها الرواية بحذر. شخصية «الزربوط»، شخصية «والد الكاتب»، «الكاتب»، «زهية»، «الزاوش»، «وردة بن سنان»، «الهادي بن منصور»، «ربيعة»...إلخ. ويشكّل حيّ «مارشي تناش» ذلك الفضاء الهامشي الذي ضمّ كلّ تلك التجارب، حيّ تسكنه عائلات تعيش خارج توقيت التاريخ، وبعيدا عن الأحياء الراقية التي يسكنها أصحاب السلطة. وسنجد أنّ هذا الحيّ كان مفرخة لكلّ الآفات الاجتماعية، ولكل أشكال استلاب الفرد وغربته، وكانت قاعدة لتفتق الوعي المتطرف الداعي إلى الحرب على الحياة. من هنا جاء عنف عنوان الرواية «أشباح المدينة المقتولة». الرواية كنقد للتاريخ: عادت الرواية إلى المراحل التاريخية التأسيسية للدولة الجزائرية المستقلة، ووقفت تحديدا عند مرحلة السبعينات، التي مازالت تشكّل محطة تاريخية للمساءلة حول خيارات الدولة الاشتراكية، ومدى فشلها في إرساء معالم دولة حديثة. وقد رسمت صورة قاتمة عن هذه المرحلة، تتسم بسلطة قمعية تدير شؤون الشعب من أبراجها العالية جدا، وهذا ما يشكّل تناقضا كبيرا في علاقتها بالفكر الاشتراكي الذي يدعو إلى إلغاء المسافات الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة، وأن تكون الدولة في خدمة الجماهير. فما حدث – في واقع الأمر - أنّ مساعي دولة اشتراكية ذات قوة شعبية لم تتحقق بل انحرفت إلى ممارسات بوليسية وقمعية كرّست منطقا ديكتاتوريا وبرجوازيا. لقد مارست الرواية وظيفتها النقدية، أي باعتبارها نقدا للتاريخ، فهي لا تكتفي برصد الحقائق أو نقلها حرفيا لتكون مرآة عاكسة للواقع كماهو، بل تجاوزت هذا المنظور الميكانيكي لدور الكتابة إلى تعرية الحقيقة، وقد مثّل صوت الوالد ( والد الكاتب في الفصل الأول )- وهو رجل ثقافة وكاتب وشاعر في الوقت نفسه - هذه الحقيقة التاريخية، فكان بمثابة الموقف النقدي للمرحلة السبعينية في الجزائر دون أن يستثني حتّى دور الشعب فيما آلت إليه الأوضاع، فكان يقول أنّ الذي يتحمّل وزر هذه الأوضاع ليست الخيارات السياسية التي اتخذها بومدين، لكن الشعب أيضا مسؤول فيما آلت إليه أوضاع البلاد. (( لم تكن الجزائر في سنوات السبعينات غارقة في أوهام تشييد دولتها الكبيرة التي ستفاخر بها العالم فحسب، بل كانت تعيش غارقة في وحل حكم يقود الشعب من فوق، ولا يريد أن يعطي الناس الحق في أن يكونوا كما يشاؤون، ووالدي كان يقول لأصحابه المنشقين والحالمين أن المشكلة ليست في بومدين فقط، ولكن في الشعب)). الأدب والسياسة: امتدادا لما قلناه أعلاه نقف أمام موضوعة أساسية وهي العلاقة الملتبسة بين الأدب والسياسة في واقع سياسي تتحكم فيه قوى سياسية قمعية، لا تقبل بالأصوات المعارضة التي تشكل نشازا وخللا في انسجام المجتمع والدولة. بين السبعينات والثمانينات لا توجد فروقات كثيرة، على الرغم مما يمكن أن تعنيه مرحلة الشاذلي من انفتاح معيّن، لكن ظل الأدب الحداثي والمتمرد مصدرا للإزعاج، وقوة مضادة ومخربة. الأدب الوحيد المسموح به والذي يتم تمويله من أموال الدولة هو الأدب الذي يمثّل الرؤية الأيديولوجية للدولة، الذي يجسّد فنيا مقاربة الدولة لنظام التسيير والحكم، بل وتجميل صورتها، وتقديمها في حلّة هي أقرب إلى التنميط الأسطوري، حيث الدولة بخير، والشعب يعيش في رخاء، والأفكار تتنفس هواء الحرية. في حين أنّ الأدب الداعي إلى التجديد فمكانه هو السجون. كان الأدب الذي يكتبه والد السارد هو أدب ملتزم بالحياة فقط، هو أقرب إلى التأملات الفلسفية في الوجود والحياة، وفي عزلة الكائنات التي تعاني من الغلق. إنه يكتب ذلك الشعر الذي يحاول أن يخترق أسوار السلطة التي فرضتها حول الإنسان الفرد، لقد أحسّ هذا المثقف أنّ فكرة الجماعة، أو الأدب الذي يعبّر عن العامة هو أدب منافق، وأدب رخيص، وأدب متملّق، لأنه يخفي الحقيقة، بل ويزيفها بألوان من الأفكار والقيم الأيديولوجية التي تسوّق في الصورة النموذجية للدولة الاشتراكية أو للدولة العسكرية. فما علاقة اختفاء والد السارد بدخول الجزائر نفق الأزمة الأمنية؟ كان سبب اختفاءه هو ما كان يكتبه من شعر ومن مقالات كانت تأمل في عصر جديد لجزائر ستنفس من هواء الحرية، وتدخل في تجربة ديموقراطية، ولم يكن غضب الجماهير من الشباب العاطل عن العمل إلاّ تعبيرا عميقا عن إرادة جيل خرج من دائرة الخوف ليواجه النظام ويدفع به إلى لعبة التفاوض لأجل إيجاد حل لحالة الاحتقان الاجتماعي. كانت الشرائح الاجتماعية تعاني من الظلم الاجتماعي، ومن القهر السياسي وما نجم عنه من بيروقراطية ومحسوبية وثراء فاحش لفئة من الناس بسبب نهب ثروات البلد وأموال الشعب، فقد بلغ السيل الزبى كما يقول المثل العربي، وبلغت الظروف مبلغا من التدهور. كان على أحد أن يدفع الثمن، ثمن الجرأة، وثمن المكاشفة. لقد عاش السارد هذه التجربة المزدوجة: تجربة اختفاء والده وتجربة الانفجار الشعبي في أكتوبر 88 ودخول الجزائر في أزمات عاصفة كانت نتائجها وخيمة على كل المستويات. وهما التجربتان اللتان صقلتا فيه شخصيته ككاتب، فقد ورث عن والده حب الكتابة، وكان يجد في الكلمات ملاذه للتعبير عن أفكاره وعن مشاعر الآخرين وتجاربهم. النضج كان عنيفا، فقد انفتح الكاتب على الحياة عن طريق العنف: عنف السلطة اتجاه والده، وعنف الواقع المتدني، وعنف الجماهير الغاضبة. من هنا، كان لزاما عليه أن يؤسس لتجربته في الكتابة على مبدأ أساسي هو الانفتاح على الحياة: فالأدب الحقيقي موجود في قصص الناس العاديين الذين يعيشون في الهامش، ويعيشون صراعهم الدائم مع الحياة. لقد أخذ بنصيحة والده الكاتب، وهي ان ينتبه إلى قصص الآخرين، كل إنسان تختفي وراءه حكاية، ومن وظيفة الكاتب أن يقطف هذه القصص ويحولها إلى نصوص أدبية. (( اختفى أبي في نهاية الثمانينيات، وهي الفترة التي سيفتح فيها بلدي على النار والجحيم، والجنون الوحشي والقتل الأعمى، ولكن كل هذه العبارات التي تجمعها من قاموس الليل لن تنفع في الاقتراب من حقيقة ما جرى، وفظاعة ما رأيناه.. أبي قبل أن يختفي كان ينصحني بأن أُجرب الحياة، وأعيش مع الناس، وهو يُردد بصوته الفخم: لا تعزل نفسك عن الحياة والناس...لا تفعل مثلي. هذا خياري أنا مع الكتابة، أما أنت فيجب أن تختار مخالطة الآخرين والتعلم من تجاربهم في الحياة، فكثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات والقصص التي لا يعرفون ما يفعلون بها؟ وأنت يوما ما ستعرف كيف تمسك بها، وتكتبها. ))(ص 31). الجسد واقتصاد السلطة: لقد تحدثنا سابقا أنّ الكاتب قد تفتق وعيه على أشكال من العنف، عنف السلطة السياسية، عنف الواقع، عنف الجماهير الغاضبة. لكن التجربة الحقيقية التي نقلته إلى اكتشاف الوجه الآخر من الحياة هو عنف الجسد. ينشأ وعي الشاب داخل منظومة من الأخلاق والأنظمة الرقابية التي تتجذر في لا شعوره، بحيث يبدو الجسد في عريه وفي رغباته ومطالبه شيئا خطيرا، قد يوقع الإنسان في الذنوب، وقد يحوّله إلى شخص منبوذ داخل المجتمع. منطق الحظر هو الذي يفرض نمطا خطابيا محدّدا لما يتعلق الأمر بالحديث عن الجسد ولاسيما عن الجنس. فالجنس كان منذ القديم وفي كل الثقافات بما فيها الثقافة الأوروبية من الموضوعات المسكوت عنها، أي التي يحظر الحديث عنها، أو الإشارة إليها في خطابات الناس، ظل موضوعا سريا لا يخرج عن حدود غرفة الزوج والزوجة، الأمر الذي جعله موضوعا غامضا، ولغزا من ألغاز الوجود الإنساني، لكنه أيضا بقدر ما يُغلق عليه بالقدر الذي يزداد الفضول إلى الخوض فيه. ومن أجل تجنب المواجهة مع أنظمة الحظر والرقابة الاجتماعية والأخلاقية التجأ الإنسان إلى أساليب كالسخرية او الترميز او التكتم عنه ببساطة، فالصمت هو شكل من أشكال الخطاب عن الجسد. ويبقى الجسد من المناطق الصامتة أو المسكوت عنها في الثقافة العربية، وهي قضية لا تعني فردا بذاته بل هي قضية صمت جماعي. ما يسميه فوكو ( بإقتصاد السلطة ) هو تلك الأنظمة الرقابية داخل المجتمع التي تتحكم في الجسد، وتضبط حركته حتى يكون جسدا طيعا ومنتجا، ولا تتحقق إنتاجية الجسد إلا إذا كان جسدا خاضعا. فالمجتمع ككل، كمجموعة من المؤسسات يحاول أن يمارس سلطته الأخلاقية على الجسد، لكن الغلق ذاته بقدر ما يحاول أن يبني الأسوار العالية حول الجسد بقدر ما يفضي إلى تهيّج خطابي بتعبير فوكو دائما. كتب المفكر الجزائري ( محمد شوقي الزين ): (( الجسد بالنسبة للوعي بالذات كالوثيقة المؤرشفة بالنسبة للوعي بالتاريخ، لأنه يمثّل بؤرة الإدراك بأشياء العالم وبشيئية الوجود وهو احسن وثيقة حية وناطقة الحاملة لذاكرة الزمن و لرسوبيات الخطاب و الفعل والسلوك. وربما الوعي التاريخي للأنا أو الوعي بلحظتها الراهنة يمرّ عبر الوعي بالذاكرة والجسد، بمعنى الالتفات إلى الأمر البديهي المسكوت عنه والمحجوب من فرط وضاحته، أو المستبعد من شدة حضوره. الوعي بالذات سبيله الوعي بالجسد ليس كحكم جمالي دليله إمبراطورية الإشهار والموضة وإنما كبعد وجودي وخُلقي وكوعي بالجسد يتطلب هدم جداريات منيعة أو حدود مفروضة بين التاريخ والأدب او بين السياسة والفلسفة، لأن الحديث عن الوعي التاريخي هو حديث عن السياقات والأفراد أو عن الدورات الحضارية والأبنية العمرانية، بينما الحديث عن الجسد هو إطناب في بلاغة الإحساس واستدعاء لخطابة الممنوع. )) الجسد هو عتبة الوعي بالذات، ببعدها المحسوس الذي من خلاله تتفاعل في الزمن و المكان. الجسد كمكون جمالي يحيل إلى بعد وجودي وأخلاقي. يلعب الجسد دور الوثيقة التي تسجل عليها أحداث الماضي، ولذا، لا يمكن فصل الذاكرة عن الجسد، فالجسد هو السجل الذي يترك الماضي عليه آثاره وحكاياته، وخبراته. ولكنه موضوع صراع بين الفرد والمجتمع، بين حق الفرد في امتلاك جسده والتصرف فيه، وبين إرادة المؤسسة الاجتماعية والأخلاقية في الاستحواذ عليه ومراقبته وضبط نشاطه والتخفيف قدر المستطاع من طاقته. من هنا، فإنّ الجسد كان ومازال يمثّل منطقة الصراع والمقاومة بين الإرادات المختلفة، وسيكون تحرير كامل طاقاته مرهون بهدم الجدارات الاجتماعية والأخلاقية التي تحدّ من حركته. إنّ للجسد خطابه العنيف، عنف الرغبات، وليس الكبت إلا نتيجة لقمع هذه الرغبات، ومحاولة نفي البعد الحسي والغرائزي في الإنسان. الثقافة الإنسانية هي ثقافة قمع الجسد، حتى ظلّ الخطاب على الجسد من الممنوعات الاجتماعية، او من اللامفكر فيه. ما معنى هذا؟ مازال الجسد يمثل صورة الخطيئة، والذنب والخيانة والدنس والفناء، وكلّ هذه الصفات التي تضعه في الهامش، منبوذا ومقموعا. لكن إلى أيّ مدى يؤدي الجسد كلّ هذا الدور الخطير في حجز الإنسان داخل منظومة من الخوف؟ يمكن أن نوضّح هذه العلاقة بين المؤسسة والجسد من خلال شخصيتين: شخصية الزاوش و شخصية زهية: تعيش شخصية الزاوش هذه التجربة مع الجسد، جسده وجسد الآخر، وهي علاقة محكومة إلى قانون الصمت والخوف والرغبة. ( علاقة المراهق بالجسد، والرغبات تبدو دائما كأنها علاقات سيئة فيها شيء من الذنب، رغم أني لم أتلق من عائلتي أي تربية دينية، بل شعرت دائما بأني حر في أفعالي وأفكاري، لكن ذلك الشعور بأنه أمر في غاية الخطورة، ولا يجب أن نتحدث عنه، وجدته بداخلي كما عند غيري من المراهقين في الحيّ، أو المدرسة. موضوع الجسد، والجنس، والرغبات نتحدث عنه بطرافة حينا، وبحذر حينا آخر، ومرات بتكتم كأنه شيء لا يجوز البوح به.. من كان من واجبه أن يشرح لنا تلك الأشياء الغامضة؟ لا أحد، حتى أنا لم أتجرأ على طرح الفكرة على والدي المتعلم والكاتب، وظننت أني أفعل ذلك رغم أنفي لأنها مسألة حساسة ليس لي فقط ولكن للجميع..)) ( ص 45 ). بالنسبة للزاوش فقد أدرك متعة من متع الحياة عبر اختبار تجربة الجنس مع زهية. وهي تجربة جديدة أدخلته عالما من المتعة، أذاقته السلام الروحي والصفاء النفسي والراحة التي لا يعرف لها تعريفا. هل تحرير الجسد هو طريق يؤدي إلى جوهر الحياة؟ هذا ما اكتشفه الزاوش عبر هذه التجربة، إنه يتحدث عن الكبت الجنسي الذي هو بمثابة عبئ ثقيل يحمله ويرهقه ويقف حائلا بينه وبين اكتشاف ذاته واكتشاف الحياة. لقد كان سجين عالم نظري عن الجسد، كما أنه كان سجين نظام اجتماعي فرض حظرا على الجسد والجنس. التصور الذي يملكه عن الجسد ينتمي إلى ما هو عرضي في الوجود، إلى الهامش، فكان الإنسان من خلال هذا التصور هو فقط روح سامية ترقى إلى مصاف الكائنات النورانية التي تعيش بعيدا عن الأرض. الجسد مقترن في المخيال الاجتماعي بالرذيلة وبالذنب وبالخطيئة، لهذا السبب فهو محاط بنظام من الممنوعات والمحرمات، وعلى الفرد إن أراد النجاة أن يتبع طريق الأنوار والروح. في كلتا الحالتين، فإنّ الزاوش كان جاهلا بحقيقة الجسد بسبب وعيه النظري به، وبسبب سلطة المحظور الأخلاقي. كما أنّ هذا الجهل بالجسد يولّد مشاعر الخوف منه، ويخلق في الإنسان الكثير من العقد والصدامات مع رغباته التي لا تجد متنفسا لها. أحيانا الكبت هو نتيجة لصورة خاطئة عن الجسد يحملها الإنسان بكثير من القلق و الريبة. أما قصية زهية، وهي التي كانت مجاهدة أيام الثورة التحريرية، فهي تكشف تحولات اجتماعية حول دور الجسد؛ كان جسدها هو محور قصتها، فقد ولدت عن علاقة غير شرعية، كما أنها وهي صغيرة تعرّضت للاغتصاب، قبل أن تعيش في منزل معلمها الفرنسي، وكان هو الآخر يمارس الجنس معها. مع اندلاع الثورة، لبّت نداء الجبهة، وخاضت الحرب لكن بطريقتها الخاصة، فكان لجسدها الدور المحوري في معركتها، تستخدمه للتجسس على الضباط الفرنسيين وأخذ معلومات حساسة منهم لصالح الجبهة، لكنها في آخر الحرب فقدت حبيبها عمر الذي غاب إلى الأبد لأسباب غامضة، أو بسبب مواقفه المختلفة عن مواقف مناضلين آخرين في الجبهة، وكان الاستقلال بالنسبة لها يمثل مرحلة جديدة مع الوحدة والتعاسة. كانت تعيش وحيدة تلاحقها نظرات الناس المملوءة بالحقد لأنها لا تمثل عندهم أكثر من عاهرة تعيش معهم. لكن لا أحد يتذكر دورها في الثورة التحريرية. ربما السؤال الذي يطرح هو: هل يمكن أن تتصالح الغاية النبيلة مع الوسيلة الدنيئة؟ عنف التحوّل: فقد الزاوش أخته رشيدة بعد أن قررت العائلة تزويجها بالرجل الذي لم تختاره، فكان قرارها أن رمت بنفسها من الطابق الخامس من العمارة. كانت الحادثة الحد الفاصل بين طفولة الزاوش ونضجه القسري بعد أن عاش تجربة عنيفة مع موت أخته. اسمه الحقيقي هو مصطفى، وبعد انتحار أخته صار يميل إلى الوحدة، وإلى تجنب اللعب مع الأطفال، أما علاقته الوحيدة فكانت مع فتاة من الحي تدعى ( وردة سنان ). هذه العلاقة تطورت وأصبحت مصدرا للسلام الروحي عند الزاوش، وكان يشعر في كل مرة براحة وبالحياة تبعث من جديد في أعماقه المنكوبة، بل وأحس اتجاهها بعلاقة حب تنمو في داخله. كان اكتشافه للحب مرحلة جديدة نقلته إلى عالم مختلف، أكثر جمالا وإنسانية. لم تستمر الأوضاع في نسقها الرومانسي، فقد حدث ما لم يتوقعه أحد، إذ تسبب في إعاقة زوج والدة وردة بعد أن حاول إنقاذها منه، ومن دون قصد أسقطه من السلالم فهشّم له رأسه. كان على موعد مع قدره المأساوي. كانت تجربة السجن بالنسبة للزاوش اختبار لمفهوم جديد للوجود مع الآخر، وهو وجود محكوم إلى قانون القوة وفرض السيطرة. عالم السجن هو عالم العنف، وعالم معزول عن الحياة الخارجية العادية. قوانينه غير قوانين الحياة خارجا. لذا، فإنّ العزلة تفرض على السجين التكيّف مع وجود جديد، وابتكار وسائل للمقاومة والاستمرار. كما أنها تفرض أن يترك الإنسان كل شيء خلفه، وينسى ما كانه، وكل ما خلفه من ذكريات، ومن علاقات سابقة. (( حاولت نسيان كل شيء، نسيان الناس الذين عرفتهم من قبل، حتى أفراد عائلتي طلبت منهم أن لا يزورونني، ورسائل وردة سنان التي كانت تصلني في الشهور الأولى بانتظام تركتها على جنب، ولم أعد أقرأها بالمرة، كانت تذكرني بحماقتي وبندمي على بطولتي الوهمية حينما قمت بفعلتي تلك، وتنسى وجودي فوق هذه الأرض، لأني أنا نفسي نسيته، ولم يعد يهمني كثيرا إلى أين ستمضي الأشياء، فأنا في السجن، في ذلك المكان المظلم من هذا العالم، حيث للحياة شروطا مختلفة وقوانين أخرى تضبط الحركة، ولا داعي للتمسك بأحلام باطلة فهنا لا شيء غير الكوابيس القاتلة، وحكايات العنف اليومي المتكررة. )) ( ص 103 ). القانون الوحيد الذي يضمن للإنسان العيش في السجن هو النسيان، عليه أن ينفصل عن ذلك الماضي، ويتبرأ منه من خلال نسف الذاكرة ومحوها. الزاوش رفض التصالح مع ذلك الماضي، لأنّ حياة السجن تعني أنه مقبل على حياة جديدة ومختلفة، وعليه ان ينسى ما كانه، ويفكر في هويته الجديدة، ان ينسى كل ما يربطه بالأصحاب والاهل والصديقة من علاقات. ربما هو الخوف من ذلك الماضي، فليس هناك ما يعذّب الإنسان أكثر من الالتفات إلى ماضيه، والتفكير فيه. الماضي لن يعود، كما أن أخطاء الماضي غير قابلة للتدارك. الزاوش هو ضحية ذلك الماضي، ضحية لبطولة وهمية قلبت حياته رأسا على عقب. من خلال تجربة الزاوش يكشف لنا الروائي بشير مفتي عن الدور الذي لعبته السجون في نضج الحركات الأصولية في الجزائر، التي استغلت الظروف الاجتماعية للمساجين الذين أغلبهم كانوا ضحية للظلم الاجتماعي الذي تمارسه الدولة، فضربت في الوتر الحساس وهو وتر الدين، وشحن النفوس بالدين الذي كان في تلك المرحلة نهاية الثمانينات بمثابة سفينة نوح التي من ركبها نجا من طوفان الفساد. لقد استغل الإسلاميون الأوضاع الاجتماعية والفساد الذي ضرب بأطنابه على كافة طبقات المجتمع في استمالة الشعب، واقناعهم بحلم إنشاء دولة دينية دستورها هو القرآن والسنة النبوية بعد أن فشلت كل الأنظمة التي استوردها النظام لإنشاء دولة الحقوق ودولة الشعب. كما أنهم استغلوا في مآسي الناس العاديين الذين كانوا ضحية أوضاع اجتماعية، وضحية لفراغ نفسي كبير، استطاعوا أن يغيّروا فيهم نظرتهم إلى الحياة، وأنها مجرد متاع لا غير، وأنّ الغنى الحقيقي هو غنى الروح والنفس، وأن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الفلاح هو طريق الله. في تلك الظروف كانت أحلام إنشاء دولة ثيولوجية و أخلاقية تثير اهتمام المواطنين العاديين الذين دخلوا في مرحلة من التدين، وقد عبروا عن إعجابهم بطريقة تسيير الشباب الإسلامي للأحياء، كمراقبة التجار، ودعوة النساء المنحرفات إلى الهداية...لكن سرعان ما تطوّرت الظروف، لتحدث صدامات دموية بين الإسلاميين وشرطة النظام، وقد سميت الحرب بالحرب المقدسة. استطاع مفتي أن ينسج خيوط قصة الزاوش بأسلوب محكم، لكن بكثير من التراجيدية. كأننا أمام تراجيديا من التراجيديات اليونانية القديمة، حيث مصير الشخصيات يُحاك منذ البداية، وهذا تحديدا ما حدث في قصة الزاوش. وردة سينان التي انتشلت الزاوش من الحزن والانطواء، هي وردة سينان التي كان سببا في دخوله السجن، لتكون ضحيته الأولى التي تموت على يديه بضربة خنجر. أي قدر عابث هذا الذي جمع بين الشخصيتين؟ كنتُ أريد أن أعرف إن كان الزاوش ما زال يكن حبا لوردة؟ هل هناك ما يبرر بشكل مقنع إقدامه على قتل من كانت حبيبته قبل أربع سنوات فقط؟ كان قد تأثر بنظراتها قبل لحظات من الإجهاز عليها، نظرات تختزل كلّ شيء، وتقول كل شيء. إنّ التحوّلات التي طرأت على شخصية الزاوش جدّ عنيفة، أحالته إلى شخص مختلف تماما عما كان عليه قبل أربع سنوات. قد يكون الواقع أكبر من أن يتجنب تأثيراته عليه، لكن أن يتخلّص ببساطة بما كان يربطه بالحياة السابقة فهذا ما أسميه انعتاق قسري من الهوية الأولى. لقد أصبح الزاوش رقما أساسيا في الحركات الأصولية، وكان عليه أن يكشف عن ايمانه بالقضية التي يحارب من أجلها، ومحطته الأولى هي قتل وردة سنان. اختبار تاريخي، لكنه يشدنا إلى طقوس التضحية بالقرابين المتجذرة في الثقافات القديمة. الدم هو العقد الذي يجمع بين الزاوش ووجوده الجديد، وعليه أن يتمرغ في الدماء ليكون أهلا للثقة، وليكون أهلا للجنة. مآلات الفن في زمن الموت: استوقفتني جملة صدرت عن شخصية في الرواية تدعى ( الهادي بن منصور ) قالت فيها: (( الفن والحقيقة لا يلتقيان كثيرا، رغم أنّهما يزعمان أنّهما يبحثان عن بعضهما )) ( ص 188 ) والسبب الذي جعل الهادي يخلص إلى هذه النتيجة هو معاناته مع ما يسميهم بشرطة الفن الذين حالوا بينه وبين تحقيق حلمه المتمثّل في إنجاز فيلم يروي حكايات حي مارشي أتناش. فلمّا عاد من المهجر بعد سنوات قضاها في بلغاريا يدرس السينما، اعتقد أنّ الوطن سيفتح له الأبواب أمام أحلامه، لكنه اصطدم بصخرة الواقع، لما اكتشف بيروقراطية الإدارة، وسياسات قمع الفن، خاصة إذا كان فنا هادفا يريد أن يكشف حقيقة الواقع دون زيف و بعيدا عن الخطاب السائد. لقد اكتشف حجم المسافة التي تفصل الفن عن الناس وعن المجتمع، كأنّ مصير الفنان هو أن يظل حبيس أحلامه وأفكاره، وأن يظل فوق ذلك يعيش المنفى القسري. المنفى الذي لا يعني بالضرورة الوجود في بلد أجنبي، لكنه أيضا يحمل دلالة الاغتراب الذاتي داخل المجتمع. اكتشف الهادي أنّ الكثير من المفاهيم الأساسية التي يستمد منها الفن قوته هي في الأعراف الاجتماعية والسياسية مفاهيم منحرفة؛ فالحرية مثلا، يُنظر إليها بأنها انحلال وشذوذ، والفن بأنه تمرد ضد القيم العامة. في هذا السياق، طرح السؤال التالي: (( من يسمعك؟ لا أحد )). هنا تتحدّد علاقة الفن بالمجتمع، وعلاقته بالحقيقة. إنه الخوف من الحقيقة لما تتعرى من كل زيفها أو تتخلص من كل السموم الاجتماعية والأخلاقية لتنكشف سلوكيات المجتمع المنهار إنسانيا عند عتبات فيلم يريد أن يقول الحقيقة، حقيقة ما يحدث داخل الوطن. كلّ شيء محكوم بالموت، حتى الحب لا يعني أكثر من علاقات مشبوهة. قالت شابة في عمر الزهور كان حلمها أن تمثل في فيلم الهادي: (( ربما الحب هو صنيعة خيالنا لا غير )) ( ص 201 ). أما خارج هذا الخيال فمجرد فيافي قاحلة. الأكيد أنّ رواية بشير مفتي ( أشباح المدينة المقتولة ) حاولت إعادة قراءة تاريخ الجزائر منذ الثورة إلى الأزمة الأمنية، من خلال حكايات ناس عاديين ينتمون إلى عالم خفي وغير مرئي، عالم فيه تحاك أنظمة التاريخ، تقول عنفها الذي دُفعت إليه دون إرادتها، كما لو أنّها مجرد دمى مربوطة إلى خيوط خفية، تمثّل أدوارها في مسرح التاريخ، لكنه مسرح العتمة، لا يزوره إلا المنبوذون، والذين سرقت أحلامهم وهرّبت إلى مكان ما. تعددت الحكايات بتعدد الشخصيات في الرواية، لكنها تنتمي إلى نفس الفضاء، وتنتمي إلى نفس المصير، هي في آخر المطاف تحكي نفس الحكاية لشخصيات مختلفة، جمع بينها العنف والبحث عن السعادة، والموت...إنها في الأخير أشباحنا نحن الذين نشبهها، أو تشبهنا، تجول في كل مكان تنظر إلينا وننظر إليها، نقرأ حركاتها لأنها حركاتنا، نقرأ أفكارها لأنها أفكارنا... في الرواية الكثير من التأملات في الجسد وفي السياسة وفي الفن، تنم عن قراءة متأنية لها لكن في سياقها الروائي، حيث السرد يفتح مسامات للسؤال الفكري والسياسي والسوسيولوجي، وكم نحن في حاجة إلى قراءة ذواتنا دون الحاجة إلى كثير من التنظيرات، بل قراءتها على ضوء تشابكها مع التاريخ والواقع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ * أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بجامعة بجاية بالجزائر.
الرواية نت




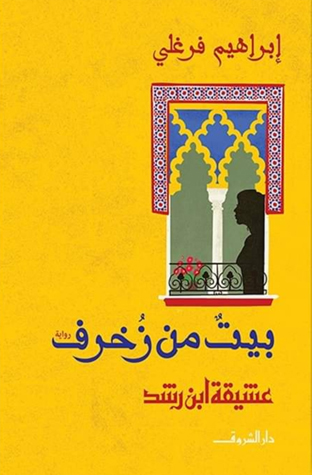


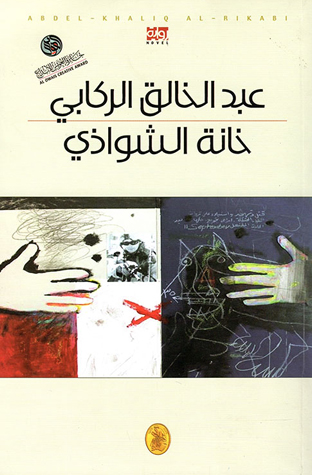

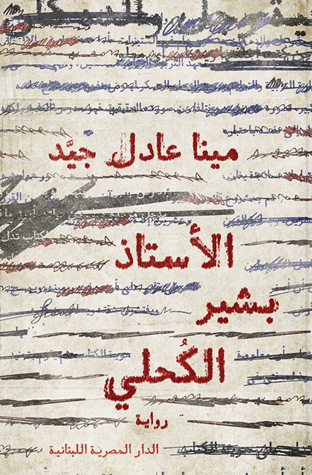

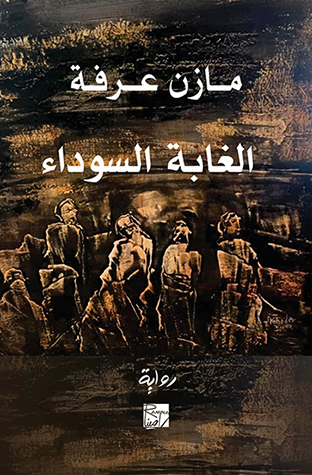


0 تعليقات