جدليةُ الحاءِ في سرديات وفاء عبد الرزاق "رقصةُ الجديلة والنهر"و"حاموت" كأنموذجيْن للدراسة والبحث
حاء المحبّة
وفاء عبد الرزاق قلب مسكون بالوطن، فمهما حاولت أن تكتب شعرا أو نثرا، أو أن تعاقر الحرف باللغة العربية الفصحى أو باللهجة العامية، أو أن تخاطب القارئ عبر القصة القصيرة أو الرواية الطويلة، فإنها لا تبتعد أبدا عن الأرض التي رأت فيها النور وشربت منها فرات المحبة ودجلة العشق. لأنّ كلّ شيء في العراق يناديها وإن بعدت المسافات، فهي لا تقيم فيه بجسدها وإنما هي الروح التي لم تبرحه أبدا. وهذا النداء الملح القوي هو صلاة ترتلها كل يوم عبر كتابتها عن قصة الألم والجرح العميق الذي ينزف منذ سنين بعيدة في جسد العراق العظيم. وإني لأعتقد أن اختيارها هذا لم يأت بدافع حسّ المواطنة والوطنية فقط بقدر ما هو نابع من وعيها التاريخي العميق بأن الأسس الأولى للحضارة والكتابة انطلقت من بلاد الرافدين، بل حتى الحمض النووي للإنسان الأول جاء من هناك وهناك بقي، وهناك تعيث به لليوم فسادا يد الشرّ التي تلاحق تجليات الجمال أينما كانت أو حلّت. لذا، فكتابات وفاء المتواصلة عن العراق، هي كتابة عن الإنسان جملة وتفصيلا، وتأريخ وتوثيق جديد لكل ما يستجد في واقعه اليومي الموشوم بالألم والعذاب، جراء ما يعانيه من حروب أتت على الأخضر واليابس فيه.
حاء الحرب
قرأتُ العديد من أعمال وفاء عبد الرزاق، لكني حينما قررتُ الكتابة عنها بعين النقد وقلم التحليل ويراع الترجمة وقعَ اختياري منذ أزيد من سنة على ديوانها الشعري (من مذكرات طفل الحرب) (1)، هذا الديوان الذي منحني فرصة التعرف إلى وفاء كشاعرة ملمّة بإشكالية الألم وقضاياه، وإذ أقول شاعرة فإني أعني بها الباحثة عن الحقيقة وسط خراب الحروب وجثث الأطفال والنساء والشيوخ، وبين الأشلاء المتناثرة هنا وهناك.. أجل، فوحدها وفاء تعلم أن الحقيقة ترتع بين أحضان الموت في كل تمظهراته. وانتهى عملي نقدا وترجمة على ديوانها (من مذكرات طفل الحرب)، إلا أن صدى نداء رسالتها الفكرية بقي يتردد بداخلي هاتفا بالعديد من الأسئلة التي كانت تتوالد في عقلي باستمرار، ولعلّ أهمها تلك التي كانت تلح عليّ بشدة وتقول: "ترى أين يبدأ، وأين ينتهي حرف وفاء عبد الرزاق؟ ما الذي ترمي إليه هذه الأديبة عبر دواوينها ورواياتها؟ أو ما هي رسالتها الحقة؟ أن تضع حدّاً للحروب على سبيل المثال؟ أن توقف الموت؟ لا أظن أبدا أن هذا هو هدفها، وهي التي تعرف أكثر من أيّ أحد آخر ألا أحد يستطيع أن يوقف الموت ولا حتى الحروب.. وهنا مربط الفرس، لأن السؤال المعضلة الذي لم يستطع لليوم أحد حلّ لغزه هو: لماذا لم يستطع لليوم أحد أن يوقف الحروب؟! إلا أن وفاء عبد الرزاق مذ بدأت الكتابة وهي تحاول بدون هوادة أن تحفر بمعولها في صخرة هذا السؤال، على الرغم من أنها تعلمُ أن الأمر ليس بالهين بتاتا، لكن عزاءها الوحيد سيكون على الأقل في ذاك الزخم المتوهج من الأسئلة الفلسفية واللاهوتية التي ستتركها للقارئ عبر كتاباتها والتي ستساعده بشكل أو بآخر على فهم أو مقاربة جدوى الوجود والانوجاد.
حاء الهُدهد هل سأتجاهل نداءات حرف وفاء المتواصلة وطرق أسئلته في عقلي؟ طبعا لا، فأنا أعرف أن ما من حلّ سوى الاستجابة لمخاض الكلمة بداخلي عبر السعي إلى قراءة المزيد من كتاباتها، وإني أعلم أن الأمر يقتضي صبرا ونفسا طويلا، إذ لا يجدي أن يتعامل المتلقي أبدا مع أعمالها بعين القراءة الاستهلاكية السريعة، أيْ نعم قد تكون بعض من أعمالها لا تتجاوز أحيانا المئة أو المئة والأربعين صفحة، ولا يقتضي منك الأمر سوى جلسة واحدة لتنهي قراءتها كاملة، إلا أنّ هذه الجلسة كفيلة حقا بأن تقضي عليك. إنّ الأمر يشبه تناول وجبة من محار البحر نيئا لأول مرة في حياتك، وبكميات كبيرة، تشرب وتأكل من القواقع نسغ الحياة، ثم تشعر فجأة بالموت يحيط بك من كلّ جانب، وتحتاج لوقت طويل كي تفيق مما أنت فيه من نوبة عسر الهضم أو عسر التفكير، أو لتتحرر من الأسئلة التي تركض خلفك بسياط من لهب. هذا بالضبط ما حدث لي حينما قرأتُ روايتَها الجديدة (رقصة الجديلة والنهر) (2)، لقد احتجتُ لوقت طويل كي أعود إليّ، راجية أن أكون قد لملمت في رحلة العودة هذه بعضا من الخيوط التي من الممكن أن توصلني إلى الإشكالية التي تقضّ مضجع وفاء. لكن قبل ذلك كان عليّ أن أجيب عن السؤال الذي من المفترض أن يطرحه أيّ ناقد أمام أعمالها الروائية: من أين تستقي وفاء عبد الرزاق شخصياتها السردية؟ وفاء ليست فقط كاتبة روائية وإنما هي أيضا صحفية، وهذا يعني أنها هدهد في تواصل مستمر مع الحدث العراقي بشكل خاص، أيْ أنها ملمّة بكل تفاصيل الشأن العراقي بما فيه تلك التي تهتمّ على وجه التحديد بأنباء الحروب وتطوراتها في كل ركن من أركانه، وهذا يبدو جليا في كل كتاباتها، وما من فراغ جاءت كل شخصياتها في رواية (رقصة الجديلة والنهر) مستقاة من وحي واقع الأحداث الأليمة التي عاشها ولم يزل يعشها العراق؛ فريحانة مثلا، لا ضفيرتها مُتَخيّلة ولا حتى هي كشخصية كاملة ومتكاملة، ويكفي فقط القيام بجولة في مختلف المواقع الإخبارية ليتأكد الباحث بأن ريحانة التي تتحدث عنها وفاء عبد الرزاق في روايتها الجديدة هي نفسها المقاتلة الكردية المنتمية إلى وحدات حماية الشعب والمرأة، وصاحبة الضفيرة الشقراء الطويلة، وهي نفسها التي ذبحتها يد الإرهاب فأصبحت بعد استشهادها رمزاً للمقاومة النسائية في (كوباني) وانتشرت صورها في كل المواقع وهي تؤشر بعلامة النصر. وقد قيل عنها إنها تمكّنت من القضاء على 100 مقاتل من التنظيم الإرهابي خلال المواجهات في المدينة. وهذه كلها حقائق تتناصُّ مع كلّ ما جاء ذكرُه ووصفُه في رواية الكاتبة: «ذات خصام قررت التطوع والالتحاق بجيش (البشمركة) والوصول إلى هدفها في قتل أكبر عدد من الإجراميين الذين ظهروا في عالمهم المسالم» (3). وليس هذا فحسب، فالكاتبة لم تكتف فقط بأخذ خميرة سردها الروائي من الواقع اليومي العراقي، ولكنها حاولت جاهدة أن تدعم موقفها هذا من خلال كلمة الشكر التي استهلت بها روايتها قائلة فيها: « شكر وامتنان للأخوين، الصحفي حسن قوال رشيد، والمستشار القانوني والخبير الإعلامي عبد الرضا المالكي، لما أسهما به في البحث عن معلومات ووقائع حقيقية تخدم مصداقية الحدث الروائي»، وهي كلمة جاءت منها لوعيها العميق بما يتعرض إليه غالبا هذا النوع من الفن الروائي، من تزوير لحقائق تاريخية تخص منطقة جغرافية معينة تعيش حالة حرب كونية شرسة ضروس. لا سيما حينما يتعلق الأمر بأحداث لم تزل لليوم تتضارب من حولها الآراء والأقوال، ولم تزل ملفاتها مفتوحة لدى كل الجهات الدولية بما فيها القانونية والسياسية والحقوقية. وهذا أمر آخر يدعو إلى طرح تساؤل نقدي ثان: هل أصابت وفاء باختيارها لتدوين وتوثيق أحداث المقاومة النسائية الكردية السورية وكذا لوقائع فجيعة وجريمة (سبايكر)، ولمجزرة (سنجار) عبر الفن الروائي في هذا التوقيت الحرج بالذات من تأريخ العراق؟ وهل فاتها حقا مراعاة هذا الأمر لا سيما وأنها تعلم أن معظم أهل التأريخ والأدب يرون أنه من الحكمة دائما الانتظار بعض الشيء إلى أن تختمر الأمور ويتمّ تجميع المادة القانونية والتاريخية الكافية للكتابة عن تاريخ معاصر مازالت الدماء تنز من بين ثناياه؟ فمثلا قضية (سبايكر) هي ملف ساخن وخطير للغاية، قيل عنه الكثير والكثير إلا أنه إلى الآن لم يتم الحسم فيه قضائيا بشكل نهائي لتشعب خيوطه وحقائقه. ربّما قد يكون للكاتبة وجهة نظر أخرى خاصة وأنني أعلم أنها لا تُسقط من بالها أبدا هذا النوع من التساؤلات وتحتاط لكل شيء ولا أدل على ذلك من موقفها تجاه ملف جريمة ملجأ العامرية التي وقعت في 13 شباط 1991 إبان حرب الخليج الثانية وضمن عملية عاصفة الصحراء، إلا أن الكاتبة لم تتطرق لها إلا سنة 2006، أيْ بعد مضيّ 15 سنة. وحتى حينما كتبت عن هذا الملف الشائك في ديوانها الموسوم بــ (من مذكرات طفل الحرب)، فإنها اختارت أن تتطرق إليه بقلم الترميز وحبر التشفير(4)، وذلك رغبة منها في أن تجعل منه حدثا خالدا في الذاكرة الجمعية للمجتمع الإنساني بغض النظر عن المكان والزمان الذي وقع فيه، تؤرخ وتوثق من خلاله بشاعة ما يرتكبه الإنسان في حق أخيه من جرائم لا يمكن أن تخطر حتى على بال الشياطين. فما الذي حدث لوفاء يا ترى وهي تنسج حبكة روايتها الجديدة (رقصة الجديلة والنهر)، هل تغلّب الحسُّ الصحفي عندها على حسها الإبداعي كروائية، وبدل أن تكتب روايتها الجديدة بقلم الروائية الشاعرة، كتبتها بلاشعور الصحفية، فجاءت تضج بالأحداث الإخبارية التي تداولتها في الفترة الحديثة من تاريخ العراق العديد من القنوات الفضائية والصحف الدولية في كل ركن من أركان العالم؟! هذا سؤال نقدي لا يمكن الإجابة عنه إلا عبر سؤال آخر: مالذي تغير في حياة وفاء عبد الرزاق، لدرجة أنها وجدت نفسها مضطرة إلى هجر أسلوب الترميز الذي نعته البعض بــ «السريالي» واللجوء بالتالي إلى الواقعية «السوداء»، أي إلى الحكي المباشر عن الحرب وشخصياتها بأسمائها الحقة دون اللجوء إلى أي نوع من الرتوشات أو الماكياج السردي، اللهم في بعض الفصول التي استخدمت فيها بعض التقنيات السردية للتلطيف من أجواء الحروب الخانقة وما يحدث على مسارحها من جرائم يُذبح ويُحرق ويموت فيها الجميع نساء وأطفالا وشبابا وكهولا دونما أدنى تفريق أو تمييز(5)؟
حاء التحرير
للجواب عن كلا السؤالين يجب أولا تحرير صورة وفاء عبد الرزاق الأدبية من كل تلك السلاسل التي لفّها العديد من النقاد حول إبداعها، مع الحرص على تحطيم كل الكليشيهات التي سجنوها بداخلها ناعتين كتاباتها بالسريالية والغرائبية، فأصبحت وفاء تبدو وكأنها قادمة من كوكب آخر وتحكي عن أشياء لا تمت إلى الواقع بصلة، ليس لأن الكتابة وفقا لمعايير المدرسة السريالية أو حتى الغرائبية نقيصة قد يحاسب عليها الكاتب، ولكن لأن الأمر فيه برمته نوع من الإبهام الذي كانت له نتائج وخيمة من حيث تقييم كتابات وفاء عبد الرزاق إلى اليوم كروائية، أكثر منها كشاعرة! إن ما حدث للكاتبة يشبه لحدّ ما تلك المعاناة التي كانت تقاسيها في صمت الرسامة العالمية (فريدا كاهلو) من نقاد عصرها الذين كانوا يصرون على وصف فنها بالسريالي، إلى أن حان الوقت الذي لم تعد الفنانة التشكيلية تتحمل هذا النوع من الحيف الممارس عليها من خلال ليّ عنق لوحاتها فصرّحت في إحدى مذكراتها قائلة بالحرف: «إنهم يعتقدون جميعا بأنني سريالية وغرائبية الفن أو عجائبيته، على الرغم من أنني لم أكن في يوم ما كما يدّعون. أنا لم أرسم ولم أستق شيئا من خيالي أو أحلامي. كلّ ما في الأمر أنني كنت أرسم واقعي وحياتي» (6)، ووفاء عبد الرزاق هي الأخرى لم تكتب إلى اليوم سوى عن حياتها من وجهة نظرها الخاصة. لا سيما وأنه يحدث في كثير من الأحيان أن يكون واقع المبدع المعيش عامة أشد «سريالية» من «السريالية» نفسها، إلا أنه ثمة فنانون وروائيون يتعاملون مع الجانب الغرائبي في حياتهم بعين الواقعية، ووفاء هي من هذه الشريحة من المبدعين. ففي (رقصة الجديلة والنهر) مثلا قيل الكثير والكثير عن الضفيرة والنهر، في حين أن الجديلة الشقراء الظاهرة بوضوح في غلاف الرواية، ما هي حقيقة سوى جديلة البطلة ريحانة، أما النهر، فهو دجلة الذي سيبقى الشاهد الأبدي على كل ما حدث في العراق من جرائر وجرائم كانت أبشعها إلى اليوم جريمة (سبايكر) التي راح ضحيتها طلاب بعمر الورود توضّأ دجلة بدمائهم وتعطّر بعنبر استشهادهم بين أحضانه: «ألم ترقصن معي للنهر حين رقصت الجثث في (سبايكر) واحتضنتها الأمواج» (7). وهنا ينبع سؤال نقدي آخر لابدّ من طرحه الآن: إذا كانت وفاء عبد الرزاق تستقي أحداث رواياتها ودواوينها من واقعها المعيش، ولا شأن لها بالمدرسة السريالية فما الذي دفع العديد من النقاد إلى الإجماع على سريالية كتاباتها؟ ثمة احتمالان لا غير؛ فإمّا أنهم يخلطون بين ماهو سريالي وواقعي، وبين ما هو سريالي وغرائبي أو عجائبي، وإمّا أنهم رأووا حقا في كتابات وفاء عبد الرزاق من العناصر ما يؤهلها لأن تكون «سريالية» بامتياز، أو عجائبية بشكل لا مجال فيه للشك أو الريبة! في رواية (رقصة الجديلة والنهر)، ثمة من سيرى في توظيف الكاتبة لعنصر الحركة البرزخية للأجساد النورانية لكل من «سيدة السنابل» (8)، والمقاتلات الكرديات بعد استشهادهن (9) عنصرا سرياليا أو عجائبيا، على الرغم من أنّ الأمر ليس فيه أيّ شيء مما يدعو إلى تصنيفه بهذه الطريقة، ذلك أن السريالية لم تكن تعني في يوم من الأيام الالتحام بالحقائق التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها بالعين المجردة، وإنما كانت توجه عينها المجهرية أكثر إلى كل ما له علاقة بلا شعور الإنسان ومنطقة الأحلام لديه، وفي كثير من الأحيان كانت السريالية ولم تزل تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة والتصورات الخيالية، ناهيك عن أنها حينما انطلقت بعد الحرب العالمية الأولى في معظم الدول الغربية أعلنت عن نفسها كمبدإ غير ملتزم بالأديان، ولا بالمعتقدات أو القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، ممّا أدّى به سريعا إلى الانكماش والتقوقع بعد ربع قرن من نشوئه، وشعر دعاته بعجزهم عن تحقيق أي هدف، وبعقم ثورتهم ضد القيم والأديان، وإخفاقهم في شرح إشكاليات الوجود ومعضلاته الكبرى كالشر مثلا، والموت، والمرض، والحروب. وإني لليوم لا أستطيع حقا أن أستوعب لماذا يصرّ الكثير من النقاد العرب على استيراد منظومات فكرية كاملة فشلت وماتت منذ زمن بعيد في الغرب، ليلبسوها ويفصّلوها من جديد على إبداعات كتابنا المعاصرين! . خلاصة القول، وفاء عبد الرزاق في رواية (رقصة الجديلة والنهر) لا تتحدث سوى عن واقعها الخاص، حتى وإن كان يتعلق بواقع ما اصطلح على تسميته بعالم الأرواح، وليس ذنبها أن العلم إلى اليوم لم يجد صيغة مناسبة ليناقش بها مثل هذه الأمور الغيبية، فهي لا تصف أشياء خيالية وإنما تتحدث عن عالم ماوراء الموت، وقد وظفته لتوصل نوعا معينا من الأفكار والرسائل التي ارتأت أنه من الممكن إذا تمّت قراءتها بعين الحكمة والحصافة، أن تغير شيئا ما في كيفية نظرة المتلقي لأمور حياته اليومية. وهي حتى حينما توقفت طويلا عند وصف ملاك السنابل أو السيدة /اللغز، التي كانت تحلّ بركة ومطر خير على كل شخصية كانت تقف إلى جانبها أو تطرق بابها من شخصيات (رقصة الجديلة والنهر)، إنما كانت تتحدث عن شخصية واقعية أكثر من الواقع نفسه، شخصية من دم ولحم، وليست مجرد روح تظهر وتختفي فجأة بدون سابق إنذار، وإن كان سياق الكلام يبدي العكس، إنما الأمر فيه تقنيات سردية روائية تتغيّأُ إضفاء جو من التحفيز الذهني على التفكير الجيد والغوص بالتالي في بحر المعاني المكنونة بين الحروف. وعليه فإنّ ملاك السنابل ليست سوى وفاء عبد الرزاق نفسها، والسنابل ماهي إلا أدعيتها وصلواتها التي كانت ولم تزل لليوم ترسلها بلسان التبتل والخشوع إلى كل إنسان يرضخ تحت نير الوجع والألم في بلادها ووطنها الأمّ العراق. فوحدها هي يحترق قلبها في البعد بنيران الفراق حتى أصبحت بشكل أو بآخر تطرق أبواب الناس المحتاجين والفقراء والمهجّرين من ديارهم كي تخفف عنهم الألم. ووحدها هي وفاء سيدة السنابل التي تطوف أيضا وسط أحداث (رقصة الجديلة والنهر) لتروي للكلّ بعين السرد قصة المقاومة الكردية النسائية وحكاية شهداء (سبايكر) وحكايات أخرى متفرقة من رواية كبيرة، اسمها الوجع العراقي. لذا فإني أقترح على السادة النقاد أن ينظروا إلى كتابات الأديبة وفاء عبد الرزاق بمنظور ومنظار نقدي آخر أنحتُ لهُ اسماً جديدا في أدبيات النقد الروائي وأسميه بالواقعية العرفانية، بعيدا عن إسقاطات مدارس فكرية أكل عليها الدهر وشرب ولا تتناسب أبدا مع واقعنا العربي وأوجاعنا التي لا يشبهنا فيها أحد، لأنها قاصرة عن قراءة أدبنا وإبداعنا وعلومنا.
حاءُ الموتِ والواقعيةُ العرفانية الجديدة إن وفاء عبد الرزاق صوت عرفاني جديد، يكتب إبداعاته بحرف التجديد. وإذ أقول هذا، فإني لا أجد عملا يدعم بالحجة والدليل الدامغ ما ذهبتُ إليه من وصف أفضل من روايتها (حاموت)، والتي أعتبرها النص القنديل الذي على ضوئه يمكن قراءة حتى (رقصة الجديلة والنهر)، قراءة سليمة والإجابة بالتالي على كل ما تضمنته من قضايا وأسئلة ميتافيزيقية وأخرى فلسفية وثالثة وجودية. فلماذا رواية (حاموت)، ومن تكون (حاموت) هذه؟ تقول وفاء عبد الرزاق في إحدى صفحات الرواية مجيبة عن سؤالنا على لسان محمد بطل الرواية الرئيس: «حاموت، مدينة الظلام والكابوس، كأنها غيمة سوداء تحاصر سماء أبنائها وتصهرهم واحدا تلو الآخر، ما هي إلا صدى أسلحة، شكوى مؤلمة ... صوت العتمة الخافت والحزن الوقور. تتفنن في رنين الخوف لتبقي الأحفاد بلا هوية، أو سلام، تصبّ عفونة الأيام عليهم فتلقيهم للغرق، يتوارثونه مهابة للمياه وتلبية لدعوتها. أن تصبح المدينة بئرا تستقبل الخطوات الوئيدة كأنما ورق يتساقط في انزلاق الظلمة لتستقبلهم الأشباح...لهو عري الأمكنة وصلب الروح. شيء ضارب في السواد يلاحق الدور والحوائط [...] النحو الذي ترتكب به أشكال الموت يجعلني أسأل نفسي، عن اسم "حاموت"، أصلها واصل تسميتها. كثيرا ما يقتحمني السؤال، فأتوجه باحثا عن سرّ الاسم، من أين جاء؟ وما هو جذره؟» (10). كما يبدو جليا من هذا المقطع المقتطف من الصفحات الأولى للرواية فإن محمدا على الرغم من أنه مَدّنَا بالعديد من التفاصيل الوصفية الخاصة بحاموت، إلا أنه لم يسفر عن سرّ الاسم ومعناه. كل مانعرف عن هذه "المدينة" سواء عبر هذا المقطع القصير من الرواية أو من خلال معلومات أخرى أكثر تفصيلا تمت معاينتها في الباقي من صفحاتها أن حاموت هي: مدينة الظلام والكابوس؛ كوكب كبير؛ يطارد الموت فيه سكانه؛ تنشط فيه الحروب والكوارث الطبيعية وتنتشر فيه الأمراض والأوبئة باستمرار؛ وفيه "شبح" يحصد أرواح الناس بلا هوادة ويضع بصمة الموت فوق بيوتهم أو على أجسادهم أو في أيّ مكان آخر يتعلق بهم. ليس وحده فقط محمد مَنْ لمْ يَمُدّ المتلقّي بسرّ اسم حاموت رغم تساؤلاته المتكررة عنه داخل النص الروائي، بل الكاتبة أيضا، فهي لم تفصح عنه أبدا حتى حينما كانت تبدو غارقة في سرد كل شيء يتعلق بحاموت، وذلك لسبب معرفي عميق: إنها تريد من القارئ نفسه أن يصبح مثل محمد بطل روايتها الذي كانت خالته تناديه بــ (عارف): «محمد هو اسمي في شهادة الميلاد، إنما خالتي كانت تناديني بـ "عارف"، لست أدري لمَ يحلو لها ذلك؟ وأيّ عارف لا يعرف أيّ شيء عن إطلالته الحقيقية على الدنيا. هل قدّر عليه أن يحيا غريبا ويتيما. أن يأتي ثمة شخص يجهله وينتزعه من حضن أبويه، ويحيله إلى كائن مملوء بالتساؤلات؟ تساؤلات لا غير تتوحد في أعماقي عن ورق الشجر المتساقط، عن حيوانات وطيور تصاب بداء يقضي عليها، تنتهي دورتها ثم تأتي غيرها منحوتة بحياة أخرى» (11). لماذا عارف يا ترى؟ ومن يكون محمد الممتلئ حدّ التخمة بالأسئلة عن معنى الوجود وماهيته؟ إنه باختصار شديد وفاء مرّة أخرى، وهو أيضا أنت أيها القارئ، وهو مرة ثالثة ورابعة أبونا آدم، الذي لم يستطع لليوم حلّ لغز الحياة والموت ورحل وترك لنا جميعا هذه الإشكالية المستحيلة تأكل عقولنا وقلوبنا كما تأكل اللقالق البذور التي ينثرها المزارع فوق حقول العشق والمحبّة. كلنا إذن آدم، وكثير منا مثل أبينا عارفين شئنا أم أبينا مادُمنا لليوم نركض بلا هوادة خلف قطب عظيم أعطاه الله بصمة الموت ولم يسلّمه مفتاحه، علّنا نجد عنده بعض ما يطفأ لهيب عطش السؤال والحيرة والتيه المشتعل بدواخلنا. وقد أبدعت وفاء عبد الرزاق أيّما إبداع حينما فتحت باب المواجهة هذا على مصراعيه في روايتها بأن جعلت اللقاء ممكنا بين هذا القطب وآدم أو "محمد" وفقا للاسم الذي عمّدت وفاء به بطل روايتها، وحققته عبر لقاء مباشر بينهما وعبر عدّة حوارات مفتوحة حبلى بأسئلة شديدة التعقيد والصعوبة: «ــ أنا الآن أمامك، ماالذي تريد معرفته، فقد أرهقتني بتساؤلاتك وإلحاحك على رؤيتي، وها أنا ذا ألبس زي رجل وأكلمك، قلت سابقا لنتقابل رجلا لرجل، ونحن معا الآن يا صاحبي. / سألته: ــ ما اسمك؟ / قال: ــ عزيز، وأنت محمد. / ارتعدت مفاصلي بسؤال آخر: ــ هل كنت هناك مع ساندي؟ / ولحظة هزّ رأسه إيجابا دارت بي الدنيا ووقعتُ مغشيا عليّ» (12). السؤال الذي يجب طرحه الآن بعد قراءة هذا المقطع التعارفي العرفاني هو كالآتي: إلى أيّ حدّ خدم هذا المشهدُ اللقائي التعارفي النسيجَ العام للرواية وحبكتها الداخلية؟ أو بصيغة أخرى، هل كان من الضروري أن تحقق وفاء هذا اللقاء وتجعل محمدا يلتقي بعزيز؟ وحدها وفاء تعرف أنّ في الردّ على هذا السؤال حلّ للغز اسم المدينة الذي لم تفصح عنه وتركت مهمّة القيام بهذا الأمر لناقد أو باحث قد يكون عارفا هو الآخر، ليحفر في عمق أعماق روايتها بفأس السؤال والتمحيص ويُخرج الجوابَ الكنزَ ثم يُعلنَ أمام الملأ وفاء عبد الرزاق عارفةً جديدة تواجه "عزيزا" كل يوم وفي كل لحظة من لحظات حياتها كإنسانة أولا، وكروائية ثانيا. وإذا كان محمد هو آدم (ع) وكل حرف خرج من صلبه وأكمل مسار الحياة من بعده، فإن عزيزا هو عزرائيل (ع): «يا أخي أيّ قلب أنتَ ما مقياس الخير والشجاعة عندك؟ وما الطاعة؟ أظنك عبدٌ مطيع وخائف، ولا يستبيح الناس ويشرّع الظلم إلا الخائف المطيع. تطيع من يا عزيز؟ أنت عزيز؟» (13). أجل، إنه عزرائيل (ع) ولا أحد غيره، وهو عبد لرب جليل (14) سلطان ذو عزة وجبروت، وصاحب ملك وملكوت، تقدّس اسمه وجلّ جلاله وعظم شأنه. عزرائيل الذي يتألم لآلام الإنسان ويرأف لحاله ويبكي من أجله، لأنه عليم بضعفه، خبير بجهله وعدم قدرته على إدراك غيبيات الخلق وتسيير الكون وفقا لنظام دقيق لا يحكمه الشرّ وإنما الخير وإن بدا في معظم الأحيان مغلفا بالظلم والقهر والعنف والدم والمرض والعواصف المدمرة، أو بمشهديات كارثية لا يستطيع عقل ولا علم شرحها أو تفسيرها كتلك التي تفننت قوى الإرهاب في تنفيذها فوق العديد من أراضي حاموت، التي هي ليست بلدان أو مدن من (العراق) فحسب، وإنما حاموت هي كوكب الأرض بأكمله: «لماذا حين سألت "عزيز" ذات جلسة بيننا قال لي: ــ أنت تعيش على شبر من أرض حاموت؟ أيّ شبر هذا وما حجم حاموت الكليّ؟ على شبر واحد يحصل ما حصل لي وللساكنين على هذا الشبر؟ يا له من شبر بائس وغني. غناه سبب بؤسه وطمع الآخرين فيه فحُل سفح دمنا وأوغل الخنجر في الخاصرة. أقارن شبر أرضلنا على حاموت مع أشبار قريبة منّا. كيف خلقوا أنفسهم من العدم، من صحراء قاحلة إلى بلد رفاه وعمار وتقدم في كل مناحي الحياة، حتى صارت تلك الشبار تضاهي أكبر أشبار العالم بل تفوق عليها، ليس تحضرا، إنما إعمار وبناء ورفاهية. [...] أين الخلل؟ فينا مؤكدا، وفيمن ترأسوا علينا...أوغاد دنسوا أرضنا ومياهنا» (15) أمّا لماذا اختارت وفاء عبد الرزاق لكوكب الأرض اسم حاموت دونا عن باقي الأسماء الأخرى، فهذا لأنها عارفة، وتعلم أنّ من لم يتعرّف إلى الكون عبر حرف الموت لا يمكنه أبدا أن يعرف الله. وفي اسم حاموت يتجلى اسم الموت (حا + موت)، ويتجلى اسم عزيز أو عزرائيل (ع) كمَلك مسؤول عن الـ (موت)، ويتجلى أيضا اسم جليل صاحب سرّ الموت الأكبر وسيّد وربّ عزيز وربّ الناس أجمعين. ولِمَنْ يتساءل الآن ويقول وماذا عن (حا) في اسم حاموت، ما دخل هذين الحرفين في كل هذه المتاهة اللاهوتية التي أقحمتنا الكاتبة في دوامات ورياح أسئلتها العاتية؟ أجيبُ رافعة حجاب الاحتجاب عن الواقعية العرفانية التي بقلمها وبحبرها تسطّر وفاء عبد الرزاق إبداعاتها: (حا) هي انصهار بين حرفين عظيمين عند أهل التصوف والعرفان الإسلامي (الحاء) و(الألف). والحاء إذا جاء موقعها في أول الكلمة كما هو الشأن في اسم (حاموت) فإنها تعني الحقيقة وعليه يكون عنوان رواية وفاء عبد الرزاق الذي كان إلى لحظات قليلة محتجبا عن الجميع هو (حقيقة موت) أيْ (حقيقة الموت)، وهي ذاتها الحقيقة التي أسهبت في الحديث عنها حتى في روايتها (رقصة الجديلة والنهر). والحاء هي حرف من حروف عالم الغيب، وهذا ما يفسر كون وفاء توظف كثيرا مشهديات الغيب في كل كتاباتها. ناهيك عن أن لهذا الحرف من عالم الملكوت اسم الجليل، وعليه يصبح جليا للجميع الآن كيف أن الكاتبة اختارت اسم الجليل دونا عن بقية أسماء الله الحسنى لتُعَرِّفَ به سيّد وإله (عزيز). والحاء من الخاصّة وخاصة الخاصة يظهر في خمس مراتب (16) وأحيانا في سبع، وأحيانا أخرى في تسع (17)، أمّا سلطانه فيتجلى في العديد من عناصر الطبيعة التي تتدثر بخمار الجمودية (18)، ويبقى الماء هو العنصر الحقّ الذي يتكون منه الحاء (19) وما من فراغ نجد الكثير من شخصيات روايات عبد الرزاق ودواوينها تحوم دائما أو تعوم في الماء أبحرا كان أو نهرا (20). أمّا عن كون الحاء ظهر في عنوان الرواية مقترنا بحرف الألف، فذاك لأنّ هذا الأخير حرف من حروف الحاء يظهر عند الفتح ليدلّ على الإحاطة والشمول للجميع، ولو لم تكن وفاء عبد الرزاق مدركة لهذه المعاني لكانت اكتفت بالاسم خاليا من الألف وجعلته هكذا (حَموت) بدلا من (حاموت). ولحرف الحاء من أسماء الذات أسماء عدّة وقد اختارت وفاء من بينها اسما بعينه وهو (العزيز) ورمزت به لسيدنا عزرائيل (ع)، المَلَك المحجوب بحقيقة الموت وسرها العظيم: «بتُّ أسمع خطواتك أيّها المحجوب، لا أدري هل أسمّيك الشبح أم المحجوب؟» (21). وبالحاء وسرّها كان سيدنا عيسى يحيي الموتى، ويكفي ختاما هذا الحرف فخرا أنه جزء من اسم محمد (ص)، ولعله السبب ذاته الذي دفع الروائية بأن تسمي بطل روايتها بـمحمد. فالحاء إذن حرف كامل ويرفع كلّ من يتصل به ويدخل فلك العشق فيه وبه ومنه: «ساعتها حلمت بأنني مرفوعا على يدي "عزيز"، مرفوعا عاليا، والهواء يتخلل ملابسي البيضاء وشعري وبدني. ذراعاه ممدودتان للريح [...] همس لي "عزيز" أن أتنفس بعمق قبل الخضوع إليه، نظرت إلى "حاموت" من بعيد فرأيتها مدخنة متصاعدة، تنفست عميقا واستسلمت لصاحبي المسرور باستسلامي التام وأنا أردد في نفسي: ــ أصبحتَ عبدا، أصبحتَ عبدا يا محمد، أصبحت عبدا للقويّ، أصبحت عبدا» (22). هكذا تختم وفاء عبد الرزاق رواية (حاموت) لتقول للجميع إنها وحدها الحرية السبيل للنجاة من كل مكائد الدنيا ومهاولها، هذه الحرية التي لا يمكن أن تنال مالم يعترف الإنسان بعبوديته للخالق، هذه العبودية التي فيها كلّ الأجوبة عن كل تلك الأسئلة القلقة التي بدأ في طرحها منذ آدم إلى عهد الرسالة المحمدية وما بعدها: لماذا أنا؟ لماذا الطبيعة وكوارثها؟ لماذا الألم؟ لماذا المرض؟ من هو الله؟ ولماذا يصرّ هذا الخالق على أن يبقى هكذا سرّا غامضا مختوما؟ هي رحلة الإنسان الصعبة والمريرة مع أسئلته، لا سيما تلك التي تتعلق بماهية الله، وهي هذه الأسئلة التي تصبح في كثير من الأحيان شيئا أشبه بحديث الأصمّ عن سحر الموسيقى، والكفيف عن الجمال، فيتخيّل الإنسانُ خالقه تارةً قوةً تُحرّكُ الكونَ. ويجسّده تارة ثانية قمرا وشمسا، وتارة ثالثة حجرا وشجرا، وفي أقصى الحالات وأخطرها يُقيم لهُ المعابد ويقود الحروب الهوجاء الدامية باسمه وتحت لوائه (23) فيتفاقمُ بذلك عنفُه وطغيانه وطيشه وجنونُه، إلا أنه على الرغم من ذلك يظل عاجزا أمام جبروت المرض والطبيعة اللذين لم يستطع لليوم ترويضهما لأنهما يفاجئانه دائما بالعلل والأسقام والكوارث ناشبَيْن في جسده مخالبهُما عبر الزلازل والبراكين والأعاصير والأمواج الجبّارة (24) أو عبر الفيروسات والسرطانات المقيتة (25)، حتّى صارت العلاقة بينهما هي علاقة البقاء للأقوى. ولم يتبقّ للإنسان سوى ذاته فكان لا بد أن يهتمّ بها ويدرسها ويسبر أغوارها، إلا أن انشعاله المتواصل بتأمين قوته والسعي إليه بشتى الطرق والوسائل وفي كل الأماكن حالَ دون ذلك فتجده يصبح من جديد أسير دوامة من التوهان لا يعرفُ إلى أين ستقوده؟ وحينما يبلغ العديد من الناس إلى ذروة الضياع يعودُ بعضهم إلى الله بالضّبط كما صوّرتهم وفاء في روايتها (حاموت) من خلال شخصيّة محمد، ويبدأون في الإنصات إلى ذلك النداء والصوت العزيزيّ الخفيّ الذي يرنّ في وجدانهم ويحدّثهم عن أصلهم العظيم وغايتهم الأعظم فيعرفونَ أخيرا أن التساؤل عن الموت وحقيقيته هو ضرورة من ضرورات الحياة، ويكتشفون أنّ الحياة نفسها موت مستمرّ. وإذ أقول هذا فإني لا أعني بهذا الموت ذاك الذي حفره العديدُ من رجال الدين في عقول السّذج من الناس واعظين إيّاهم بأن كلّ ما سيأتي بعد الموت هو الأهمّ وأنّ ما يحدثُ قبله ليس له أيّة أهمية على الإطلاق حتى أضحت حياتهم مجرّد كتاب من المرثيات الطويلة لا شيء فيه سوى الحزن والاكتئاب. فإذا لمْ يكن الإنسانُ قادرا على أن يعيش ما قبل الموت، فكيف سيمكنه أن يكون قادرا على التعامل مع ما سيأتي بعد الحياة، أو كيفَ سيمكنه أن يتأهل ويستعدّ لما سيأتي بعد الموت؟ وحدها الحياةُ طريق الإنسان إلى الله، هكذا يعلّمنا «محمد» بطل رواية (حاموت) حينما عاشَ حياته بكل تفاصيلها محاولا فهمهَا عبر طرح الكثير من التساؤلات المتعلقة بالعديد من القضايا الفكرية الكبيرة، لأنه يعلم أنّ الطريق نفسه سؤال عظيم، يجبُ معرفة كيفية طرحه، وكيفية الجواب عنه، ولا يهمّ أن يكون الجواب صحيحا أم لا، ولكن الأهمّ في كل هذا وذاك أن يتحرّكَ الإنسان نحو حقيقة الموت بكل ما فيه من حيويّة الحياة، أيْ بدمه ولحمه وجسده وقلبه وروحه مثلما فعل أيضا أبطال رواية (رقصة الجديلة والنهر): ريحانة وشيرين وروهاني وحامد وغيرهم. لأنّهم جميعا كما محمد العارف يعلمون جيدا أنّ الله لم يخلقِ الشرّ، وإنمّا هو وليد حريّة وهبها البارئ لخليقته وأسيء استخدامها فانحرفت قاطرة الحياة عن قضبانها وسارت في طريق آخر نحو الجحيم. لذا فإن روح الإنسان تئنُّ حينما يقتحمُها الشرّ لأنّه عنصر دخيل على كيانها النقيّ، بينما يظلّ صدى ذاك الصوت الخافت يتردّد بين جوانح الإنسان محاولا توجيه بوصلة سلوكه نحو أصله المجبول من روح الخير والمحبة العظيمة، وهو نفسهُ هذا الصوت الذي تجيدُ الروائية وفاء عبد الرزاق الإنصات إليه فتُحوّلُه إلى حروف تصيرُ شعلةً تضيءُ بها عتمة النفوس علّها ذات قراءة لسردياتها وأشعارها تهتدي هي الأخرى إلى ملكوت الحاء ومشهدياته السارية في الوجود بسرّ: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ»(26).
الهوامش د. وفاء عبد الرزاق، (من مذكرات طفل الحرب)، ط 1، دار نعمان للثقافة، لبنان،2008/ ط 2 وط 3، دار كلمة، مصر، 2009/ 2010. ترجم الديوان كاملا إلى اللغات التالية: ـ الفرنسية: هادية دريدي، دار هارمتّان، باريس، 2008 (تدقيق محمد الرفرافي و"Josyane De Jesus Bergey")، كما أقيم له بالمناسبة حفل توقيع بباريس في يوم 19/02/ 2009؛ ـ الإسبانية: ميساء بونو، مطبعة آنفو، فاس، 2010 حفل توقيع الديوان في نسخته الإسبانية أقيم في المغرب بتاريخ 26/03/2011، بالمركّب الثقافي ((الحرية))، بتنظيم وإشراف دارة الشعر المغربي؛ ـ الإنجليزية: يوسف شغري، دار صافي، الولايات المتحدة الأمريكية، 2014 (وقد دققته شركة Translation4all,Inc)، وبمناسبة هذا الإصدار أقيمت للديوان احتفالية تقديم وتوقيع ضمن أنشطة المعرض الدولي للكتاب في مدينة سياتل بأمريكا بتاريخ 25-2- 2014؛ كما ترجمت قصائد اقتطفت منه إلى لغات أخرى منها التركية والإيطالية أدرجت في موسوعة السلام للطفل العالمية. حصل الديوان على ما يلي من الامتيازات والتقديرات والجوائز: ـ من لبنان سنة 2008: جائزة المتروپوليت نقولاوس نعمان للفضائل الإنسانيَّة؛ ـ من فرنسا سنة 2009: تمثيل القارة الأسيوية في مشروع دار هارمتّان السنوي والموسوم بـ (من القارات الخمس) تحت إشراف البروفيسور "جوزيف تومسيان"؛ ـ ثم من الجزائر سنة 2009: أصبح موضوعا لنيل شهادة الإجازة في الأدب العربي بجامعة تبسة. د. وفاء عبد الرزاق، رقصة الجديلة والنهر، دار العارف، لبنان، 2015. المصدر نفسه، ص 60. انظر في هذا الصدد الدراسة التي كتبتُها عنه باللغة العربية والمنشورة في عدة مواقع إلكترونية بعنوان [(من مذكرات طفل الحرب)؛ بين مطرقة الترجمة وسندان النقد]. وأعني هنا بالتقنيات استخدامها للعنصر الرومانسي التشويقي عبر تفجير بذرة الحب والعشق بين الشخصيات الرئيسة لرواية (رقصة الجديلة والنهر) وهم يتحركون بين أماكن مختلفة توجد حقيقة على أرض الواقع الجغرافي العراقي والسوري. Herrera Hayden, Frida. Vita di Frida Kahlo, 2. ed., a cura di Maria Nadotti, Narrativa, Milano, La tartaruga, 2001 د. وفاء عبد الرزاق، رقصة الجديلة والنهر، دار العارف، لبنان، 2015، ص 133. انظر على سبيل المثال الصفحات 16 و22 وكذلك 51 من رواية (رقصة الجديلة والنهر). انظر صص 132 و133، المصدر نفسه: ((يجب ألا تحاولي يا ريحانة، وأقولها لك للمرة الألف، نحن مجرد أرواح)) / ((نحن أرواح، أرواح يا صديقتي، لا يأخذك الحماس الوطني وتتخيلي الواقع)). د. وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014، صص 7/8. المصدر نفسه، ص 11. المصدر نفسه، صص 35/36. المصدر نفسه، ص 41. يرجى الاطلاع مجددا على الصفحة 41 وفيها وفاء تذكر اسم السيد الذي ينفذ عزيز أوامره: « ــ نعم أنا عبد مطيع فلا تفرغ غضب لومك عليّ / ــ عبد؟ عبد لمن أيها القاسي؟ / ــ أنا عبد سيدي جليل / [...] ــ هل يعقل هذا، دمار "حاموت" بيد عبد؟ لا أصدّق / ــ أنا سيدك فلا تقل عبدا، وإلا نفضت جلدك من دمك، وسخطك بويلي وقوتي وجبروتي وأحلتك جثة هامدة». المصدر نفسه صص 86/87. انظر على سبيل المثال لا الحصر عدد القصائد التي يتكون منها ديوان (من مذكرات طفل الحرب)، وكذا عدد الفصول التي تتكون منها رواية (حاموت) وستجد أنها كلها 15 قصيدة بالنسبة للديوان، و15 فصلا بالنسبة للرواية. وما رقم 15 سوى تثليث للرقم 5. انظر عدد فصول رواية (رقصة الجديلة والنهر). يرجى الاطلاع على الكيفية التي وظفت بها وفاء أيقونة الشجرة في كلتا روايتيها (رقصة الجديلة والنهر) وكذا (حاموت) باعتبار أنها عنصر من عناصر الجمودية المشار إليها أعلاه. مصداقا لقول عز وجل في أكثر من آية: ــ «وكانَ عَرْشُهُ عَلى المَاءِ» [هود: 7] ــ «فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ» [الطارق: 5، 6]؛ ــ « وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» [الأنبياء: 30]؛ ــ «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا» [الفرقان: 54] ــ أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ [يس: 77] يرجى التوقف مليا بعين التأمّل عند ثيمة النهر في رواية (رقصة الجديلة والنهر)، صص 134/135: «أمطرت السماء سنابل مضيئة، رقصت الضفاف والنخيل، ماء دجاة اهتزت أمواجه احتضانا لرقصة الأرواح لطاهرة. وبدا أصغر الشياء رائقا كما قلب نبي« . وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014، ص 33. وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014، ص 124 . وفاء عبد الرزاق، (رقصة الجديلة والنهر)، دار العارف، لبنان، 2015، ص27: «لكم دينكم ولي دين... عن أيّ دين يتحدثون يا ترى؟ وكيف يصبح الدّين الشيطان بعينه؟ هل سيتخلّى العذاب الإلهي عن هؤلاء؟ يقولون لهم الجنة! يغرون السذج والخمارين والحشاشين بدخولها فيفجرون أنفسهم طمعا الدخول... سيستقبلهم وفد من حور العين... من أجل النساء إذن؟ الحرق والذبح والسبي والقتل، أهو مفتاح لجنتهم؟» وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014، ص33: «كان الخبر عن إعصار "ساندي" سيكون الأعتى الذي سيصيب كندا وأمريكا. عرض التلفاز صورا مرعبة للدمار الذي خلفه هذا الإعصار، ثم واصل المذيع قراءة الخبر واجم الوجه». وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014، ص109: «سألني الطبيب عن صحتي فوصفت له حالتي: أشعر بإعياء شديد، وفقد الشهية والنحول، وعدم قدرة على الحركة كما السابق. كما أختنق بسعال مصحوب بدم. سألني فيما أدخن أو تعرضت لإشعاع وتلوث. ضحكت بقوة رغم ضعفي وسعالي الخانق: ــ أوليست "حاموت" مدخنة يا دكتور، مدخنة وبئر ولا منقذ لنا. [...] بعد مضي أسبوع اتصل الطبيب عبر الهاتف: محمد، لابد من إخضاعك للعلاجات الكيميائية. / شهقت، شهقت وتسمرت في مكاني. لم يمر في بالي يوما سأصاب بالسرطان. عرفت صمت عزيز وحزنه المتواصل. أنا الآن أمام حتفي، لذا يهرب صديقي من المواجهة». سورة الذاريات، الآيات 56 / 57 / 58




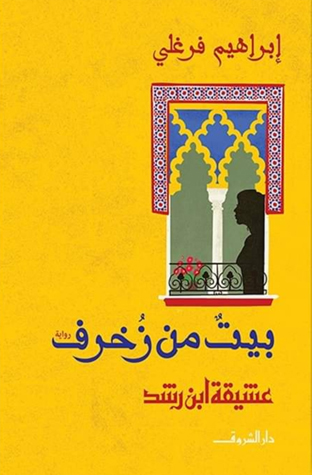


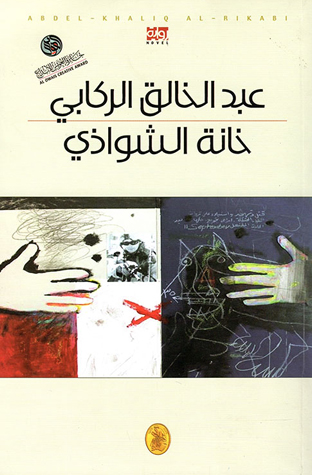

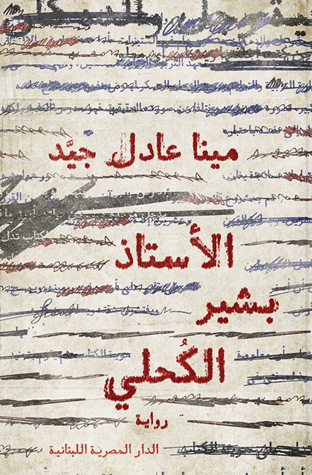

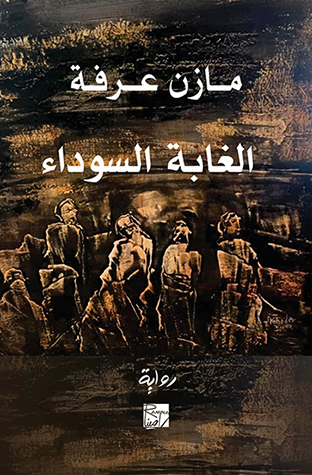


0 تعليقات