الطيّب صالح والشخصيّة الروائية الإشكالية
تعتبر رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للروائي السوداني الطيّب صالح، من الروايات الإشكالية التي يمكن للدارس أن يتوقّف مطوّلاً عند الكثير مما تطرحه من قضايا، كانت ولا تزال مجال حوارات مستفيضة في المشهد الثقافي والسياسي العربي والأوروبي.
حيث تأتي موضوعة الاستعمار ومؤثّراته في رأس قائمة هذه القضايا، نظراً لما استتبعه من عنف متبادل بين الطرفين، ليتدحرج هذا العنف على شكل كرة نار جهنمية عصفت بالشخصيات وقيمها الإنسانية الأسمى...
ألا وهي قيم الحبّ والتسامح والتعايش الخلاّق بين الأمم، وليؤكّد الروائيّ وجهة نظره من خلال شخصياته التي تنقّلت ما بين الجنوب والشمال، حاملة معها قلقها وغربتها وإرثاً من العداء للغرب كغرب وللحداثة عموماً، نظراً لأنّ المرحلة التي كُتبت فيها الرواية، كانت تضجّ بأفكار ثورية دعت للخلاص من الاستعمار وتبعاته، ومنها على سبيل المثال أفكار فرانز فانون.
وإذا كان المستعمر الإنجليزي الذي احتل السودان، قد مارس أنواعاً مختلفة من الاضطهاد ضدّ الشعب السوداني المقاوم، فإنه في الوقت نفسه مارس اضطهاداً لغوياً وثقافياً، بات معه مستقبل الأجيال الجديدة مرتبطا بثقافته وباللغة الإنجليزية..
وهذا ما حصل لبطلي الرواية الدكتور سارد الحكاية الذي عاد من إنجلترا بعد سبع سنوات أمضاها هناك، ونال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ومصطفى سعيد بطل الرواية؛ الشخصية الروائية الإشكالية، الذي بدوره حصل على الدكتوراه في مجال الاقتصاد، ثمّ عمل هناك أستاذاً في الجامعة.
اغتراب
كلتا الشخصيتين، كما سيلاحظ القارئ، أنهما عانتا هناك من حال اغترابية أثّرت عليهما نفسياً وسلوكياً، إذ يقول سارد الرواية في أكثر من موضع، انه عمل ثلاث سنوات منقباً في حياة شاعر إنجليزي مغمور، وبالتالي فإنه عاد إلى بلاده، وهو أكثر اقتناعاً بأهميتها سواء في علاقات العمل الفلاحية البسيطة، أو في طيبة أهلها وعلاقاتهم الاجتماعية المليئة بالدفء.
وكان مصطفى سعيد البروفيسور في الاقتصاد قد توصّل إلى هذه النتيجة قبله، وعاد إلى القرية ليعيش حياته كفلاح حقيقيّ. والدفء الذي يقصده السارد وبأبعاده الاجتماعية والثقافية، سيقابله الصقيع هناك: الغربة والوحشة وانتفاء العلاقات كنتيجة طبيعية للتعالي الثقافي تجاه الآخر، ولذلك وجدناه يصف نفسه بـ «مجرّد ريشة في مهب الريح»، بينما هنا في السودان هو نخلةٌ تمتدّ جذورها عميقاً في الأرض، وتعطي ثمرها.
منطق التفوق
أما مصطفى سعيد، الشخصية الإشكالية الأهم في الرواية العربية، فقد كان عليه منذ أيّامه الدراسية الأولى الاستجابة لمنطق التفوّق الثقافي، حيث إنه اضطر إلى تعلّم الإنجليزية مبكّراً حتى بات ينطقها كأهلها. وبالتالي كانت مكافأته كبيرة بأن أرسل لاستكمال دراساته في لندن، وهو لا يزال في الخامسة عشرة من عمره.
وإذا كان مصطفى سعيد مغلوباً على أمره في هذه المعادلة الصعبة فرضخ لشروطها، إلاّ أنه سيعاني هناك ذات المعاناة التي رواها سارد الحكاية، فهو بالرغم من شهرته في مجال الاقتصاد، لم يتمكّن من الدخول إلى قلب هذا العالم المغلق بوجهه وأمثاله من مثقفي العالم الثالث، لذلك فإنه عبّر عن رفضه لهذا العالم، وعلى تعاليه عليه ليمارس انتقاماً غامضاً وغير مبرر، من الحضارة الغربية..
لاسيما وأن انتقامه اتّجه نحو النساء، باعتبارهنّ الطرف الأضعف في معادلة الصراع بين الشرق والغرب، حيث إننا وعلى مدار الرواية نلتمس مصطفى سعيد منقّباً الأمكنة باحثاً عن «طرائده»، كصيّاد افترسه الجوع الجنسي..
وقد تكررت تعابير «الصحراء» و«الصحراوي» و«العطش» كثيراً في السرد ليخرج قارئ الرواية بانطباع مؤسف، عن مثقفي العالم الثالث وآلية فهمهم في تلك الآونة لظاهرة الاستعمار، إذ إن الحضارة الغربية ظلّت بالنسبة لهذا المثقف، فاتحا يشعره بدونيته المؤنثة وفق ما ذهب إليه جورج طرابيشي، مع شعوره المتفاقم بالعجز عن المواجهة، أو بـ «العنة» الثقافية..
وبالتالي فإن ردّة فعله ستتجه لتأكيد فحولته كما فعل مصطفى سعيد، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يكون بطلاً أو رمزاً يحتمل دلالات إضافية سواء حول ظاهرة الاستعمار ومعاناة الشعوب، أو جسراً للتواصل يربط بين كلّ ما هو مشترك قيمياً بين الحضارتين.
حال خاصة
وفي هذا السياق، لا أظن أن ردّة فعل مصطفى سعيد المتمثّلة بإشباع رغباته الانتقامية عن طريق إغواء النساء، ومن ثمّ معاقبتهنّ سواء بالإهمال والهجر أو بالقتل، تمثّل حالاً عامة للمثقفين العرب الذي قصدوا أوروبا للدراسة، أو هاجروا بغرض الإقامة، وإنما هي حال خاصة اقتضاها بناء الشخصية الروائية لأجل تفعيل الأحداث وتصعيدها درامياً، دون الأخذ بعين الاعتبار أثر هذه السلوكات غير السويّة، حتى ولو كانت موجهة ضدّ المستعمر.
وفي السياق النقدي للعمل يُعيد رجاء النقاش في مقال له نشر في مجلة المصوّر المصرية عام 1966، سلوك مصطفى سعيد هذا إلى شرقيته من جهة، وإلى كونه أفريقيا أسود اصطدم بالحضارة الغربية، وعنصر اللون هنا، بتعبيره، له أهميته الكبرى، فالبشرة السوداء أكثر من غيرها انصبّ عليها غضب الغربيين وحقدهم المرير. وستؤسس هذه المقالة لكثير من الآراء التي جاءت بعدها في ما يخصّ ثنائية غرب/شرق..
ولكنّ أحداً لن يلتفت إلى تأثّر الطيّب صالح بالثقافة الغربية والرؤية الاستشراقية حول مسألة العنف الجنسي، وتصوّراتها عن الشخصية الشرقية، ودليلنا على ذلك سعيه إلى استعادة روح «عطيل» شكسبير، ومن ثمّ زجّه في تراجيديا الغيرة، لتأكيد مقولة البعد النفسي لسلوكه العنيف كشرقي وكأفريقي، بمعنى أنه أعاد إليهم نموذج «عطيل» كغاز لديارهم، وليس قائداً من قوّادهم.
معركة دائمة
وما سيفعله هو القتل، إذ إنه بعد كلّ هذه الفترة التي أمضاها هناك، كان يخال نفسه في معركة دائمة بينه وبين الأنوثة وهذا المجتزأ قد يوضّح تحليلنا«غرفة نومي صارت ساحة حرب.. أقضي الليل ساهراً، أخوض المعركة بالقوس والنشاب والسيف والرمح، وفي الصباح أرى الابتسامة ما فتئت على حالها، فأعلم أنني خسرت الحرب.»
وفي الختام، يمكننا القول، إنه إذا كانت رؤية المؤلّف الفكرية مشوّشة ومضطربة على نحو ما حول ظاهرة الاستعمار والعلاقة بين الشرق والغرب في بعدها الإنساني، إلاّ أن روايته تعتبر من أوائل الروايات التي تناولت ظاهرة المثقف المأزوم..
في تلك المرحلة التي كانت تعجّ بالأفكار التحررية، إلاّ أنه، مع الأسف، لم يتمكّن من فهم بعدها الإنساني فـ «عاش على السطح من كلّ شيء» بتعبير سارد الرواية العائد إلى بلاده بلهفة الغريب، ولكنه بعد ذلك سيعيش على السطح أيضاً، لأن «محجوب» ورفاقه من الفلاحين، كانوا قد مضوا بعيداً في ترتيب شؤون البلد بقدر ما أتاحته الظروف المجتمعية والسياسية لهم.
عن صحيفة البيان




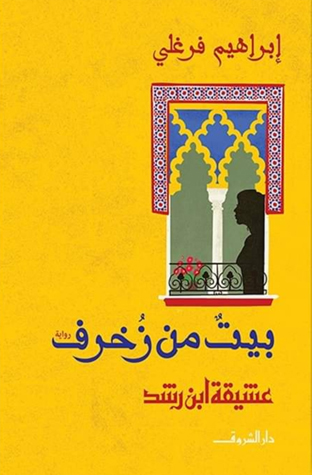


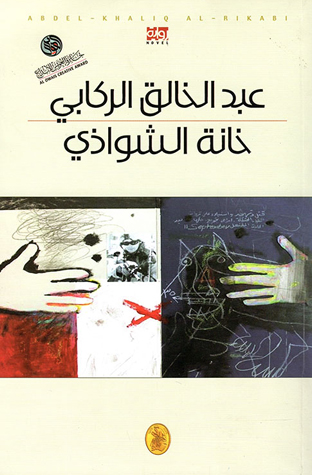

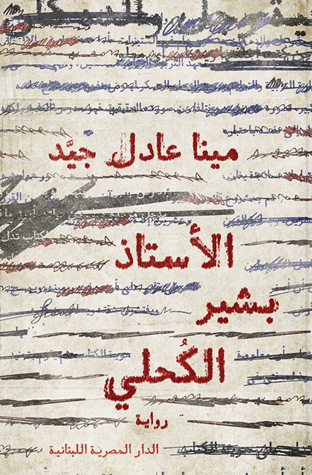

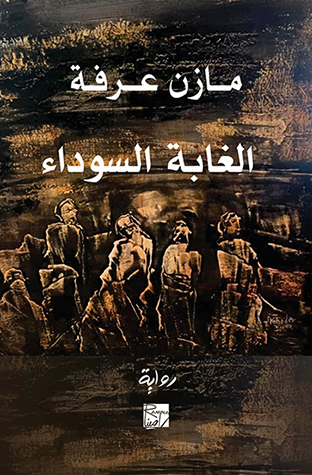


0 تعليقات