سر العنبر لمَي خالد.. من عبق الحكايات إلى سحر الأماكن
لا تكف الكتابات الجديدة عن إدهاشنا بالتقاط ما يتوه عنَّا في زحام الحياة من تفاصيل، وإذا كانت الرواية بشكلٍ خاص هي فن المكان، ورصد حي لعلاقات الناس به سواء كان ذلك في المدن أو الريف، فإن هناك من يلتقط ماهو أبعد من الأماكن والعلاقات ليربط ذلك كله بالتاريخ أيضًا، تاريخنا الخاص والعام، بل ويتجاوز ذلك للأثر الباقي الذي ربما لا نعرف أصله أو منشأه، ولكننا بعد تأملٍ طال أو قصر نستكشف خباياه التي شكلتنا حتى أصبحنا ما نحن عليه الآن.
من جائحة وباء الكورونا تنتقل بنا مي خالد في روايتها الجديدة الصادرة حديثًا عن دار العربي، بعنوانها الملفت "سر العنبر" إلى سحر الأماكن في القاهرة القديمة والجديدة على السواء، لتحكي لنا عبر بطل روايتها ميرا/ شاليمار عالمة الأنثروبولجيا التي سحرتها حكايات جدتها وأسرتها روائح الأشياء فسعت جاهدة لتوثيق عالم يوشك أن يزول ويتداعى متأثرًا بتلك الجائحة التي حبست العالم كله في بيوته، وجعلتهم يتوقفون لأيام وشهور علهم يسترجعون ما فات.
تمنح مي خالد في روايتها القارئ فرصة بل فرصًا عديدة لتجميع الحكايات وإعادة كتابتها، ولعلها تستفز في كل قارئ متعة التجسس، أو هي تستثير فضوله لحالة الرصد والتوثيق بشكل خاص، كم حكاية سمعناها ومررنا عليها مرور الكرام، كم قصة أدهشتنا أو تعجبنا من بدايتها وختامها ولم نتوقف قليلاً عند التفاصيل، تثير الرواية هذه الأفكار والهواجس وتستعيدها من جديد من خلال حكايات أبطالها حينًا ومن خلال ما يمكن أن يتذكره كل قارئ من حكاياته الخاصة.
فيلم وثائقي تعده باحثة في علم الإنسان، شغوفه بالعطور وتتبع مسار الحكايات عن سكّان عمارة مصر الجديدة، وعلاقات قديمة تربط العائلة والأجداد بوكالة العنبريين بالجمالية، وجدٌ يمتلك وكالة للعطارة، وأبٌ يمتلك سرًا يتعلق باعتقاله بشكل خاطئ، وبنت تدور بين هذه الحكايات، تسعى أن توثقها فتنجح تارة وتتعثر أخرى، تقودها حكايات الحب القديم إلى أسرارٍ جديدة، ونكتشف معها العالم وكأنه صندوق بندورا سحري ما إن يفتح حتى تنسكب منه الحكايات مع العطور والروائح ..

(( سيتوقع من يشاهد الفيلم أن حواري القصير الغني مع “رمزي” على باب العمارة سيكون مقدمة لقصة حب، هذا لأنني لم أوضح أن “رمزي” كان يزوغ ببصره بعيدًا عني، ويبعث بنظرات غزل وحنين نحو محطة المترو التي كان يهرب من شقتهم ليهيم بها. هذا فضلًا عن أن “رمزي” كان محرمًا عليَّ لأسباب عدة، أبسطها هو أنه قد تزوج وصارت له عائلة في البلد البعيد، وأغربها هو أن أمي قد أحبته كابن، فيصير لي “أخًا محرمًا بالمحبة”.
علمتني دراسة الأنثروبولوجيا أن ما تعده غريبًا في وطنك قد يكون عاديًّا في مجتمع آخر، لذا اخترعتُ بعض المعتقدات والمسميات التي تريحني، والتي غالبًا ما يكون لها نظير عند قبيلة ما، في مكان ما على الكرة الأرضية. أما السر الأول الذي حجبته عن “رمزي” وكان هو السبب الأهم من وجهة نظري في استحالة تواصلنا كحبيبين فهو أنه كان حب “رويدا” الأول. فأكثر ما غاظني يوم اشتكيته لأمي، كونه رآني طفلة حمقاء تلهو مع “رويدا”، التي لا بد وأن تكون بلهاء بدورها. نعم كانت “رويدا” في السابعة من عمرها، لكننا كنا نعي معنى الحب، وكنت أرسمها بالطباشيرة نفسها على الحائط وهي ترتدي طرحة زفاف، وبجوارها رجل يمسك عصا وأكتب بخط طفولي على وجهه “رمزي”))
رواية داخل رواية
على طريقة التداعي الحر تسير الرواية، ومن خلال فصول قصيرة معنونة بذكاء تأخذنا مي خالد إلى بطلتها وحكاياتها المتشعبة، وتنتقل بنا بسلاسة بين الزمان والأماكن، حريصة كل الحرص على وضع بصمة خاصة وعطرٍ مميّز لكل شخصيات روايتها، وبينما القارئ مندمج في حكايات البطلة شاليمار وعالمها، ومن غادر ومن بقي من سكان العمارة تقفز إلينا بطريقة تبدو عشوائية حكاية أخرى، ثريّة ومتشعبة لجارتها الغريبة إيفا، تلك الجارة التي يبقى القارئ على حيادٍ في أمرها، لانعرف هل ستعتلي منصة الحكاية وتتحوّل إلى بطلة في الحكاية بالفعل، أم أنها ستبقى حكاية ظل، على خلفية أحداث عالم ميرا، حتى تأتي النهاية تفسّر كل ما فات.
(( إذا رأى شخص عود عنبر في حلمه، فهذا يعني أنه سيجد الكثير من الأشياء الضائعة منه.
ضاعت مني أشياء كثيرة على مدى حياتي ولم أجدها، مثل الألبوم الصغير الذي كان يضم صوري أنا و”حاتم”، حبي الأول، وخبأته أمي، ولم أجرؤ على مواجهتها. وضاع إيماني بالأنثروبولوجيا لما استخدمه “حاتم” ليكتب تقاريره التجسسية على مشاعر البسطاء. وضاع الشال الفلسطيني الذي أهدته لي “كارا” والذي أخفته أمي أيضًا، لأنه على حد قولها يجعل شكلي كالرجال. وضاعت الآلة الكاتبة الحمراء التي دق عليها أبي ألحانًا أطربتني، وأعطتها أمي لبائع الروبابيكيا، وظللت أبحث عنها في صالات المزادات، ومحلات بيع الأشياء القديمة والأنتيكات في شارع المعز. لكنني لا أرغب الآن في أن أجد شيئًا ضائعًا أكثر من الجزء الناقص من حكاية “كارا”. فقلبي يحدثني أن ذلك الجزء سيملأ فراغًا أو يلئم جُرحًا، مثله مثل العنبر، الذي هو أقل الروائح حلاوة، لكن لولاه ما تماسكت عناصر العطر وصارت أريجًا ينعش الأرواح))
شخصيات ثرية وحكايات متشعبة
تقود ميرا بطلة الرواية دفة السرد من بدايته لمنتهاه، ومن خلال ذاكرتها التي تسعى لتقويتها بكل ما أوتيت من خبرة جدتها "ريحانة" من أعشابٍ وعطور، ومن خلال الصور والمسودات التي أعدتها لفيلمها الوثائقي ذاك، وبين حكاياتها تلك تنهض شخصيات شديدة الثراء والتعقيد، تحمل الرواية إلى مناطق أخرى، من هذه الشخصيات "رمزي" الذي تعتبره أخوها بالمحبة، وتلك العلاقة شديدة الخصوصية التي جمعتهم، كما نتعرف بشكلٍ مفاجئ على جوانب أخرى من حياة البطلة وعلاقتها بابنتها الفريدة بابنتها فريدة التي شاركتها اللعب والحياة وبادلتها دور الأم والابنة، ثم سافرت لدراسة الهندسة وغيرت خططها فجأة، وكذلك شخصية الجد وحكايته الغريبة التي لا نتبين حقيقتها إلى في نهاية الرواية، بل وتحضر شخصيات ثانوية بطرافة وذكاء مثل زوجة البواب "أم أوباما" وغيرهم .
ربما تبدو الرواية في جزءٍ منها محاولة لاستعادة ما ضاع منّا، أو هي سعيٌ للتوقف قليلاً وتأمل ما حولنا من أشياء/ وأشخاص، علاقات ومعارف عابرة، وكيف تؤثر فينا ونؤثر فيها، وكيف تكون الذاكرة في النهاية مستودعًا لا نهائيًا للحياة نفسها، تلك التي تمر ولا نلقي لها بالاً، فتأتي رواية أو حكاية أو ربما حادثة عابرة لتوقف جريان الأحداث، أو عزلة من وباء عالمي، تجعلنا نفكّر في ما فات، ونعيد رصده وتكوينه.
مي خالد روائية مصرية، تعتمد في كتابتها الروائية دائمًا على تيمة خاصة بها، فنجد لديها في "تانجو وموال" حضور الموسيقى، كما نجد حضور الألوان في "سحر التركواز"، وعالم الخيوط والأقمشة في رواية "تمار" وغير ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مي خالد خريجة كلية الاعلام - الجامعة الامريكية في القاهرة، مذيعة بالبرامج الانجليزية الموجهة/الاذاعة المصرية، تعمل في ترجمة وتمصير الاعمال الدرامية التلفزيونية
حصلت روايتها «جيمنازيوم» على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2016. وفازت رواية «تمار» الصادرة عن دار العربي للنشر، بجائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الرواية صادرة عن دار العربي للنشر (ما بين الأقواس من الرواية).

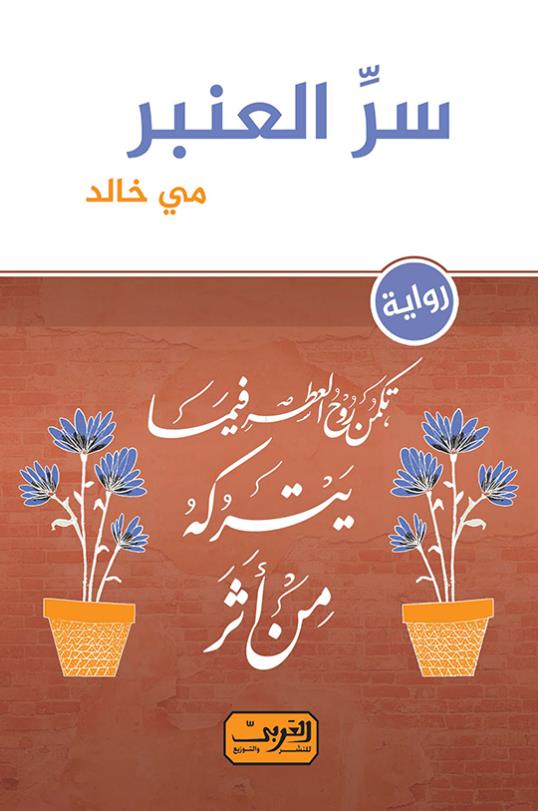



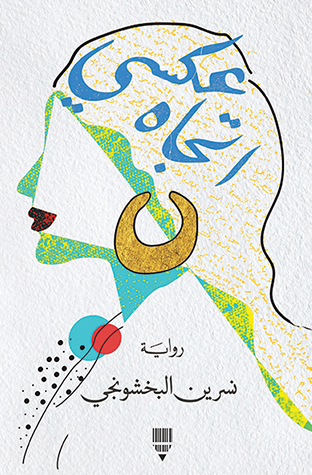



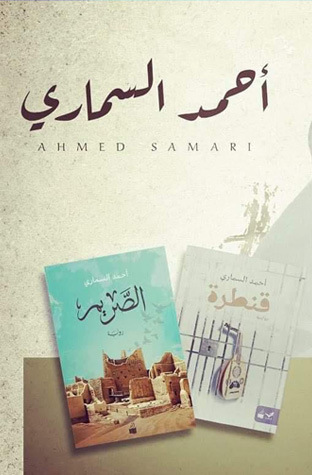
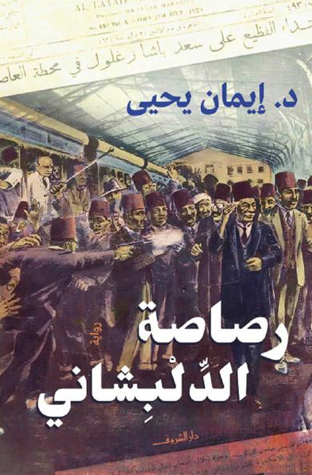
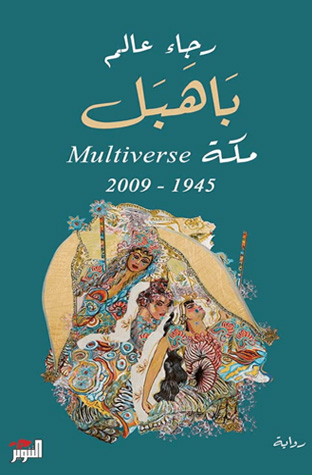



0 تعليقات