فوزي كريم... "مَلاذٌ" بين دفّتي كتاب
حسين السكاف
على حياء، يظهر الحب في هذه الرواية، بينما تهيمن فكرة المستقبل الكارثي، والخوف من تبعاتهِ على معظم أحداثها ومشاهدها... الحب جاء شفيفاً في روح شاب لما يزل على مقاعد الدراسة الجامعية... شابٌ يرى في مستقبل بلده "مدينة نحاس" كما صورها المسعودي في "مروج الذهب"... "مدينة النحاس" وكأنها جاءتني من عالمٍ آخر غير عالم الكُتُب. عالمٌ كنتُ قد استشعرتُه حين وقعتْ عيناي على الحكاية أوّل مرّة. وتذكّرتُ الصدى الذي خلّفتْه في النفس.".
في روايته الأخيرة "من يخاف مدينة النحاس - دار المتوسط 2018" يفصح فوزي كريم (1946-2019) الذي تميَّزَ عن أغلب مجايليه من الشعراء والمثقفين العراقيين، بعدم تبنيه أية فكرة سياسية أو آيديولوجية معينة، حيث ظلَّ حراً لم يشوهه مبضع السياسة والإنتماءات، عن ذلك التحرر بصراحة تامة، ليتلمس القارئ سرّ تفرد المؤلف، وفي الوقت نفسه، يتلمس أيضاً، مصدر مكابداته وآلامه، في بلدٍ لا يعرف سوى الانتماءات والتحزب...
"ليست الرواية تراثاً وحدها. كلُّ كتابٍ تراث. "في الكُتُب تتجلّى روحُ الزمن الماضي كله: الصوتُ المنطوقُ والمسموعُ للماضي، في حين يتلاشى جسدُ ذلكَ الماضي وجوهره المادّي جميعاً مثل الحلم." كل كتاب بين يدي يتطلّب مني استدارةً إلى الخلف. إنه صوتُ الماضي الذي ليس له من صوتٍ مسموعٍ.". من هذه الفكرة ينطلق الراحل فوزي كريم في روايته ليضع أمام القارئ مكابداته التي ما انفكت تؤرقه لأكثر من خمسين عاماً، مكابدات العراقي الذي تلمسَ في بلدهِ مستقبل كارثي، يقترب بصورته المتخيلة من "مدينة النحاس" المدينة التي تُسِحر البشر وتقتلهم سقوطاً، بعد أن تنال اعجابهم، تلك القصة التي تضمنها كتاب المسعودي "مروج الذهب" والتي تشير إلى هلاك من يرى مدينة النحاس بعد أن يتسلق أسوارها... "حيث تحيا، يا ابن آدم، ثمة "مدينة نحاس" تنتصب فجأة على مقربة منكَ، مُغويةً أكثر منها مُهدّدة. ترتقي جدارها عن غير إرادة، أو وعي. تصفّق لها مُهلّلاً، ترمي بنفسكَ، ولا ترجع آخر الدهر."
منطقة "العباسية" في كرادة مريم ببغداد. المنطقة الخصبة على ضفاف نهر دجلة، التي أصبحت منطقة رئاسية بعد أن سرقها حزب البعث، لتكون بعد الاحتلال وسقوط البعث بما يسمى المنطقة الخضراء" تشكل مسرح الرواية، فيها ولدَ المؤلف "بطل الرواية" وترعرع، حتى أكمل دراسته الجامعية. ومنها انطلق في رحلته خارج الوطن، هارباً من مستقبل البلد الكارثي كما كان يتصوّره نتيجة معطيات مقنعة تصورها لنا مشاهد الرواية... العباسية دائمة الحضور في مؤلفات ومقالات فوزي كريم، وكأنه لا يعرف منطقة أخرى في بغداد غيرها، بل تكاد أن تكون الوطن كله بالنسبة له، ولعلنا نتذكر ذلك التوق الذي كان يناشده فوزي كريم في روايته "العودة إلى كاردينيا" لعبور الجسر حيث الضفة الأخرى، ليكتشف "كورنيش أبو نؤاس" المقابل لمنطقة العباسية، وذلك الخوف والتردد الذي كان يتلبسه، بدايةً... إنه الإنتماء للمكان، أو لنقل "بغدادية" المكان، لذا نجده في أكثر من مكان داخل الرواية يستخدم المفردات العامية من اللهجة العراقية، أو على الأصح اللهجة البغدادية، ليضفي على الرواية روحها التي يريد أن يُشعر القارئ وبحميميتها... "حطّتْ أختي استكان الشاي على مسند "الكرويته" إلى جانبي، ثمّ وزّعت البقيةَ على أمي وعمّتي الجالستين، على "منادرهنّ" القطنية، وبين أصابعِ كلّ منها سيجارة "المزبّن" البيضاءُ النحيلةُ التي لم تشتعل بعد، فهي مفضلة بعد استكان الشاي مباشرة."
الحب في رواية صاحب ديوان "قارات الأوبئة" يظهر مقاوماً لظواهر الموت والدسائس التي كانت منتشرة زمن الرواية، الحب "ملاذ" كل رافضٍ لتلك الظاهرة القبيحة التي كانت تقترفها عصابات من الجهلة تحت غطاء شعارات سياسية... وليس عبثاً أن يختار المؤلف اسم "ملاذ" ليكون اسم حبيبته التي كانت شقيقة أقرب أصدقائه "مصطفى"... "الحبُ، أو مشروعُه بكلمة أدق، لم يحدث بسببِ نظرةٍ مفاجئة محكومة بالصدفة. بل حدث بواسطة حبّ آخر، أملتْه الصداقة العميقة... الذي صرتُ أشعر أن مصطفى هو شخصي في المرآة، لي كل الحقّ في أن أتأمّله دون حرج، وأحدّثه دون محاذير... في اليوم الأوّل الذي صحبتُه فيه إلى بيته، رأيتُ أخته التي تصغره سنة أو سنتين، تقف على عتبة باب البيت، تراقب أطفالاً، يحثون الترابَ على بعضهم البعض، وهي تبتسم. كانت بشرتُها صافيةً، وعيناها واسعتين بصورة تُلفت النظر، وقد عقدت شعرها البني الكثيف إلى الخلف... ما أن جلستُ، حتّى رأيتُها تُطل عليّ مبتسمة، لتسألني إذا ما كنتُ أرغب بشاي وماء..."
يرفض بطل الرواية حاضره، ويسميه بـ "الحصار" لذا يجد في قصة حبه مهرباً نحو الماضي، وكذلك الكتب التي تتحدث عن الماضي، يجدها أكثر نقاءً وأهميةً من حاضره... "شعرتُ أن شيئاً ما يفيض بي، حتّى خشيتُ أن يُربك في فمي الكلمات. كانت هي تنظرُ مبتسمة، وكأنها تُقبل إليَّ من بين دفّتي كتاب. "في الكُتُب، تتجلّى روح الماضي.."، قلتُ لنفسي، تخرج من دفّتي كتاب، وتجلس معي، لتبتسم.". وهو بهذا يمنح الماضي نظرة حميمية مسترخية وأكثر إنسانية، بينما يظهر الحاضر بالمقابل، كارثياً يُنبئ بمستقبلٍ دموي، لذا يصرّ بطل الرواية على أن حبيبته صورة جميلة عن الماضي، خرجت له من بين طيات الكتب التي تنتمي إلى الماضي الجميل...
فوزي كريم، الذي عرف منظر الدم وسحل الجثث في الشوارع وهو في الثالثة عشرة من عمره، عاش هول التناحرات والاعتقالات وأيضاً سحل الجثث وتعليقها على أعمدة الإنارة في شوارع بغداد، وهو على مشارف بلوغه سن الرشد... كل ذاك وغيره جعله قارئاً نهماً للكتب، كون ذلك يتطلب الإنزواء بعيداً عن الشارع، كما جعله قارئاً لمستقبل بلده، فلم يكن مستقبل بغداد في نظره إلا "مدينة نحاس" تقتل كل من يحاول تسلق حاضره بغية الارتقاء نحو المستقبل... "أن الكتب التي أقرأ، أبعد ما تكون صلةً عن الحاضر. والحاضر سياسة. والسياسةُ، كما يعرف الجميع، حافة سكين، ورصاصة طائشة، قد تتعرّض لها كل رقبة."... الشاب الذي قرأ مستقبل بلده، منذ حفلة الدم الأولى حين قُتِلَ الملك، وهو في الثالثة عشرة من عمره، لم يحد عن الصواب في قراءة مستقبله آنذاك حين رآه مصطبغاً بالدم، فما من يوم مرَّ على بلده بعد ذلك، إلاّ وكان الدم عنوانه... "الحاضر كتيبة مسلحة لمحْق الكائن، والمستقبل بعدٌ دمويٌ، وأكثر...". ذلك الحاضر المرّ، الذي يرى فيه صاحب كتاب "تهافت الستينيين" تهديداً لبقاء حبه حياً نابضاً بجماله الإنساني، كان يخشى من أن يبتلعه الحاضر الدامي، يخشى على نقاء حبيبته من كل الملوثات العديدة التي يتلاطم بها حاضرهما... "انتابني شعورٌ بأن كلَّ الذي يريد أن يحدث، إنما يحدث للإجهاز على مشروع حبّي هذا. يريد أن ينتزعني من الماضي، ويلقيني مُرغماً في المستقبل. يريد أن يلغي الكتاب بوجه "ملاذ"، التي طلعتْ منهُ إليّ. يريد أن يطمرَها كما يَطمر الماضي.".
ثم تنكشف عزلة ذلك الشاعر "غير المنتمي" لعصابة الحاضر، بأجمل صورها وهي تختلط بالحب والشكوى، لأضعف وأرق كائنٍ عرفه الإنسان، الأم التي لا تحتمل وجع أبنائها رغم تلمسها لذلك الوجع المرير... "إنني أفيضُ بالحبّ، يا أمّي. أفيضُ بحبّ فتاة، لعلّكِ تعرفينها عن بُعد، أو عن قُرب، لا أدري. ولكني على يقين من أنكِ، لو التقيتُما، ستحبينها بقدر ما أحبّها... ولكنني أفيضُ بالحزن أيضاً، أشعر بأني محاصرٌ، منذُ زمن، والحصارُ يضيق أكثرَ مع الوقت. كيف أستغيثُ بكِ، وأنتِ أضعفُ من أن تتحملي استغاثتي؟!".
ينهي فوزي كريم روايته بعبارة ظل مشهدها ماثلاً أمام ناظريه طيلة سنوات عمره، كما ظلت رائحة المشهد منذ مجموعته الشعرية الأولى "حيث تبدأ الأشياء" (1968) حتى آخر رواية له "مدينة النحاس" عالقة في كتاباته وذاكرته، يستنشقها أحيناً كثيرة...
"الجثثُ تُعلّقُ في ساحاتِ بغداد عبر تاريخها كلّه. تتعفن، ويستنشقُ العراقيون الرائحة."




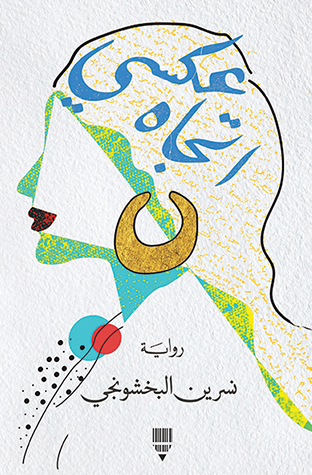



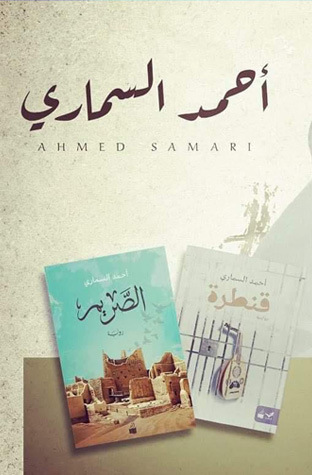
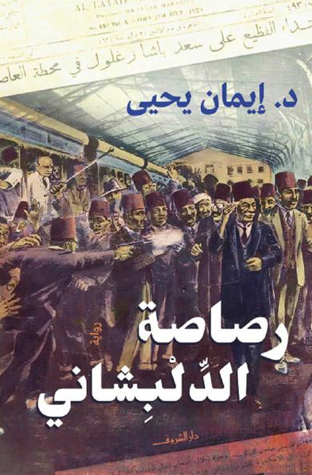
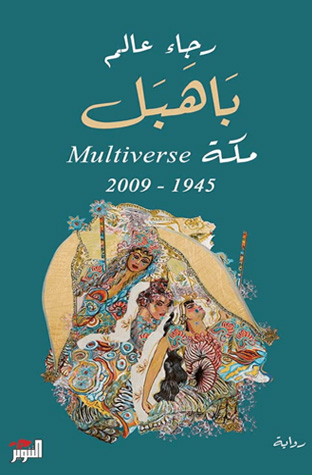



0 تعليقات