الحياة مجرّد وداعٍ طويل.. قراءة في "حتى مطلع الشغف" لموسى برهومة
لا شيء يمنح العين رؤية وهي مغمضة، مثلما تفعل الذكريات. ولعل ترك الشخصية الروائية تتذكر، لواحدة من التقنيات الروائية المفضلة لدى أي كاتب، لكن أن تطاردَ الشخصية ذكريات الآخرين، لتقوم هي بصنع روايتها الخاصة، فتشق غلاف الكتاب، وتنسج عالمها الخاص، وتتجاوز الصدق الفني في العمل الروائي لتنسلخ عنه وتبحث عن شكل لها في الواقع، يجعلها محسوسة لا مقروءة فقط، فهذه تجربة أكثر عمقاً وجدلاً. في رواية "حتى مطلع الشغف"* لمؤلفها موسى برهومة، يمكن العثور على هذه التجربة التي لا تتوقف عند حدود جرأة الشخصية الروائية، خصوصاً إذا كانت هذه الشخصية "البطلة" امرأة، تتجسد منذ الصفحات الأولى كأنثى تتذكر وتدرك وتطالع صورة البحر، ثم لا تلبث أن تسحبها أمواج الذكريات، ليذوب وعيها بين امرأة الماضي وامرأة الحاضر، ولينطلق الكاتب بعدها بجرأة فيحرق سفن الرجل ويترك المرأة تتمدد وحدها في جغرافيا نصه الروائي مثل جزيرة لم يصلها رجل من قبل. وعلى امتداد النص الروائي، الذي يسرد شيئاً من سيرة امرأة حطمت صخرة الطائفية بماء الحب الذي قطرته من الألم، فعشقت رجلاً من غير طائفتها، يطل بين حين وآخر من قصاصات ذكرياتها، ولا يحضر إلا إن حضرت أو حكت، ويغيب إن قالت هي أنه غائب، أو إن غابت، وباختصار، لا وجود للرجل "الحبيب، الخائن، الفنان، العادي"، إلا من خلال المرأة التي لا يمكن أن نعرف عنه أو عن وجوده شيئاً، إلا من خلالها. لكنها ربما، ليست امرأة واحدة، بل إنها وكما تسرد لنا الرواية فيما بين السطور: نساء، إذ يشي لنا تعدد المستويات في الرواية، من خلال الانزياح تجاه لغة فنية تراوح بين الشخصيات، مشبعة بالرؤى والمشاهد السينمائية واللوحات والإشارات الفلسفية، إضافة إلى تلك الفرويدية، التي لا تطفو على سطح النص وتكاد لا تظهر في الحوار بين الشخصيات، إنما تنساب في مسام الرواية لتعطيها رائحتها الخاصة والمميزة.
الرواية، تجسد بطريقة ما، خفيفة وجميلة، رسالة فرويد إلى تلميذته ماري بونابرت والتي تقول: "إن السؤال الكبير الذي لم يلق جواباً عندي قط، بعد ثلاثين سنة من دراسة النفس المؤنثة هو: بماذا ترغب المرأة". امرأة واحدة هي بطلتنا في هذه الرواية، وامرأة أخرى، تكتبها بطلتنا لتتداخل الروايتان، رواية داخل الرواية، وامرأة تفضي إلى امرأة أخرى، والبطلة في وحدتها أو تشظيها، بين الأنثى في داخلها، وأنثى أخرى، أو بين الماضي والحاضر اللذينِ يجمعهما الحب حتى يكادا يمشيان جنباً إلى جنب في الرواية، وبينهما، لا يمكن الإمساك باللحظة التي تتضح فيها رغبات البطلة. وربما إن هذه الرغبات ليست غامضة، بقدر ما هي متجاوزة للواقع وصروحه الصلبة، فهي رغبات متغيرة ومتبدلة، نابعة من المشاعر الشخصية للبطلة ومن ضروراتها التي يمليها عليها كيانها الخاص لا مجتمعها ولا بطله الأوحد "الرجل"، فهي تبحث عن حبها "داخل روايتها" والذي لا تريد له أن يتلاشى، كما لا تود لحبيبها أن يخبو، لا بسفره، ولا بأصابعه التي تعمل في النحت، فإن كان هو يحاول جعل الحجر ينطق كما قال مايكل أنجلو ذات زمن، فهي بالمقابل، تحاول على امتداد النص الروائي أن تقول للرجل: لا تُشكلني، بل اكتشفني. كسرت هذه الرواية بطولة رجل المجتمع التقليدي، واستحضرته من خلال المرأة التي برع الكاتب في إخفات وعي الرجل -الكاتب، البطل- لتركها تبرز طوال أحداث الرواية التي امتازت كذلك بالتحليق بعيداً عن الصندوق الذي يكدس فيه المجتمع العربي موجوداته العرفية أو الكلاسيكية إن صح التعبير. وبذاتِ المشهد المتسع للبحر، تنتهي الرواية كما بدأت، دون تصريح، ولا نهاية تحد من تأويلات القارئ، ولعل البطلة التي نافست الكاتب طوال صفحات الرواية في انتزاع روايتها الخاصة، ظلت هائمة في الأخير، تمشي مع ماضيها وحاضرها سوياً، وتتمظهر كل مرة، في امرأة مختلفة، وتدرك في كل مرة، أن الحياة تعاش إن كان هنالك حب، يقود إلى حيث يقود، لكنه بالتأكيد أبعد من الواقع الميت بمجرد إدراكه، وأطول من لحظة وداع تقطع الشغف لتجعل من عرفناه كأنه ماكان، ذلك أن الحياة، مجرد وداعٍ طويل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عاصف الخالدي: كاتب من الأردن.
- الرواية صادرة في يونيو 2017 عن المركز الثقافي للكتاب ببيروت، الرواية نت




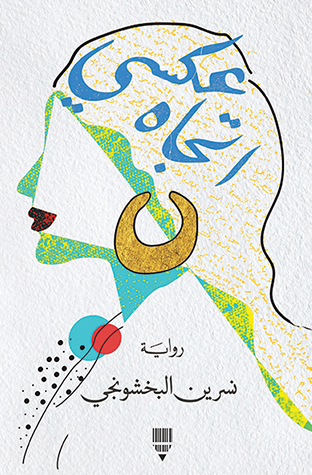



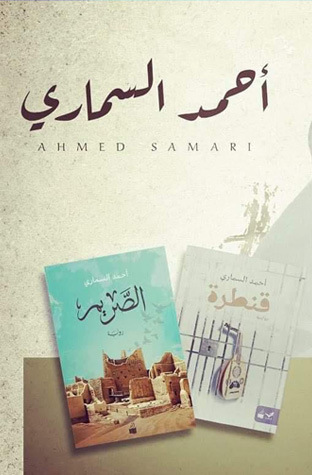
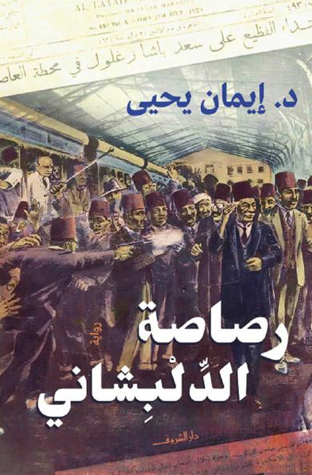
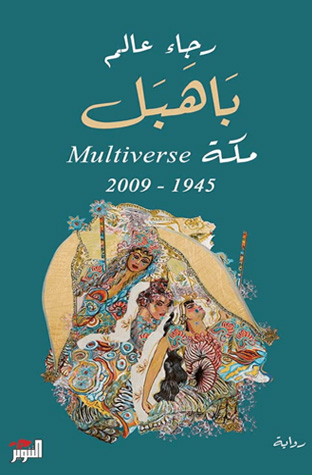



0 تعليقات