"لعبة السعادة، أو الحياة القصيرة لمراد زاهر" للجزائريّ بشير مفتي
الرواية السابقة لـ(بشير مفتي) كانت بعنوان: (دمية النار)). ففي الدمية ذاتها معنى اللعب. لولا أنَّ تلكم الرواية اقترب فيها الكاتب من كواليس اشتغال المخابرات، فحملت الرواية شحنة بوليسية وهو موضوع جديد -فيما أعلم -باستثناء محاولة (إسماعيل بن سعادة) في ((شيفرة من سراب))، (منشورات الشهاب، 2014)، وقد نُشرت من بعد، ولم تَرْقَ – في نظري- إلى درجة من النضج الكافي.
لقد حملت هذه الرواية الجديدة (منشورات ضفاف - بيروت، الاختلاف - الجزائر 2016) معنى اللعب بشكل صريح، ولكنَّه هذه المرَّة يجعل للسعادة لعبة. فكيف يحصل ذلك ونحن نعرف أنَّ السعادة هي حلم الإنسان ومأموله وقد لا يخطر بباله أن تصبح لعبة؟
ما يهتدي إليه الكاتب في صناعة السرد، أنه يستعمل ضمير المفرد المتكلِّم حيث يكون هو الشخصية وهو الراوي في آن. فما يكون أمام القارئ إلا أنْ يندمج - بدوره – في المكتوب، يَعْنيه الأمر كما يعني الكاتب/ الراوي. فإذا انتقل إلى ضمير المخاطَب (أنت)، وخلق مسافة بينه وبين المروي عنه، فهو لا يزيد إلا في استكمال الصورة ذاتها ولينْتشل عملية السرد من رتابة محتملة. فهكذا تبدأ الرواية:
الصمت أتقنه جيدا..
لكنه صمت خارجي، صمت يتكلم دون أن يسمعه الآخرون، صمت له عينان تراقبان العالم وتفكران في كل صغيرة وكبيرة، صمت له لسان باطني لا يسمع صوته إلا أنا بينما أترك للآخرين هامشا واسعا للحديث بطلاقة، للرغي دون توقف، والناس عادة تعشق الكلام، تحكي في كل شيء ولا شيء، هي بحاجة فقط إلى مستمع، إلى شخص يرمون عليه مشاكلهم، وهمومهم، وأثقالهم، وحتى أسرارهم)).
نندفع إلى تقمُّص شخصية (مراد) الطفل البدوي الذي عاش والدُه فلاحاً وشارك في الثورة ولم ينلْ شيْئاً. وهو الطفل الوحيد الذي قُدّر له أنْ يعيش وقد فَقَد والداه إخوة كثيرين قبْله. يحفظ ما تيسَّر من القرآن ويتردَّد على المدرسة. ولكن تشاء الأقدار أنْ يموت الوالدان تباعاً ليترك صفاء البادية وبساطتها عندما ينْقُله خالُه: (بن يونس) إلى العاصمة.
من هنا يخلق الكاتب حالة من التوتُّر والترقُّب تتمظهر في عدَّة مستويات. منها ما يخلقه ضمير المتكلِّم نفسه حين يحمل القارئ على أنْ ينغمس في حياة هذا الطفل/ الشاب لاحقاً. ومنها ما يأتي عن طريق مجموعة من الأسئلة ذات النزوع الفلسفي عن معنى الحياة والسعادة والفرق بين التكلُّم والصمت، وما إلى ذلك من القضايا التي تعترض الإنسان في حياته، سواء أصادفته طوْعاً أو كرهاً.
((لم تقم السعادة أبدا على الصراحة بل على الأكاذيب، كلما أتقنت الكذبة صرت سعيدا. الوهم والحقيقة مثل السعادة مجرد ألاعيب اخترعها البشر ليقنعوا أنفسهم بأشياء ليست بالضرورة صحيحة مائة بالمائة إلا في خيالاتنا، ولكن كم في خيالاتنا من حقائق هي جزء من جروحنا اليومية الكثيرة )).
غير أن ما يُعمِّق الإحساس بالتوتُّر هو هذه الأحداث التي تتشكَّل من خلال مقطوعات قصصية كلٌّ منها تتبلور تدريجياً لتنسكب في حياته. إذ التنقُّل من البادية إلى المدينة يُحدث شرْخاً واضحاً في مساره، وهذا الخال الذي يوفِّر له كل ما يحتاج إليه لم يكن ينوي إلا أنْ يجعله أشبه بعَبْد طائع ذليل أو لعبة توهِمُه بالسعادة.
يرسب في امتحان الباكالوريا، لكنْ بسبب يد خاله الطويلة ينجح بعد عملية تزوير على حساب تلميذ آخر يُقْصى ظلْماً وعسفاً، ما يجعل هذا الحدث يؤرِّقه أينما حلَّ.ويقبل طائعاً أنْ يتزوَّج ابنة خاله (نور)، بعدما حملت من شاب آخر هَجَرها، وبنسب الموْلود إليه. ثم يقضي أيامه ولياليه منشطراً بيْن (نريمان) التي أحبَّها حبّاً شديداً وبين وضعية ليس مقتنعاً بِجَدْواها.
إن هذه الأحداث وغيرها، تثير لديْه تساؤلات متوالية كما تثيرها بالقدْر نفسه أو أكثر لدى القارئ، فنعجب لهذا الشاب الذي لم يكن قادراً على أنْ يتَّخذ الموقف اللازم في الوقت المناسب وانساق وراء ما يُمْليه القَدَر حتى صار عديم الشخصية.
وتتخلَّل هذه الأحداث فقرات يختار فيها الكاتب ضمير الغائب حيث يخلق مسافة بين الكاتب/ الراوي والمروي والمروي له. وكأنَّه يعيدنا إلى ما يُشبه الفقرتيْن اللتين افتتح بهما الرواية، إحداهما لـ (عبد الرحمن منيف) يقول فيها: (( أيها الغريب الذي لا مأوى له، مأواك في عيْنيّ، في هاتيْن العيْنيْن سأجعل لك أرجوحة، وفي هذه الأرجوحة تقضي ما تبقَّى لك من العمر ولن تندم)).
والثانية لـ (فرانز كافكا) وتنتهي بالقول: ((فالنوم هو أكثر المخلوقات براءة، والرجل الذي يهجره النوم هو أكثر الرجال ذنوباً)).
قد يعني ذلك حين نتتبَّع مسار (مراد)، أنَّه ظل غريباً على المدينة وعالم خاله، ولم يستطع أنْ يحسم في خياره حين لم يبقَ في عينيْ (نريمان)، فكان – حتْماً- سينتهي فريسة للندم.ولم ينعم بالراحة أيْضاً، ما جعل حياته قصيرة كما يعلن عن ذلك العنوان الفرعي للرواية.
لكنَّ حياة خاله تمثِّل نافذة على تاريخ الجزائر غداة الاستقلال، حيث سطا كثيرون على الفيلاَّت والفنادق والمقاهي، وانقلاب 1965 والخطاب الاشتراكي في السبعينيات والتيارات المختلفة في أوْساط الطلبة بالجامعة وغيرها، وتبقى "الشرعية الثورية" مطيَّة للنهب وفرض السيطرة من قِبل أقلِّية أنهكت العباد وخرَّبت البلاد. ويسمع من خاله دروساً لم يصادفها لا في المدرسة ولا في الجامعة.
(( شيء لا يصدق، ولكن متى كان يمكن تصديق الأشياء التي لا نعرف خلفياتها جيدا؟ لو سألت خالي لقال لي: لعبة السياسة، لعبة الحكم.. افترسهم قبل أن يفترسوك، كلهم قبل أن يأكلوك، تغذى بهم قبل أن يتعشوا بك، السياسة حرب، وليست لعبة تسلية)).
تجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أنه إذا افترضنا أن (الطاهر وطار) كان أول من دشَّن موضوع الكتابة عن الثورة برؤية مختلفة في الرواية المكتوبة بالعربية- وبغض النظر عمَّا لروايته:لا((اللاز)) من قيمة أدبية لا تُنْكر - إلا أنه لا بد من الاعتراف أيْضاً، بأنَّ رواجها يعود في جانب كبير منه إلى مفعول الدعاية السياسية. وينسحب ذلك على آخرين ممَّن كانت تُشتمُّ في كتاباتهم رائحة الخطاب الاشتراكي يومئذ.
لذلك، فإنَّ الكُتَّاب الذين مازالوا يندفعون إلى طرْق هذا الموضوع، يتوهَّمون أنهم يُفْشون أسراراً مُغَيَّبَة ويكفيهم أنْ يُقحموها في أعمالهم، بينما قد أصبحت مشاعة بين الناس في بعض كتب التاريخ وبعض المذكّرات. ما من شأنه أنْ يطرح صعوبات أمام الكُتَّاب في تحقيق أدبية الأدب من حيث طبيعة اللغة وتقنيات السرد والتخييل. و(بشير مفتي) يمنح كلاًّ منها نصيباً فيسْري العنوان في تمفصلات النص ويحضر بأوْجه متمايزة كأنَّه تلاعب محزن بدُمية السعادة.
فمنذ البداية حتى النهاية، كلّما حاولنا أنْ نتوقَّع موقفاً يقطع مع التبعية لهذا الخال، لأننا نريد ذلك، تمادى في ارتكاب الأخطاء نفسها، ما من شأنه أنْ يزرع الشعور بالغضب والحنق على هذا البدوي الأحمق الذي لم يتعلَّم درْساً واحداً ممَّا وقع له. فانتهى نهاية مأساوية وهو في عزِّ الشباب. وكأنَ (بشير مفتي) يريد أنْ يخلص إلى أنَّ (مراد) نموذج الشخصية السلبية التي ليست لها الجُرأة لأن تقول (لا) وقد تبرّر ذلك بما يصنعه القَدَر، أو أنَّ الروح الانتظارية تقودها إلى أنْ تترقَّب طمعاً في الذي يأتي ولا يأتي.
بهذا المعنى تكون السعادة لعبة، لأنه يأخذها في صورتها الخيالية السريالية، أو كأنه يعبث بها لأنه لا يدرك مغزاها أصْلاً. بينما قد لا تكون سوى أشبه بأرجوحة تميل بك في شتَّى الاتجاهات، فإذا لم تطمئن إلى موقعك في هذا الوجود، فستكون- لا محالة- من النادمين.
هكذا مع تنامي الأحداث، يتنامى الشعور بالتوتُّر، قد تنخفض درجتُه في جلسة هادئة مع أصدقاء أو في سرير عشيقة محبوبة، وقد ترتفع إلى حدِّ الغليان حين يقبل بالزواج كرهاً أو يُعوِّل على خنق عشيقته.
لكن الذي يعين على الانتقال من جو إلى آخر في سلاسة ويُسْر، هو هذه اللغة البسيطة التي يعتمدها الكاتب كما في سائر رواياته.فهي لغة لا تَكلُّفَ فيها، وبحيث يمكن للقارئ أن يلتهم فصولاً بلا انقطاع إنْ هو لم يُكملْ الرواية كلَّها في جلسة واحدة. فاللغة التي تسمح بالاسترسال هي – فيما أرى- من العناصر الأساسية في التشويق.خاصة ونحن في زمن نشهد فيه زهداً في الإقبال على الكتاب.
قد يصحُّ القول، إنَّ الكاتب، إنما يكتب رواية واحدة في حياته مهما تَعَدَّدت أعمالُه، ما يُفسِّر ظاهرة التناص بين رواياته. لكني أجد أنَّ(بشير مفتي)- وإنْ لم يكن يشذُّ عن هذه القاعدة- إلا أنَّه يهتدي في كل رواية إلى مدخل مختلف وأجواء متميِّزة. وهو ما يحقق الإمتاع في ماهية الإبداع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كاتب جزائريّ.
الرواية نت




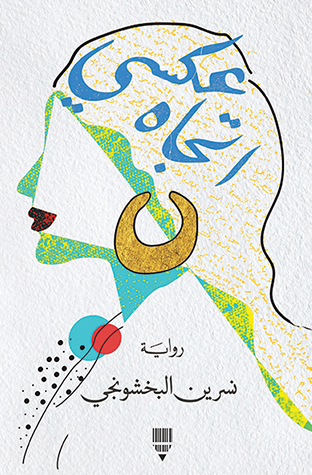



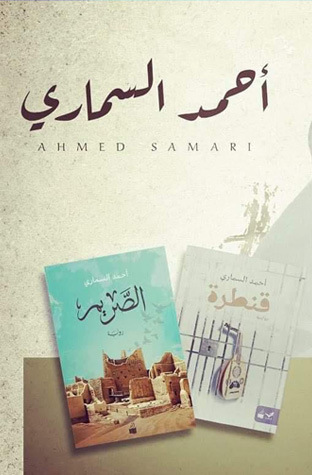
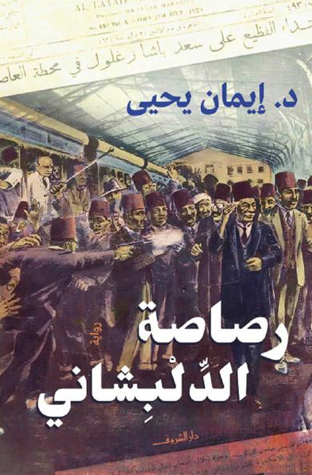
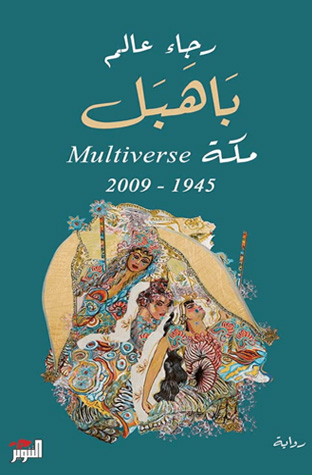



0 تعليقات