«حارس الموتى».. عنف الأحياء ومؤانسة الأموات
نفذ جورج يرق في «حارس الموتى» (دار ضفاف، دار الاختلاف)، روايته الثانية، إلى التخوم الأخيرة للعطب الإنساني، جامعاً بين مصير إنسان بريء في مجتمع غادرته البراءة، والحرب الأهلية اللبنانية ـ 1977 ـ التي حوّلت القتل إلى هواية وتجارة. تبدو الحرب، في تفاصيلها الروائية، تجسيداً للشر، وتظهر البراءة شواذاً ينتظره العقاب. يتعيّن النظر الروائي، في الحالين، ترجمة لشر إنساني متعدد الوجوه، يقول: إن صحبة الموتى خير من مصاحبة الأحياء. ومع أن في حكايات السرد الروائي ما يعلن عن الشر، فإن في المقولات الفنية، التي أدرجها «يرق» في روايته، ما يفصح عن نظر روائي مأسوي بامتياز، كما لو كانت الحرب حالة من حالات الخراب الإنساني لا أكثر. لذا تنطوي الرواية على المصادفة والمفارقة والكابوس، وتأخذ شكل رحلة من البراءة إلى «الإثم الكامل»، يتكامل فيها «شر الوجود»، الذي قوامه المصادفة، وشرور المجتمع الموزعة على حكايات متوالدة. تستهل الرواية بجملة واضحة محدودة الكلمات: «المصادفة وحدها مسؤولة عما أعانيه الآن»، حيث في المصادفة ما لا يعد بخير، وفي كلمة «الآن» حكاية مأسوية لم تنتهِ. جمع الاستهلال بين البراءة والخوف الواسع الذي ألجأ الخائف البريء، إلى «ميليشيا»، تصطاد البشر. وصولاً إلى فضاء كابوسي، يوحّد بين الملهاة والمأساة عنوانه: المستشفى، الذي قد يقتل البشر وهو يعالجهم، ويصيّر الموت، إلى صناعة وتجارة.
مصادفات في البدء رعب المصادفة، الذي أفضى إلى رعب الحرب، المتمدّد في رعب المستشفى وطبائع بشرية مرعبة. تستكمل هشاشة الإنسان البريء بعنف المصادفة، ويذهبان معاً في رحلة سوداء منفتحة على الموت. تظهر المصادفة شراً بذاتها، فعلاً أعمى يصيب بالعماء من وقع عليه. أضاء السارد عماء المصادفة بهشاشة الإنسان الذي وقعت عليه، فهو أقرب إلى السذاجة، ينفر من السلاح ويهوى القراءة، طالب فلسفة، يعرف الجريمة من طريق القراءة، ما جعله قارئاً لروايات «أغاثا كريستي» البوليسية، التي تتهم شخصيات متعددة وتفصح في النهاية عن قاتل غير متوقع. يشبه فضاء الرواية البولسية فضاء الحرب، مع فرق بينهما، ذلك أن القاتل في الحرب يظل مجهول الهوية، ترى آثاره ولا يُرى، ولذلك يقول البريء، الذي تعرّف إلى «الملاعين» في الثكنة وخارجها: «خطفني الملاعين»، كاشفاً عن مصادفة أخرى، تردي البريء قتيلاً، إلا إذا أنقذته مصادفة أخرى، لا تعترف بمعاناته على أية حال. تبدأ المصادفة فعلاً ساخراً، ومميتاً في سخريته السوداء، تسحب الإنسان من طريق اختاره إلى آخر لم يقصده. يقول السارد: «أذكر أنني كنت أجهز جثة وقت نزول ضربة قوية على رأسي» وأذكر «الصليب المحاط بلمبتين، وصلباناً كثيرة متلاصقة وعدداً هائلاً من اللمبات». لا مكان للبراءة في زمن آثم، ولا مكان للسيد المسيح في زمن تجار الموت. تحايث المصادفة السائرة من معاناة إلى أخرى مفارقة صاخبة واسعة القهقهة، مصرّحة بعطب إنساني لا يداوى: فالرجل الدامي الوجه، في مستهل الرؤية، يتهم شاباً لا يعرفه، والمسؤول العسكري الذي مع جنوده «يدافعون عن شرف الوطن»، يشرف على عمليات السرقة والاغتيال، والشباب المسلحون يضجرون من الصمت ويطلقون النار على العصافير، وطبيب المستشفى تاجر قبل أن يكون طبيباً، والراهبة الجميلة، تتهاون في شؤون الدين والدَين معاً. بيد أن المفارقة تتكشف واضحة، في أقدار الإنسان البريء: كلما ابتعد من مواقع الخطر، دخل إلى عالم لا أمان فيه، كما لو كان بحثه عن النجاة بحثاً مجتهداً عن الهلاك. لا غرابة أن يكون صديق الإنسان البريء، هو القتيل الوحيد الذي يغتاله «الرفاق»، الذين يساوون بين الزحف على الوحل و «الصلابة القتالية». أعرب السارد، في منظوره الرومانسي الأخلاقي، عن يأس صريح متوسلاً متواليات حكائية تلامس، بحزن ورهافة، معاني التعليم والمدرسة والسياسة والدين والطـب والإدارة، تعطف الملهاة على المأساة، وتمزج التشكي بالصمت. تجلّى اليأس الصريح في مآل البريء، الذي وجد راحته في مكانين تسكنهما المفارقة: المتراس، الذي يستحضر خوف الموت ويستعيد خوفاً أكثر سلطة عنوانه: الخوف من البشر، وغرفة الموتى في المستشفى التي يسكنها الموت. لم يضف جورج يرق «فلسفته» إلى الرواية، إذ شر الوجود قوة لا تهزم، إلا مصادفة، بل اشتق من علاقاته الروائية شراً إنسانياً، رحيباً مقترباً، بقصد أو من دونه، من نجيب محفوظ وكافكا وأفكار شوبنهاور وكيركجارد. لكأنه يقول: يسير الإنسان إلى ما لا يعرفه، ملبياً أبعاد روحه المعتمة، كما لو كان الإنسان ينسى التعاليم المضيئة قبل أن يقرأها. ولذلك تبدو «حارس الموتى» رواية مضيئة ومعتمة في آن: مضيئة في القول الأخير الذي وصلت إليه، و «معتمة» في التفاصيل الكثيرة التي أفضت إليه. ولعل عتمة الروح الإنسانية، التي لا تبدو أليفة إلا في هوامش بسيطة، هي التي جعلت من المصادفة، كما المفارقة، بطلاً من أبطال الوجود، واستدعت ثنائية المرئي والمحتجب، إذ في «كرم المسؤول العسكري» رصاصات قاتلة، وفي الممرضة المسربلة بالبياض تهتك لا يرى، تعبيراً عن الإنزياح المأسوي الذي يضع البريء في مواقع لم يسعَ إليها. شيء قريب من «عبث الوجود»، اختصره السارد في المستشفى، الأقرب إلى «الكباريه»، كما يقول، وفي «برّاد الموتى»، الذي هو موضوع وإشارة: غرفة تستقبل الجثث، ومكان للإرتزاق والتلصص و «تجميل الموتى»، قبل أن يستقروا في المأوى الأخير. أخذ المستشفى شكلاً قريباً من «الأمثولة»، فهو معرض بشري للأحياء والأموات، يحتشد فيه الجشع والخداع والربح والخسارة وتجارة الدواء، وموقع «لحكايات التجاذب الجنسي». رفع يرق «غرفة الموتى» إلى مقام الأمثولة الكاملة، واشتق منها عالماً فنتازياً، تحوّم فيه همهمات الأموات ورغبات غامضة، يخيف حال دخوله، يغدو أليفاً لاحقاً، يوزع الرزق والأمان والصمت وصراخاً لا يسمع. يصبح البريء، الذي انتهى إلى عمل مع الموتى، حارساً للجثث الباردة وحارساً لخوفه ورزقه، بعد أن دخل إلى مهنة «تجهيزات الأموات»، التي تعني تصفيف شعرهم وحلق ذقونهم وتأمل لباسهم والتكسب «بأسنان الذهب»، التي لا يحتاج أليها الذاهبون إلى القبر. استولد السارد من غرفة محدودة المساحة عالماً شاسعاً، مخيفاً ووديعاً، يأنس إليه المطارد من الأحياء: «أصبح البراد هو المكان الوحيد الذي أجد فيه الدفء والأمان». سخرية سوداء باذخة، ومتخيل سوداوي يتحاور فيه الأحياء والأموات بألفة وهدوء. يكاد البريء المتهم أن يصبح في صحوه جثة، يقطع النهار بالحديث مع جثث «ينظفها»، وأن يغدو في «مناماته» كائناً ملتبساً لا هو بالحي ولا هو بالميت.
أموات - أحياء اقترب يرق في «منامات حارس الموتى»، من المتخيل المرعب، الذي يتهكم فيه الأموات على الأحياء، ويستعير فيه الأحياء من الأموات «ملابسهم» وحكاياتهم. لذا احتل «عالم الأموات في المستشفى»، وهو ذروة الرواية ومركزها الإبداعي، فهو نواة الحكاية الصلبة، التي تعقب «نواة الحرب» القريبة من «وثيقة تاريخية «معروفة التفاصيل. أملت «نواة الحكاية الكبرى» على الحركة الروائية أن تسير صعداً، بالمعنى الحكائي والمكاني، فبعد القرية المتخاصمة تأتي هوامش بيروت الفقيرة، تتوسطها «صناعة الحرب»، وصولاً إلى الحقيقة الأخيرة الماثلة في «برّاد الموتى» الذي ينتهي إليه حصاد الحرب والحياة. كما لو كان «برّاد الموتى» هو البداية والنهاية، وكان المتهم البريء شاهداً على عبث البداية ومأساوية النهاية. يقول السارد في مستهل كلامه «المصادفة، وحدها مسؤولة عما أعانيه الآن». كما لو كنت تلك «الآن» بداية ونهاية: بداية على خوف جاء على غير موعد، ونهاية تمتد فيها البداية ولا تعد بالأمان. لا فرق إن كان الجسر مكاناً معروفاً يتراكم تحته الموتى، أو جسراً رمزياً يمر فوقه العابرون «إلى مكان ما»، ومنهم المتهم البريء «عابر»، تلك الكلمة «الفاتنة» التي تجمع بين الأسى والسؤال، فالعابر يستقر في لا مكان. أنجز جورج يرق، في «حارس الموتى»، رواية متميّزة عن الخوف، متوسلاً إيقاعاً فنياً متصاعداً، يخترق القرية وضواحي المدينة ورذائل الحرب و «عالم الموتى»، الذي ينطوي على الرعب الذي يسبقه، منتهياً إلى لحظة عبور ملتبسة، ولا يفلت الإنسان منها إلا مصادفة. نفذ يرق، وبإحكام أقرب إلى الندرة، إلى «حقيقة» الإنسان الخائف التي تتراءى في بعدين: يضع الخوف الإنسان خارج ذاته ويصبح غريباً عمّا كانه، كأن يصبح البريء الذي يحنو على العصافير «مجهّزاً للجثث»، مذكراً بشخصية البطل المذهول في رواية «المحاكمة» لكافكا. أما البعد الثاني فهو أكثر رعباً عنوانه: الإنسان اللاّمرئي، حيث الخائف يفتش عن مكان لا يراه فيه أحد، أكان متراساً، أو غرفة باردة. أنتج يرق، بعناصر فنية متعددة، فضاء كابوسياً، لا نعثر عليه في الرواية العربية إلا مصادفة، ناشراً متخيلاً «أسود» خصب التفاصيل، يغدو فيه الكابوس شخصية أليفة من شخصيات الحياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن صحيفة الحياة اللندنية

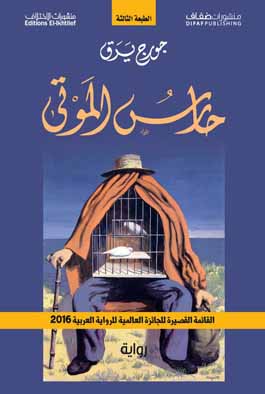


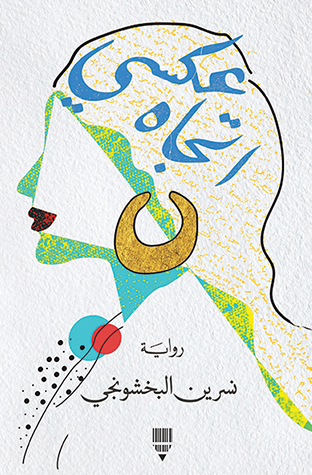



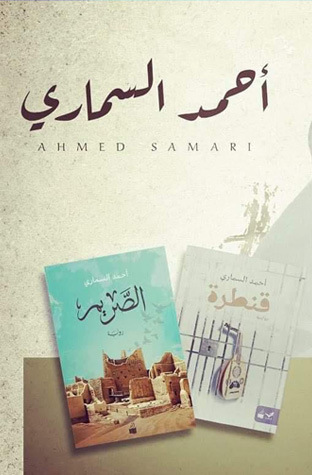
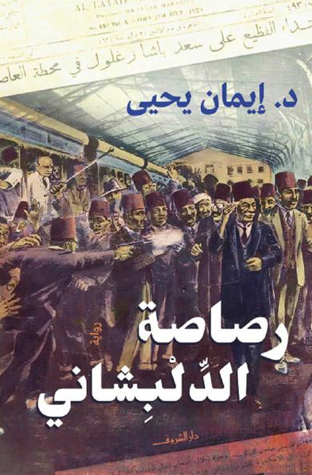
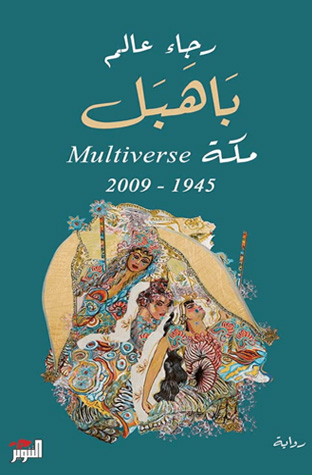



0 تعليقات