(يدان لثلاث بنات) لعبد الرزاق بوكبّة.. أن تكتب السّيرة صاحبها
إن رمزية العنوان وتفكيكها هي من قبيل الولوج إلى المعرفة المنتجة على ضفاف النص الذي تشترك فيه جملة من العناصر. وليست من قبيل النص في حد ذاته باعتباره عملا خاصا بكاتبه، أي أن الاهتمام بالرمز تفكيكا وفهما يثري القراءة وينمّي فعل النقد البنّاء لأن ما يُنتجه النص من فُهوم يختلف عن النص ككتلة أو جنس أدبي معيّن. هذا المنحى هو الذي مهّد للقراءة وفق المنهج المندوري، نسبة إلى محمّد مندور، باعتبار النقد التأثري (الانطباعي) ملائما لما جادت به قريحة عبد الرزاق بوكبّة بين ثنايا الكتاب، لأنّ التعامل مع كاتب منفردٍ بأسلوبه يقتضي إيجاد السُبل المساعدة للتفاعل معه وفق ما اختاره هو، أي بمنطلق المرافقة في الأخذ والرد وجعل النص في سياقه العام وفضائه المنتج فيه؛ لا بمنطلق الوصاية في القراءة وإجبار القلم على امتطاء الأنامل حسب مزاج معيّن أو أمزجة الفهم ممّا يجعله آئلًا إلى اللّافهم، أو الخوض فيما لا يمكن الخوض فيه أهليّةً وآليّةً. لذا ستكون القراءة وفق ما انطبع في الذهن دون تعقيد؛ ولا بجعل النص خارجا عن إطاره العام الذي رسمه بوكبّة باعتباره البؤرة الدلالية في الكتاب. لقد غصت في الكتاب وفق ما انطبع في ذهني من الوهلة الأولى؛ فالقصص التي ذكرها بتسلسل فريد من نوعه وانتقاله من زمن لآخر مع المحافظة على الفكرة الرابطة بين الزمنيين، والقاموس اللغوي المستعمل والذي أظهر حقيقة الجدل القائم حول وظيفة اللّغة ومفهومها. ولأن كتاب بوكبّة يندرج ضمن أدب السيرة (ذاتية) فقد نتساءل عن جدوى القراءة النقدية أو حتى أحقيّة ذلك؟! فالسيرة تخص صاحبها ولا يمكن أن نخضع نصه للنقد أصلا. لكن هذا الطرح لا ينبني على أسس معرفية ولا علمية، فالكاتب ليس ملكا لنفسه وما ينتجه في الأجناس الأدبية يشكل الأدب (الحياة) ولا حياة دون الأدب وعناصره الرئيسة، فسيرة بوكبّة (باعتباره شخصية أدبية جزائرية لها حضورها في الكتابة والإعلام) هي بمثابة التجربة التي يتعلم منها الشباب معنى التدرّج المعرفي والمكابدة من أجل الوصول على المرام والثقة في النفس وتنمية الوسائل التي مُكّن منها من يرى نفسه مشروع كاتب أو شاعر أو في أي فن من الفنون. والأكثر من هذا فإن العناية بأدب السيرة وإخضاعه للقراءة النقدية يجب أن يلقى العناية من القائمين على شؤون الدرس الأدبي؛ وينتقل ذلك لفضاءات أخرى كأن تُدرج مثل هذه النصوص المحلّية وقراءاتها النقدية في مناهج التعليم للتلاميذ حتى نؤسس لروح القراءة والتفاعل بين طالب العلم وأهل الصنعة.
أدب البيت؛ نشرُ للغسيل أم انفتاحٌ معرفي؟
1- يخوض الكُتاب المهتمون بالأدب والفكر جملة من التحديات تتعلق بطبيعة النصوص نفسها (الجنس الأدبي) وبطريقة إخراجها؛ وتختلف الاهتمامات باختلاف رباط كل واحد منهم، وحين يُنتج الكاتب أو الأديب نصا ما ويخرجه للقارئ فتتكون العلاقة الطبيعية بين الكاتب/ النصّ/ القارئ، وقد تتعدّاها إلى علاقات أخرى يتحكم فيها النقد الذي ينبني على أسس تجعل العمليّة (القراءة) أكثر ثراءً، ولأن النقد هو العلاقة التي يقيمها العقل مع النص فإن النوع النقدي الذي يُكتبُ له الحضور له هو النقد الأكاديمي الذي يختلف تماما عن النقد العادي (الصحفي مثلًا) والانطباعية كمدرسة نقدية تنبني على أسس معرفية علمية إذ أن الأثر الذي يتركه النص في ذهن القارئ يمر على الذوق، فتتشكل العلاقة الحميمية أو التشاكسية مع النص. والجنسُ الأدبي مُتخم بالأدبيات نفسها تتزاحم فيه كتزاحم الفكرة واللغة لدى الكاتب؛ وهذا ما لاحظته في (يدان لثلاث بنات). فالنص من أدب السيرة في جزئية أدب البيت، ولكن ليست بتلك الصورة النمطية المسوقة أو المستوردة في أدبياتنا، إذ أن لمسة بوكبّة جليّة بين ثنايا ما خطّته أنامله، فتعدد نمط النص وشمل معاني جمّة وسّعت مفهوم أدب البيت إلى مفاهيم وفضاءات أخرى (الأناسة/ الثقافة/ الاجتماع). قد يتساءل البعض: لمَ قام بوكبّة بهذا العمل الذي نَدُرَ حضوره في أدبياتنا وثقافتنا؟ أليس هذا خروجا عن المألوف أو انزياحا أدبيا من منه؟ أو كيف نقرأ نصّه أو نسلّط عليه قراءاتنا النقدية وهو من قبيل الإحساس والشعور الذي لا يصل إلى مستوى الوعي باعتبار النص (خربشات يومية)؟؟ وهل نشرُ الغسيل وإظهار خصوصيات العائلة يخدم الكاتب نفسه فضلا عن القارئ؟ مثل هذه التساؤلات موجودة ولا يمكن إنكارها لأن التراكم يُنتج اللافهم في كثير من الأحيان، إذ أن إهمال وإغفال هذا النوع من الأسئلة يوسّع الفجوة بين الكاتب والقارئ.. وقد ينحى آخرون منحى مخالفا تماما: كأن يكون نص بوكبة وما فيه من إشارات ورسائل واضحة من جهة ومشفرة تحتاج تدقيقا ونبشا من جهة أخرى قد يكون انفتاحا معرفيا ومسلكا سلكه في عالم الأدب، ليؤكد أنّ الأدب والفكر لا سقف ولا تسقيف لهما ولا يمكن أمزجة النصوص حسب مزاج الناقد والقارئ، فالكاتب إنسان وأب ورب أسرة وله ماض وحاضر وبينهما مد وجزر من الأحداث، هذه الأخيرة قد تكون ذكرى بالنسبة لمن لا يرى الأشياء بوضوح أو لمن لا رسالة له، لكن الأديب والكاتب المتمرّس يراها بعين أخرى وبتحليل آخر فيُخرجها إخراجا مختلفا، وهذه هي ميزة ٌ لا يمكن تجاوزها. وبين الطرحين يمكن القول: لا يمكن أن يكون الكاتب (حسب رأيي) غير متشبّع بقيم الأناسة، يذوب فيها كما تذوب الشمعة للإضاءة.. إضاءة الفُهوم والعقول في زمن يحتاج الإنسان فيه نماذجَ تشتغل على هذا المسلك. وبالعودة إلى الإهداء يحيلنا الانطباع الأولي إلى ولادة أخرى تحدث عنها الكاتب، ولادته هو في قالبٍ جديد لا يستشعر معانيه إلا من عاشه عن قرب، أو تغلغل بجوارحه داخله. ولادةٌ ممازجة مع تواريخ ولادة بناته الثلاث علياء نجمة ومريم. ولادةُ روح جديدة دبّت بين شعور الكاتب ووعيه. بين الأُبوّة والرسالة. بين بوكبّة إنسانا وبوكبّة أديبا (إنتاجًا ورسالةً). - ولو أنّ مهتما بأدب الرجل قد همّ بدراسة ما أنتجه طيلة مسيرته الأدبية والإعلامية لاكتشف (بالفطنة والتمحيص) شخصية بوكبيّة أخرى ما بين 2009 – 2014 تواريخ ازديان فراشه بفلذاته كبده الثلاث- لذا لا أرى مذهب الرأي الأول من النقد في شيء. فالكاتب ليس ملكًا لنفسه وليس الإشكالُ في نشر غسيل بيته وخصوصيات حياته، وإنما الإشكالُ في طريقة العرض والتي أرى أنّ عبد الرزاق قد وُفّق إلى حد بعيد فيما أراد تمريره. ولا يقتصر الأمر على مضمون الكتاب والقصص التي أتى عليها بأسلوب مكثّف يُميّزه عن غيره من الروائيين والأدباء بل يتعدى الأمر إلى شكل النص، فالانتقال من حادثة راهنة إلى الماضي ليس بالأمر الهيّن، لأن الخيال الأدبي الجمالي المرتبط بالذاكرة لا يُؤتى إلا للنبيه كما قال الأديب محمد الخضر حسين. لذا نجد قصّة عن حادثة تخص فردا من أسرته فيعالج بها في سطور مسألة تربوية أو نفسية، ثم يحيلك مباشرة على الماضي وما فيه من عادات وتقاليد، فيجعلك تقارن بين النموذجين في الرؤية والتحليل والفهم أو يعرّج على ظاهرة اجتماعية، فينتقل بك إلى الزمن الماضي في تصوير دقيق فتتسع دائرة الفهم ويُغذى الذوق ويُثمّن العمل نفسه. يذكر بوكبّة مثلا: أن مريم تعشق مشاهدة التلفاز ولا تتنازل عن لوحة التحكم ولا عن برامجها المفضلة وهذا ما يجعل البيت في فوضى عارمة وصراخ البنات مما يشوّش عليه هو الذي كثيرا ما يعتكف داخل مكتبته إما حاملا قلمه أو في صراع وحوار مع شخوص روايته أو ينكب على كتاب ينهل منه. فيكون في موضع لا يُحسد عليه بين مسؤولياته كأديب (رسالي) وكونه أبا مسؤولا عن أسرة؛ في مثل هذه المواقف ينقل لنا بوكبة القصة وتعامله معها، فتكتشف شخصا آخر له حضور في النفس البشرية وطرق التعايش مع رغباتها. وحضورٌ في الاجتماع بتعريجه على قصة من قصص طفولته، فيذكر الشاهد من القصتين بترابط فريد من نوعه. كأن يذكر تعامل والده مع خطأ ارتكبه أو مشاغبة منه أو خروجه عما ألفته العشيرة آنذاك، فيربطه بموقفه وتعامله مع العناصر المشوشة عليه في خلوته مع شخوص روايته أو العناصر التي هي في الأصل ولادةٌ له أو قيمة مضافة له في حياته الأدبية. لذا فالتعامل مع النصوص وفق المنهج النقدي الأحادي يُهمل الكثير من الرسائل المؤسسة للأدب وأبعاده الوظيفية، ولو ضُيّق النظر وأُمزجَ الفهم ونُسج على منوال معيّن لما توسعت دائرة الفهم ولَاِنحصر في مفهوم كلاسيكي يكون بمثابة التراكمات الموجودة في الأدبيات (راكدة/ وافدة) مفهومٌ تقليدي وُلد من رحم نظرية (الفن للفن مثلا) أو إسقاطا على نص ما أُنتج في سياق مخالف. وهذا ما يجعل النقد التأثري الأنسب للقراءة النقدية التي باشرتها مع الكتاب.
2 الفلسفة البوكبيّة في النقد الاجتماعي. الأديبُ ناقدٌ في الآن نفسه إذا امتلك الرؤية العميقة في التحليل والطرح، فيمزج بين الإبداع في النص والعمق في الرسالة، وهذا لا يعني التزاحم بين النقد والأدب في صورة واحدة (النص) وإنما يقتصر على حضور الكاتب في النقد (اجتماعي سياسي ثقافي ديني) ومن خلال النصوص التي ذُكرت في الكتاب يمكن الخلوص إلى فكرة الحضور النقدي لبوكبّة، وارتأيتُ أن أسمّيها (الفلسفة البوكبيّة في النقد الاجتماعي) اختصرها في شريط الذاكرة (فلاش باك) وسآتي على الأمثلة التي تؤكد هذا الطرح:
- يذكر لحظة تعرّض الوالدة للضرب من طرف الوالد لمجرّد تشويش منها على القيلولة أو تأخر في طهي الطعام وهذا لا يعني التحامل على الوالد أو نشر الغسيل كما سبق، ولكنه تعريج من الكاتب على وجود الظاهرة التي انتشرت في المجتمع الجزائري المحافظ الذي كان يرى المرأة تابعا لا عنصرا مكمّلا، لذا تظهر شاعريّة الكاتب حين يتكلّم عن بناته ومشاكساتهم وعلاقته بهم في التوجيه والتوفيق بين حياته الأسرية وحياته الأدبية.
- اللحظات الجامعية التي يلتقي فيها مع طلبة متشددين (خاصة فترة التسعينات) والنقاشات التي تؤول دوما إلى طريق مسدود لاختلاف وجهات النظر وعدم وجود قابلية للأخذ والرد والنقاش المثمر، فتظهر فكرة بوكبة حول مفهوم الحرية الشخصية والاحترام الذي وَجُب أن يتحلى به الإنسان. ففرض الرأي والفكرة قد يجعل المفروض عليه كافرا بها في قابل الأيام، وهي دعوة من الكاتب إلى التحلي بالرصانة والهدوء في النقاش واحترام الخصوصيات وعدم المزايدة على تديّن الناس وانتسابهم إلى خط الإيمان.
- العادات والتقاليد السائدة في القرية والتي لا يمكن مناقشتها ولا الخوض فيها، يكون فيها كبير القوم وصيّا على الخلائق وتكون الوصاية بأسماء متعددة (باسم الدين في الغالب) ويحاول الكاتب أن يفرّق بين الشرع أو الفهم المُنتج على ضفافه والعرف المناقض له وهذه مهمة المثقف التي هو كفيل بها. فالمشهد الذي رسمه عن قرية (أولاد جحيش) يعتبر صورة مصغّرة عن المجتمع الجزائري في حقبة زمنية لطالما شهدت تغيّرا في المفاهيم والظروف المشكلة للحياة عامة (اقتصاد.اجتماع.ثقافة) فيوم عاشوراء مثلا وما ارتبط به من عادات وتقاليد كوّنت وعيا في القابل عن هشاشة بعض المفاهيم التي تحتاج إعادة نظر. (البوسعدية نموذجا)
- يحتاج الكاتب في لحظات عديدة إلى الخلوة، فيرتّب أوراقه من جديد، فالخروج من الضوضاء إلى العزلة على فترات هو بمثابة الجرعة التي تجعل المسيرة تكتمل لاحقا، وهذه ميزة لازمت الكثير من الأدباء والمفكرين.. ويظهر هذا الصبر والجلد في أصحاب التجارب إذ يذكر الكاتب يوميات رعي الغنم وما فيه من قيم تاريخية إسلامية (سيرة النبي) وقيم اجتماعية واقتصادية، لأن القطيع في القرية يمثل الاجتماع المُؤني والزاد المعتمد عليه في العيش وكل تخاذل أو تغافل في تحمل المسؤوليات تجاه القطيع يؤدي إلى خلل في السيرورة العامة. لذا تنشأ روح الكاتب من هذه الجزئيات التي نهملها في الغالب، أو لا نعيرها اهتماما. وقد تتنوع وتتعدد من بيئة لأخرى.إلا أنّ الفكرة الرئيسة تربط بين صبر المثقف والكاتب في رسالته وبين تكوينه العفوي الذي تتداخل فيه جملة من العناصر التي أخرجته بالصورة التي هو عليها.
- الخلافاتُ الشعبية ذات البعد الإيديولوجي التاريخي التي نخرت المجتمع وحالت دون الوصول إلى رؤية واضحة دافعة إلى تصحيح المسار؛ أشار إليها الكاتب من خلال ذكر الخلاف بين العرب والأمازيغ وما يترتب عنه، والقصة الواردة في النص عن المشهد بين الحمار والأتان هو تدقيق في غاية الأهمية؛ إذ يلمّحُ الكاتب إلى سذاجة الصراع في صورة بهيميّة، فكلما تخلى الإنسان عن العقل إلا وكان أقرب إلى البهيمة؛ هذه البهائميّة لطالما حالت دون وجود مشروع مجتمع متجانس يؤمن بالاختلاف وفقه التعايش، وهنا تظهر الفلسفة البوكبيّة في النقد الاجتماعي كما أسلفنا. فالمثقف يرى ما لا يراه غيره من العامة، فيستحضر مجموعة من الآليات (المعرفية والرسالية) ويوظفها في قالبٍ يمتلك أهليّةَ الخوض فيه، وهذا ما يحيل إلى سؤالٍ جوهري حول ماهية الأدب في الحياة؟ هل الأدب حبيسُ الفهم الكلاسيكي الذي انتقل من الفضاء المكاني قديما (الأسواق والنوادي) إلى فضاء آخر راهنا (القاعات والجمعيات النخبوية) ؟ أم أنّه بمثابة المؤطّر للحياة العامة؟ إن ماهية الأدب بأجناسه المتنوعة يَكمُن في أبعاده الوظيفية ومخرجاته الاجتماعية، والنصوص التي يُكتب لها النجاح وظيفيًا وتدبيريا هي التي تروم العمق والخوض في المسائل التي وَجُب الخوض فيها، فما تطرق له بوكبة ليس بالسرد المُسلّي عن أيّام الطفولة بل هو من قبيل التنبيه إلى خطورة البهائميّة في مسائل الاختلاف وحضورها بدل العقلانية.
3 بوصلة الرّشاد / الماضي لصناعة المستقبل. كيف جئتُ إلى الكتابة السردية؟ والمجيء يختلف عن الإقبال من حيثُ الدلالةُ. هل الكتابة تجيءُ؟ أم أنّ الكاتب هو من يجيءُ إليها؟ قبل التطرق إلى الجزء الثاني من الكتاب تجدر الإشارة إلى القاموس اللغوي الذي استعمله السارد في النص الذي رام فيه البساطة في الطرح بما يتوافق مع الفكرة التي أراد تمريرها، فالنصوص في شقّها الاجتماعي غالبًا تكيّفُ القلم مع مطالبها، فتكون اللغة ومستوياتها بحسب المقام. وتظهر مسألة مفهوم اللغة ووظيفتها وفي هذه الجزئيّة ومن خلال المنهج المتبع في القراءة سابق الذكر أقمت علاقة الاختلاف في وجهات النظر، بَيدَ أن الأمر لا يتعدى إلى التنظير للمسألة واستجلاب أقوال وآراء العلماء بل يقتصر الأمر على رأي ابن جني حول اللغة (هي كلّ ما يعبر به القوم عن أغراضهم) والقولُ يشمل التواصل وما يعرف بالمخطط التواصلي (رسالة ومرسل ومستقبل والعناصر المشكلة للعملية) إذْ يستعمل بوكبة في بعض الفقرات ألفاظا دخيلة على اللغة العربية أو هي من لسان المجتمع (الدارجة) لتكون الفكرة أوضح حسب رأيه أو تجاوزا وإعادة نظر للقاموس اللغوي المستعمل من طرف الأدباء، فاللغة الرصينة لم تعد نافعة راهنًا بالشكل اللازم وما دام التواصل ووضوح الفكرة موجودا فقد يُعادُ النظر تدبيريا من خلال إنتاج النصوص مثلما فعل الكاتب. لكن هذا المنحى قد يتحوّلُ في القادم إلى عنصر تشويش على ماهية الأدب، فتدخل أقلامٌ ونصوص بمثابة الطفيليات وتنمو بطريقة عشوائية فتختلط الأجناس الأدبية، فالقاموس المستعمل في (يدان لثلاث بنات) قد انفرد به صاحبه لكنَّ القراءات تُنتج فهوما متنوعة ومنها تقنينُ الدخيل والمُعرّب فليس كلّ والجٍ لعالم الأدب قادرًا على هذا النوع من التوظيف، بمعنى أن التشاكس الذي أقمته مع نص بوكبّة يتعدى إلى المآلات التراكُمية، فيكون المنعطفٌ في استعمال القاموس دون أن ينبني على أسس لسانية وعلمية سليمة. وكثيرا ما ظهرت نصوصٌ بعيدة كل البعد عن تصنيفها أدبًا استمدت شرعيّتها (ولو نسبيا) من إسقاطات خاطئة على نصوص أخرى أنتجها أهلُ الفن أنفسهم، فكانت حجّة للطفيليات الأدبية وحُجةّ نقدية على من ساهم بشكل أو آخر بانتشار هذه الطفيليات. ولأنّ فتح الفضاء والانفتاح الاستدلالي المعرفي يكون بتأسيس نصوص لا تدع مجالًا للقياس السقيم بل للتثمين أو الاستدراك والتفاعل البنّاء؛ فقد أعيبُ على الكاتب في بعض الجوانب حين يستعملُ كلمة قد تكون أقوى لو كانت عربية فصحى (كقوله مثلا: الويكاندات (عطلة نهاية الأسبوع) وغيرها كثيرٌ من الكلمات إمّا العاميّة وإما الفرنسية التي تحوّلت إلى مخرج بلساني عربي) رغم أنه مبحث تُعنى به اللسانيات الاجتماعية إلا أنّ اِستعماله قد يتطوّر ليزاحم الأصل، لذا فاللغة تحقق مبدأ التعبير عن الأغراض ولكنّ الغرض الرساليَّ يختلف عن الغرض العادي، وهذا هو الفرق بين الأدب ولزومية حضوره في مفاصل الحياة ككل مما يُكتبُ له الخلود المعنوي وبين ما يعرف بعبثيّة تسويد الصحائف التي تتلاشى مع الزمن. هذا لا يعني أن القراءة تحاول أمزجة طريقة إخراج النص حسب مزاج معيّن، بل تحاول التأكيد على أنّ الكاتب المُنفرد بأسلوبه هو محلُّ ترصّدٍ؛ الترصدُ المُفضي إلى تعدد في الفهم إما إيجابا وإما سلبا، فقد ينبشُ قارئٌ ما أطرافا من نص (يدان لبنات ثلاث) ويبني عليها حكما، فقيمةُ صاحب النص تزيلُ بعض التفاصيل في عملية القراءة. والقرّاءُ نسبٌ متفاوتةٌ فهما وتحليلا. وسبق أن ذكرتُ بأن المنظومة التربوية في الجزائر بحاجة إلى التعريف بأهل الفن وبالنصوص بالإبداعية ذات القريحة المستقلة والفكر الواسع وإدراجها ضمن مقرراتها عوض استيراد نصوص مشرقية لا تخدم البيئة أصلا. تكونُ عملية إدراج النصوص بتوافق في الرؤية بين العناصر الكفيلة بهذا، يشتغلُ عليها خبراءٌ في مخابر علمية تعتمد على أسس ومناهج حديثة، لأن المادة متوفرّة حسب رأيي بوجود أدباء ومفكرين ونصوصهم التي تسافر مشارقَ الأرض ومغاربها. والأولى أن تُستثمرَ محليا باعتبارها دافعًا في الحاضر وإرثا في المستقبل.
- الكتابة السردية وبوصلة التيه هي مقدماتٌ لبوصلة الرشاد والتكامل الذي أظهره عبد الرزاق بوكبّة جامعا بين تجارب مختلفة من الإعلام إلى التجربة في الشعر والنصوص النثرية وما تخللها من احتكاك بقامات فكرية وأدبية شكّلت داخله (كاتبا مثقفا إعلاميا روائيا) بحيثُ وصلَ إلى ما كان يرى نفسه فيه. يقول الأديب مصطفى صادق الرافعي: "لا تتم فائدة الانتقال من بلد لآخر ما لم تنتقل الروح من حال إلى حال، فإذا لم تنتقل الروح فأنت مقيمٌ لم تبرح" الروحُ التي تسكن عبد الرزاق بوكبة انتقلت من حال إلى حال مما جعله يأبى العودة مع صديقيه الشاعرين من العاصمة إلى ولاية سطيف، روحُ التحدي والإصرار التي تسكنُ من يرومُ الوصول إلى المكان الذي يرى نفسه أهلا له وأجدرُ به وتدفعه إلى اقتناص كل الفرص المتاحة، لذا كان الجزء الثاني من الكتاب أهم مدخل للإحاطة والتفاعل مع السيرة، فالانتقال من حياة البداوة إلى التمدّن يشكلُّ البؤرة الدلالية في النص الذي بين أيدينا، الطفولةُ في قرية (أولاد جحيش) وما فيها من مكابدة ورباط وتعلّق وتمرّد مهّدت الطريق للتكيّف مع صعوبة الحياة في المدينة (العاصمة) والمذياع الذي شكّل وعيًا وجعل من صاحبه يفوق أقرانه بمراحل ضوئية كان بمثابة الدافع الماضَوي لصناعة المستقبل، تشكّلت تلك الروح (روح الأدب والفكر والإعلام) ببساطة في بيئة بسيطة وخصبة، فكانت دافعا معنويا لتسجيل الحضور في بيئة تستوجب حضورًا ذهنيًا ومعرفيًا. المقاطع التي أتى عليها السارد وعنونها بـــ (تحت الرعاية السامية لــــــ) هي البؤرة الدلالية في نصه، في لحظة الانتقال من الشعور إلى الوعي بكونه قادرًا على كتابة اسمه في الساحة الأدبية والإعلامية لما يملك داخله من روح (روح الطفولة والشباب، روح التضحية والتمرد والتميز والاندفاع والتعلق والتذوق) لذا لم يكن من المهم الالتفاتُ إلى المعاناة (مشكل المبيت والعمل والجوع وغيرها) فهذه لا تقارنُ بما مضى حسب رأيي، ولكن يُلتفَتُ في مقام الإبداع إلى طريقة استغلال الفرص المُتاحة، فالمبدع هو من يشتغل على المتاح لتأتي النتائج طواعية.اشتغل عبد الرزاق على المتاح، فأنتج نصا يُكتبُ له بأسلوبٍ انفرد به، فكانت الثمرةُ إثراء الساحة الأدبية بنصوص إبداعية تنهل من معينها أجيالٌ وأجيالٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- كاتب من الجزائر
الرواية نت - خاصّ




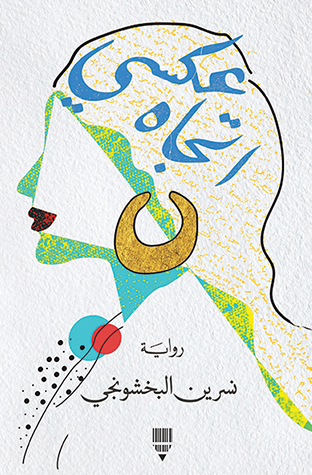



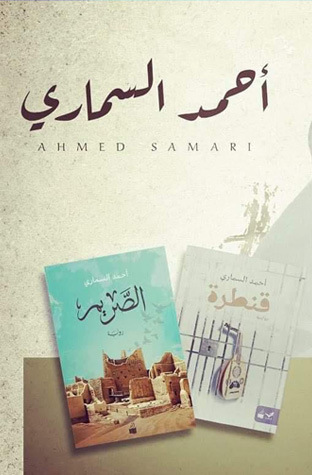
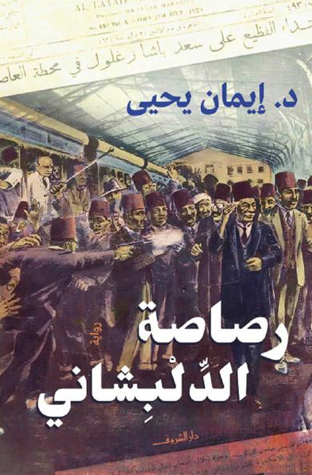
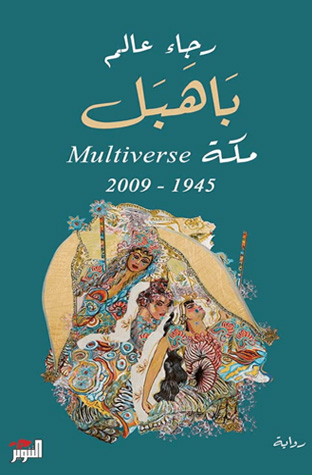



0 تعليقات