رشيد الضعيف يكتب سيرته على «ألواح»
يقول غلاف «ألواح» إن الكتاب رواية، لكن رشيد الضعيف ذكر في صحيفة «السفير» اللبنانية أنه كتب شذرات من سيرته، واختار العنوان لأنه استخدم اللوح الإلكتروني، واستوحى شرائع حمورابي والكتب المقدسة التي حفرت على ألواح. قال إن الكتاب هو الذي ألّفه، أوضح صورته عن نفسه، واستعاد أحداثاً ساهمت في تكوينه. كان الكاتب خادم الكتاب، وجاءه ضرورة لا إلهاماً، وكانت فيه أحداث لم تقع حقاً، لكنها لو فعلت لكانت حدثت كما دوّنها. يحاول الضعيف إذاً صدّ الفضول والأحكام، أو تشكلها في ذهن الآخر، بالقول إن «ألواح» الصادر عن دار الساقي، بيروت، ينتمي إلى أدب «الفاكشن» الذي يجمع الحقائق والأدب. ثمة أيضاً حاجة إلى تهدئة «الشخصيات» الأخرى في الكتاب التي اشتركت فيه من دون موافقتها. الغلاف لوحة لبابلو بيكاسو تتداخل فيها بضعة ألواح رسم وسط خلفية سوداء، كأن مجموعها يشكل الكل. النص صوت واحد هو الشاهد والحكم الوحيد على حياة والمختار من أحداثها التي ستختلف بالطبع إن رُويت من منظور آخر. وإذ يهجس الراوي رشيد بالصورة والحقيقة، وبينهما الهوية، يؤكّد منذ الصفحة الأولى اختلافهما القاطع. يظن الآخرون أنه يعرف ما يريد ولا يريد، وأنه مخـطّط ومنفّذ دقيق، لكن حقيقته تغلق عليهم. هو مدخن شره، ومصاب بيأس مطلق وأرق مزمن سيتسبب بموته قبل الأوان، وله أعداء حاقدون. اكتشف في الثامنة أو التاسعة اسم عائلته السلبي حين عيّره به تلميذ من عائلة «عدوة». وصمدت حساسيته من الاسم حتى الجامعة حيث شتم الطلاب الساخرين (شقيقاتهم على الأصح) وهاجم الأستاذ لأنه لم يؤنبهم في فعل طفولي خالص. هل يثير البوح فضولنا في زمن تلفزيون الواقع والفايسبوك، وهل نكافئه إن وصفناه بالجريء؟ في تناوله حياة الأسرة التي ضمّت ثمانية أولاد يفصّل ألوان فقرها الذي كان فقر الأكثرية الريفية (ثقافياً) سواء عاشت في الريف أو المدينة، ثم يقول: «لم نكن فقراء، لكن حاجاتنا كانت تزداد ليس إلا». فاقم الأهل، بالطبع، أزمتهم بكثرة الإنجاب، وعجز الأب الفاشل، الساذج والغبي (الصفحة 54) عن تلبية حاجات أسرته الكبيرة. امتهن الحلاقة في الوقت الذي افتقر إلى النظافة والأناقة والحديث اللبق. كُلّف أحياناً العزف على الناي في المناسبات للعجز عن الاستعانة بعازفين مهرة، وساعده ذات أمسية رشيد البارع في العزف، فجُنّ المدعوون (الصفحة 52). شقّ واحد قميصه، ونتف ثانٍ شعر رأسه، وأطفأ ثالث سيجارته في كفّه. لكن الخشونة القروية أفسدت لحظة انتصار الشاب وفخر والده به. رماه الحضور بالأوراق النقدية بدلاً من إعطائه مبلغاً في آخر السهرة، فشعر بالمهانة وقدّمها هدية للعروسين. يعزف الناي لأنه يحب العزف، قال للحضور، فكاد قلب والده يتوقف حزناً على مدخول نصف عام. توفّي الأب باكراً في نهاية خمسيناته، في اليوم التالي لقبول رشيد في الجامعة. يقول الكاتب في موضع إنه بدا كأنه أجّل موته إلى أن اطمأن عليه، ويذكر في موضع آخر أنه أصيب بسكتة قلبية حين حرمته زوجة شقيقه إرثه لتخصّ عائلتها به. يطمئن رشيد إلى الشعر الأبيض (دلالة موت الشهوة) في رأس والدته الجميلة التي ترمّلت في السادسة والأربعين. ثم يكتشف «بقعاً على طهارتها» حين تقول إنها كانت معجبة برجل يعرفه، أنيق وفخور بنفسه. يرفض رغبتها سواء كانت استرجاعاً لذكرى أو محاولة فردية لتلبيتها بعد موت الزوج. يعارض حكمه الصارم على والده تردداً في إدانة الأم التي يقول أولاً إنها قوية، صلبة، دبّارة «تدير مصائر» وهي جالسة على كرسيها أمام الباب (الصفحة 17) ثم يتساءل إذا كان يستطيع أن يغفر لها سذاجتها وبراءتها القاتلة التي لا يزال يدفع ثمنها (الصفحة 113). هل يفسّر الانتقال من الريف إلى المدينة انتقال والدته من التدبير إلى الجهل؟ تجهل في بيروت استخدام المصعد وسيارة النقل (السرفيس) لكنها تتمنى فقط لو استطاعت كتابة اسمها لكي لا «تبصم». في غياب للحب والمنطق ومجرد التعاطف يرى من السخف تعليمها التوقيع باسمها، ويتساءل في الصفحة 100: «ألا يكفي أمي أن تكون أمي؟ ألا يجعل منها هذا تامة كاملة؟ (...) ماذا تريد إذن أكثر من أنها والدتنا وأمنا إلى الأبد؟» يشعر ولا يشعر بالذنب لامتناعه عن زيارة قبرها منذ وفاتها، ويحنق من توريطها إياه من دون أن يوضح إذا كان المعنى وجودياً عاماً أو سلوكياً خاصاً. يقول إنها هي التي ربّته، وبراءتها تسببت بالألم والغضب، لكن هذا لا يعني أن والدته متهمة بشيء! (الصفحة 102). قد لا يدهشنا كره الكاتب الطبيعي لوالديه، لأن معظمنا، وربما كلنا، يحب ويكره أهله في آن. لكنّ هناك جهلاً ونرجسيةً غريبين ومذهلين في تملك الأم التام وتحديدها بالأمومة وحدها، ورفض الاعتراف بـ «أنا» مستقلة لها مع ما يعني ذلك من حقوق وحاجات وغرائز في أي مرحلة من حياتها. تزوجت الأم في الثالثة عشرة، ولم تنجب حتى بلوغها الثامنة عشرة، ونذرت أن تمشي حافية القدمين كل صيف خمسة وعشرين كيلومتراً لكي تحفظ العذراء أولادها. يتذكر رشيد الليلة الوحيدة المشؤومة التي رافقت زوجها فيها إلى المطعم، وعجزت عن تناول الطعام فاكتفت بالليموناضة والبذر. كره الأطفال والدهم لأنه سلبهم أمهم: «لماذا ألقى قنبلة وسط البيت؟» وانتهت الليلة بإطلاق النار على أكبرهم يوسف، وبتر ساقه، وعجز الأب عن النجاح في امتحان الثأر الأساسي في الثقافة المحلية. نال الشهادة الأولى بعد أربعة أعوام من السن العادية لكنه اعتبر المسألة تقنية لا فشلاً. «كنت موجوداً بقوة في ذاتي. كنت محتلاً ذاتي بحيث لم يكن فيها فراغ يمكن أن يملأه شيء أو أحد من الخارج من حولي» (الصفحة 56). ما معنى ذلك في هذا السياق؟ يبرّئ نفسه من النرجسية في الصفحة نفسها حين يبرر الكلفة الكبيرة لإزالة شعر جسده بالنظافة لا الجمال. يقع ضحية الحب والحرب. يُحرق بيته لتهجيره، ويصاب بشظية صاروخ وهو في سيارته، فيسرق عابرون ما فيها، ويحاول أحدهم في مستشفى معادٍ إعطاءه دماً فاسداً ليقتله. يمتلئ بالعظمة حتى في موقع الضحية، فيقول في الصفحة 107 إنه ظن قبل الحادثة أن التظاهرات ستملأ الشوارع إذا أصيب اغتراضاً على ظلم الإنسانية «لأنني أنا الإنسانية». تناديه نتالي من باريس فيمشي على سطح المياه ليكتشف أنها لم تكن امرأة رجل واحد. يحاول امتلاكها بالإكثار من النوم معها، لكنه يرهق جسده عبثاً ويُكرِه نفسه على القبول بأن يكون الحبيب المخدوع. يختم رشيد بالبداية. ولد في 6 آب (أغسطس) 1945 يوم ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما. ودّ لو ولد في اللحظة نفسها لرمزية الحدث وثنائيته. انفجار هائل مرعب ينشر الرعب واليأس «وآخر واعد بالخلاص منعش ومحيٍ» في الصفحة 153. يكتب كأنه الوحيد الذي ولد ذلك اليوم، لكنه ينتهي شبيهاً بوالده، بوجه مطفأ وعينين بلا نور. عن صحيفة الحياة




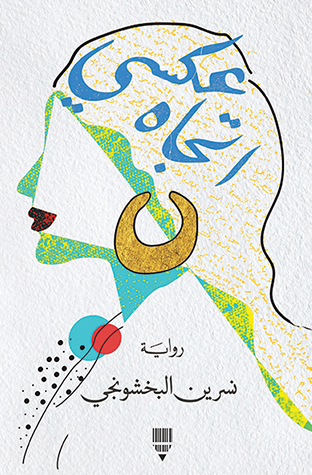



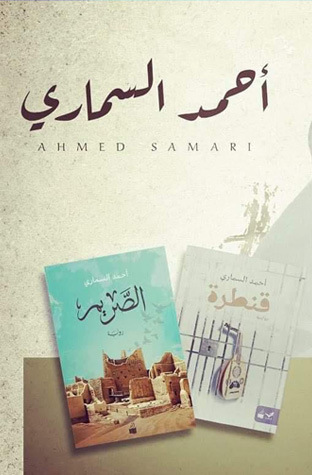
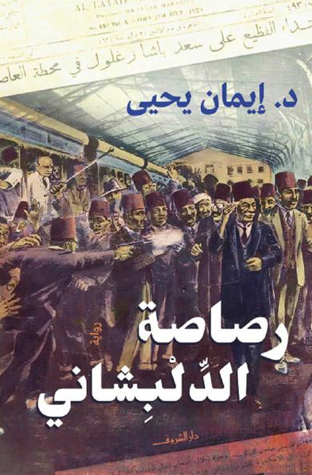
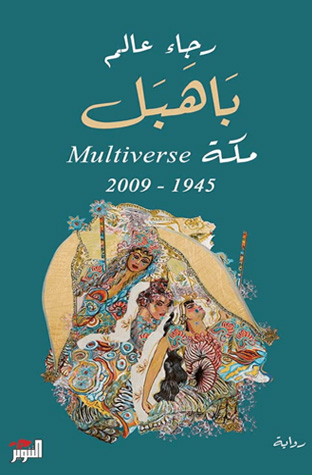



0 تعليقات