«أرواح كليمنجارو» رواية الصعود نحو القمة وظلال الأرواح الحالمة بالحرية
هي رواية صدرت حديثًا للأديب إبراهيم نصر الله، استلهم أحداثها من الواقع، بعدما نجح في تسلق جبل «كليمنجارو»، والوصول إلى قمته بصحبة عدد من المتطوعين والأطفال الفلسطينيين، الذين فقدوا أطرافهم في الهجمات الإسرائيلية عليهم. وحين نرجع إلى عنوان الرواية «أرواح كليمنجارو» نجد لفظة أرواح توحي لأول مرة بالغياب والسر والخفاء، لكننا حين نواصل تحليل المتن نكتشف أن الظاهرة المهيمنة هي الحذف، ونجد صورًا كثيرة لهذا الحذف، من بينها بتر الاحتلال الإسرائيلي لسيقان الأطفال الفلسطينيين ولأحلامهم . وموضوع البتر يشكل جانبا مهما من وجهة نظر المؤلف، حيث تصير القضية بأكملها سلسلة متواصلة من البتر، والبتر يولد بترًا. أما الموضوع الثاني الذي يومئ له العنوان فهو أعلى قمة في أفريقيا وهي «كليمنجارو» منطلق الرحلة ومنتهاها المادي، فالصعود لهذه القمة لم يكن بالأجساد، ولم يكن هدفه الوصول لقمة جبل، بقدر ما أراد محققوه أن يقولوا للبشرية «نحن أبناء هذه الحياة، أبناء شعب يقاتل من أجل حريته منذ أكثر من مئة عام، وإننا لن نهزم». وبالنظر للرواية نجد أن متنها الحكائي يتشكل من عشر قصص، انبنت على عدد من الشخصيات، وقد انفردت كل شخصية بقصة ودور واجتمعت في قصة الأمل في الحرية وتخطي كل مراحل الانهزام. زمن السرد: بدت الجملة التي قالها «صول» أحد الأدلاء في الرحلة: «كل شخص جاء إلى هنا وهو يريد شيئًا ما من الجبل، قلة هم أولئك الذين يدركون ما الذي يريده الجبل منهم»، نقطة فاصلة بين زمنين: الزمن الماضي الذي تركه المشاركون في الرحلة خلفهم، وزمن المستقبل الذي ينتظرهم بعد أن قاموا بتسجيل أسمائهم لدى موظفي بوابة كليمنجارو. وجريًا وراء ميشال بوتور ورولان بونوروف وأونوليه الذين قسموا الزمن الروائي على زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة، فإن زمن المغامرة هو زمن صعود جبل كليمنجارو، وزمن كتابة الرواية هو عام (2015) وزمن القراءة هو الذي نتمثل من خلاله الأحداث الإجمالية التي امتدت على فترات زمنية وضحت ما تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من جرائم بحق الأرض والإنسان. إن ما سماه جينيت بالحكاية الرئيسية أو الحكاية الأولى لم يستغرق في الرواية من الزمن سوى أيام فقد كان الترتيب الزماني متوزعًا على زمنين: زمن الحكاية الأولى: حين أصر أطفال فلسطين، الذين فقدوا أطرافهم نتيجة العدوان المتطرف عليهم، على صعود واحدة من أعلى قمم العالم برفقة متطوعين ينتمون إلى جنسيات وديانات مختلفة؛ ليثبتوا للعالم قدرتهم على تخطي الاحتلال بالإرادة والأمل. وزمن الاسترجاعات التي تتحقق بمديات وسعات مختلفة، إذ أن رواية «أرواح كليمنجارو» تنتمي إلى ما يسمى بروايات تيار الوعي، وهو تيار كان تأثير برغسون واضحًا فيه «بتركيزه بشكل خاص على الحياة النفسية التي تتوالى في الصورة المكانية للزمان، والتي تتضخم كلما تقدم الزمن، وذلك بإضافتها للحظات زمنية تضمها إليها». فالطفلة الفلسطينية نورة لم يثنها فقدها لأطرافها ومعارضة أهلها عن فكرة صعود الجبل. ويوسف الذي فقد ساقه كان يستعيد شريط الذكريات في مدينته غزة وكل لحظات المعاناة. أما غسان فقد التهمت الحروق جزءا كبيرًا من وجهه وأفقدته عينه اليمنى، وفقد يده. وبقي كابوس ما حل به يلازمه. نمط السرد حين قدم إبراهيم نصر الله هذه الرواية هل أراد أن يريها لقرائه أم يقولها لهم؟ إن حكاية الأحداث بتعبير جينيت هي المهيمنة على رواية «أرواح كليمنجارو»، بل أن الرواية تقترب كثيرًا من بعض خصائص التمثيل المسرحي، ولعل طبيعة الحوار الواردة من أبرز العناصر التي يترسخ بوساطتها الإيهام بالمحاكاة في الرواية. «كانوا يسألونني دائمًا: أنت يوسف، ما الذي فعلته في حياتك أكثر من أنك أصبت؟». الآن سأقول لهم: لم أكن أنا الذي أصبت نفسي، كان هنالك من أصابني، وقتل أصدقائي أيضًا، أما ما فعلته أنا فقد استطعت أن أتسلق كليمنجارو… لقد صعدت إلى حلمي برجل واحدة». إن حصر فكرة الخطاب داخل النطاق اللفظي كما يرى نورمان فيركلو هو أمر أبعد ما يكون عن الواقع، وحتى لو كانت النصوص نصوصًا لفظية أساسًا، فإن الكلام متضافر مع الصورة البصرية أساسًا وتعابير الوجه والحركة والوقفة، فللجسد لغة يقولها لا تقل تعبيرية عن الكلام. في الرواية تلتحق الطبيبة أروى ببعثة طبية ذاهبة لعلاج الأطفال في الخليل، وترى في وجه الطفل الفلسطيني غسان معاناة الآلاف من الفلسطينيين، وفي بعض المقاطع الاسترجاعية قد يتغير نمط السرد فيحل العرض البانورامي (باصطلاح لوبوك) محل العرض المشهدي، إلى درجة ملحوظة، فنجد الراوي يبدأ بتقديم مجمل يستغرق سطرًا ونصف السطر لزمن يستغرق أكثر من سنوات، ثم يتسع المجمل: «مرر إيميل راحة يده اليمنى مرتين على رأسه الحليق، كأنه يمسح غبارًا عالقًا منذ سنوات طويلة، لقد رأى نفسه في يوسف، استعاد ذلك الولد الصغير الذي كان يقلد المحاربين في الحرب الأهلية اللبنانية». كما استثمر إبراهيم نصر الله تقنيات السينما، ومن مظاهر هذا تسجيل الإيماءات والحركات والالتفات للأصوات والألوان وهو يصور لحظات صعود أبطال روايته إلى الجبل. ومن التقنيات السينمائية الموظفة اللقطة المزدوجة، حيث تصير الأشياء المتباعدة متقاربة في الذاكرة، رغم المسافة الحقيقية الفاصلة والتباين القائم بينها بالواقع. فغسان حينما تنقل إليه الطبيبة أروى قول رئيس فرقة المساعدة يرى جبل كليمنجارو سطح بيته ويأمل أن يصله ليقاوم جنود الاحتلال: «في كل إنسان قمة عليه ان يصعدها وإلا بقي في القاع … مهما صعد من قمم». صمت غسان طويلًا، ثم رفع عينيه ونظر في عينيها مباشرة، وقال : ربما يكون هذا البيت، الذي يحتل الجنود سطحه الآن، هو الجبل، ولذلك لا أحلم بشيء منذ مدة طويلة مثلما أحلم بالصعود إلى ذلك السطح». وجهة نظر ماذا قالت الرواية؟ وماذا أراد المؤلف أن يقول؟ ذلك هو السؤال المهم الذي يطرح نفسه بعد الانتهاء من قراءة كل عمل روائي، ويكتسب السؤال أهمية أكبر مع إبراهيم نصر الله، لأن نصه متعدد المعاني. إن رواية «أرواح كليمنجارو» تنتمي إلى النمط المتعدد الأصوات، أو الديالوغي بحسب باختين، فهيمنة العرض المشهدي على النص، ووصول الأحداث إلى المتلقي عبر عين الراوي العليم، مقدمتان تمهدان إلى الإقرار بهذه الحقيقة. «لسبب ما أحس كل واحد من الفريق بأنه سيتحول برغبته أو رغمًا عنه إلى شخصية في كتاب لكاتب لم يقرؤوا له سطرًا واحدًا ،لاحظ هاري ذلك فطمأنهم: لم أجئ هنا ككاتب بل لأكون شخصية حقيقية». لقد استطاع راوي «أرواح كليمنجارو» بفضل تنقله من موقع شخصية إلى مواقع أخرى أن يعرض علينا رؤى جميع الشخصيات الرئيسة في الرواية وأحلامهم. من هنا كثر استعمال ضمير الغائب، ورؤية الشخصيات بعيون بعضها من دون أي تدخل: فيوسف مثلاً بعين إميل هو المسيح المعذب: «فكر إميل، واكتشف أن هذه هي المرة الأولى التي يغسل فيها قدم إنسان، أي إنسان… وليس يدري من أين بزغت له تلك الفكرة: إنه يغسل قدم مسيح صغير، مسيح عذب كثيرًا، وها هو يصعد درب الجلجلة غير آبه بجراحه وآلامه، غير آبه بساقه المبتورة وأصابع يده التي تبخرت في الهواء». ولعل أبرز ما يميز الأيديولوجيا التي تحملها شخصيات الرواية هو الارتباط بالأرض والمكان ارتباطًا يحيلنا إلى مفهوم الهوية الفلسطينية باعتبار أن الأرض تشكل مصدرها الأساسي .»جون لماذا لا تأخذ ابنتيك وتعود إلى أمريكا فقد قدمت لنا ما لا يستطيع كثيرون تقديمه؟ قال له أحد أصدقائه الفلسطينيين. كيف يمكن أن أذهب بهما إلى أمريكا ؟ هاتان البنتان فلسطينيتان، وهذا وطنهما». ولعل إيمان الراوي بضرورة الوحدة والنسيج الإنساني هو ما جعله يشحن جبل كليمنجارو بدلالة أيديولوجية، إذ صار علامة على وحدة الأجناس والأديان، ولعل الحديث عن الأيديولوجيا يتطلب حديثًا عن اليوتوبيا، فكلاهما من عمليات المخيلة، بحسب بول ريكور، مع ملاحظة أن الأيديولوجيا تبريرية في دفاعها عن السلطة الراسخة، وعلى عكسها يظل خطاب اليوتوبيا ناقدًا للسلطة بطرحه « أينًا آخر أو مجتمعًا لم يوجد بعد» وهذا المجتمع تصنعه الأحلام والأساطير، ومن خلاله كشف الراوي عما تعرض له الشعب الفلسطيني من محاولات بشعة لمسخ الهوية، وتغييب مظاهر الحياة ومحوها، والحضور الطافح للموت. وقد بنى الراوي موقفه من الموت داعيًا إليه كاختيار باسل، مدينًا أي حتف خلافًا لذلك، وهكذا حمل الوعي الجماعي الفلسطيني في نصه نحو المقاومة كفعل يستوجب الموت ويجعل منه طريقًا للحياة في خضم حياتهم البائسة فـ»الطفل الفلسطيني يستطيع تسلق أعلى جبال العالم، وإن كان برجل واحدة، ليرفع علم بلاده فوق القمة». ورحلة صعود الجبل بالنسبة ليوسف كانت فرصة أخيرة له ليرى العالم: «أمنيتي الوحيدة الأخيرة كانت الخروج من الحصار، وأن أتنقل في أماكن لا حواجز عسكرية فيها»… وحين سئل أثناء الصعود هل تعبت؟ قال: « لا، لا أبدًا، أي مجنون ذلك الذي يمكن أن يقول: تعبت من الحرية!». ناقدة وأكاديمية من الأردن هدى قزع عن صحيفة القدس العربي

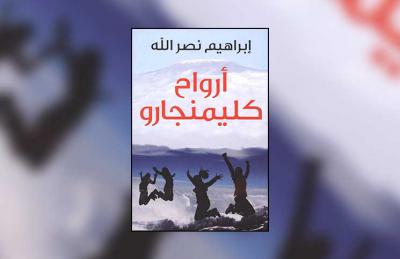


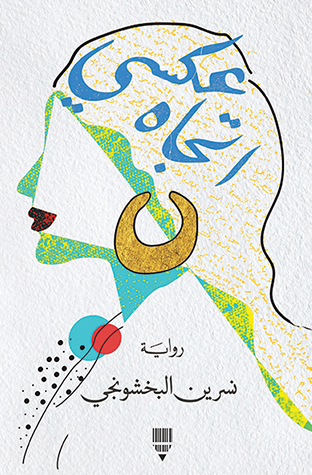



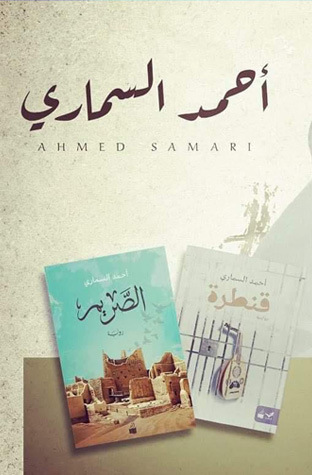
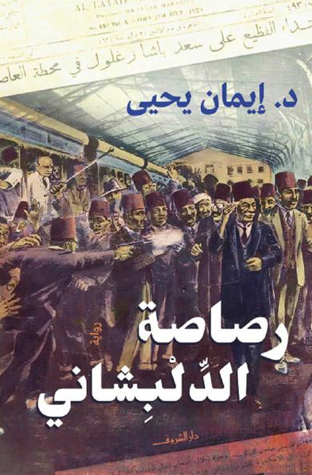
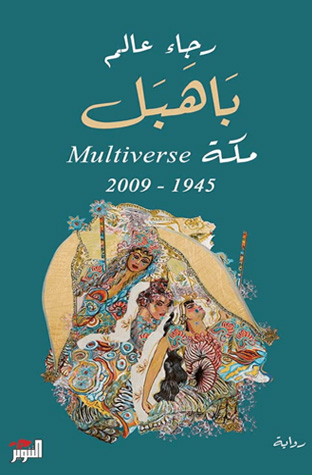



0 تعليقات