الرواية بين شعرية الخيال ونثرية الواقع
قبل ظهور الرواية الحديثة في القرن السادس عشر الميلادي في أوروبا، كانت وظيفة الأدب تُختزل بالأساس في الإتيان بأجوبة مطلقة لكل الأسئلة، والعثور على حلول كاملة للمشاكل العويصة التي كان يتخبط فيها الإنسان. في تلك الفترة، لم تحصل بعد الفجوة الكبيرة بين اللغة والعالم، كما لم تحدث كذلك الهوة بين الكلمات والأشياء. لقد كانت المسافة آنذاك جد قصيرة بين التعبير والحياة؛ بحيث كان الخطاب في تناغم مع أذواق وانتظارات الطبقة المسيطرة الحاكمة، وكان الإنسان في انسجام مع العالم، وكان الحكي شكليا أقرب لما هو أسطوري منه لما هو روائي، إذ كان الزمن (الحكائي) دائريا ومتكررا (ميشيل زيفارا) كما كان المتن معروفا مسبقا لا يفاجئ بالجديد «إيتيومبل»؛ مما يسمح للقارئ بالتماهي مع شخصيات أسطورية امتازت بالبطولة والنبل والشجاعة والقوة والفضيلة؛ شخصيات من طينة رولان وأماديس ولُنْسلو والملك آرثير وآبيلار… في هذه الفترة، ليسود ما اصطلح عليه بـ»روح الفروسية»، وخيمت قوانينها المنظمة للعلاقات داخل المجتمع الأرستقراطي؛ حيث يستند مجتمع إلى الحقائق الكبرى، ويتكئ على المثاليات القديمة. مع مرور الزمن، سيعرف المجتمع الأوروبي ظهور طبقات اجتماعية أخرى (خصوصا البرجوازية)؛ الشيء الذي أدى إلى تطور المدن وتحديثها، والدخول في حقبة التقدم الصناعي، والانخراط في لعبة التقنية الماكرة، وظهور الفرد مقابل الجماعة؛ ونتيجة لذلك، سيواجه الإنسان الأوروبي تعقيدات كثيرة في شتى مناحي الحياة، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم أخلاقية أم لغوية… وبالتالي لم يعد سهلا على الأدب في جميع تجلياته أن يجيب عن الأسئلة المقلقة لهذا الإنسان، أو يحل المشاكل التي تطرح عليه باستمرار، بل سينخرط الأدب بدوره في صياغة أسئلة أكثر تعقيدا، وسيطرح إشكاليات مثيرة للجدل مع كل من سرفانتس ورابلي وماركوريت دو نفار وبوكاتش، وستتحول الرواية إلى فضاء للنقد والهدم، وتصير مجالا للغموض والالتباس، وساحة لصراع التأويلات؛ حيث سيقوم هؤلاء الروائيون بخلق شخصيات – لا علاقة لها تماما بالعالم الأسطوري أو بالمخيال الأرستقراطي أو بمدونة الفروسية – بوصفها شخصيات هامشية بعيدة كليا عن المركز، وخارجة للتو من عالم معتم آتية من القاع؛ بحيث لم يعد بطل الرواية ذاك الفتى الجميل، والفارس المغامر، والإنسان النبيل الذي ينتصر دائما في النهاية، ويعيد النظام إلى الاختلال، ويتغلب على الأشرار، ويقيم العدل، ويحظى بتقدير الناس وإعجابهم. كان يعيش دون كيخوتة – مثلا – منذ البداية مأزقا وجوديا بامتياز؛ ومرد ذلك كونه فشل فشلا ذريعا في أن يجد علاقة منسجمة بين الخيال والواقع، وأحلامه ومثبطات المجتمع، وقراءاته، وتجاربه المخيبة للآمال؛ هذا ما يفسر انكساراته المتعاقبة، وهزائمه المتكررة، وإحباطاته المتوالية. فهناك إذن، قطيعة بين عالم اللغة وعالم الأشياء؛ قطيعة أراد دون كيخوتة ردمها بقراءته لروايات الفروسية، على الرغم من عدم تفوقه في هذا المسعى. لهذا يمكن اختزال المصير المأساوي لدون كيخوتة في ما قاله الناقد الفرنسي ميشيل رايمون: «إنه وعي يصبو لملء فراغات الواقع بإغراءات الخيال»؛ حيث لم يحقق دون كيخوتة أهدافه فارتكن إلى العزلة، وانتظر الموت مستسلما وهو على فراش المرض، وخاب بالمحصلة النهائية أمله في أن يُنْهي حياته كبطل ينازل الأعداء في أكبر المعارك شهرة. فنجد أن ثرفانتيس لم يقم في روايته بحل المشكلة الأساس في حياة بطله الدون كيخوتة؛ بل ترك الأزمة التي عصفت به مفتوحة على ممكنات التأويل التي قد يقترحها كل قارئ لهذا العمل الروائي. إن الدرس الأدبي والفلسفي الذي يمكننا الخروج به من قراءتنا لـ»دون كيخوتة دي لامانشا» يقترن بما اعتبره الفيلسوف الألماني هيغل، متحدثا عن الرواية الحديثة بوصفها «صراعا بين شعرية القلب ونثرية العلاقات الاجتماعية». فهذه النثرية صورها رابلي بطريقته الخاصة، عندما ركز في رواياته على تفاصيل هامشية لم يعرها الأدب الأرستقراطي أدنى اهتمام؛ أي تلك التفاصيل الجانبية التي طالما اعْتُبرت-من المنظور الإيتيقي- بمثابة مواضيع لا يليق بالأدب تناولها؛ لأنها مجردة من كل بعد إستطيقي. وسيأتي رابلي ليكسر هذا التصور الذي يقيم علاقة سببية بين ما هو أخلاقي وبين ما هو جمالي، انطلاقا من جعل كل الموضوعات مباحة وممكنة بما فيها التغوط، والأكل المفرط في شكله الكرنفالي والجنس في شقه الحيواني الخ.. فلا حدود يمكن أن تُرسم على خريطة الأدب؛ ولا توجد رقابة يمكنها أن تحد من حرية الكاتب، ولا قوانين تحدد الفضيلة والرذيلة، ولا أعراف تعرف الخير والشر. يهدف رابلي ففي روايتيه «بونتاكريال» و»كاركونتيا» إلى تصوير الإنسان من خلال سلوكيات، وتصرفات تظهر جانبه المظلم الخفي، وتسلط الضوء على بعده الشيطاني الجهنمي، وتزيل اللثام على غوغائيته الدفينة؛ لذلك يجعل رابلي من الهزل آلية لهدم جميع أشكال التابوهات، ومن السخرية أداة لنقد سلطة الدوكسا في كل تمظهراتها، ومن الخفة وسيلة لكسر وثاق كل فكر خرافي، لتصبح الرواية مع هذا الكاتب الفرنسي دعوة للحلم الذي يحرر العقل من الضرورة الواقعية، وللفكاهة التي يرى فيها أكتافيو باث الاختراع الكبير للحداثة، وللتفكير باعتباره مُوَلدا للسؤال والتساؤل، وللشك والارتياب؛ ومحررا من كل القيود والإكراهات… بعبارة أخرى، جعل رابلي من الرواية «أرضا حيث لا أحد يمتلك الحقيقة» بتعبير ميلان كونديرا؛ حيث سيولي في كل رواياته الاهتمام باللعب والضحك، ويعيد الاعتبار للثقافة الشعبية المهمشة، ويرى في الحمق قوة أكبر وأكثر وضوحا من الحكمة، سواء في كل من «بونتاكريال» و»كاركونتيا» حيث يمزج الكاتب بين الإمتاع والتفلسف، ويجمع بين الهزل والجد، ويزاوج بين الخفة والثقل، ويخلط بين السطحية والعمق. إن المزج بين المتناقضات سوف نجده – مرة أخرى- عند الكاتب التشيكي جاروسلاف هاسيك، من خلال روايته الشهيرة «مغامرات الجندي الشجاع شفيك»؛ ذلك أن هذا الجندي، ذا الوجه الساذج والابتسامة التي تشبه البدر، يحارب في جبهات القتال خلال الحرب العالمية الأولى، لكن من دون أن يعرف سبب ذلك. ما يجعلنا نلمس أن هناك شرخا كبيرا بين شعرية الحرب في المتخيل الجماعي، وبين نثريتها في الواقع الدامي؛ حيث سيؤدي بـ»شفيك» إلى الحيرة والشك: لماذا هو موجود في ساحة المعارك؟ ومن هم في الحقيقة أعداؤه؟ ومن أجل أي قضية هو يحارب؟ وماذا سيجني من الحرب؟ ولماذا يقتتل الإنسان ضد الإنسان؟ إنها، في الواقع، أسئلة ذات بعد أنطولوجي وفلسفي ما فتئت تؤرق الجندي الشاب من دون أن يجد لها جوابا شافيا؛ فإذا كان الأدب الفروسي الأرستقراطي يصور المحارب كبطل ينازل أعداءه بحب وضراوة، معتقدا أنه يحمي بلده، ويعلي رايته، ويقوم بواجبه اتجاه الوطن، فإن شفيك على العكس تماما، لا يحس بأدنى شعور وطني يبرر وجوده في حروب قاتلة نشبت من دون أن يكون له يد فيها؛ فالجندي شفيك هو بطل منكسر تتلبسه الحيرة من الرأس إلى أخمص القدم، ويرمز إلى جيل بأكمله من البسطاء الذي دفع ضريبة باهظة في حرب قامت من أجل مصلحة السياسيين الذين يديرونها من كراسي السلطة. إنها ضريبة عنوانها العنف والقتل والدم؛ ضريبة حولت بين عشية وضحاها أشخاصا أبرياء إلى مجرمين ومتوحشين ودمويين، إضافة إلى نقدها اللاذع لعبثية الحرب تظهر رواية الكاتب جاروسلاف هاسيك كيف أصبحت أفعال الإنسان مجانية وعارية من كل قصديه؛ إذ لا تستجيب لأي مبرر أو منطق. وتأسيسا على هذه الأمثلة، يمكننا الخروج بنتيجة مفادها أن الرواية – وبالتالي الأدب – لم تعد تخضع لرؤية أحادية، ولا تحمل الحقائق الكلية والمثاليات الكبرى، بل أصبحت- مع هؤلاء الروائيين وغيرهم (جيمس جويس، مارسيل بروست، إرنست همنغواي، يوكيو ميشما الخ)- فضاء واسعا لطرح أسئلة محيرة يصعب حلها، ومساحة/ساحة عنوانها العريض هو الشك والريبة، وجغرافية تثار فيها إشكالات عميقة، واحتمالات تأويلية متعددة، مما سمح لها بأن تتطور، وتأخذ أشكالا عديدة ترتبط بعلاقات معقدة مع الواقع والأشياء ضمن رؤية فلسفية عميقة للشرط الإنساني؛ فهذا الشرط الإنساني غالبا ما يكون مبهما، وغامضا، وإشكاليا يصعب تحديده بدقة أو تعريفه بسهولة؛ لأنه ينفلت كالزئبق من كل جواب. لذلك، عندما تسعى الرواية لإخضاعه للمساءلة المستمرة، وتجعل من الأدب ذو صلة بهموم القارئ وأسئلته، وتطلعاته، وأفق انتظاراته. ناقد أدبي ومترجم مغربي محمد برزوق عن صحيفة القدس العربي




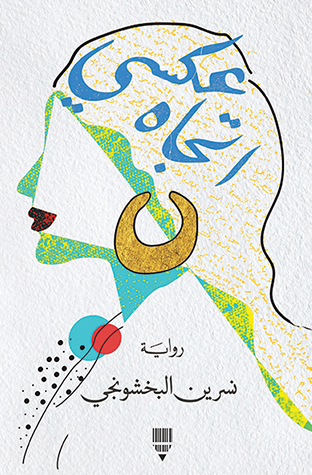



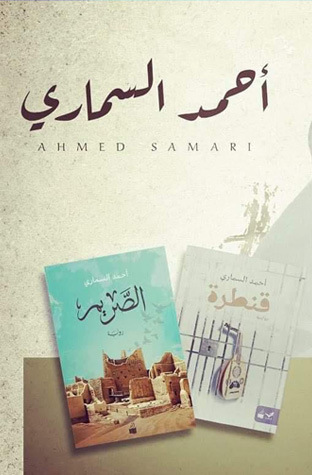
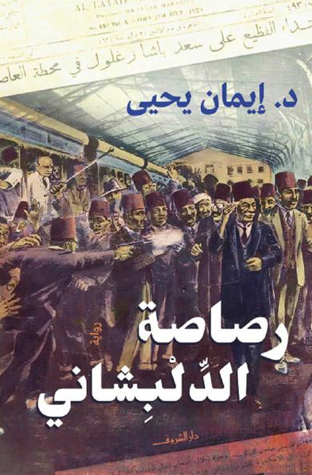
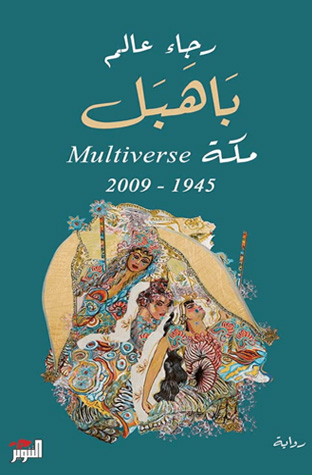



0 تعليقات