الغابة السوداء تتكلم.. رواية جديدة للعراقي صلاح عبداللطيف
صدرت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، رواية الغابة السوداء تتكلم، عن منشورات الكتب خان المصرية، وهي الرواية الرابعة للروائي العراقي المقيم في ألمانيا صلاح عبداللطيف. ومن أجواء الرواية نقتطف ما يلي :
انطفأ نور النهار، في ذلك اليوم الخريفي الصامت، على ضفاف البحيرة اللايبزجية، التي تركت الطيور الحائمة فوقها تمشط شعرها بمناقيرها كما تشتهي. استلذت البحيرة بمداعبة الطيور لها ، مثل عجوز فرحة بأحفادها وهم يهندسون صخبهم الطفولي كما يشتهون. لعبت على ضفتي البحيرة، أجيال عديدة بزخم نهم، كأنهم سكارى لا يستطيعون ضبط جنونهم المتفشي في أرواحهم التي تطاير منها فرح شهي.
على الضفة اليسرى، جلست منى، التي بدلت اسمها قبل أن تصل إلى العشرين إلى مونيكا شنابل، وهو الأسم العائلي لأمها لاورا شنابل. بدت مثل شمعة ذابلة وهي في طريقها إلى الموت. تتبعت عيناها الطيور ذاهلة من الهشاشة الجنائزية التي سكنتها، وحولت وجهها إلى كتلة اصفرار تشبه لون الحامض ومذاقه. في بريق عينيها البحريين الجريئين، اختفت حيرة جاورت قسوة يصعب نكرانها، مخلفة على وجهها رمادا لا يناسب الدفء المخفي وراء زجاج وأنفاس قلبها.
عدلت، واقفة، من جلستها على كرسي المقهى، فبان هيكلها المتناسق مثل مهرة خسرة سباقا. في عينيها اندفن حزن عميق. انفصلت عن محيطها، غارقة في نبش قاعها بحثا عن الأصابع العازفة لنشيد موحش، صعد مثل سيارات الإسعاف وهي تنذر بموت وشيك. مدت ساقيها بكل طولهماعلى الأرض الخضراء المغطاة بحبات ندية. ياله من تلاش كلي. استلت بسمة متعبة حينما وضعت لها النادلة كأس نبيذ أبيض فوق الطاولة. شعرت بأنها كائن هش يبرق بحب حياة لا تنتمي إليها، نفخت غضبها بتنهيدة انتزعتها من أعماقها.
أشياء كثيرة تغيرت في حياتها منذ أن هرب أبوها، وهي يافعة من ألمانيا إلى بلاد لا تعرفها بالضبط، لكن ناسها يلهجون بلغته الأم. اعترض في أيامه الأخيرة معهما على ملابس أمها الشفافة، التي تتهدل جهاتها بين الحين والآخرمن على كتفيها، ذاهبا في جنونه إلى أقصاه، مثل زكام هائج لا يغفر لمرضاه زلة صغيرة، مرسلا لهم الحمى وفقدان الشهية والتيبس الحركي، حتى يقرر أن يمضي إلى ضحية جديدة كما يشاء.
قضت أمها لاورا المنتقلة من شرق ألمانيا إلى فرايبورج، بعد الوحدة الألمانية، صحبة زوجها الكادر الفلسطيني اليساري زكي، سنين حياتها الأخيرة معه سجينة صرامته، التي تصير مثل قنبلة تتفجر شظاياها في أي لحظة، مطلقة شظايا شتائمها المفجعة المتزحلقة بعنف على ممرات أذنيها، فتفشل دموعها المنهمرة بسخاء من عينيها في صدها، لتصير جمرات تكوي قلبها.
ظل زكي، المولود في خان يونس، طيلة سنواته العشرين في ألمانيا، مثل غراب ناعب لا يستقر على غصن. لا يريد الانتماء إلى البلد الذي يعيش فيه، غير مستطيب لمجالسة الألمان من حوله، الذين كنوا له ودا اعتذاريا تراكم بسبب سنوات الحرب العالمية الثانية، بعد أن تربى جيل ما بعد الحرب على الانكسار والاعتذار من ضيق أفق الأباء الذين قادوا البلاد إلى كارثتها البغيضة. بقى على حافة انتظار لا ينتهي للعودة إلى غزة، ليتحدث هناك لهجته بلا هفوات، كما يحصل له مع ألمانيته التي يتحدثها بعد عشرين عاما بلسان يمشي على عكازين.
لم ينتم طيلة سنواته العشرين في ألمانيا، إلا إلى مقاهي العرب وجيتوات اليساريين الألمان، مضربا عن الجلوس في مقهى أو بار ألماني لا يصرح بلونه الأممي، متكورا في محارته رغم قامته المديدة، فغربته لا تختلف في مضارب آل جرمان بيتا كان أم عملا.
لا شيء أيقظ في تلك المدن الألمانية المدهشة مثل فرايبورغ، عاصمة الغابة السوداء، التي يقصدها السياح من شمال القارة الأمريكية والكثير من البلدان، أرواح أشباه زكي سوى الهذر عن تحرير فلسطين القريب، وحتمية انتصار حركات التحرر في المنطقة، بأصرار دول الصمود والممانعة، قاصدين بذلك الدكتاتوريات التي تضع جزماتها فوق رؤوس مواطنيها، ودعم شقيقاتها من قوى الثورة العالمية.
لكن عري النساء في فصل الصيف، عندما تنبعث الأرواح ثانية من رماد الشتاء، مزهرة أجسادا شقراء منورة مثل أشجار الرمان، تكون أقصى عقوبة تسلط على المهاجرين مثل زكي، المنقضة شهواتهم مثل نسور جارحة على عقولهم. حديث النهار في القاعات والغرف المغلقة لا يشبه حديث الليل في البارات والمراقص، التي تنزف منها شهوات شباب عشريني، لم يخرج من مراهقته التي لم يمر بها أبدا. لا سوابق غرامية في حياة ابن المخيم، الذي سعى للوصول إلى شرق ألمانيا أول الأمر، ثم إلى فرايبورغ في جزءها الغربي ثانيا.
في تلك الأجساد، ثمة وحوش كاسرة تعرف مواطن اللذات المؤجلة والشهوات المجنونة لأولئك المهاجرين، الذين يشربون كل يوم صيفي دواء مرا ليطفىء النيران المشتعلة في داخلهم. لكن تلك النيران المشتعلة سرعان ما تشب في أسرتهم آخر الليل، لتسرق النوم من عيونهم، ولا تسعفهم كل أحجمة العفة والتعاويذ العقائدية أو الدينية. وما أن يطل الفجر حتى يلمسوا بصاق الشيطان في سراويلهم الداخلية. ذاك ما سيسميه شيوخ المؤمنين منهم امتحانا أو انحطاطا لمجتمعات مسجلة في صحف النار والعذاب في آخرتهم الكريمة، أما تلاميذ الكنيسة الماركسية الشرقية، فهو الاستئثار الأناني للراسماية المتوحشة، ولا يعنيهم من اسناد المناضلين الألمان إلا اسناد الرفيقات الألمانيات لأجسادهم المتهالكة آخر الليل
غير أن تخريجات شيوخ المدرستين التي تشبه الذهب، لا تبرق إلا داخل جدران المسجد أو الاجتماع الحركي. فالأجساد الناعمة التي كأن الشمس لم تمر عليها خوفا من أن تذيبها، تدك تلك القلاع الورقية المتهالكة التي بناها زكي ورهطه. ورغم محاولاتهم أن يطفئوا نيرانهم بكؤوس الشاي المعفر بالنعناع أو البيرة، إلا أن أرواحهم الحائرة سرعان ما تنهار تحت ضربات معاول جنود إبليس ، فتحملهم ريح كل صيف مثل ريش هش لترميهم على أسفلت لا يرحم جراحهم النازفة تحت جلودهم. وستتفاقم تلك الجراح عندما سيسلط الله عليهم بناتهم بعد سنوات، وهن يرتدين في بلدانهم نفس الجينز الضيق الفاحش والكعوب العالية، فيحيطهم المكر ليس في دار الكفر فحسب، بل في أزقتهم وشوارعهم .






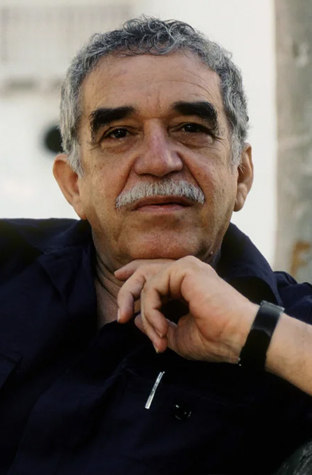








0 تعليقات