أخبرني عن خيالك، أخبرك من أنت
تعلّمتُ أو تعوّدتُ أن لا ألتفت إلى ما أنجزته، ليس لأنني تركته ورائي، بل لأنه انفصل عني وأمسى كأثر قصصي أو روائي في ذمّة القارئ –والقراءة-. هكذا أنسى على نحو سريع ما كتبته، ما أن يخرج من طور الكمون كمسودّة إلى طور التحقّق مع النشر –المبين-. وأتحول بعدها إلى التفكير في ما لم أكتبه بعد، فينزاح بي قلق وجودي إلى مغامرة جمالية جديدة، لا أنخرط فيها مباشرة، إلا بعد حدوث مسافة ضرورية، أو بعد استغراق رمادي في صمت قاس لفترة، بحسب ما تقتضيه شروط اللحظة اللاحقة. الشيء الوحيد الذي يذكرني بسديم ما كتبته، أو يجدّد علاقتي الغريبة بأثره، هو حينما أصادف قراءة ناقد في أحد متوني السردية، أو سماع انطباع أو رأي قارئ في عمل من أعمالي الحكائية. عندها يهاجسني سؤال لاذع : هل حقا أنا من اقترف هذا الجنون؟ ليس سؤالا استنكاريا على كل حال، وإنما هي حالة ملتبسة وضبابية تنتابني أنّى تكرّر الأمر. أتحاشى الرجوع إلى كتبي القصصية والروائية الصادرة آنفا، وكيفما استيقظ الحنين إلى واحد منها، فلا يسطو عليّ حدّ الانجراف إلى إعادة قراءته، أبدا لم أقفل راجعا لاكتشاف ما صدر لي خاصة إن كان رواية، ولا أظنني سأفعل بوقت من الأوقات، فليس رعب الصدمة ما يجعلني أجافي المسألة، وإنما هو إيمان مطلق بأنني عشت شقاء كتابته ومتعته في آن مرّة واحدة، ولا يمكن أن تتكرّر، والمعنى هنا هيراقليطي تماما، نعم، يستحيل عبور النّهر مرّتين. هذا فضلا عن أن إغواء ما لم ينجز بعد، يصخب بشكل مزعج وفاتن في آن، مستحوذا على كل يقظة وسهو، غياب أو حضور في كينونتي. يظلّ الدنو من حقيقة الكتابة الهاربة أو التطابق معها، اكتشاف أو عيش معناها الشقي والمنفلت، الاقتراب من قيمتها وجدواها، من سحريتها ككل، ممكنا على نحو خالص وغامض في آن، لحظة الكتابة ذاتها. أما خارجها، فيتحول النظر إليها بانفصال ولا ويعدو أن يكون مجاورة أو متاخمة. نظرٌ كما لو من حافة إلى هاوية، وشتان بين النظر من فوق، وبين النظر من قاع الهاوية. لا أؤمن بعقيدة روائية أو قصصية، ومجمل عملي محض لعب ومتعة، وهذا لا يعني أنه تسلية، بل عمل مؤسس على شقاء، أجدني في كل مجازفة أمتحن خيالي أمام إكراه الحدود وسلطة الواقع، وأتسلل بملء الجسارة خلفها إلى مناطق الحلم والغرابة التي تفخّخ اليومي. إلى مناطق الغياب والنسيان. إلى الظفر بسراب الأشياء العابرة، تلك التي يتوارى خلف انطفائها السريع أثر مدهش، غير مرئي، وحدها الكتابة تقبض عليه وتخلّده أو تؤبّده. الكتابة التي تمتحن ذاتها بالمغامرة داخل اللغة والمخاطرة بالأشكال اللامألوفة – في الحقيقة الأشكال لا نخترعها فهي موجودة مسبقا، المهم أن نعثر عليها ولكن الأهم هو استعمالها بطريقة جيدة أو غير اعتيادية - ، أتحاشى ما أمكن عدم السقوط في فخ الأنماط وأراهن على المجهول... كأنّ المسألة تتعلق تماما بهندسة عدم. لا أولي المعرفة الروائية والقصصية اهتماما مفرطا يجعل منها غاية، بل أتناسى الخبرة السابقة ولا أعير حكمة التجربة ومراسها أي انتباه، فكلّ مغامرة جديدة يجب أن تكون اكتشافا جذريا يعيد النّظر في كلّ ما تحقّق سابقا أو تراكم لديّ من رصيد جماليات ورؤى وقيم وظواهر وأساليب ومهارات وتقنيات وأشكال...الخ لا علاقة للأمر بالتلقائية هنا والعفوية. كيفما كان الوعي النظري أوالتفكير الجمالي ضروريا قبل وخلال كتابة العمل، إلا أن خُطط الكتابة لحظة الانجاز تنتصر لذاتها، وتدمّر كل الخطط الواعية المسبقة، وبهذا تتحقّق المتعة الخالصة المحتكمة إلى ما تفاجئك به غرابة الكتابة نفسها وغموضها. أؤمن بالعمل الشّاق لا بصرامة الجدية العقائدية ولكن بروح اللعب اللامشروط ، إذ لا معنى لأيّ عمل بدون لعب ومخاطرة، والتجريب لا محيد عن رهانه الدائم في الجنوح بالتعدّد الحكائي وتعدّد الأشكال السردية إلى أثر جمالي غريب، ولا مألوف، ليس طموحه هو خلق مطلق روائي أو قصصي، وهذا حلم وارد، وإنما هو الخروج بنسق الكتابة الروائية والقصصية عن مدار أنماطها المتداولة، والزج به خارج عروضه المستهلك، داخل أفق مريب ولامعتاد، تغدو فيه الكتابة أبعد من أن تكون تخومية وحسب، ليست تتغذّى بقلقها وانزياحاتها وتحولاتها وفقط، وإنما تتماهى مع مآلاتها. أجدُني من حيث لا أدري، بعد الانتهاء من كتابة "عزلة الثلج"، أميل إلى التفكير بأن هذه الرواية شبيهة بحاشية أو ملحق، اختتمتُ به حلقة روائية بدأت مع "موسم صيد الزنجور"، وتضاعفت مع "النّهر يعض على ذيله". حلقة لم أخطّط لها، ولا كان في نوايايا التجريبية -الآثمة- أن تكون استراتيجيتُها مؤسّسة على متوالية ثلاثية. نعم، كلّ عمل أنجزته كان الاشتغال عليه شبيها بخلق جزيرة عزلاء في محيط من عدم. بمعنى أن تجربة كل رواية كانت مستقلة بذاتها، ولم يخطر في بالي أن تكون امتدادا نوعيا أو استكمالا، أو لنقل ابتداء من حيث انتهى العمل سابقا. لا أقصد أو لا أريد أن يُفهم بأن هذه التجارب هي بالضرورة أجزاء ثلاثة لعمل واحد. القصد هو وجود نسق هارموني يواشج بين الأعمال الثلاثة، ليس مشتركه الأساس هو تخييل الأطلس المتوسط وجمالياته القوطية كموضوع وحسب، وإنما النزوع الفانتازي، والهندسة المتاهية، والتكنيك البوليسي لما يسمى بالرواية السوداء فضلا عن المنحى البوليفوني للأصوات واللغة والحكاية والأشكال... زِدْ على ذلك تأرْجُح الكتابة بين الديونيزوسية شعريا والأبولونية معماريا...الخ
-
في رواية "موسم صيد الزنجور" وإن كان مجمل الإثارة هو سحرية "البحيرة" كموضوع وتقنية وشكل ،يتوارى خلف كل ذلك هاجس خفي ومركزي هو خلاسية الهوية المغربية من منظور هامشي ومنسي. وهذه الخلاسية لم تتوقف عند حدود مضمونها الإثنوغرافي أو الأنثروبولوجي، فالهاجسُ جماليٌّ صِرْفٌ في الأوّل والأخير، ولهذا جاء تصريفه استعاريا أيضا في معمار متاهي وشعري. الشّعرية لا تتوقف عند حدود اللغة، بل إن التفاعل الهارموني فيما بين عناصر الرواية بالمجمل، أوكلية، هوما يبتدع هذه الشعرية. ما يصنع شعرية العمل لا يتوقف أيضا عند ما هو تخييلي وأدبي محض، بل ثمة أثر دامغ للشعرية متخلّقٌ عن أدوات أخرى، كالرياضيات والفيزياء والهندسة وهو ما يبتكر في المجمل، شعرية مضاعفة، كامنة أسرارها في الموسيقى. أبعد من ذلك، ليس من باب الطرافة أن أقول، يمكن النظر إلى رواية "موسم صيد الزنجور " ككتاب فى الرياضيات أوالهندسة وليس فقط كتابا سرديا أوحكائيا أوأدبيا. لكن، النظرة الأوفى والأمثل إلى الرواية في اعتقادي ولا ألزم بها أحدا طبعا، هي أنها كتاب في الموسيقى . أن يكون نص "موسم صيد الزنجور" مؤلفا موسيقيا، لا يستند إلى أن أحد شخوصه الأساسيين، عازف ساكسافون. ليس هذا هو القصد.بل الرواية ككل، هي محض خطاطة موسيقية .
-
في رواية "النهر يعض على ذيله" وإن كانت استعارة النهر والمكتبة هي ما ينساب ويلتوي على طول فراسخ الحكي، في استقصاء جامع لمحفل جماليات اللذة والجسد والمسرح والسينما والقراءة...، مقابل سحرية المصادفات ونسق الوقائع الغامضة والألغاز والأرقام ومعمار السّفر المتاهي ككل. بغض الطرف عن الخوض في نمط العيش على ضفة نهر، وكيف ينظر كائن نهري إلى العالم، وبغض النّظر عن المصائر اللعينة التي يرسم قدريّتها غرامُ الكتب والولع بالمكتبات، ففي المضمر كان هاجس الكينونة المتوسطية للمتاهة المغربية هو الزمن السري والموضوع المفقود كإبرة في جبل من القش، وهو زمن صرفته الرواية أيقونيا في خرائطية السفر. لم يكن حضور كتاب "الحمار الذهبي" للوكيوس أبوليوس اعتباطيا، والتماهي معه ليس محض اشتباك يغذّي النزوع السّحري أو الفانتازي للرواية أو خلفيتها بالأحرى، أعمق من ذلك وأبعد، هو النزوع الوجودي والفلسفي للسفر، والترحال بكل قوته الإيحائية والفعلية، المجازية والعملية في آن. المتوسطيون أطالسة التيه والسّفر في العالم، وهذا ما تقوله المتون الأسطورية والأعمال الحكائية والتجارب الإنسانية وأدب الرحلات في مثلث البحر الأبيض المتوسط، منذ أقدم وثيقة فنية. وبرغم أن الرواية تفرد علامتها بقوة إلى جدل المكتبة والنهر والذي يعني ضمنيا جدل الماء والنار. جدل اللذة والموت. فالسفر والتيه منظورا إليه من زاوية وجودية وفلسفية وجمالية خاصة جدا بنمط الحياة المغرب/ متوسطية، هو الموضوع الحقيقي ل"لنهر يعض على ذيله".
-
في رواية "عزلة الثلج" وإن تبدو الغابة من جهة والزّربية من جهة ثانية في آخر المطاف هي الحبكة المزدوجة السرية والرمزية للعمل، فضلا عن الحضور القوي للمعطى الأنثروبولوجي والفانتازي دائما، فموضوع الموت بشتى تضاعيفه بما فيه الموت التاريخي، كان هو سؤال الرواية اللاذع عبر غواية الانتحار أو شعريته بالأحرى. إن كانت اللغة البصرية أو التخييل السينمائي يحضر بنسب متفاوتة في "موسم صيد الزنجور" و"النهر يعض على ذيله"، فحضوره أقوى وبشكل مركزي ودامغ في "عزلة الثلج". في العملين الأولين الرواية تحتوي السينما كأداة وتقنية، وفي "عزلة الثلج" تتماهى معها. ... من الملاحظات التي انتبهت إليها أخيرا، ولم أكن أعيها مسبقا، هي أن تخييل الماء يشكّل مشتركا في أغلب ما كتبته رواية وقصة قصيرة، وهذا واضح جدا من خلال العناوين الروائية : "موسم صيد الزنجور" و"النهر يعض على ذيله" و"عزلة الثلج". وإجمالا فالتفسير الممكن لهذه العلاقة بتخييل المياه يدخل في تركيب الهوية المغربية جغرافيا أولا، قبل أن يكون للمسألة أكثر من معنى -شخصي وفلسفي-. مع العلم أنني من مواليد 3 يوليوز، وهذا يعني أنني أنحدر من برج السرطان، وهو برج مائي، هذا للمزحة فقط ولا أحمله محمل جدية. ... مجمل القول، أنني كاتب : مولع باللعب، واللعب مؤسّس على فلسفة حياة قبل أن يكون مسألة فنية وجمالية. لن أفتح باب السفر في تاريخ اللعب، كما قدّره وآمن به ومارسه كتاب كبار، ويكفي القول أن الكتابة نفسها هي أخطر لعبة. مولع بالتجريب، فالكتابة إما أن تكون مغامرة ومجازفة أو لا تكون، والتجريب المتواصل هو التماهي مع قلق الكتابة ذاته. فعدم الاطمئنان إلى الجاهز، والنأي عن مجاورة المألوف والعادي، وتجاوز فخ النمط هو الحرف الأول من أبجدية كل تجريب يطمح إلى إحداث رجّة أو تحول أو إبدال في سيرورة النوع بل في مفهوم الكتابة نفسها ، ويضيف إلى موجز تاريخها قيمة مضاعفة ومعنى جديدا أو جذريا بالأحرى. مولع بالغرابة، لأنني على صلة دائمة بالتفكير المؤرق في الوجود. هذا اليومي والمألوف والمعتاد لم يستطع أن يصرف نظري عن غموض الحياة والكون، فما من دقيقة أو لحظة إلا وهي محض معجزة أو حلم، وأما على نحو خاص، فحياتي مطوقة بالمصادفات المرعبة والوقائع الغريبة وهي غالبا ما تحتكم إلى نسق خفي. النزوع الفانتازي مصدره هذا الافتتان بالغرابة التي تفخّخ حياتنا اليومية ولا نكاد ننتبه إليها. لا أمارس هذا النزوع كشيء مفارق للواقع، بل أعتبره واقعا مضاعفا. أن تكشف الفانتازيا عن لاواقعية الواقع يقول أنها تعيد النظر جذريا في أطروحة الواقع بالنظر إليه كشيء جاهز، وثابت ومطلق. قد يبدو الخيال مفرطا في أعمالي، لأن الخيال في المبتدأ والخبر هو امتحان الكتابة الأخطر على نحو دائم، وليس الخيال هو الإمكانية السحرية الوحيدة للذهاب فيما وراء الحدود وحسب، أبعد من ذلك اكتشفتُ أن في مجمل الحكايات الأمازيغية والمغربية التي تشبّعت بها في طفولتي ، كما في مجمل النصوص العربية النثرية القديمة التي اطلعت على أغلبها ذات المنحى العجائبي ، وفي الحكايات الإفريقية السحرية ، وفي النصوص السردية الفانتازية المتوسطية ، ومنها " الحمار الذهبي " ، وفي مجمل النصوص الفانتازية العالمية ، ثمة ما يشبه " كوجيطو " أساسيا، ما يشبه مبدأ أو قانونا ، تحصيله هو أن معرفة صحيحة بهوية الشخص ، أو كينونته بالأحرى ، لا تستقيم بمعرفة إسمه ، ونسبه ، ومهنته ... بل تستقيم بطريق أخرى هي معرفة خياله . نعم يكاد يكون السؤال المتواري والمضمر بلذوعية ، أو المقولة المنتخبة على سبيل الخلاصة ، في كل أدب فانتازي هي : أخبرني عن خيالك ، أخبرك من أنت !
-
كلمة ألقاها الكاتب في اللقاء الدراسي الذي نظمه مركز الحمراء للثقافة والفكر حول أعماله الروائية بمراكش، 29 يونيو 2018.
-
- ملاحظات في الحلقة الأولى من التجربة الروائية*-
الرواية نت






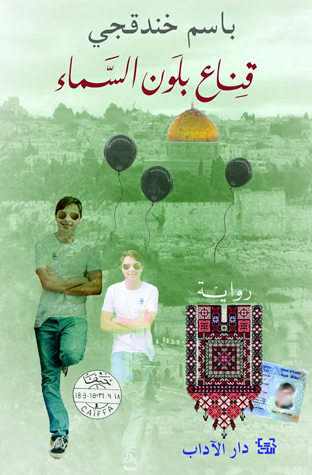







0 تعليقات