روزا ياسين حسن: الكتابة للصغار أصعب منها للكبار
حققت الروائيّة السوريّة الشابة روزا ياسين حسن (1974)، حضورًا لافتًا منذ فوز روايتها الأولى "أبنوس" بجائزة حنا مينه في عام 2004 في دمشق، وهي الجائزة التي لم تستمر، للأسف بعد ذلك. جودة تلك الرواية جعلتها تُترجم إلى الألمانيّة في عام 2011، أي قبل وصول روزا إلى ألمانيا بمنحة من مؤسسة هاينريش بُل في أواخر عام 2012.
صدرت روايتها الثانية "نيغاتيف، من ذاكرة المعتقلات السياسيّات" عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان في عام 2007. في عام 2009 صدرت روايتها "حرّاس الهواء" عن دار الريس في بيروت، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة بوكر العربيّة في عام 2010. وبدلًا من الفوز بتلك الجائزة فازت، في العام ذاته، بجائزة بيروت 39، وترجمت إلى الألمانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة في الأعوام 2013، 2014، 2017 على التوالي. لتفوز الرواية ذاتها، في عام 2014، بالجائزة التقديريّة لمؤسّسة لاغاردير ومعهد العالم العربي في باريس.
في عام 2011 صدرت روايتها "بروفا"، عن دار الريس، بينما صدرت روايتها الأخيرة "الذين مسّهم السحر" عن دار الجمل في عام 2016. وهي الرواية التي تحدّثت عن المظاهرات والاعتقالات والتنكيل الذي جرى ويجري في سورية منذ ربيع عام 2011.
دخلت روزا تجربة جديدة؛ وهي إصدار رواية للفتيان بعنوان "باتجاه مكان لا موت فيه"، باللغات الألمانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة، قبل صدورها بالعربيّة، وهي تتحدث عن ثلاثة شبّان يعيشون هول المطالبة بالحريّة وإسقاط النظام في سورية. وعن هذه الرواية وهذه التجربة والمنفى ومواضيع أخرى كان لنا معها هذا الحوار.
(*) هذه المرّة الأولى التي تكتبين فيها رواية قصيرة للفتيان، وصدرت باللغات الألمانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة قبل صدورها بالعربيّة. ماذا يعني لك التوجه للقارئ الغربيّ قبل القارئ العربيّ؟
- بالنسبة لي كانت تجربة جديدة تمامًا، ولا يمكنني أن أقول بأنها كانت تجربة سهلة؛ بدا لي أن الكتابة لـ"الصغار" أصعب بكثير من الكتابة لـ"الكبار"، والصعب في الأمر أن تقتنع بأنك فقدت الدهشة التي يتمتع الصغار بها.
في المنفى امتلكني سؤال أساسي، وهو كيف يمكنني أن أكون أحد الجسور بين ثقافة منطقتنا، عمومًا، والثقافة الأوروبية، خصوصًا، حين نلاحظ بأن ثمة هوة واسعة من عدم الفهم والأحكام المسبقة والشك بين الثقافتين. وبما أنها رواية للفتيان، يعني أن الشريحة المستهدفة هي الأطفال بين 12 إلى 18 عامًا، فمن المهم أن يطّلع الفتيان الذين يقرأون بالألمانية والفرنسية والإيطالية، اللغات التي طُبعت الرواية بها، على ما يحدث في سورية، وكيف يعيش أقرانهم من الفتيان حياة أقل ما يمكن وصفها بأنها لاإنسانية! ربما يأتي وقت وتنشر بالعربية لا لكي يقرأها أطفالنا، فهم من يصنعون الحكاية الآن بأعمارهم وآلامهم، وأحيانًا أشعر بأنهم غير محتاجين إلى آلام مضاعفة حين قراءة آلامهم الشخصية كمن يغُتصب مرة بعد مرة، ولكن كي يقرأها أولادهم وأحفادهم ويعرفوا ما عاشه الأجداد يومًا.
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="3826242480">
لابني الدور الأكبر في كل كتاباتي
(*) هل كان لابنك، الذي يعيش معك ويبلغ 15 عامًا، دور في كتابة هذه الرواية؟ وبالتوجّه إلى هذه الشريحة بالذات؟
- أعتقد بأن له الدور الأكبر في كل كتاباتي وليس في هذه فحسب. وجود ابني "آرام" يجعلني مقتنعة بأن الحياة لن تبقى على ما هي عليه، وأن الأطفال لا ينتظروننا كي يكبروا. هم يكبرون بسرعة مذهلة ويفاجئوننا كم كبروا، وكم أنهم يفهمون الأمور أحيانًا بجلاء أكثر منّا، والأهم بنقاء أكبر! ابني يعطيني معنى للحياة، وربما كان العمل على هذه الأجيال القادمة أهم من العمل على أجيال أنجزت وماتت دهشتها مثلنا. باختصار الأطفال أو الفتيان يهبونك قناعة بأن الشيء الوحيد الثابت هو التغير الدائم، وهذا التغير لن يكون إلا بهم ومنهم. وحين تؤمن بالتغيير فإنك تؤمن بالفعل، أيًا كان ذلك الفعل، وتأثيراته القادمة، وبالتالي تتجرّد من يأسك بما يخصّ التغيير!
(*) هل هناك أفكار جديدة تحصلين عليها في مكانك الجديد، منذ خمس سنوات في ألمانيا؟ أم ما زلت تستقين أفكارك من بلدك سورية؟
- أنا أستقي أفكاري وتخييلي من كل شيء ومن كل مكان، من وطني الأم ومن تجاربي ومن منفاي ومن المدن التي زرتها وأزورها ومن الأشخاص الذين أعرفهم وسأتعرّف عليهم، والكتب التي أقرأها، والأفلام التي أشاهدها ومن الذاكرة، من كل شيء. الروائي الذي لا يتعلّم كل يوم، والذي يعتبر نفسه قد أنجز ولا شيء جديد ليتعلمه، أو يضيفه إلى إبداعه، يكون قد كفّ عن الإبداع. وأنا مقتنعة ومعجبة بأن الروائي هو أكبر انتهازي في العالم، وأكثر من يستغل كل شيء لخدمة إبداعه.
لست كاتبة في المنفى
(*) هل تعتبرين نفسك كاتبة في المنفى؟ وماذا يعني لك المنفى؟ وكيف تقضي روزا ياسين حسن يومها بعيدًا عن مسقط الرأس؟ وماذا تعني لك هامبورغ كمدينة بحريّة تشبه في مزاجها مزاج مسقط الرأس؟
- الكتابة كما أراها فنّ عابر للأمكنة والأزمنة، لذلك أنا أعيش في المنفى بجسدي الفيزيائي فحسب، ولكني لست كاتبة في المنفى، بل كاتبة تسافر روحها في كل العالم. أنا لا أقول إن الوجود الفيزيائي لا معنى له، بل على العكس، فهو المدخل للكتابة، ولكن في الكتابة تغدو الفيزياء نافلة.
لقد كتبت في سورية وكانت الظروف صعبة للغاية، وما زال غيري هناك، وفي أماكن تماثلها صعوبة، ويكتب ويستمر في الكتابة. وأتيت إلى المنفى وما زلت أكتب وسأظل أكتب حتى النهاية. وكي لا أقع في فخ النوستالجيا والبكاء على الماضي، حاولت أن أستغل هذا المنفى، أن أطوّعه وأستفيد منه في عملي؛ بمعنى أن أحوّل هذا الفخّ المفروض عليّ إلى إبداع. أنا أعيش هنا بعينين مفتوحتين على كل شيء جديد!
هامبورغ تشبه مدينتي البحرية اللاذقية؛ بمائها وانفتاحها، وتشبه دمشق، مدينتي التي أحب، بتنوعها وتعدّد ثقافاتها، ما يجعلني أزاوج دومًا بينها. لدي اقتناع بأن الوطن هو ذاكرة وحب تعيش في أرواحنا، وليست قطعة أرض فحسب! كما أن تعدّد الهويات أمر يُغني، ويجعل منّا أكثر فهمًا للحياة وانفتاحًا على الآخر.
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:320px;height:100px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="7675478845">
(*) أنت تقومين بإعداد محاضرات لطلاب الأدب العربي في جامعة هامبورغ. كيف هي فكرتهم عن الأدب العربيّ عامة، والأدب السوريّ بشكل خاص؟ وكيف تجدين علاقتك معهم؟
- كانت فرصة رائعة أن أستطيع تدريس الرواية العربية الجديدة للطلاب في جامعة هامبورغ، وهنا أعود إلى مثالي السابق؛ كيف يمكن لي أن أكون جسرًا بين ثقافتين. وهذا ما حاولت وأحاول مرارًا فعله هنا. يعني أن أختار نصوصًا خارجة عن الأحكام المسبقة التي سُجن الأدب العربي فيها زمنًا طويلًا. وتلك الأحكام تنقسم بين من يرى الأدب العربي كألف ليلة وليلة، وبين من يراه أدب المقموعين الخائفين الذين لا يستطيعون الكتابة عن شيء، وبين من يراه أدبًا في الدرجات الدنيا لسلّم الكتابة العالمية، وهذا ما أحاول نقضه بتدريسي لكثير من النصوص العميقة الحديثة والجريئة والحرة لكاتبات وكتاب لا يقلّون إبداعًا عن الكتاب العالميين، وأستمتع برؤية الدهشة على وجوه طلابي! تراكم الأفعال المغايرة سيؤثر يومًا بعد يوم وإن ببطء.
الشعب السوري يستحق
الحرية والديمقراطية
(*) كيف تنظرين إلى ما يجري في سورية الآن؟ وما هو دورك ككاتبة في ما يحصل، خاصة أنّ هناك سوء فهم لدى الغرب لما يحصل في سورية؟
- بالنسبة لي فأنا مقتنعة بأن ما حدث في سورية في 2011 كان ثورة شعبية ضد الطغيان من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، وما حصل بعد ذلك من أسلمة للثورة، واستغلالها من قبل أمراء الحروب والأنظمة الداعمة للنظام، والأنظمة التي تدّعي وقوفها ضده كذلك، ما هو إلا ألعاب سياسية واستغلال لإرادة الشعوب. قد نكون خسرنا الجولة الآن، ولكن الحياة مستمرة، والشعب السوري يستحق الحرية والديمقراطية ككل شعوب العالم. وانشغال العالم بمكافحة الإرهاب الذي كان للنظام السوري، وبقية الدول اللاعبة معه وضده، الدور الأهم في إذكائه، ما هو إلا حجة لقمع تطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية.
الأوروبيون ليسوا كلا واحدا، هم تمامًا كالشعوب العربية، مختلفون ومتباينون، وثمة جزء من المجتمع متعاطف للغاية مع القضية السورية، وثمة جزء لا يهمه من الأمر إلا ما يؤثر عليه وعلى طريقة عيشه. ومع هؤلاء أردد دومًا، بأن حلول الإرهاب لا تكمن في قمع الشعوب وإسكاتها بحجة مكافحة الإرهاب، بل بخلعه من جذوره، وهذا لن يحدث بدون بناء مجتمعات متنورة متعلمة حرة وديمقراطية تعيش بكرامة وانفتاح، وإلا ظل جذر التعصب والكره والغضب، وبالتالي الإرهاب، قويًا. هذا ما أحاول تأكيده دومًا هنا. وكما قلت لك صديقي كل فعل صغير نقوم به سيؤثر بالتضافر مع غيره من الأفعال، وما نحاول اليوم فعله كلنا سيتراكم ببطء ربما ولكنه سيؤثر بطريقة ما غدًا، وهذا ما أفكر به دومًا حين أقوم بأي شي في حياتي. عن ضفّة ثالثة - العربي الجديد
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="1305511616">
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-8970124777397670" data-ad-slot="4898106416">







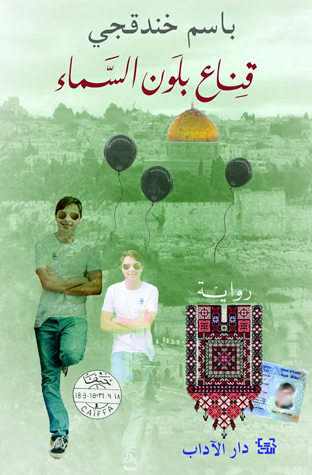






0 تعليقات