عزام: لا يمكن للرواية تجاهل المحنة السورية
ممدوح عزام هو كاتب وروائي سوري من مواليد السويداء عام ١٩٥٠، ويعتبر من أبرز الأصوات الروائية السورية، ويتميز نصه بالحبكة الروائية المشوقة والسرد اللغوي المحكم، من مؤلفاته روايات "معراج الموت"، و"قصر المطر"، و"جهات الجنوب"، و"أرض الكلام". سألته الجزيرة نت عن قضايا تتعلق بالأدب والفن الروائي ودور المثقف وتأثيره وتأثره بالحراك الشعبي وتطور وسائل التواصل الاجتماعي فكان هذا الحوار. - ما الدور الذي يمكن للمثقف عموما، والأديب أو الروائي على الخصوص أن يلعبه في التحولات السياسية والاجتماعية- العنيفة، مثل التحول الذي تشهده سوريا الآن؟ هل تعتقد أنه من الأفضل أن يلعب دورا توثيقيا أدبيا، أو دورا سياسيا مباشرا؟ سياسيا، لا دور للمثقف في الأزمات التي تتصف بالعنف، فالعنف نفسه طارد للوعي والثقافة إلا إذا كان المثقف داعية أو بوقا، وفي الحالتين فإن دوره يتعدى أمور الثقافة ومتطلباتها ومشاكلها، هل يتدخل المثقف في أمور الثقافة أم في أمور السياسة، وفي حال كان الجواب الثاني هو المطلوب فإن الدور يتعدى الشأن الثقافي، لا يعود المثقف عاملا في الشأن الثقافي. وقد يحتاج المرء لتعريف الثقافة في هذه الحال، وأيا كانت الإجابات فهي لن تمس شؤون السياسة، وفي حال العنف فإ دورا تنويريا وعقلانيا يناهض العنف، هو الموقف الأكثر ملاءمة لمكانة المثقف، خاصة حين يعجز عن تقديم أي صوت مؤثر، وفي ظل الأحداث التي تمر بها سوريا فإن المثقفين تحولوا إلى بضاعة فاقدة الصلاحية، سرعان ما ظهر أن السلاح أقوى من الكلمة، وأنه حين يحضر يضطر المثقف للاختباء خلف نظاراته، أو العودة إلى ياقة قميصه وكرسي مكتبه. وفي كل الأحوال فإن التجربة -أو الواقع العياني- هي الحكم القادر على معايرة الأدوار الفاعلة، والثابت حتى الآن هو أن المثقف السوري قد تخبط بطريقة مثيرة للشفقة، في اللحظات التي توهم فيها أنه قادر على التدخل في الشأن السياسي، فلا طبيعته النفسية والوجدانية تتيح له أن ينفذ أنشطة تتسم عامة في بلادنا، بالزئبقية، والكذب، وخيانة المبادئ، ولا بنية القوى الفاعلة على الأرض تستطيع استيعاب قيامه بدوره الخاص، دور المنور العقلاني والديمقراطي الداعي إلى التعددية واحترام الرأي والعقيدة لدى الآخرين، إنها تريده كتابع، أو كشارح، أو كبوق، ولهذا فإن العمل في الثقافة قد يضمن للمثقف شكل الحياد البسيط الذي يسمح له بإنتاج الثقافة دون أن يهدده بفوهة البندقية في حال عمل في السياسة. - ما رأيك بشكل عام حتى الآن بالتجارب الأدبية -والروائية على الخصوص- التي خرجت من سوريا بعد اندلاع الثورة السورية منذ حوالي أربع سنوات؟ وكيف تفضل أن تكتب عن تجربة الحرب؟ لم أقرأ سوى القليل من الكتابات، وهي أعمال جيدة في الحقيقة، ومصدر جودتها الأهم أنها كتبت تحت النار أو في ظلال البلاد الأخرى، حيث هاجر المثقف أو الكاتب حصرا هنا ما دمنا نتحدث عن الأعمال الإبداعية. ويبدو أن الشعر والقصة القصيرة قد تمكنا من التقدم وإحراز بعض النقاط اللافتة في التعبير عن الوضع السوري قبل غيرهما من الأنواع الأدبية، وكل هذا حسن بالطبع، خاصة أن معظم هذه الأعمال اتسمت بسوية فنية تتماشى مع أي تقييم، وذلك بعيدا عن المقارنة مع المرجع الذي حرض على الكتابة. ويمكن أن أشير هنا إلى ما استطعت متابعته من خلال المواقع الإلكترونية حيث يعمل الشباب السوريون المهاجرون ويكتبون يومياتهم أو مقالاتهم، وهي أعمال ما كان لها أن تظهر أبدا لو كانوا في الداخل، لأسباب لها علاقة بالرقابة من جهة، وبعدم توفر منابر الكتابة من جهة ثانية. أما عن نفسي فمن الطبيعي أن يكون لدي مشروع للكتابة عن الحال، وهو موجود قطعا، ولا ضير من الاعتراف بأن الثورة وما جرى فيها ومن حولها تثير الكثير من الارتباك بسبب حجم الأسئلة الهائل، وضخامة المستجدات الحاصلة، وفورة التغير البشري الذي شمل السوريين كافة. فما حدث في السنوات الأربع لا يمكن مقارنته بقرن من الزمن، لا في كمية الأحداث، ولا في جوهر التبدلات التي طرأت على الأفراد والجماعات والطوائف والإثنيات، وهو مما لا يمكن للرواية أن تتجاهله، لا للتوثيق بل لترى أثره على الروح، وسوف تكون تجربة روائية صعبة جدا أمام جميع الروائيين السوريين والعرب الذين يتجاهلون محنتنا حتى الآن.. صعبة فنيا وحكائيا. - كشفت الثورات العربية عن دور وسائل التواصل الاجتماعي -خصوصا فيسبوك- في الكتابة والتعبير، ويلاحظ تراجع الاهتمام بالصحافة المكتوبة بالمعنى التقليدي، فما التأثير العميق الذي سوف تطبع به وسائل التواصل الاجتماعي أساليب الكتابة وطرق التفكير؟ الحقيقة أن العرب طوروا وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تطورهم، فيسبوك مثلا لم يبتكر من أجل النصوص الأدبية القصصية منها والشعرية، لم يبتكر من أجل خلق تواصل حراكي يحمل الرسائل المشفرة التي غطت المظاهرات أو الاجتماعات، بل من أجل شكل بسيط من التواصل الذي لا يتضمن أي حوار أو أي نقاش جدي. وبالعودة إلى سؤالك ألاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تعمل ضمن جوهرها الأصلي وهو التواصل فقط، ودون أن أقلل من شأن هذا المنحى الجديد الذي لم يكن متوفرا من قبل في تعرف القارئ على الكاتب، أو في انتقال النصوص الإبداعية بحرية لا تعيقها الحواجز الرقابية أو الموانع المالية فإن النصوص التي تنشر على فيسبوك تلقى استجابات تفتقر إلى الطابع الحواري. هنا ثمة إعجاب يظهر في التعليقات ذات اللهجة المدحية، أو التطبيلية في الحقيقة، أو في إعلان إعجاب محايد دون تعليق، لا حوار، ولا نقاش في المادة، ولا كلام عن فن النوع الأدبي المنشور. واختفاء النقد والحوار في الأنواع التي يتجرأ الكتاب على نشرها في هذه المواقع، وتكريس لغة المديح قد يؤديان إلى أحد أمرين: الأول انتفاخ الذات الكاتبة وعجزها عن تطوير أدوات الكتابة، والثاني: تقلص إمكانية إغناء الكتابة الإبداعية بالفن الذي تنتمي إليه، وقد تكون الحصيلة كمّا ضخما من مادة لم تخضع للنقد والحوار وصقل الأدوات الكتابية. - ثمة نقاشات دائمة تنتشر في أوساط المشتغلين بالأدب، وهي سيطرة وانتشار نوع أدبي على حساب تراجع نوع آخر، فمثلا يقال إن الرواية تتقدم على الشعر، أو إن القصة في تراجع مثلا، وغير ذلك.. هل تعتقد أن أجناس الكتابة الأدبية تتراجع وتتقدم باختلاف الظروف التاريخية؟ سمعت هذا الكلام منذ أكثر من ست أو سبع سنوات، ولا أظن أن بوسع أي نوع أدبي أن يزحزح نوعا أدبيا آخر إلا إذا كان ذلك النوع قد فقد علاقته مع القراءة، لنقل قد فقد علاقته مع الحياة، وهو يغادر الساحة الأدبية لهذا السبب، وليس لأن نوعا آخر قد أزاحه، هذا مصير المقامة مثلا، يمكن أحيانا للنوع الأدبي أن يلغي أو يطور ذاته بحيث يقلب القواعد، كالمسرح الحديث مقارنة بالمسرح الكلاسيكي، غير أنه يبقى مسرحا. ولهذا فإن من الجور أن نحمّل الرواية مثلا الجريرة القانونية لموت الشعر أو القصة القصيرة، هذا ما يتردد أحيانا في الصحافة. يقال أيضا إن السينما قتلت الكتاب، وإن التلفزيون ثأر له دون أن يتعاطف معه وقتل السينما، أظن أن الموضوع برمته ليس أكثر من هواية صحفية لا تريد أن ترى حياة الأنواع الأدبية خارج نطاق التنافس أو المماحكة. - ما التأثيرات العميقة التي ستطال الرواية العربية عموما بعد انطلاق هذه الحركات التغييرية العميقة في العالم العربي؟ من الصعب أن نتكهن، أنت تعرف أن الأعمال الأدبية الجيدة تخرق نظام العمل في النوع الأدبي دائما، هذا أحد مصادر الجدة فيها، ومن هنا يمكن أن تكون آراؤنا في هذا الصدد مستندة إلى التوقع والاحتمال: هل كان البطل الوحيد -لا الفرد بالطبع- هو سيد الرواية العربية في العقود الماضية؟ نعم.. وقد عكست تلك البطولة تحول المجتمع العربي عن التبدلات العميقة التي تصنعها الجماعات إلى التبدلات الشكلية أو السطحية التي تناط بأفراد، فهل لا يزال المجتمع يراهن على عودة البطل؟ يمكن أن نقول اليوم: لا.. دون أن نراهن في المقابل على المطلق في قولنا. لا تزال الجماهير خارج دائرة التقرير، إنها تقاتل بمرارة وعزيمة من أجل تغيير قواعد اللعبة التاريخية التي حكمت العالم العربي، وحولت تاريخه إلى تاريخ أفراد وأبطال، وهو ما سوف تبحث عنه الرواية السورية في المستقبل. المصدر : الجزيرة

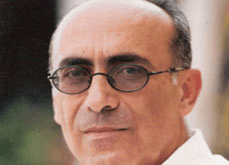






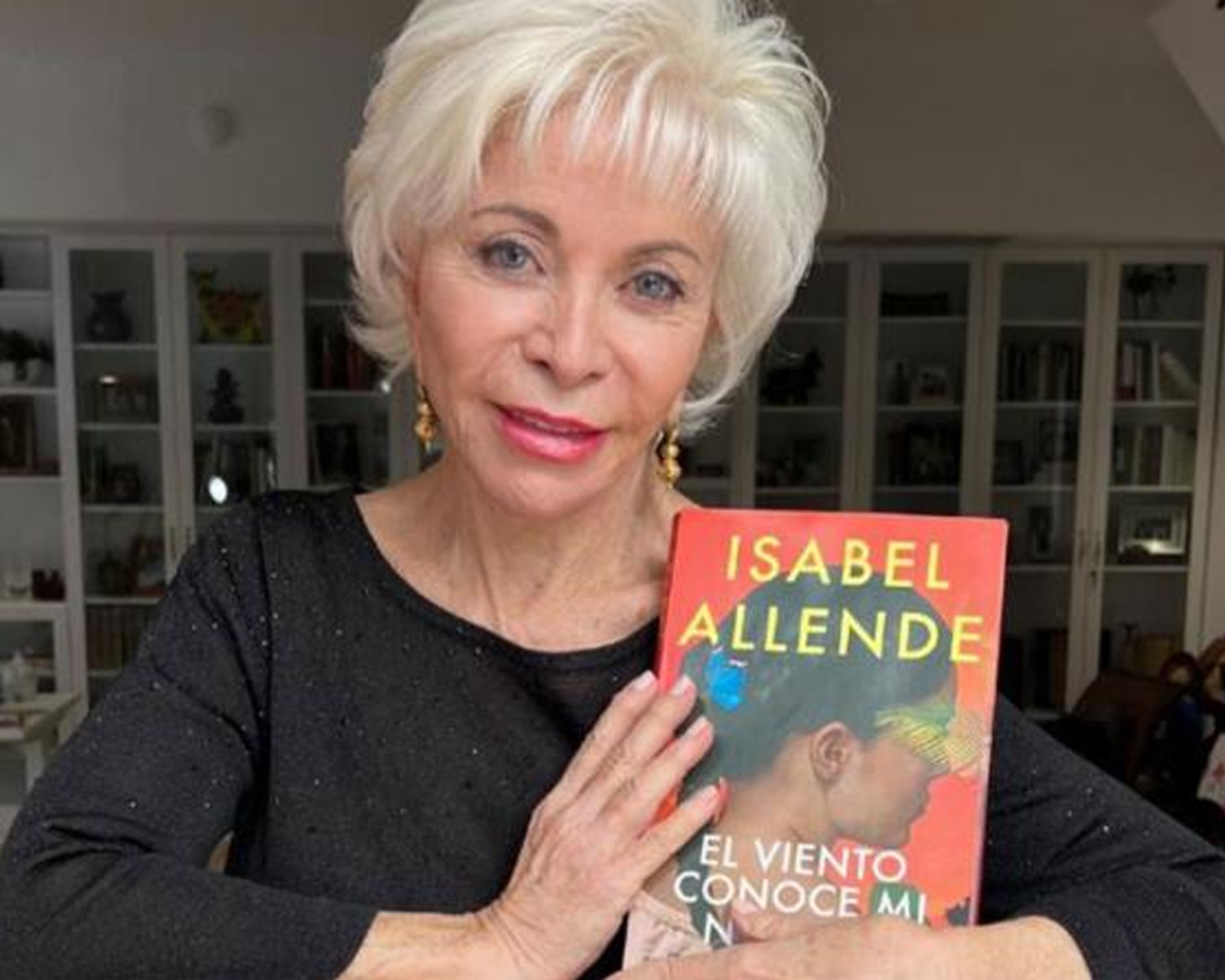



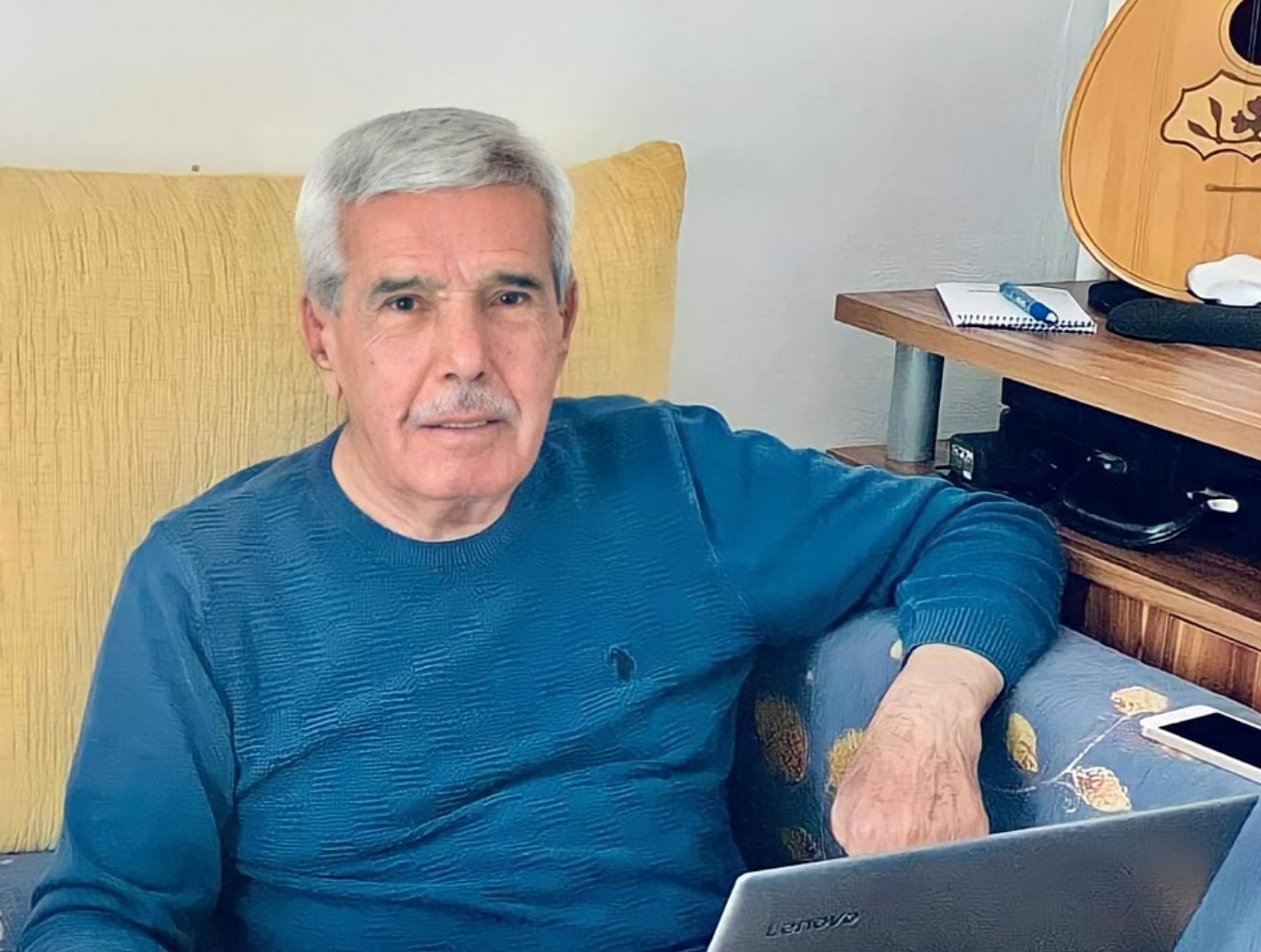

0 تعليقات