ثلاثة فصول من رواية "الجبل الأبيض"
في عز الأزمة وضيق ذات اليد؛ خرج شاكر يبحث عن كوة في سديم الظلام؛ لعلها تفتح له باب الأمل؛ وتُحسن مستواه الاجتماعي،وفي لحظة لم تكن في الحسبان أطل الفرج بعنقه من أرض سلطنة عمان؛التي انبعث منها فيضٌ من السعادة التي ملأت قلبَه ومنحته مساحةً شاسعةً من الأملِ؛ وكثيرا من التعلقِ بالمستقبل؛ وحُب الناس؛والرغبة في التشبث بالحياة؛ بعد أن أوصد عليه القدرُ كل مسربٍ للرحمةِ. كان شاكر في غيثَان الشباب؛ مازال ماءُ الفتوة يتلألأ من طراوة الحياة: قصيرُ القامةِ؛ متوقذ الذكاءِ؛ كانت جميع تقاطيعِ وجههِ تُعبر عن رصانة وتفكير؛ يمتزجان بالعاطفة والطيبوبة؛ لم يكن يعلم أن تكوين أسرة صغيرة يحتاج إلى كثير من المصاريف؛ وإلى مزيد من الصبر؛ ينبغي عليه تحمل كل إكراهات الحياة ومصاعبِها. كان طموحا؛ وطموحُه دفعه إلى مضاعفةِ مصاريفه، ففتح على نفسه منافذ كثيرة من الرغبات والمتطلبات، لكن يده لم تَكُن تطالُ ما يتمناه قلبُه؛ فغالبا ما تُصفع رغباته بضيق اليد. وهكذا؛ وأمام هذا الوضع الجديد فتح على نفسه باب القروض الصغيرة التي أصبحت تنهش راتبه الشهري الضئيل؛ وكأنه فتح على نفسه باب جهنم؛ حيثُ تكاثرت عليه الديونُ؛ ولم يعد في استطاعته تلبية حاجياتِه ومتطلباتِ أسرتِه الصغيرةِ؛ بل لم يعد قادرا على تدبير بعضِ أساسيات البيت من مأكلٍ ومشربٍ، مما دفعه الأمر إلى مزيد من الاستدانة؛ إلى درجة أنه بدأ يستلف من الأصدقاء والمقربين؛ ولهذه الأسباب لم يكن له من مخرج لأزمته؛ إلا البحث عن حل نهائي يُسدد به كل ديونه؛ ويخرجه من أزمته التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم. بات التفكير في السفر بعيدا عن الوطن ضرورةً مُلِحةً؛ لأن أرض الوطن ضاقت به؛ ولم يَعد يستطع تحقيق مُتطلباتِه المتزايدة والمتكاثرةِ؛ والتي هي في حقيقة الأمر متطلبات كل شاب في بداية حياتهِ الزوجية؛ متطلباتٌ تفرضُها الرغبةُ في تأسيس وبناء أسرة ترغب في العيش الكريم والحياة الشريفة؛ وفي التوفرِ على بيت بسيط يأويهم و يصونُ كرامتَهُم ويَعفيهِم من الإيجار الشهري الذي يلتهمُ نصفَ راتبِه؛ ناهيك عن مصاريف الماء والكهرباء ومصاريف أخرى. حل فصل الربيع؛ وأسفرت الأرض عن مُحياها؛ وأبدت زينتَها الخضراء؛ تَسر الناظرين؛ حيث السماء صافية والجو بديعٌ؛ طبيعةٌ خلابةٌ ينتعشُ بها الإنسانُ وتُدخلُ في نفسه بارقةَ أملٍ؛ لكن جمالَ الطبيعة ورونقَها لم يُثر اهتمام شاكر لأن باب الخضرةِ والجمالِ كان مغلقا أمام عينيه بمسحةٍ من سواد الحياة وقتامةِ الواقعِ. فكر في تقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليم من أجل الالتحاق بإحدى دول الخليج كأستاذ معارٍ؛يريدُ أن يبيعَ بضاعته المعرفية التي كسدت؛ في بلاد لم يحترم قومٌ منهم مهنةَ الأنبياءِ؛ لتنوير عقولِ أبنائِها الغضةِ في المجال القرائي والمعرفي؛ مقابلَ راتبٍ شهري مشجعٍ و محفزٍ على حب الحياة؛ ويضمن العيش الرغيد لهُ ولأولادِه. كانت الشمس تتوسط كبدَ السماءِ من منتصف أبريل؛ أوشكت أن تلامس رؤوس الناس من فرطِ الحرارة؛ذهب شاكر إلى عملِه؛ فبدأ يومَه بشكل اعتيادي كسائر أيام اللهِ السبعة؛ وفي لحظة من اللحظات فتح مساعد المديرِ البابَ عليه؛ وهو في القسمِ يشرحُ الدرسَ للتلاميذ؛ استقبله بمحبة لأنه كان يعزه ويحترمه، وكان من حين لآخر رغم تأزمه يعطيه بعض النقود،فقد كان حقد الفقر يخنق جيبه من حين لآخر،ومما زاد الطينَ بِلةً زوجُه الفاسقُ التي كانت الخيانةُ تجرِي في عرُوقها وتُغرقها في مستنقعات الرذيلةِ مع فقيهِ الحَي. قال مساعدُ المديرِبلهجتِه الأمازيغية: إنك يا شاكر مطلوبٌ فورًا، ينبغي عليك الالتحاق بقسمِ المواردِ البشريةِ بنيابة التعليم؛ من أجلِ تسلم رسالة رسمية من وزارة التربية الوطنية. شعرَ شاكر بقشعريرةِ الفَرحِ تسري في أوصاله وباقي سائر جسده؛ كانت فرحة تَغمرُه بوفرتِها؛ وتُزيلُ عنه بعضًا من تراكماتِ الأحزانِ التي كان يرزحُ تحت وطأتها؛ راودهُ نوعٌ من الإحساس بأن طلبهُ قد حظي بالقَبولِ؛ وناداه صوتٌ من داخله أن الحظ قد ابتسمَ له أخيرا . وذات يوم أشرقت الشمس على غير موعد؛ كانت تلقي بخيوطِها على النافذة؛ وتشرئِب بعُنُقِها لتُطِل على شاكر؛ وهو يضعُ اللمساتِ الأخيرة على الحصة الزوالية الأُولى،بدأت الدقائقُ وكأنها تزحفُ وتسير سَير الحلزونِ؛ تمُر عليه وكأنها سنوات عجافٌ؛ تَمنى لو تنفض الدقائق عنها غبار التكاسُل وتستعيد نشاطها وحيويتها وتمر بسرعة، وأخيرا دق الجرس وبسرعة السهم وبدون استئذان أطلق ساقَيهِ للريح مُتجهًا نحو إدارة التربية و التعليم . جدران متصدعةٌ بهت لونها من جراء التقادم؛ أبوابُها مهترئةٌ؛ وأصواتٌ ترتفعُ من هنا وهناك يتقاذفها المرتادون؛ ألقى شاكر نظرة خاطفةً على الفِناءِ فأُصيب بالخرسِ؛ لِما شاهده من الخلاء؛ لا أشجارٌ ولا نخيلٌ يُوحي للداخل بالحياة ونكهتها، ثم دخل مكتب الموارد البشرية؛ ووجد فيه رجلا مربوعَ القَد طويلَ القامة؛ كان يجلسُ وراءَ مكتب دوارٍ، حياهُ بِتحيةِ الإسلامِ، وقدم له نفسه قائلا: أنا الأستاذ شاكر الذي استُدعيَ من طرفكم. قاطعه الرجلُ؛ وقال: بالفعل لقد أرسلنا إليك رسالةً إلى الثانوية، لنُخبرك بأنك مطلوبٌ للعمل في سلطنة عمان كأستاذٍ معارٍ لتدريس مادة اللغة العربية…….. فَكر شاكر؛ ماذا لو كانت كذبة من كِذباتِ أبريل، لذلك احتاطَ وتحوطَ، فلن يقبل للحظةٍ أن يكون ضحية من ضحايا الكاميرا الخفيةِ، أو ضحيةَ خطإٍ من أخطاءِ الإدارات العمومية.. وبينما هو يراجع نفسه من أثر صدمة الخبر السعيد؛ أخرج الموظفُ رسالة رسمية من نسختينِ؛ سلمهُ واحدةً ووقعهُ على النسخةِ الثانية لكي يحتفظَ بها لأرشيفِ الادارة. كان الخبرُ بالنسبةِ لشاكر كقطعةِ ثلجٍ مرت على جبينِه؛ في يوم قائظٍ؛في صحراءَ قاحلة؛ تسلم المراسلةَ الوزارية قرأها بسرعةٍ وتمعن من فحواها؛ بحيث طلِب منه التوجه مباشرةً في اليوم الموالي إلى مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة؛ للتعاقد مع اللجنة المكلفة بجلب الأساتذة المغاربة في مختلف مواد التدريس و التعاقد معهم. ومنذ أن تسلم شاكر هذه الرسالة الوزارية؛ وهو في عالم ملئ بالأَحلامِ الوردية؛ والأماني الواعدة التي كانت تُراوده وهو في عِز شبابِه؛ وها هو الآن يرى بشائرَ هذه الأحلامِ تُسفر عن وجهِها؛ أو على الأقل بدأت تقترب شيئا فشيئا من بلورتِها على الواقع؛ الذي طالما حلم بتغييره وتحقيق كثير من الرغبات والمتمنيات التي رسمها في ذهنه؛ وتمنى أن يعيشها ويتذوق طعمها؛ شأنُه شأنُ زملائِه في العمل؛ إنها أحلامٌ يتيمة؛ لكن بوادرها بدأت تهل على شاكر؛ وبدأ يشعرُ بها وهي تدنو منه وكأنها الحبيبةُ التي تمنى أن يعانقَها يوما ما؛ وأن يَحكيَ لها حكايةً طويلةً لا تنتهي فصولُها ولا يَموتُ أبطالُها. في اليوم الموالي توجه شاكر باكرًا إلى العاصمة؛ وفي يده حقيبةٌ فيها كل وثائقه الإدارية وشهاداته الجامعية؛ حتى يَسُد المَسربَ على مُناوراتِ الإداريين المعهودة، دخل بابَ الوزارة وهو مرفوعُ الرأس وكأنه فاتحٌ عظيمٌ؛ سيفتحُ أقاليمَ جديدةً ويَجلبَ منها كُل الخيراتِ. حقا إنه يريد أن يستفيد بخيرات الخليج وبأمواله الباذخةِ؛ التي طالما سَمِعَ عنها في الصحفِ والمجلات؛ التي تتقاطرُ تباعا على البلد؛ لقد أراد أن يجلب العملةَ الصعبةَ ويُرقعَ بعضًا من حُلة حياتِه الباليةِ، ويُصبح إنسانا نافعًا للمجتمعِ؛تفتخرُ به العائلةُ ويعتز به الأصدقاءُ. كانت وِجهةُ شاكر الآن صوبَ مديرية الجالية المغربية بالخارج؛ كان المكان ضاجا بالحركةِ كخليةِ نَحلٍ؛ أعدادٌ هائلة من الأساتذة قد نزحُوا من كُل فج عميقٍ؛ في تلك اللحظةِ تحسس خفقات قلبِه التي ازدادت ضرباتُها بقوةٍ حتى كادَ قلبُه أن يطيرَ من قفصه الصدري؛ فقد فزع من المشهد المريعِ الذي كان يَنِم عن مأساةٍ صارخةٍ؛ جعلت كل سفراءِ العِلمِ يريدون الفرارَ والخلاصَ من جحيم الفقرالمدقعِ؛ وكانت تطفُو على مُحياهُم مخايلُ الحزنِ المشوبِ بفرحة الفِرار؛ التي تُعبر عنها قسمات وجوههم البائسةِ؛ وحتى لباسُهم كان يعكسُ نوعًا من الحدادِ الذي لطالما عاشوه في حياتهم. تفحص في الجوار مليا لعله يجد صديقا يأنس به ويستقي منه ما استبهم عليه من إجراءات معقدة؛ وإذا بيد ناعمةِ الملمس تمتد إليه وتُحييه؛ كانت يدُ صديقِه الذي كان يدرس معه في الجامعة؛ التفت إليه مُرحبا؛ثم عانقه بحرارة تختصر سنين الفراق؛ وهاهو التقى بصداقة تائهة في دروب الحياة مرة أخرى في عالمٍ صغير بعد فراقٍ طويل. حرارةُ اللقاء بين صديقين باعدَت بينهُما مسافةُ الزمن السحيق؛ التي لم تستطع مواجهة المد الجارف لموضوع الساعة؛ فقد خرج خطابُهما عن كلاسيكيته؛ ونأى بعيدا عن الاستفسار عن الحال و الأحوال؛ بل تمركز حول واقع اللحظة؛ وقد عكست ذلك خطوط جبهةِ الصديق حين استطرد قائلا: أَحُثك بأن تضع نُصب عينيك مدينة "مسقط" كفضاء دافئ للعمل حيث الاستجمام والحداثة؛ إنها نابضة بالحياة والحيوية والأمل والغد المشرق؛ لم يعر شاكر لكلام صديقه اهتماما؛ فقد كان في قرارهِ يُمَنِي نفسَه بأن يَتخلص من هذا الواقعِ المادي المرير؛ الذي فرضته عليه إكراهاتُ الحياة التي وضع نفسه بين أنيابها. جاء دور شاكر الذي كان ينتظر التعيين على أحر من الجمر؛ أخبرهُ المكلف بالتعيينات؛ رجل عماني قصيرُ القامةِ؛ مُقِلٌ في الكلام؛حتى إذا تكلم تشعر وكأنه يخاطب نفسه؛ لكن لصوتِه نبرة واضحة؛ وهو ما جعل شاكر يلتقط بعضَ الاشاراتِ منها لكي تُسعفه على التوضيحِ من كلام الرجل. استلم شاكر ورقة التعيين؛ كاد أن يبتلعها بعينيه من فرطِ الفرحةِ؛ توجه إلى مكتب مجاور فيه أحدُ الموظفين في السفارة العمانيةِ؛ الذي يُوقع على جوازاتِ السفر ويُعطي التأشيرات؛ وبجانبه شابةٌ جميلةٌ من خلال لباسها تبدو أنها مضيفةُ طيرانٍ؛ وهي التي سلمتهُ تذكرةَ السفرِ من مطار الدار البيضاء الدولي إلى مطار السيبِ الدولي.
2 جاءت لحظة الوداع؛ فراقُ الأهلِ و الأحباب؛ تغييرُ المكان بمكان آخرَ؛ ربما يكون أفضل؛ أو يخبئ له شلالاتٍ من الفقرِ التي ترسو في مرافئه القادمة؛ أسئلةٌ كثيرة تراودُ شاكر وهو يودع زوجتَه. تقابلا وجها لوجه وكأنهما في أول لقاء؛ مضى وقتٌ طويل وشفتاهما عاجزتان عن خوض غمار الكلام؛ الصمتُ يلف المكان؛ حدق في عينيها جيدا؛ قرأ فيهما فرحا؛ تلفهُ عباءة من حزن؛ كانت الدموعُ تحاصِرُ مُقلَتيها؛ تنتظرُ لحظةَ الانطلاقِ لتتهاوى كشلال يهوي من شاهقٍ؛ وفجأة سمع صوتَ ابنتِه الصغيرة تُناديه بابا بابا بابا..... صوتٌ كسر الصمتَ السائِد في البيت الصغير؛ صَيحة مدوية أحس بها وكأنها خيط من نار يشق قلبَه ويَشطِرَهُ إلى شَطرين؛ بدأت يداه ترتجفان؛ تحمل أسرار الصوت القادم من غرفة النوم؛ ابتلع العبرات التي كادت أن تخذله؛ نفض عن وجهه لمسَةَ الحُزنِ؛ عانق زوجتَهُ في صمتٍ؛ وأغلقَ باب شُقته الصغيرة ثم انهمرت دموعٌ خرساءُ بطيئة على وجنتيه؛ بَللت ثوبَه الجديد. بين السماء والأرض مُعلق كقشةٍ في مهب الريح؛ تتقاذفُها أمواجٌ من المَطباتِ الهوائية؛ يجلسُ شاكر على كرسي وثير؛ من حين لأخرَ يرمي بنظرات إلى الخارج عبر نافذة الطائرة؛ وصدرُه يعلو ويهبِط من وقع هول هذا السفر البعيد؛ يتأملُ مدينتَه البيضاءَ؛ التي يجري دمُها في عروقهِ؛ ينظر إليها؛ وتنظر إليه بنظرة تدرف توسلات؛ تستقر في القلب حتى كاد أن ينفطر؛نظرات تقطر أسى وحزنا. وفي رمشة عين اختفت المدينة وتوجهت الطائرة شرقا؛ وكأنها حصانٌ حرون يعرف المكانَ؛ يعدو بحوافره ويقطعُ عُبابَ السماء بثبات وهدوءٍ؛ حينها شعرَ شاكر بنوع من السكينة التي تَدِب في أعماقِه. في أول يوم من أيام سبتمبر وجد شاكر نفسه بسلطنة عمان؛ نزل من الطائرة؛ لفحته حرارة شديدة ظنها صادرة من مراوحِ الطائرة؛ أو مِنَ المُحركات التي تنفث حرارتها في وجهه؛ خرج إلى قاعة الاستقبال؛ كان المكانُ تحتويه الغُربةُ والغَرابَة؛ كانت الوجوهُ غيرُ الوجوهِ والملابسُ غيرُ الملابسِ؛ وفي خِضَم هذه الدهشة؛ أثارت انتباهَه لافتاتٌ مرفوعاتٌ في الهواء في كلتا الجهتين من اليمين و اليسار؛ تحملُ أسماءَ الأساتذة المعارين؛ وما لبث أن توجه إلى لافتة المنطقة الشرقية؛ حيث سلم على الرجل المكلف بالإعارات؛ ودُون مزيدٍ من الكلام استلم منه جواز سفره؛ وتوجها معا إلى الحافلة الرابضة بباب المطارِ؛ طلب منه الصعودَ والبقاءَ هناك دون حراك؛ وكأنه وقَع في كمينٍ معد له سلفا منذ قديم الزمان؛ أو أنه ثم اقتناصُه كصيدٍ ثمين؛ كأن الصياد يَكمُنُ له منذ زمن طويل؛ ثم عاد الرجلُ إلى قاعة الانتظارِ ليَستكملَ باقي الاجراءات. اتخذ شاكر لنفسه مكانًا في مقدمة الحافلة؛ كانت تختلف كثيرا عن حافلات بلادِه التي أنهكَها طولُ المسافات والإهمال؛ حتى أُصِيبَت بمغصٍ كَلَوِيٍ؛ فلا تستطيعُ الحراكَ إلا بمشقة أنفس. وبعد انتظار طويل ومرهق غالب شاكر النعاس؛ وغرق فيما يُشبه الحُلم الذي كسرته انطلاقة الحافلة؛ اتخذت طريقا في اتجاه وسط المدينة؛ توقفت بدوار عُلقت عليه إشارات كثيرة؛كُل إشارة باسم منطقة من مناطق السلطة؛ وقد أثار شاكر اسم الوَطِية؛ وهي المدخل المؤدي إلى "مدينة مسقط" عاصمة سلطنة عمان، ويقال بأن السكان كانوا ممنوعين من الدخول إلى العاصمة وهم لابسين نعالهم؛ حيث إنهم كانوا يَخلَعُون وَطِيَاتِهِم في هذا المكان؛ ويتركونها جانبا ويدخلون حفاةً إلى مركز المدينة لقضاء حاجياتهم؛ وغالبا ما كانوا يقصدون المدينة لرفع شكايةِ تَظَلمٍ ضِد أحدِ أفراد عائلاتهم؛ يكون قد استحوذ على قطعة من أراضيهم أو طمسَ علامة من حدودهم. تابعت الحافلة سيرَها بسرعة فائقة مبتلعةً بضجيج مُحركها بعضًا من أحاديث الركاب؛ الذي اختلط كلامُهم بأغانٍ خليجية كان يصدح بها المدياعُ؛ وقد أثار إعجابه صوت "أبو بكر سالم" الجهُوري الذي مازال عالقا بأذنيه لحد اليوم؛ وصوت "عبد الله الرويشد" الشجي و المليء بالأحاسيس الإنسانية الجميلة. رفع شاكر بصرَه إلى سقف الحافلة؛ ثم انحذر بنظراته نحو الركاب الذين يُحيطون به يمينا ويسارا؛ وجوه مصبوغة بالرحلة الشاقة نحو الخبز والاعتبار البسيط التافه؛ وجوه أحرقتها نارُ الحياة التعيسة في بلدان القهر والظلام؛ وجوهٌ علاها البؤس و الحرمان؛ تذكر شاكر هوجو والبؤساء؛ وكوركي و الأم؛ ومحمد شكري والخبز الحافي؛ وموسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح....أحس برأسه تنتفخ؛ ارتمى على جريدة مرمية فوق الكرسي المحادي للسائق؛ فتحها فبدت فيها عناوينُ بارزة؛ تفحصها فازدادت رأسه انتفاخا وانغلقت أمام عينيه شهية القراءة؛ كل شئ فيها بعيدٌ كل البعد عن آماله ومعاناته؛ طوى الجريدة وأرجعها مكانها. توجهت الحافلة بشاكر مع مجموعة من الأساتذة من جنسيات أخرى أتت إلى مديرية التعليم ب"إبراء"؛ وهي عاصمة "الشرقية شمال"؛ إنها مدينة في حجم شارع من مدننا المكتظة؛ مدينة صغيرة فيها شارع واحد وسوق صغير فيه بضع دكاكين؛ متلاصقة وكأنها جسد عجوز؛ تشهد رواجا تجاريا مزدهرا. قصد شاكر مع بعض الأساتذة مطعما شعبيا صغيرا أمام باب الإدارة؛ كان لشاب مصري اسمه إبراهيم؛ كان لسان حاله وهو الغاضب والساخط على الوضع السياسي الظالم في بلاده مصر؛ اعتقد شاكر في بداية الأمر أنه واحدٌ من الشيوعيين والتقدميين المناضلين؛ الذين فروا من قمع النظام الحاكم بمصر؛لكن في النهاية تبين له أنه يتكلم بحنق وغضب على تردي الأوضاع القاسية التي يعيشها المواطنون في مصر؛ كأي مواطن مصري قح؛ غيورٍ على وطنه؛ ناقم ٍعلى وضعه المزري. كان جميع المغتربين يلتقون بهذا المطعم الصغير؛ ومن بين كراسيه يتصاعدُ الدخان ويصطدم بالسقف ثم ينداح في جميع أرجاء المقهى راسما أشكالا مختلفةً كلها بلون الرماد القاتم المختلط بأنفاس المدخنين؛ الكراسي تصطف ملتصقةً بعضُها ببعضٍ؛ تتهالك فوقها أجسادٌ منهكة؛ وبين فِينَةٍ وأخرى يطل فأرٌ سمينٌ يجري مدعورا في اتجاهات مختلفة؛ خائفا من قِط يجري وراءه. لم يُعجب شاكر جوالمقهى الموبوءِ؛ فانسحب إلى مكان آخر؛ جلسَ على كرسي حديدي قرب طوار الشارع؛ تناول إفطارَه؛ الذي لم يتعد بضعَ لقيماتٍ صغيرات يدفعها تباعا الى فمه الفاغر؛ وعيناهُ تتبعان وجوه العمانيين؛ والهنود و الباكستانيين وجنسيات مختلف ألوانها ولغاتها؛ وكأن هذه المدينة؛ الملجأُ الوحيدُ من مقصلة الفاقة والفقرالتي تعيشها باقي الشعوب المعوزة؛ كل فرد منهم يحملُ بداخله قصة طويلة وعميقة؛ قصة ميلودرامية كان الفقر هو بطلُها؛ وكانت الرغبةُ في تحسين أوضاعهم الاجتماعية القاسية هدفها؛ وكانت وجهتهم هي سلطنة عمان التي بالنسبة للجميع؛الحلم الوردي الذي يغذي أحلام هذه الشعوب المقهورة؛ المتناثرة و المتفرقة على طول خريطة الدول العربية و الإسلامية. ومن حين لآخر يَمُد شاكرعينيه الى رجل قصير ضخم الجثة مفتول العضلات؛ ذي صدر عريض؛ وأطراف مفتولة قوية؛ وجهه يحاكي البدر جمالا؛ يكادُ الدم ينفجرُ من خديه؛ كانت عيناه حزينتين تغمرهما الدموعُ؛ يجلس وحيدا على كرسي ويحتسي فنجان شاي بحليب؛ يجلس بصمت يحمل ضجيجَ سِنينِه متأملاً؛ يفكر ويكلم دواخله؛ وبين الرشفة والثانية يتأمل هذا العالمَ الجديد وكأنه كائنٌ غريبٌ على هذا الكوكب. حدث شاكر نفسه... يبدو لي هذا العالم معاناة مركبة ومعقدة؛ وغشاوته قادتنا إلى هذه البلاد؛ ربما قد يجئ الواحد إلى هنا على مضض؛ حيث لايمكنه أن ينأى عن وطنه بهذه السهولة؛ أكيد إن تراكم الديون وشح الرواتب وضيق اليد هي أقوى من مقصلة الإعدام؛ وحتى لا أقول مع قائل بأن الجيب الفارغ جحيم . وفجأة داهمهُ صوتٌ مزعج: تبا لهذه الحياة التي يدفعنا فيها العوَز والحاجة إلى مغادرة ديارنا وأوطاننا؛ ونحمل أوجاع أولادنا بين ضلوعنا؛ ونأتي هنا خانعين تكسو وجوهَنا المذلةُ و المهانةُ؛ صحيح إن الحياةَ لعبةٌ بين المانح و الممنوح.... استكانت نفسه الثائرةُ بزفرةٍ طويلة؛ بعدها أحس بنفس صدره الممتلئ تنخفض تدريجيا؛ وأدرك معها أن الواقع لا يعلو فوق صدر منتفخ بالغضب؛ وأدرك كذلك أن ما من طائل يُرجى من حرف "لو" فهو تحسرٌ يعمي عن بلوغ المعنى الحقيقي ولو كان غير ذلك ما كان للغويين أن ينعتونه بالتمني. ...تنهد شاكر من أعماقه مستغفرا ربه؛ وتابع تناول فطوره بتأن وصمت . وعندما فتحت مديريةُ التربية أبوابَها؛ توجه إلى قسم التعيينات؛ كان المسؤول بها قد سلم لكل واحد ورقةَ تعيينه؛ ومبلغا ماليا بقيمة خمسين ريالا عمانيا؛ كانت مجرد حبة مسكنةٍ لحاجيَاته التي تتناسل يوما بعد يوم؛ ريثَما تتحسن الوضعية المادية بتسلم الرواتب الشهرية؛ ثم بعد ذلك كلف المسؤول سائقِي السيارات التوجهَ بهم كل واحد إلى منطقة تعيينه؛ حسب حاجيات كل منطقة. وكان شاكر والرجل الغريب الذي كان يجلس بجانبه في المطعم؛ من الأساتذة الذين تعينوا بمنطقة دماء والطائيين؛ وبالضبط بولاية محلاح التي توجد على سفح الجبل الأبيض. ورغبة منه في فتح باب الحوار والتعارف سأل شاكر أحدَ الموظفين العمانيين عن منطقة دماء و الطائيين. رد عليه الموظف بلهجته العمانية المنفتحة على اللغة العربية الفصيحة؛ مستعرضا جزءا من تاريخ عمان حيث قال: ترجع تسمية وادي دماء والطائيين إلى انهيار سد مأرب في اليمن؛ حيث هاجرت القبائلُ العربيةُ من هناك إلى أماكنَ متفرقة؛ فجاءت "قبائل طيء" ضمن القبائل القحطانية التي نزلت وادي سمائل؛ ثم خرجت منه إلى "وادي دماء والطائيين" حيث استوطنت هناك؛ وصار الوادي منسوبا إليها؛ ثم لحقت بها كذلك بعض القبائل العدنانية. أما عن تسمية "وادي دماء" فتقول الرواية التاريخية: إن هذا الوادي شهد الكثير من الحروب الطاحنة التي أُرِيقَت فيها دماءٌ غزيرةٌ؛ وعليه عادت تسمية الوادي بتلك الحوادث. بعد ذلك تدخل الأستاذ سيد متسائلا: وما هي أهم الموارد الاقتصادية؟ رد عليه الموظف موضحا: تضُم هذه المنطقة بعضا من المعالمِ الأثرية المتمثلة في الحصون والقلاع والأبراج والمساجد ومعالم أثرية قديمة؛ وتعتبر العيونُ والأفلاجُ والكهوفُ من هذه المعالم السياحية البارزة في ولاية دماء والطائيين؛ ومن أبرز معالمها السياحية كذلك تواجد "وادي ضيقة" الذي يعتبر من أخصب الأودية في المنطقة وأوفرها مياها. وتشتهر ولاية" دماء والطائييين" بحرفتي الزراعة وتربية المواشي؛ فهي منطقة زراعية كثيرة المراعي؛ حيث تعد المصدر الرئيسي لدخل الأهالي من مواطني الولاية؛ إضافة إلى الزراعة بمنتجاتها المختلفة؛ وأهمها التمورُ المختلفةُ ألوانها وأنواعها؛ التي تنضج مبكرا بحوالي شهر تقريبا؛ قبل أي ولاية أخرى من ولايات السلطنة؛ الأمرُ الذي يوفر عائدا ماليا جيدا لأصحاب مزارعها كنتيجة للتسويق المبكر لمحصول التمور؛ ومن أهم الصناعات التقليدية: صناعة الفخار؛ والنسيج؛ وصياغة الحلي، والحدادة.... لقد كسر هذا الحوارُ الصمتَ السائدَ في بهو الإدارة؛ وحينهاعلم شاكر بأن "الأستاذَ سيد" هو مدير مدرسة محلاح الثانوية التي سيشتغل بها؛ وهورجل في الأربعينيات من العمر؛ من مدينة الاسكندرية؛ أنيق؛ قصير القامة؛ عريض المنكبين؛ أبيض الوجه؛ وعندما يتكلم يصطبغ وجهه الخجل وكأنه عروس في خدرها يوم الزفاف؛ من عائلة محترمة؛ كان يعاني من إسهال حاد في الكلام؛ لاسيما حين يتكلم عن فلذات أكباده الذين تركهم في مصر مع جدتهم؛ كان كلما تذكر أولادَه؛ رق قلبُه واغرَورَقَت عيناه بالدموع؛ وكانت له لاَزِمَةٌ يُرددها: يا الله، هذه هي دنيانا ونحن أهلها؛ تفعل بنا ما تريد..... ركب شاكر وسيد سيارة "تويوتا" زرقاء اللون؛ رباعية الدفع؛ يسوقها شاب عماني متهور؛ نزق؛ نحيف البنية؛ يسوق بسرعة جنونية؛ انطلقت السيارة بين الجبال بسرعة كالسهم؛ أحس شاكر بنعم الله التي بدأت تتقاطر عليه؛ إلا أنها نغصت عليه هذه السرعة المفرطة؛ فلم يظفر جسدُه التعيس بتلك الجلسة المريحة؛ لحظة صدح من مذياع السيارة أغانٍ عمانية محلية أَضفت على الجو مرحا. أثار انتباههما قوة السرعة الفائقة؛ حيث أصابهما الهلع الشديد؛ لأنهما لم يتعودا هذا الارتجاج والسرعة الجنونية غيرالمحسوبة العواقب؛ وهذا التصرف المتهور...لقد أبديا استنكارهما لهذه السياقة الهوليودية؛ و رَجَوَا من السائق الشاب خفض السرعة والسير بمهل وتأن؛ لكن هذا الأخيرِ ركب عناده و لم يعبأ بكلامهما؛ فزاد من دواسة السرعة؛ وكأنه في حلبة السباق للتتويج برتبة عالمية في سباق السيارات. شعر شاكر بالدوران والغثَيان حَد التقيئ؛ وبدا كخرقة بالية منقوعة في العرق المتصبب من الهلع و الخوف؛ تتقمز وتنكمش أساريره كطحال فوق مشواة؛ تتمدد وتنقبض حتى شحب لون وجهه المستدير؛ سرق السائق نظرة شامتة في المرآة العاكسة؛ فلم يشفق لحاله وبادره بكلام مشوب بالهزءِ و السخرية والاستخفاف "ما يقلق أستاذنا اللطيف؟؟ " وزاد في تهكمه وتعجبه .... أَلأولِ مرة تركب السيارة؟ يبدو أنك تود استفراغ أمعائِك؟؟؟ بغضب رد شاكر: إذا تماديتَ في تهورك لطختُ مقاعدَ سيارتك بالحموضة . تلمظَ شاكر شفتيه ثم مررَ طرف لسانه عليهما : لو سمحت اختصر كلامَك بمنحي ورقةَ كلينكس من فضلك. ورفقا بشاكر منحه السائق حزمةً من أوراقِ كلينكس . كانت رحلةً شاقةً ومتعبةً من مدينة "إبراء" إلى مدينة "محلاح" بولاية دماء و الطائيين وذاك لطول المسافة؛ مرت السيارة على قرية صغيرة اسمها "النبأ" تقع بين مستهل السلسلة الجبلية؛ على منخفضات أرض تحفها الأشجارُ من كل النواحي؛ وتجري فيها عيونُ الأفلاجِ منسابة؛ وتحفر لنفسها أخاديد وشعابا في كل الجهات، عندما تجاوزوها دخلت بهم السيارة في طريق ترابي بين التضاريس الجبلية الوعرة؛ مرة ترتقي قمة الجبل ومرة تنحدر عبر منحدرالوادي، وتارة تسير وسط طرق شديدة الخطورة. التفت شاكر من مقعده الخلفي إلى الوراءِ؛ وتراءَت له سحبٌ كثيفة من الغبارِ الذي خلفته السيارة؛ ومن حين لآخر كان ينصت لنقرات الحَصَى؛ التي ترتطم بهيكل السيارة محدثة نقرات إيقاعية مما زاد للمشهد لحظة درامية، فزاد خوفُه من المجهول لهذه الرحلة التي لم ينته مشوارها بعد، جاس بأنامله فوق ملفه الأحمر الذي يذكره بواقعه المرير ومجيئه إلى هنا، بينما مرافقُه الأستاذ سيد الذي يجلس إزاء السائق؛ غير عابئٍ لما يحدث بدواخل نفسية صاحبه؛ وهو مُتَلاَهٍ على ما يحدث خلفه بملفه الأحمر الذي يداعبه من يد إلى أخرى. كان يشعر وكأنه ذاهبٌ إلى المجهولِ؛ وفي لحظة من اللحظات بدأ يشعر بالندم؛ وبتأنيب الضمير على قدومه إلى هذا البلد أصلا ،بدأ يشعر بأنه يعيش الآن مغامرة طائشة؛ ضَيع فيها اتجاهَ البَوصَلَةِ وسط هذه الجبال الشاهقة؛ ووسط هذه المنعرجات الملتوية والشديدة الانحدار. دنا عقربُ الساعة إلى السابعة مساءً؛ وهو الوقت الذي يعرف مغيب الشمس في منطقة "محلاح"؛ توقفت بهم السيارة قرب سكن العُزابِ المُطل على"وادي دماء و الطائيين"، تساءل شاكر في قرارة نفسه ما علاقة المنطقة بحاتم الطائي. لكن في نفس الوقت كان يُخَمن أن رائحةَ نسبٍ قد تكون لها علاقةٌ بهذه المنطقة، ولكن الأمرَ لم يتأكد له بعد..... كان سكن العزاب يقع بمدينة "محلاح" يعتبرونها مدينة رغم قلة ساكنتها المحدودة العدد؛ فهي تلبي حاجياتهم ورغباتهم الضرورية؛ لكونها تمتاز بالاكتفاء الذاتي؛ وإن كانت بالنسبة لهم لا تسد ما يرغبون فيه من كماليات أخرى.... يتكون السَكنُ من بِضعِ بيوت واطئة من الإِسمنتِ المُسلحِ؛ طلِيَت باللونِ الأبيض تيمنًا بالجبل الأبيض. أخذ الغسقُ يتغير من اللون القرمزي إلى السواد بالتدريج....ترجل شاكر من السيارة؛ فالتفت يُمنةً ويُسرةً كطائرٍ يشربُ بحذرٍ شديدٍ؛ لم يكن في المكان إلا بعض البيوت المتراصة، التي يلفها الصمتُ الرهيب والمكان الموحش؛ ويضفي عليه مناخ الحرارة المفرطة؛ مما جعل أجسادهم تنز عرقا غزيرا؛ ولحق به صديقه "سيد" وتوجها معا صوب المجمع السكني. وفي طريقهما لاح لهما طيفٌ في هيئةِ رجلٍ؛ كلما اقتربا منه برزت لهما ملامحه بتجل ووضوح، ها هو رجل حقيقي تتضح ملامحه؛ ذو بشرة سمراء برونزية؛ وعينان حمراوان متقدتان؛ و صلعة براقة؛ نحيف البنية؛ معقود الحاجبين؛ كأنه جني خرج لتوه من قُمقُمٍ نحاسي كان مرصودًا به. قدم لهما نفسه: مرحبا بكما؛ أنا الأستاذ نبيل معلمٌ لمادة التربية الموسيقية؛ صعيدي الأصل من سهاج؛ لكنني أقطن بالوراق بضواحي القاهرة. هو رجل كثير الحركة نشيط وحيوي؛ يمتاز بابتسامة ملغزة؛ ذكي وسريع البديهة؛لجوج؛ خفيف الظل والدم معا؛ ناكت بامتياز؛ لا يكف عن الطواف بفناء السكن كنحلة حوامة؛ ما يُسجلُ عليه ترديدُ عبارةِ "أيةُ خدمات يا إخوة؛ أنا رهن إشارتكما" وهذا كاف لتحمله رغم ملامحه المفزعة حقا. بعد لأي دعاهُما "نبيل" لشرب فنجان قهوة؛ فتظاهرا بالإباءة وعزة النفس؛ ولكن تحت إلحاحه الشديد؛ قبلوا دعوته شاكرين ترحابه؛ لأن "شاكر" دائما يفترض عداوتَه قبل صداقتِه، وإن كانت هذه العادة غير مستحبة فيه؛ لأن معاشرة الرجال تفندُ الكثير من المزاعم. وبعد أن رشفوا كؤوسا من القهوة؛ دار حديث بينهم حول ظروف العمل والسكن بسلطنة عمان؛ وكان "نبيل" يحكي عن السنين التي قضاها بين ظهران سكان مدينة محلاح؛ وظروف مجيئه إليها؛ وعادة وتقاليد أهلها؛ ومواسم الزواج والأعياد الدينية و الوطنية التي يشاركهم فيها بمقاطعه الموسيقية.
3 المكان عادة يترك بصمته في الشخص من أول مرة؛ وكان المكان في هذه القرية النائية ليس في أحسن حال؛ كان سَكن العُزاب موحشا؛ فهوعبارة عن غرف صغيرة مجهزة؛ فيها حمامٌ ومطبخٌ صغيرٌ؛ محاطة بسور وباب حديدي مغلق بإحكام؛ لكي لا تدخله الذئاب و الكلاب الضالة. تعلو سقفَه حاوية كبيرةٌ من القصدير معبأةٌ بالمياه التي تجلبها "التِرِلاَتُ"من البئر المجاورة للبلدة، عندما تفتح الصنبورَ تنزل المياهُ حارة؛ وكأن سَخانا كهربائيا بها، لطالما كان شاكر يرغب في الاستحمام فتلفحه حرارةُ الماء الساخن، لايستطيع الإنسان الاستحمامَ بها مباشرة؛ حيث لابد له من خلط المياه الساخنة بماء الثلاجة لكي يأخذ درجة حرارة مناسبة للجسم. لقد ترك المكان فيهما انطباعا من الاضطراب والخوف؛ ضاعف من غربتهما؛ بدا عليهما شعور بالندم؛ و الحسرة؛ شعرا كأن السماء قذفتهُما فجأة إلى هذا المكان النائي عن العالم، مكان موحش ومقفر؛ غارق في الكآبة والملل، عندما تسرحُ ببصركَ بعيدا لا ترى إلا القفر، لا طائرا يطيرُ؛ ولا وحشا يسير، وبعد فتراتِ الصمت الذي يكسره هدير سيارة قادمة من بعيد تمر من ساعة إلى أخرى إما متجهة أو قادمة في اتجاه المدينة؛ أو مغادرة إياها إلى القرى المجاورة لها. عندما لم يجد شاكر في هذه الغرفة شيئا يستأنس به؛ يجنح إلى خياله ليرسم ظلالا كجدار يحتمي بها ويحمي نفسه من الاهتزاز؛ مريحا نفسه بوهم الحماية، لقد استطاع أن يجلب معه من خلال استغراقه في الخيال ألفة الوطن ودفأ الأسرة، وبدأت تتوارد عليه تفاصيل بيته في بلده، حيث الغرفة قد تحولت من سجن صغير يحمل شاكر مفاتيحَه؛ إلى بيت يحتوي أحلامَ اليقظةِ؛ التي أعطته متعة الاستقرار؛ فأصبحت الغرفةُ بالنسبة له ذات قيمة، بمعنى أنه عرف كيف يكيفُ نفسَه مع غرفته الصغيرة، وكيف يخرج من ذاته لكي لا يشعر بضيق المكان، كان الخيال كفيلا بتأثيثه وتنقيحه حسب هواه، فعندما أغلق عليه بابَ الغرفةِ الصغيرةِ فتح بابَ الخيال؛ وبدأ يتذكر دولابَ ملابسه؛ والنافذة المطلة على الحديقة المجاورة. أما نبيل فقد كان يختلف عن سيد وشاكر، كان منسجما مع الوضع، معجبا بفضاء المكان،لطالما كان يجدد متعة الحياة فيه لما يخلقُه من مغامراتٍ، كان ضحوكا،يلطف الأجواء بِنُكته من حين لآخر من أجل إدخال الابتسامة على سيد وشاكر، بيد أن الابتسامة كانت ثقيلة على محياهما. كان نبيل رجلا على سُنن العرب؛ كريما؛ مجوادا؛ مضيافا؛ قدم لهما وجبة عشاء؛ وكانت الوجبة مكونة من لحم دجاج مقلي ومرق الملوخية؛ كان طعمُها غريبا؛ عافته نفس شاكر. وبعد أن شربوا الشايَ الأسودَ خرجوا إلى باحة السكن المضاءة بمصابيحَ بيضاء، تحوم حولها فراشات تائهةٌ تبحثُ هي كذلك عن الحقيقة الضائعة في هذا المكان المقفر، جلسوا على حصير من "النايلون"، يتجاذبون أطراف الحديث، كان نبيل الشخص الوحيد الذي يدخن بشراهة؛ يشعل السيجارة بأختها . وبينما هم منهمكون في أحاديثهم، سمعوا هسيس أفعى، وسط القش اليابس، انتاب شاكر و سيد الرعب؛ وقفزا بسرعة جنونية واتخذا مكانا بعيدا خوفا من مكروه يصيبهما؛ بينما نبيل لم يأبه بذلك واستمر في تدخين سيجارته الشقراء. قال لهما: ما بكما؟ إنها مجرد أفعى تتحرك في المكان تبحث عن وَلِيفِهَا الذي اصطدتُه بالأمس، إنه عندي سجينٌ انتظرا سأُريكُم إياه. ضحك نبيل بجنون هههه وبخفة متناهية دخل غرفةً مجاورةً كانت مفتوحة؛ وأخرج منها قنينة صغيرة فيها أفعى تتلوى على نفسها وكأنها تريد الانتحار؛ لكي لا تموت مهانة ومنهزمة بين يدي هذا الكائن البشري. قال نبيل: ألم أقل لكما إنها تبحث عن وليفها ههههههههه رد عليه سيد بحزم: انتبه يا نبيل؛ لاتضحك معنا هكذا ضحك؛ إن ما تفعله الآن يعتبر مخاطرة بنفسك وبحياتنا نحن، إنك تعرضُنا للذغَة أفعى صحرواية سامة. سكت سيد لحظة؛ واتخذ لنفسه مكانا بعيدا مستكملا حديثه مع شاكر؛ وكان في حيطة من أي مكروه قد يصيبهما. وأمام هذا المشهد الرهيب ازداد المكان ظلمة وسوادا، وجاء وقت النوم، خَيرَهُما نبيل بين غرفتين، فاختار شاكر الغرفة التي على اليمين، أما سيد فكان يحب الهدوء و الرحابة فاختار الغرفة الكبيرة المعزولة التي كانت على اليسار. دخل شاكر غرفته؛ وبحث وسط العتمة عن الجدار؛ يتلمس الأمان؛ التصق بالحائط حتى أصبح جزء منه؛ أشعل ضوء السقف، بدت الغرفة مريحة ومبهجة، ذات سرير حديدي ولحاف أبيض، عليه علامات مرق قديم، أخرج لحافا أحضره معه من بيته؛ غطى السرير واستلقى على ظهره؛ توسد راحة يده اليمنى؛ مستعرضا شريط الذكريات. أفكارٌ كثيرة تزدحم برأسه، وأوراقٌ كثيرة تطفو على سطح ذاكرته، كانت تمر عليه وكأنها شريط سينمائي يمر أمام عينيه بشكل مكثف؛ يسترجع كل الأحداث بمنتهى الدقة والتفصيل. وما إن أطفأ الضوء المحادي لسريره حتى استحوذ عليه النوم؛ فنام شاكر على هدير صوت المكيف الذي ينعش جوَّ الغرفة؛ فلولاه ما غمض له جفن؛ فهو ابن البحر والنسيم والريح الخفاقة. ولم تمر إلا هنيهات حتى استيقظ مرعوبا؛ لأنه كان يحلم بأن هذا السرير تختبئ تحته أفعى الكوبرا؛ رقطاء؛ قد تنفث سمها في جسده في أي وقت وهو نائم، انشغل مرة أخرى بالتفكير، وهو يداعب جفونه حتى لا يستسلم لنوم عميق. سمع نقيق الضفادع وقال: يبدو أن هذه الضفادع تقاسمني السَّهر وتعاني نفس الكوابيس التي أعاني منها؛ أوأنها خائفةٌ على بُيوضِها من غدرِ الأفعى التي تُؤرقني في منامي....حاول النوم مرَّة ثانيةً، تقلب من زاوية إلى أخرى؛ أصلح وضعَ المخدة تحت رأسه عدة مرات دون جدوى؛ قام إلى النافذة ليتأمل النجوم ولمعان ضوئها؛ بقي على حاله ذاك ولم يثني صنيعه هذا؛ غير صوت نبيل لما دعاه لتناول وجبة الفطور. خرج شاكر من غرفته؛ وتوجه إلى غرفة نبيل قدم له التحية؛وقال: صباح الخير يا أستاذي. ردَّ عليه نبيل: صباحُ الفُلِّ و الياسمين يابيه واستطرد قائلا: كيف كانت ليلتك الأولى في هذا المكان؟ كيف مرت؟ رد عليه شاكر: كانت ليلةً مزعجةً بالكوابيسِ المرعبةِ. ثم بعد ذلك سأله عن "سيد"…….ردَّ عليه: يبدو أنه مازال نائما.... ثم قال: انتظر سألقي عليه نظرة لعله قريب من المكان. خرج شاكر مُسرعا؛ منتعلا نعلا أسود اللون ممزقا من الجانب؛ تركه نبيل بجانب الباب؛ اقترب من غرفة سيد؛ دق الباب برفق؛ فلم يرد عليه أحدٌ؛ أعاد الكرة مرة أخرى دون رد أو سماع صوت؛ عاد شاكر إلى غرفة نبيل وأخبره بأن سيدا غير موجود في غرفته؛ فرد عليه نبيل: ربَّما خرج في جولة على ضفاف الوادي أو نزل إلى المزارع المجاورة. لقد خاف سيّد من الاستغراق في النوم؛ فنهض من فراشه مُبكرا كعادته للقيام بطقوسه المعتادة؛ بدءا بالاستحمام الصباحي إلى حلاقة الدقن؛ وترتيب الغرفة؛ وتنظيم الحقيبة الجلدية التي يضعها دائما على كتفه الأيمن. إنه لم يكن يشعر بالارتياح؛ لكنه كان يشعر بانتعاشة الصباح؛ فقادته ساقاه إلى محيط سَكن العُزّاب، متفحصا المكان؛ وملقيا إطلالة على الجوار؛ ثم بعد ذلك عاد إلى السَكن وتوجه إلى غرفة نبيل.......طرق الباب ودخل؛ ثم ألقى التحية: السلام عليكم بادله نبيل بتحية مماثلة: وعليكم السلام يا بيه؛ وين رُحت خفنا عليك كثير كثير..... فرد عليه سيّد: لا تخف كنت أتفسح قرب هذه الجبال وهذه الوديان. قال نبيل: تفضل يا بيه وقاسمنا إفطارنا. جلس سيد بجانب شاكر وكأنه غير واثق من نبيل؛ بالرغم من أنه يستضيفه وبالرغم من أنه من بلدياته، وعندما تناولوا جميعا وجبة الإفطار؛ أقسم عليهم نبيل أن يستضيفهم لمدة ثلاثة أيام؛ لأنها من واجبات الضيافة في الصعيد كما قال؛ وهو في هذه البلاد يمثل سكان الصعيد وينوب عنهم في تقديم واجب الضيافة. تفرقوا إلى غرفهم؛ فغيَّروا ملابسهم؛ وخرجوا إلى السوق المحلي لولاية محلاح للتبضع وإلقاء نظرة على المدينة.
روائيّ مغربيّ

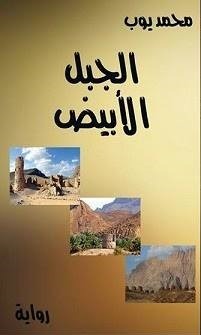












0 تعليقات