حكايتي مع الكتب والنوم
لم يكن الأمر سهلاً، ولم تكن الفكرة في مكانها حين اخترت كتاب كارل ماركس "رأس المال" كأول كتاب أريد مطالعته، كنتُ في السن العاشرة من عمري حينها، ولم يكن لدينا من المال ما يكفي لقوت يومنا، فكيف لنا أن نصلح التلفاز الذي تعطّل نتيجة التغيرّات في قوة الكهرباء؟
وبعد أيام شعرنا بالملل أنا وأخوتي، تذمرنا قليلاً مثل كل الأطفال، وطالبنا أبي بإصلاحه، لكنه أجاب ببرود وقال (هذا تلفازكم من اليوم وصاعداً) مشيراً بيده إلى خزانة تركن في زاوية الغرفة، فيها عشرات الكتب؛ وحين أردتُ فهم كلام أبي، مسكتُ بكتاب كارل ماركس "رأس المال"، لم يكن اختياري في مكانه لأنني لم أفهم شيئاً من الأسطر القليلة التي قرأتها، غير ذلك شعرتُ بالغضب، ترنحتُ قليلاً متأففاً من تلك الحالة، لا تلفاز، والطقس حار في شهر تموز، ولا مدرسة، ننتظر بفارغ الصبر غروب الشمس قليلاً، لنركض إلى الشارع أنا وأخوتي للعب بالكرة مع بقية الأطفال في الحي.
وبعد أن أعدتُ الكتاب إلى مكانه تمددتُ على البلاط لأسرق القليل من برودته في ذاك الطقس اللعين، الذي لم أحبه إلى اليوم، وبدأتُ أدقق في أسماء الكتب، ماركس، أنجلس، تشيخوف، دوستويفسكي، غوغول، تولستوي، وغيرهم الكثير، الأسماء الوحيدة التي راقت لي حينها كانت: نجيب محفوظ، هاني الراهب، نزار قباني، وغيرهم من الكتّاب العرب، راقت لي تلك الأسماء لأنها عربية باللغة التي نتكلم بها، لكن كتاب كارل ماركس أشعل في داخلي فتيلة التحدي، كما لو إنني أريد أن أقرأه ولو لم أفهم منه شيئاً؛ أعدتُ المحاولة مرتين في المجلدات الثلاث، لكن دون جدوى، ولم ألجأ حينها إلى الكتّاب العرب، أردتُ فقط التعرف على أحد الكتّاب ذي الأسماء الغريبة بالنسبة لي حينها؛ رميتُ كتب ماركس ومسكتُ كتاب لينين، كذلك الأمر، بدأ الإحباط يتسلل إلى داخلي، مسكتُ كتاب تشيخوف وبدأتُ أقرأ، كان كتاب تشيخوف شرارة النار التي ستحرقني في عالم الكتب، أذكر تلك القصة إلى يومنا هذا، قصة "لمن أشكو كآبتي"، وأذكر بالتحديد الأسطر الأولى من تلك القصة، لأنها كانت لحظة أشبه بذاك الذي يبحث عن كنزٍ سمع عنه كثيراً ووجده، رددتُ الأسطر الأولى كثيراً من فرحتي أنني فهمت ماذا يقصد الكاتب، نعم كانت تلك الأسطر كافية لتدخلني إلى عالم الكتب.
"غسق المساء.. ندف الثلج الكبيرة الرطبة تدور بكسل حول مصابيح الشارع التي أضيئت لتوها...". بهذا السطر يبدأ تشيخوف قصته مع الحوذي (ايونا بوتابوف). أعدتُ قراءة القصة لأكثر من خمسة مرات، مثل مسافرٍ ظمآن في الصحراء ووجد نبع ماء أمامه، لدرجةٍ أني وضعتُ الكتاب بجانب وسادتي على السرير ونمت لأحلم بالحوذي (ايونا بوتابوف) بطل القصة. لم أتوقف عن القراءة بعدها، بل ازداد الإصرار في داخلي للقراءة أكثر وأكثر، لأكتشف قصة أخرى تعجبني مثل قصة تشيخوف، ووقعت يدي على مقولة لديستويفسكي عن غوغول "كلنا خرجنا من معطف غوغول"، ومن حسن حظي كان يوجد في المكتبة ثلاثة أعمال له، "المعطف والأنف" "ليلة في مايو" و"الرسالة المفقودة"، قرأت الكتب الثلاثة، بعض الأحيان كنتُ أفقد بوصلة المعنى وأحاول التركيز أكثر، لكن أذكر بالتحديد أن الثلاثة كتب قرأتهم من يوم الجمعة إلى يوم الخميس، أي في أسبوعٍ واحد، وخطر لي سؤال حينها، أنني قرأتُ ثلاثة كتب في أسبوع، إن استمر الأمر هكذا طيلة حياتي، كم الكتب التي سأقرأها؟ إن عشتُ إلى عمر الستين كم كتاباً سأنهي في العام الواحد؟
وبدأتُ أحسب كم عدد الكتب التي يجب أن أقرأها إلى عمر الستين، أن أنهيتُ أثني عشرة كتاباً في الشهر، أذكرُ تماماً تلك اللحظة بينما كنتُ منهمكاً في الأرقام دخل أبي إلى الغرفة وسألني ماذا أفعل؟ حينها قلتُ له أحسب كم كتاباً سأقرأ إلى أن يصبح عمري في الستين، قال لي حينها هذا جيد أن تفكر هكذا، لكن من المهم أيضاً النوعية التي يجب عليك قراءتها، أن تختار الكتب التي تميل إليها مخيلتك وتستطيع أن تتطور من خلالها.
رددتُ تلك الجملة في رأسي كثيراً، إلى أن وقفتُ أمام نقطتين، الأولى أن كلامه صحيح، يجب أن أختار الكتب الأقرب إلى مخيلتي؛ والجواب الثاني هو أن أقرأ ولو كان قطعة ورق ممزقة من كتاب. وبقيتُ في تلك الدوامة إلى يومنا هذا، هناك فترات قصيرة اضطررتُ فيها بالابتعاد عن الكتب، لكن لم أسمح لنفسي أن تطول المدة تلك؛ بالمناسبة هذه هناك طرفة صغيرة حصلت معي سنة 2009 حين انتقلت للعمل من سوريا إلى بيروت مع الفنان راغب علامة، بعد زيارتي الأولى له في بيروت، اتفقنا إلى أن أنهي أموري في سوريا أن يؤمن سكناً لي، حين وصلتُ إلى بيروت ودخلتُ مكتبه في ساحة ساسين قال لي أين حقائبك؟
قلتُ له في الأسفل، أريد أن أنقلهم مباشرةً إلى مكان إقامتي، حينها سألني وكم هي حتى لم تستطع أن تحضرها معك إلى هنا للأعلى؟ قلتُ له تسعة حقائب، لم يستفسر أكثر وظن أن معي ألبسة في تلك الحقائب، لكن بعد أن انتهيت من ترتيب الحقائب في البيت، قلتُ له أحتاج بعض الألبسة ولوازم الحلاقة والحمام، حينها سألني مستغرباً عن الحقائب، وقال لي "معك كل هالشناتي ولسه بدك تياب، أي شو فيهم ذكرياتك؟" قلتُ له من بين تلك الحقائب لا يوجد غير حقيبة واحدة فيها ألبسة، والباقي كتب؛ نعم حملتُ معي من منطقة كسب التي كنتُ أعمل فيها إلى بيروت تلك الكتب، رغم أن بيروت مدينة الكتب، لكن لم أتخيل نفسي أني سأترك كل تلك الكتب خلفي وأمضي، حتى صاحب المنزل الذي كنتُ أقيم فيه في كسب أبو آرتين قال لي بلغة عربية ركيكة "أنتي لازم ما تتجوزي غير وحدة متلك مضيعة مخها بالكتب". كان يستيقظ في الصباح الباكر يجدني أقرأ، وهي عادتي إلى يومنا هذا، لا أستطيع الجلوس في الليل دون كتاب، كما لو إنه ثأر ويجب أن أنتقم منه، كل ليلة مع الكتاب، الأيام التي لا أقرأ فيها لا أحسبها من عمري، وأن سألني أحدهم عن عمري أقول له أربعة أعوام، هي تلك الأعوام التي كنتُ اسكن فيها في دمشق، عشتُ أربعة أعوام أقرأ فيها كل يوم ست ساعات على الأقل، لدرجةٍ أني ذهبتُ في إحدى المرات لأشتري كيلو بطاطا وظننتُ أني ذاهب لأشتري كتاباً، ودخلتُ المكتبة وقلتُ له أعطني كيلو كتب. هناك فترات توقفتُ فيها عن القراءة، لم أشأ ذلك، لكن كنتُ مرغماً، وبالتحديد حين اختفى أبي سنة 1997 إلى سنة 2002، كنّا أربعة أخوة، نساند بعضنا في السراء والضراء، نقيم الحفلات حين نستطيع تأمين قوت يومنا، ونقيم حلقات الفكاهة حين لا نجد ما نأكله، وبين حفلة الشبع وحلقة الفكاهة كانت تمضي أيامنا؛ خمسةُ أشخاص كنّا في منزلٍ واحد، أربعة أخوة ووالدتنا.
عشنا طفولة قاسية، من الممكن تسميتها اللاطفولة، وليست حياة، كما لو إنها عقاب على عائلة كل ذنبها أنها ولدت في هذه الحياة. أصبح من أساسيات حياتي أن أعمل وأدرس، وبين الأولى والثانية أسرق بعض اللحظات للقراءة، لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، اضطررتُ بالتخلي عن القراءة ومتابعة دراستي بما إنني كنتُ في الصف الثالث الإعدادي، ويجب عليَّ أن أنجح، وأن أستمر في غسل الصحون في المطاعم والفنادق من أجل ألفين ليرة سورية في الشهر لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، ودخلٍ آخر صغير يقبضه أخي الكبير من عمله المتقطع في عالم الطباعة.
كانت تمضي أيامي بصعوبة، تنقلتُ بين عدة مهن في طفولتي، بين أجير في ورشات الخياطة، يصنع الشاي والقهوة للعمال؛ إلى بائع صغير على بسطة صغيرة في الحي، أبيع فيها البسكوت والراحة والعلكة للأطفال؛ إلى عامل تنظيف، وجلى في المطاعم والفنادق؛ كانت أمنياتي محدودة بين أشياء صغيرة وبسيطة جداً، كأن أعود إلى البيت بعد العمل ولستُ متعباً كي أقرأ قليلاً، وفي الشتاء أن لا يهطل المطر حين أنتهي من العمل، كي لا يتسرب الماء لداخل حذائي المنهك مثلي، وأن أملك القوة كل يوم أن أذهب إلى العمل سيراً على الأقدام من الأشرفية إلى الجميلية لكي أوفر خمس ليرات ثمن المواصلات، فكانت حساباتي محصورة على النحو التالي: خمس ليرات مواصلات في اليوم يعني مئة وخمسون ليرة في الشهر، أي أستطيع أن أشتري بهم خمسة عشرة علبة سجائر من ماركة شام قصيرة، تعودتُ على التدخين في سنٍ مبكرة جداً، ومازلتُ اجدها أجمل متعة في الحياة (ما حدا ينتقدني بهي).
هذه تفاصيل صغيرة من طفولتي، غير تلك الأشياء كُلها كان ما يشغل بالي أيضاً هو النوم، كنتُ أتمنى دائماً أن أجد حلاً لتلك المعضلة بالنسبة لي، كنتُ أشعر أن وقت النوم وقتٌ مهدور من الحياة، ويجب أن أعوّد نفسي على النوم القليل، لكي أستطيع أن اعمل أكثر، وأجد وقتاً للقراءة، ففي ازدحام تلك الأيام كان من الممتع جداً أن ألجأ إلى الكتاب بدلاً من البشر، كنتُ أشعر أن الكتب أرحم من نظرات الشفقة التي كان ينظر الناس إلي بها، أبٌ مفقود، منزل محجوز عليه من قبل الدولة بسبب عدم دفع الأقساط التي كانت مترتبة عليه، لا كهرباء في البيت.
في إحدى المرات اقترح عليَّ مدير المطعم الذي كنتُ أعمل فيه أن أبقى إلى انتهاء وجبة السحور في رمضان، مقابل ألف ليرة إضافية إلى راتبي، وافقتُ دون تردد، وبدأت رحلتي في تحدي نفسي أن أنام قليلاً، وبدأتُ بالنوم من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة السابعة فقط، أي ساعتين، بعدها أذهب إلى المدرسة، وبعد المدرسة أنام ساعتين فقط لأستطيع الوصول إلى العمل سيراً على الأقدام، وبين كل تلك الضغوطات كان الكتاب ملجأي الوحيد، حاولتُ في إحدى المرات أن أقرأ وأنا أسير في الطرقات حين ذهابي إلى العمل، لكن من المرة الأولى استسلمت، حين مرَّ بجانبي أربعة شبّان وقالوا "عامل حالو مثقف وفهمان"؛ ألغيتُ الفكرة وانتظرت أن ينتهي شهر رمضان لكي أعود للقراءة في الليل قبل النوم ولأعوّد نفسي بالنوم قليلاً.
نجحت بعد فترة قصيرة، ووصلتُ لمرحلةٍ غريبة حينها، حين كان يمر يومين دون نوم وأنا في كامل نشاطي وحيوتي، بدأتُ أرتب أيامي بأن أنام مرة كل يومين، وفي كل مرة أن لا أتجاوز الست ساعات؛ أذكر من تلك الحقبة حين عرضَ علي مدير فندقٍ كنتُ أعمل فيه أن أعمل في المسبح في الصيف، ووافقت دون تردد، ستة آلاف ليرة في الشهر مرتب جيد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص حينها، وبعض النقود أجنيها من العاهرات والمسؤولين حين كانوا يثملون على طاولات البار وأنا أقصُ عليهم الحكايا الفكاهية؛ وبين العمل في المسبح في الصباح الباكر تحت أشعة الشمس أوزع الطعام والشراب على الزبائن، والوقوف خلف البارات مساء لأسقي العاهرات والمسؤولين في البار، كنتُ أنام بين الساعة الخامسة صباحاً موعد إغلاق البار إلى الساعة الثامنة صباحاً موعد افتتاح المسبح، كنتُ أكتفي بالنوم على الشيزلونج المخصص للحمام الشمسي في المسبح، وأقوم بزيارة عائلتي في العطلة. مرَّ عامين على هذا النحو، وفي الشتاء كنتُ أكتفي في العمل خلف البارات أسقي الزبائن ما تيسر لي من الكحول. الذي نجحت به في تلك الفترة من حياتي، أنني استطعت أن أحمي عائلتي من ظلم الحياة، وفي نفس الوقت جعلتُ أختي الوحيدة أن تتابع دراستها في مدرسة خاصة (الفرنسيسكان). والأمر الثاني الذي نجحت فيه هو تعويدي على النوم القليل، كنتُ أكتفي لساعات قليلة جداً، وكنتُ أجد الوقت للقراءة أغلب الأيام.
بعد أن انتهيت من الخدمة الإلزامية سنة 2005 التي لم أداوم فيها كثيراً لأنني كنتُ أعمل، بدأت حياتي تنقلب رأساً على عقب، وبدأت الأموال تدفق عليّ مثل النهر الجاري، بدأتُ العمل في أربعة أماكن مختلفة، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة في كافيتريا في مدرسة خاصة، في (القبر الإنكليزي) في ريف حلب ، هناك أصدقاء في صفحتي من تلك الأيام، أذكر منهم جورجيت وغراسيا؛ ومن الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة مع شركة الصحاف في حلب لتوزيع الموالح والمكسرات، والساعة الرابعة بعد الظهر كنتُ أقف خلف البارات وأسقي الناس ما تيسر لي من المنكر، وفي نفس الوقت كنتُ وكيل دار نوبلس اللبنانية في حلب، أقوم بتوزيع الكتب وتوقيع العقود مع المكاتب والمؤلفين؛ نعم كنتُ أعمل كل يوم ما يقارب ثمانية عشرة ساعة، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة منتصف الليل، ستة أيام في الأسبوع، اليوم السابع كان مخصصاً لتوزيع الكتب، والجلوس في المقاهي ولعب الشطرنج مع بعض الأصدقاء وحل الكلمات المتقاطعة. المجالين الذين نجحت فيهم نجاحاً باهراً هما أني استطعتُ أن أكون سيداً صغيراً في مدينة كبيرة، وأراهن على أي مغامرة مادية، والاستغناء عن النوم. كنتُ أشعر أن الحياة قصيرة في النوم باكراً ولساعات عدة، ومازلتُ إلى اليوم لا أنام في الليل، أنام في الساعة الثامنة صباحاً، إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً فقط، هناك أيام أتخلى فيها عن قاعدتي، حين يسرقني الكحول من يومياتي وأغطّ في نومٍ عميق لتسع ساعات ربما.
في تلك المراحل من حياتي كانت قراءة الجرائد بالنسبة لي مهمة جداً، ربما كان الإدمان على حل الكلمات المتقاطعة هي السبب ولأنني أستطيع شراء الجريدة من أي مكان في طريقي وقراءتها أثناء التنقل من مكان إلى آخر؛ وكنتُ انتظر يوم الخميس بفارغ الصبر لكي أقرأ نصوصي التي كنتُ أنشرها في جريدة الجماهير في حلب حينها، كان شعوراً جميلاً جداً، كما لو إني أحصل على مكافأة كبيرة. والصحف التي يكون فيها مقال عن النوم كنتُ أحتفظ بها أيضاً، لأبرهن للناس أن النوم لساعات طويلة ليس بشيء صحي، أذكر من تلك المقالات بعض الشذرات عن الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، أنه كان يعتبر النوم لساعات طويلة تقصر الحياة، لأن النوم أشبه بالموت، وكلما أكثرنا من ساعات النوم كلما كانت حياتنا أقصر، وكان يستيقظ باكراً ويشرب القهوة ويدخن التبغ ويقضي تلك الأوقات بالتأمل، لأنه عاش ومات وهو أعزب، أذكر حينها في ذاك المقال كان هناك قراءة عن عمله نقد العقل الخالص، حينها دخلت إلى مكتبة في منطقة العبّارة في حلب، وطلبتُ منه الكتاب، شعرتُ باستغراب صاحب المكتبة حين لفظتُ له الاسم باللهجة الحلبية (خيو بدنا كتاب كانط) مع تشديد الطاء جداً. وأذكر من تلك الحقبة في حياتي مقال عن الأديب ألبير قصيري، أنه كان يمضي الليل وهو مستيقظ وينام في النهار، وعاش حياته في فندق في باريس. وغيرهم الكثير؛ احتفظتُ بالكثير من الجرائد، وانتقلت معي أثناء سفري إلى بيروت واستقراري في دمشق سنة 2009.
في دمشق كنتُ أملك مكتبة جيدة، وجرائد تكفي لتغطي مدينة بأكملها؛ بعدها بثلاثة أعوام تقريباً، طلب مني أبي أن أستقبل في بيتي صديقين له لفترة قصيرة إلى أن ينتهوا من أعمالهم في وزارة الاقتصاد في دمشق. كان الوقت شتاءً، وفي بدايات الثورة السورية، كنتُ أشعر بالبرد كثيراً، ولا مجال للسهر لأن أصدقاء والدي كانوا من الذين ينامون باكراً ويستيقظون باكراً، ولا يوجد شيء أن ندفئ البيت به، لا تيار كهربائي، ولا وقود للمدفأة، والغرفة في الطابق الثاني غير جاهزة؛ وكنتُ أشفق على واحد منهم لأنه كان كبيراً في السن قليلاً وكنتُ أشعر انه يرتجف من البرد، حينها قررتُ أن أبدأ بحرق الجرائد والكتب لكي يدفئ البيت قليلاً، شعرتُ في نفسي بمرارة كبيرة ورغبة أكبر في حرقهم، لأن الثورة السورية بدأت تكبر حينها وشعرتُ أن الأمر لن يمر بسلام، ومن الأفضل أن أدفئ البيت قليلاً من أن يسرقه أحد، وبدأت من تلك الليلة أشعل الجرائد والكتب التي احتفظت بها على مر سنوات، مر شهر كانون الثاني وبعض الأيام من شباط ونحن نتدفأ بتلك الجرائد والكتب، إلى أن أتى اليوم الذي لم يبقَ فيه غير تلك الجرائد التي نشرت فيها نصوصي، وأحرقتُ بعضها واحتفظت بتسعة أعداد إلى اليوم، لكي أتذكر الهولوكوست الذي قمت به بجرائدي ومكتبتي وأتذكر تلك الأيام.








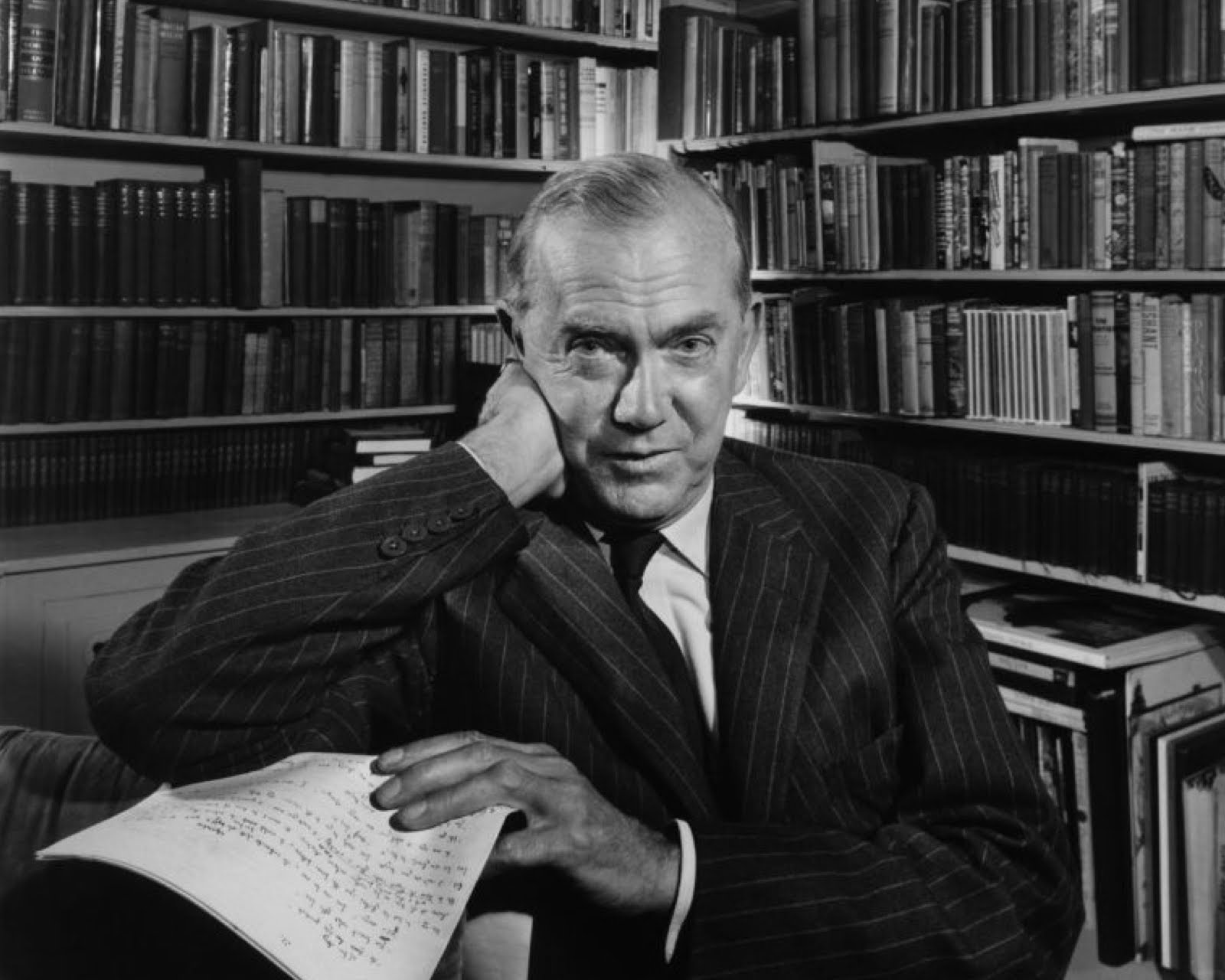

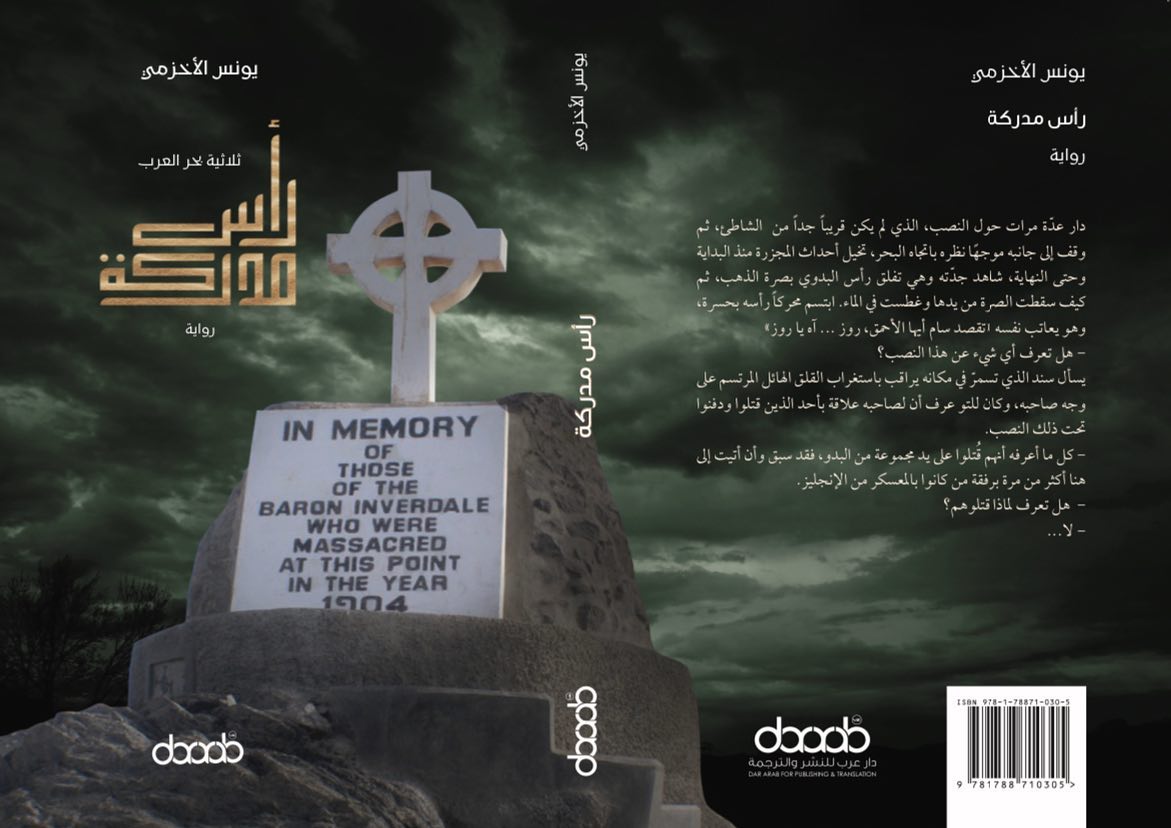



0 تعليقات